 بداية البدايات رسمت لنا أعمق تجليات بناء الحضارة الإنسانية انطلاقا من مخاض عسير في الصراع الإنساني، الذي حدث في الواقع اليومي للإنسان، رغبة منه وبحثا عن البقاء وتوفير حياة كريمة، هكذا وجد أول البشر نفسه في مجال صارعه وقاومه وتحداه، فذاته تعاني، تقاتل، تكدح وتعمل ثم تحارب لتحقيق نفسها وحماية مصالحها. فالحضارة بنيت على أكتاف المقاتلين وتصادم الذوات، مما ولد انفتاح المنغلقين عنوة وجلب أسس قوم لبناء ذات قوم آخرين ، فكانت الأمم بهذا تتسابق حول امتلاك أنجع الوسائل الحديثة في التفوق والعلو والإحساس بالقوة، غير أن صراع "الإنسان ألأول" مَهّد لمنطلقات ومسلمات إنسانية وفطرية طبعت ذات الدماغ الذي تأمل لأول مرة ليخطط ويتحضر ويتجاوز طبيعته الأولى ويحاول أن يتقدم، فتشكلت لنا معالم الوعي الدماغية للإنسان الأول وترسبت في عروق دماغه لتطابق فيما بعد ماهية ما نصطلح عليه "بالفطرة"، التي تشكل عليها الدماغ، لتصل الفطرة لتُميز أدوار الناس ووظائفهم في الحياة تحقيقا للاستمرارية والوجود وتجنبا للقتل والإبادة والتوحش، غير أن تطور البشرية في امتدادها التاريخي خلق لنا صراعا عكس لنا بداية تحلل الفطرة وأوجد معضلة "الإنفصام" في الذات البشرية، وهو "صراع الفطرة الدماغية مع العقل المبدع"، كما نعلم جميعا أن العقل الوضعي بنى نفسه وفق صيرورة طويلة، كانت ملامحها الأولى من أوروبا في تجاذبها الطرف مع الكنيسة والسلطة و تقسيم الأدوار في الحياة فيما تُعرفه الماركسية "بالطبقية"، وكذا الأنوار التي تحدت رموز التعاقد الذي وضعته "الحضارة" الأوروبية. عموما أين وصل الصراع اليوم بين الفطرة و"عقل الوضعية" اليوم؟
بداية البدايات رسمت لنا أعمق تجليات بناء الحضارة الإنسانية انطلاقا من مخاض عسير في الصراع الإنساني، الذي حدث في الواقع اليومي للإنسان، رغبة منه وبحثا عن البقاء وتوفير حياة كريمة، هكذا وجد أول البشر نفسه في مجال صارعه وقاومه وتحداه، فذاته تعاني، تقاتل، تكدح وتعمل ثم تحارب لتحقيق نفسها وحماية مصالحها. فالحضارة بنيت على أكتاف المقاتلين وتصادم الذوات، مما ولد انفتاح المنغلقين عنوة وجلب أسس قوم لبناء ذات قوم آخرين ، فكانت الأمم بهذا تتسابق حول امتلاك أنجع الوسائل الحديثة في التفوق والعلو والإحساس بالقوة، غير أن صراع "الإنسان ألأول" مَهّد لمنطلقات ومسلمات إنسانية وفطرية طبعت ذات الدماغ الذي تأمل لأول مرة ليخطط ويتحضر ويتجاوز طبيعته الأولى ويحاول أن يتقدم، فتشكلت لنا معالم الوعي الدماغية للإنسان الأول وترسبت في عروق دماغه لتطابق فيما بعد ماهية ما نصطلح عليه "بالفطرة"، التي تشكل عليها الدماغ، لتصل الفطرة لتُميز أدوار الناس ووظائفهم في الحياة تحقيقا للاستمرارية والوجود وتجنبا للقتل والإبادة والتوحش، غير أن تطور البشرية في امتدادها التاريخي خلق لنا صراعا عكس لنا بداية تحلل الفطرة وأوجد معضلة "الإنفصام" في الذات البشرية، وهو "صراع الفطرة الدماغية مع العقل المبدع"، كما نعلم جميعا أن العقل الوضعي بنى نفسه وفق صيرورة طويلة، كانت ملامحها الأولى من أوروبا في تجاذبها الطرف مع الكنيسة والسلطة و تقسيم الأدوار في الحياة فيما تُعرفه الماركسية "بالطبقية"، وكذا الأنوار التي تحدت رموز التعاقد الذي وضعته "الحضارة" الأوروبية. عموما أين وصل الصراع اليوم بين الفطرة و"عقل الوضعية" اليوم؟
أولا: الغرب
في مفهوم الحيرة ـ نادية عبد الجواد
 لئن أولت الفلسفة اهتماما بمضامين مجرَدة و كونيَة نسمَّيها مفهوما و توخت في معالجتها المنحى العقلي المنطقي الذي يسعى دائما للبحث عن تطابق ما مع الواقع من أجل الضفر بحقيقة يستقيم داخلها الوجود الإنساني كنسق أفلاطون مثلا فان ذلك جعلها تتعالى عن المسائل اليوميَة التي تمسَ الكيان الإنساني في صيرورته و تموضع الحياة موضعة تجمَدها و تجرَدها حتى تصير فكرة محضة و لا تطرح على نفسها كلَ ما يتعلَق بالذات و أعماق الإنسان و تشابكه بل تمرَ على اليوميَ مرورا غير إشكالي. و لعلَ ذلك ما فرَق الفلاسفة إلى فرقة هادمة للميتافيزيقا متجاوزة لها و أخرى محافظة تخشى على الفكر السقوط في حركيًة اليومية و فقدانه للمعنى.
لئن أولت الفلسفة اهتماما بمضامين مجرَدة و كونيَة نسمَّيها مفهوما و توخت في معالجتها المنحى العقلي المنطقي الذي يسعى دائما للبحث عن تطابق ما مع الواقع من أجل الضفر بحقيقة يستقيم داخلها الوجود الإنساني كنسق أفلاطون مثلا فان ذلك جعلها تتعالى عن المسائل اليوميَة التي تمسَ الكيان الإنساني في صيرورته و تموضع الحياة موضعة تجمَدها و تجرَدها حتى تصير فكرة محضة و لا تطرح على نفسها كلَ ما يتعلَق بالذات و أعماق الإنسان و تشابكه بل تمرَ على اليوميَ مرورا غير إشكالي. و لعلَ ذلك ما فرَق الفلاسفة إلى فرقة هادمة للميتافيزيقا متجاوزة لها و أخرى محافظة تخشى على الفكر السقوط في حركيًة اليومية و فقدانه للمعنى.
فمعرف الحيرة مثلا هو من المعارف التي لم تحض بالاهتمام من قبل الفلاسفة لكنَّها كانت منبثَة في أنساقهم, فهي من المسكوت عنه الذي بدأت الفلسفة المعاصرة في إماطة اللثام عنه و لعلَ ذلك ما سنقوم به ببيان التناول المتعالي الكلاسيكي لمعرف الحيرة و إن كان ثانويَا و التناول التفهَمي الفينومينولوجي الذي يلتفت إلى المسكوت عنه و يخلَصه من الصمت الذي غيَبه داخل تاريخ الفلسفة.
فمالحيرة ؟ و بأي معنى يمكن الحديث فلسفيا في شأنها ؟
مصير الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ما بين الجابري و أركون ـ المصطفى المصدوقي
 كانت المرحلة الكلاسيكية من تاريخ الإسلام،و التي تتطابق زمنيا مع فترة العصور الوسطى في الغرب،مليئة بالتساؤلات و الدراسات و المؤلفات العامة،إنها مرحلة التفكير العلمي و النقدي ،مرحلة المناظرات الحرة بين العلماء في الفكر الإسلامي.
كانت المرحلة الكلاسيكية من تاريخ الإسلام،و التي تتطابق زمنيا مع فترة العصور الوسطى في الغرب،مليئة بالتساؤلات و الدراسات و المؤلفات العامة،إنها مرحلة التفكير العلمي و النقدي ،مرحلة المناظرات الحرة بين العلماء في الفكر الإسلامي.
كانت الفلسفة قد شهدت ازدهارا ملحوظا ما بين عامي 150-450 هجرية،غير أن هذا الازدهار و النجاح سينحسر مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي/السابع الهجري،و مع هذا الانحسار سيبدأ العقل الإسلامي في الانسحاب من الساحة العلمية في الوقت الذي بدأ فيه الغرب بالازدهار.
و من أبلغ الأمثلة التي يمكن أن نضربها بهذا الصدد،مثل ابن رشد،إذ إن مؤلفاته أصابها النسيان و الفشل في المجتمعات العربية،بينما الفكر نفسه و المؤلفات نفسها ترجمت إلى اللاتينية و حظيت بنجاح متزايد في المجتمعات الأوروبية المسيحية حتى القرن السادس عشر.
فلماذا فشل الفكر الفلسفي في الفكر الإسلامي؟لماذا فشل ما كان مزدهرا قبل القرن 13 الميلادي و انسحب من الساحة الفكرية و العلمية؟ذلك هو السؤال الذي سيقود تحركاتنا في هذا المقال.
سؤال حاول كل من محمد عابد الجابري و محمد أركون أن يجيب عليه،كل بمنهجيته في التحليل و التفكيك.
«لقد ضرب الغزالي الفلسفة ضربة قاضية لم تقم لها بعده قائمة»هكذا كتب محمد عابد الجابري متحدثا عن مصير الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي.
قوة الحضور ومنطق النسيان ـ هادي معزوز
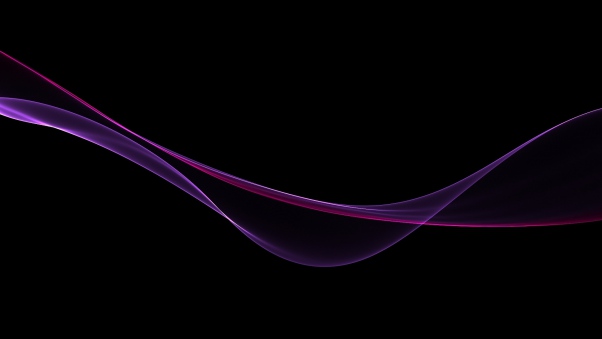 الحضور تذكر للتذكر، وحلول للمنسي فينا كحاضر، إنه تفوق لإرادة قوة من بين الإرادات المحتملة، وخروج للغائب من براثن النسيان نحو الوجود بما هو موجود en tant qu’étant، وحده الإنسان من يستطيع الإيمان بفكرة الحضور، ووحده هذا الكائن من تمكن من نسيان الحضور، أي حضوره كنسيان وليس كحضور، حيث لا تستقيم الحياة ومنطقها العابث إلا بواسطة هذا الأمر، وإن كان قدرا محتوما لوجودنا فإنه أيضا قتل لنفس الوجود، وإقبار لروح الانخراط في الوجود الأصيل، وليس الوجود المزيف الذي نعيش على أنقاضه لحد الساعة.
الحضور تذكر للتذكر، وحلول للمنسي فينا كحاضر، إنه تفوق لإرادة قوة من بين الإرادات المحتملة، وخروج للغائب من براثن النسيان نحو الوجود بما هو موجود en tant qu’étant، وحده الإنسان من يستطيع الإيمان بفكرة الحضور، ووحده هذا الكائن من تمكن من نسيان الحضور، أي حضوره كنسيان وليس كحضور، حيث لا تستقيم الحياة ومنطقها العابث إلا بواسطة هذا الأمر، وإن كان قدرا محتوما لوجودنا فإنه أيضا قتل لنفس الوجود، وإقبار لروح الانخراط في الوجود الأصيل، وليس الوجود المزيف الذي نعيش على أنقاضه لحد الساعة.
والنسيان على جانب ضِدِّيدٍ، سلاح ذو حدين، فهو الذي يقينا ألم التذكر، أي تذكر ما نريد نسيانه، كما أنه المسؤول عن نسياننا للوجود الأصيل وانغماسنا التام في الوجود المزيف، النسيان جوهر الحياة وضامنها الأول، إذ من خلاله نستمر في الحياة تفاديا للوقوف عند أكثر اللحظات بشاعة، وعند أشدها حزنا ووطأة على الوجدان، وهو في نفس الآن تخطي للماضي وتحرير لإرادة الحياة فينا، يؤكد نيتشه في مؤلفه considérations inactuelles بخصوص هذا الأمر: " في أصغر السعادات كما في أكبرها، هناك شيء من خلاله نعرف أن السعادة سعادة، والذي ليس سوى إمكانية النسيان la possibilité d’oublier، أو بعبارة أدق: ملكة الإحساس بالأشياء ومدى تعميرها خارج أي منظور تاريخي." من ثمة فلو كان الإنسان لا ينسى، أي أنه لا يمكن إلا أن يسكن اللحظة الواحدة، عندها تتجمد فيه إحداثيات الزمن، وآنذاك فقط يموت كإنسان ويموت أيضا كوجود، إننا ننسى لسبب بسيط ألا وهو الاستمرار في الحياة، كما ننسى أيضا هروبا من البشاعة، إن جوهر الذاكرة هو النسيان وليس التذكر كما يعتقد أغلب الناس، أو كما كانت تعتقد الفلسفة قبل نيتشه.
سؤال الرغبة والمتعة في التجارب الفلسفية الجديدة بالمغرب : تجربة عبد الصمد الكباص وحسن أوزال ـ ادريس شرود
 عندما نطرح سؤال الرغبة والمتعة، فإننا نستدعي ذلك المجهود الذي بذله مجموعة من الباحثين المغارية للإقتراب من الأسئلة الحقة للفكر والفلسفة. ذلك أن التفكير في الرغبة والمتعة، هو تفكير في الحياة، وفي إمكانية العيش على نحو آخر. في هذا السياق تتموضع مساهمات ثلة من الباحثين، يمثلون ما أطلق عليه الباحث عبد العزيز بومسهولي ب"التجارب الفلسفية الجديدة". ما يجمع هؤلاء الباحثين هو هم التجاوز؛ تجاوز ذلك التصور اللافلسفي للفلسفة بردها إلى تربتها الحقة كتجربة للفكر وحياة للكائن في الحاضر. فقد مضت عقود طويلة - يقول عبد الصمد الكباص- والإيديولوجيا تقدم كمنتوج مسجل تحت إسم الفلسفة بالمغرب. الشئ الذي فرض تحولا عميقا في قضية الفكر ومهمة الفلسفة، جعل من سؤال الحاضر والحق في الجسد، المنطلق الأول والأخير لكل تجربة فكرية أو وجودية. ولاقتحام هذه التجربة ، دعا الباحث حسن أوزال إلى مجاوزة سؤال ما الإنسان؟ باتجاه سؤال: كيف ينبغي للإنسان أن يحيا؟.
عندما نطرح سؤال الرغبة والمتعة، فإننا نستدعي ذلك المجهود الذي بذله مجموعة من الباحثين المغارية للإقتراب من الأسئلة الحقة للفكر والفلسفة. ذلك أن التفكير في الرغبة والمتعة، هو تفكير في الحياة، وفي إمكانية العيش على نحو آخر. في هذا السياق تتموضع مساهمات ثلة من الباحثين، يمثلون ما أطلق عليه الباحث عبد العزيز بومسهولي ب"التجارب الفلسفية الجديدة". ما يجمع هؤلاء الباحثين هو هم التجاوز؛ تجاوز ذلك التصور اللافلسفي للفلسفة بردها إلى تربتها الحقة كتجربة للفكر وحياة للكائن في الحاضر. فقد مضت عقود طويلة - يقول عبد الصمد الكباص- والإيديولوجيا تقدم كمنتوج مسجل تحت إسم الفلسفة بالمغرب. الشئ الذي فرض تحولا عميقا في قضية الفكر ومهمة الفلسفة، جعل من سؤال الحاضر والحق في الجسد، المنطلق الأول والأخير لكل تجربة فكرية أو وجودية. ولاقتحام هذه التجربة ، دعا الباحث حسن أوزال إلى مجاوزة سؤال ما الإنسان؟ باتجاه سؤال: كيف ينبغي للإنسان أن يحيا؟.
الجسد والتقنية: المفارقة المدهشة
أسارع إلى التأكيد على ذلك التحول الذي أصاب الإنسان والوجود مع سيادة التقنية وتطور العلم، والذي صار بموجبه المشروع الإنساني يدرك كجسد، أي كبناء مسترسل للرغبة (1)، وكرهان للمتعة(2)، وبالتالي كعلة تأسيسية(3). تزامن ذلك مع ظهور فلسفات رفعت تحديا كبيرا من أجل تحرير الرغبة وتحويلها من مجرد طاقة يحكمها قانون النقص، إلى شكل من امتلاك الحاضر الذي ينشده الكائن الحداثي(4). لكن تحقيق هذا المشروع محكوم بعمل التقنية نفسها، والتي لا تخضع لا للأمر الأخلاقي ولا للغاية الإيتيقية أو الإستطيقية.
ممكنات التدخل الفلسفي في الحاضرـ د.زهير الخويلدي
 "يجب أن ينبع الانخراط الفلسفي من خصوصية الفكر الفلسفي وأن يكرس حدوده ضمن هذا المعنى"1[1]
"يجب أن ينبع الانخراط الفلسفي من خصوصية الفكر الفلسفي وأن يكرس حدوده ضمن هذا المعنى"1[1]
من هو الفيلسوف على الوجه الحقيقي؟ ومن يحدد وجهه المطلوب ؟ هل هم نقاد الثقافة أم غيره من الفلاسفة ؟ ألا يضع إبداعه من ذاته ويستمد مشروعية وجوده من ريادته في مجاله وتوقيعه لأعماله؟
لا يوجد معيار متعال وقبلي يمكن اعتماده للتمييز بين الفلسفي وغير الفلسفي ولا توجد حقائق نهائية ومناهج تامة التكوين وإنما كل معدات الفلاسفة ملقاة على عارضة الطريق وتعبث بها رياح التغير وتسبح في يم الصيرورة ويظل الجميع ينتظر التغيرات العاصفة بأن تساعد على ولادة الفيلسوف بصورة فجائية.
ماهو بديهي أن المرء لا يولد فيلسوفا وأن الناس لا يعتنقوا الفلسفة مثل اعتناقهم للمعتقدات الدينية والأفكار السياسية وإنما يشتغلون بالفلسفة بحكم الظروف والوضعيات وأحوال الوجود التي يعيشونها في حياتهم.
يمارس العصر الذهبي الذي كانت فيه آراء الفلاسفة مهمة ومطلوبة وكانت نظرياتهم ذات قيمة إغراء كبيرا والسبب هو الاعتبار الذي كانت تلقاه مقترحاتهم ونصائحهم لتحسين الأوضاع والنظر إليها بوصفها بدائل ناجعة واستحسان رؤاهم وتمجيد أقوالهم بشأن الأحداث والتعامل معها على أنها جدية وحاسمة.
نهاية الفلسفة النسقية :عرض لوجهة نظر ريتشارد رورتي ـ عبد المنعم البري
 ماذا تعني نهاية الفلسفة؟ إنها تعني تجاوز شكل معين من الفلسفة لفتح المجال أمام شكل جديد. وفي هذا الاتجاه يقدم الفيلسوف الأمريكي المعاصر ريتشارد رورتي Richard Rorty (ولد عام 1931) مراجعة تفكيكية لمفهوم الفلسفة ولحدوده. ويصوغ تمييزات ومفاهيم جديدة يتم على هامشها تحديد الفعل الفلسفي، ويكشف عن الانزياحات التي تتعرض لها الثنائيات التقليدية التي تحكمت لمدة طويلة في تمييز هذا الفعل. وفي هذا الإطار تتقمص الفلسفة عنوانا جديدا استلهمه رورتي من هيرمينوطيقية الفيلسوف الألماني هانزجورج غادامير H.G. GADAMER (ولد عام 1900)، ومن وجودية الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر J.P.SARTRE (1905-1980) والفيلسوف الألماني مارتن هايدغر M.Heidegger (1889-1976). وهذا العنوان ذو الأصل الهيرمينوطيقو-وجودي هو: "الفلسفة المنشِّئة" La philosophie édifiante(*) .
ماذا تعني نهاية الفلسفة؟ إنها تعني تجاوز شكل معين من الفلسفة لفتح المجال أمام شكل جديد. وفي هذا الاتجاه يقدم الفيلسوف الأمريكي المعاصر ريتشارد رورتي Richard Rorty (ولد عام 1931) مراجعة تفكيكية لمفهوم الفلسفة ولحدوده. ويصوغ تمييزات ومفاهيم جديدة يتم على هامشها تحديد الفعل الفلسفي، ويكشف عن الانزياحات التي تتعرض لها الثنائيات التقليدية التي تحكمت لمدة طويلة في تمييز هذا الفعل. وفي هذا الإطار تتقمص الفلسفة عنوانا جديدا استلهمه رورتي من هيرمينوطيقية الفيلسوف الألماني هانزجورج غادامير H.G. GADAMER (ولد عام 1900)، ومن وجودية الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر J.P.SARTRE (1905-1980) والفيلسوف الألماني مارتن هايدغر M.Heidegger (1889-1976). وهذا العنوان ذو الأصل الهيرمينوطيقو-وجودي هو: "الفلسفة المنشِّئة" La philosophie édifiante(*) .
1 - الفلسفة المنشئة/الفلسفة النسقية.
ارتبطت الفلسفة مع إيمانويل كنط E. Kant (1724 - 1804) بنظرية المعرفة فأضحت تتبوأ رتبة "تأسيسية" جعلتها تنفرد بامتياز خاص عن بقية قطاعات الثقافة. وقبله مع رينه ديكارت R.Descartes (1596 -1650) وجون لوك J. Locke (1632-1704) تم اعتبار الفلسفة كحقل يمكن من تجاوز مستوى "الرأي" البسيط، ويفتح طرقا واضحة ومتميزة تقود نحو "اليقين"(1). وقبل ذلك بكثير كانت الفلسفة مع أفلاطون PLATON (حوالي: 427-347م) علما محصنا داخل أسوار أكاديمية رفعت على مدخلها جملة تخصيصية تقول: "لا يدخلها إلا من كان رياضيا". فحكم على الفلسفة أن تعيش على وتيرة الصرامة الرياضية والمنطقية التي تتعارض مع تفتح القول الشعري وحريته. إن هذه اللحظات الأفلاطونية والديكارتية والكنطية تؤكد أن تاريخ الفلسفة، ومعه تاريخ بقية المعارف، هو تاريخ لـ"نظرية المعرفة" ولاستبداداتها المرآوية(2).
الفلسفة وتدريس الفلسفةـ هادي معزوز
 " الكل باطل وكل شيء مباح."
" الكل باطل وكل شيء مباح."
ـ نيتشه ـ
" مالي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف. "
ـ ابن الفارض ـ
قد يكون من الوهم بمكان حصر الفلسفة في كتب الفلاسفة، واعتبار صرامتها الفكرية وبنائها المنطقي المتطرف شيئا يبعدنا عن كنه هذا العلم وعن جوهره، إذ قبل أن تكون الفلسفة مبحثا يهتم بمشاكل وجود الله وبداية العالم وخلود النفس، كانت دعوة صريحة إلى الحياة وحفلا بهيجا من خلاله نولد من جديد وبروح أخرى... الفلسفة فن عيش ورقص خارج منطق المألوف، إنها تريد منا أن نتمتع بخفة الإله الراقص على حد قول نيتشه، فنستحيل كائنات خفيفة لا تسعى إلى الوصول إلى الحقيقة على غرار ما يشاع على الفلسفة، وإنما إلى ربط علاقة حميمية والحياة، فأن تفهم الحياة مثلا، معناه أنك حولتها من معادلات صماء ومن تفسيرات جوفاء ومن تجارب عقيمة، إلى حفل وإلى لن ينتهي إلا كي يبدأ من جديد، إذ الفلسفة لا تسعى إلى تقديم الحلول وإنما للتعامل مع المشاكل كألعاب من خلالها نصبح أطفالا قادرين على إضفاء طابع اللهو على أكثر الأشكال جدية، مادام أول عدو لها هو اللعب، وإن كان لعباً غير بريء فإنه يعطينا درسا في الحياة، بقدر ما ينفلت من وهم كسب وبلوغ الحقيقة.
إمبراطوريّة الإرهاب ـ سلام زويدي
 كيف لنا أن نتعاطى مع مفهوم الإرهاب؟ وأي ضربٍ من القراءة تَقدر على النفاذ مسباريا إلى أصله وفصله ونشأته وتطوّره عبر الأحقاب التاريخيّة؟ هل نتعامل معه بمنطق الأركيولوجيا أم بمنطق الجينيالوجيا أم أن الأمر على ضوء الراهن الوهن يتطلّب قراءة ماديّة تاريخيّة تعكس المرحلة العليا التي وصلت إليها الرأسماليّة؟
كيف لنا أن نتعاطى مع مفهوم الإرهاب؟ وأي ضربٍ من القراءة تَقدر على النفاذ مسباريا إلى أصله وفصله ونشأته وتطوّره عبر الأحقاب التاريخيّة؟ هل نتعامل معه بمنطق الأركيولوجيا أم بمنطق الجينيالوجيا أم أن الأمر على ضوء الراهن الوهن يتطلّب قراءة ماديّة تاريخيّة تعكس المرحلة العليا التي وصلت إليها الرأسماليّة؟
لقد ارتأينا أن نباشر الإرهاب ونستأنف القول فيه فلسفيا من جهة جعله النصف المظلم من نظام الإمبراطوريّة المعولمة ، أي الجرح المتقرّح الذي لطالما سعى نُسّاخ العصر إلى إخفائه فجعل عنوان مداخلتي " إمبراطوريّة الإرهاب" هو في حقيقة الأمر دعوة إلى ضرورة تصريف الإرهاب في غير ذلك المصرف الدارج في الموروث الثقافي العربي، ومنه تحديد التناقضات الأساسية الفاعلة في صلب حركة التاريخ العالمي والمحدد للمهام المطروحة على القوى المناهضة للإرهاب، ذلك أن فهم إشكاليّة الإرهاب وتشخيصها يتطلّب في نظرنا تحديد الأطراف الفاعلة في الساحة العالميّة ومن ذلك فالإرهاب وفق هذا التمشي يُفهم في سياق حركة الاقتصاد السياسي الذي بات اقتصادا سياسيا معلوماتيا وهذا هو مضمون مداخلتي والذي فيه سأحاول المرور بالأطروحات التاليّة :
جمالية الفرد المبدع : التفكير في الحياة على نحو آخر ـ ادريس شرود
 حين قدم نيتشه مبدأي الخلق والفرح، كالشيء الأساسي في تعليم زرادشت، فثمة فعالية بشرية من وراء ذلك، مرتبطة بإرادة محررة ومرحة. وكلام نيتشه عن الإرادة، وخاصة إرادة القوة، لا علاقة لها بإرادة الهيمنة، بل بإرادة قوة خلاقة ووهابة من حيث الجوهر(1). إنها فعل إبداع لأفكار وإمكانيات جديدة للحياة، ورد فعل ضد معضلة الافتقار إلى الإبداع وإلى مقاومة الحاضر، كما يقول جيل دولوز. أكيد أن هذا الحاضر هو قيمة الوجود القصوى التي تتوجه لها كل إرادة أو معرفة من أجل إحداث تحويل في المنظور والحياة. الشيء الذي يفرض الشروع في قلب الأولويات والاهتمامات، بإعطاء الأهمية لدور الأفراد في تقرير مصيرهم، وتجريب قدراتهم واختياراتهم، وتنظيم وجودهم. ولإنجاز هذه المهمة، لابد من إبداء تصور عن فعل التفكير، قد يساهم في تغيير دلالة الفكر أو التفكير بشكل مختلف. لكن الانخراط في هذه الصيرورة، يقتضي العمل على الذات من أجل بنائها، كي تكون على استعداد لتعلم التفكير(2)، وتعلم الحياة .
حين قدم نيتشه مبدأي الخلق والفرح، كالشيء الأساسي في تعليم زرادشت، فثمة فعالية بشرية من وراء ذلك، مرتبطة بإرادة محررة ومرحة. وكلام نيتشه عن الإرادة، وخاصة إرادة القوة، لا علاقة لها بإرادة الهيمنة، بل بإرادة قوة خلاقة ووهابة من حيث الجوهر(1). إنها فعل إبداع لأفكار وإمكانيات جديدة للحياة، ورد فعل ضد معضلة الافتقار إلى الإبداع وإلى مقاومة الحاضر، كما يقول جيل دولوز. أكيد أن هذا الحاضر هو قيمة الوجود القصوى التي تتوجه لها كل إرادة أو معرفة من أجل إحداث تحويل في المنظور والحياة. الشيء الذي يفرض الشروع في قلب الأولويات والاهتمامات، بإعطاء الأهمية لدور الأفراد في تقرير مصيرهم، وتجريب قدراتهم واختياراتهم، وتنظيم وجودهم. ولإنجاز هذه المهمة، لابد من إبداء تصور عن فعل التفكير، قد يساهم في تغيير دلالة الفكر أو التفكير بشكل مختلف. لكن الانخراط في هذه الصيرورة، يقتضي العمل على الذات من أجل بنائها، كي تكون على استعداد لتعلم التفكير(2)، وتعلم الحياة .
مفهوم الجوهر في علم ما بعد الطبيعة عند ابن رشد من خلال مقالة "الزاي" من تفسير ما بعد الطبيعة ـ زريوحي صديق
 1 - مفهوم الجوهر في تاريخ الفلسفة:
1 - مفهوم الجوهر في تاريخ الفلسفة:
بالرغم من أن مفهوم الجوهر له علاقة بأكثر من مجال معرفي واحد، إذ أنه يضرب بجذوره في المنطق، والعلم الطبيعي إلا أنه في ما بعد الطبيعة يكتسي أهمية خاصة، لأن ما بعد الطبيعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الجوهر والعرض القوة والفعل، الواحد والكثرة "إن كون الشيء جوهرا أو عرضا هي القسمة الأولى التي ينقسم بها الوجود بما هو موجود…"(1) لذا فإن أرسطو خص هذا المفهوم بمجموعة من المقالات يمكن تسميتها" بمقالات الجوهر" استهلها بمقالة "الزاي" وهذه المقالة هي أول مقالة ابتدأ يفحص فيها عن الجوهر…(2).
لقد كان أرسطو كما يشير إلى ذلك ابن رشد واعيا بأهمية هذا المفهوم حيث اعتبره مسألة المسائل، والتي هيمنت على تاريخ الفلسفة كله إذ قد طرحها الفلاسفة السابقون عليه جميعا بدءا من طاليس، وانتهاء بأفلاطون لكن مع ذلك لم يقل فيها أحد منهم قولا برهانيا، ولم يصلوا إلى إدراك حقيقة الجوهر، بمعنى أنهم لم يتوصلوا إلى معرفة (الشيء الذي هو ماهية هذا الجوهر(3) فالموضوع الأساسي الذي شغل بال الفلاسفة هو: ما هو الوجود؟ ولما كان المعنى الأساسي والأولي للوجود هو عندما يعني "ما يوجد" أي عندما يعني الجوهر، فإن السؤال يصبح إذا ما هو الجوهر؟ هذا الجوهر الذي يؤكد بعض الفلاسفة (الايليون) إنه واحد، بينما يقول آخرون (الذريون) بأنه كثرة، تلك الكثرة التي هي بالنسبة للبعض متناهية ومحدودة العدد، وبالنسبة للبعض الآخر غير متناهية. "أما الجوهر فمن الناس من قال أنه واحد، ومنهم من قال إنه أكثر من واحد، ومنهم من قال أنها أشياء متناهية ومنهم من قال أنها غير متناهية"(4). والشيء الذي يجمع بين هؤلاء حسب ابن رشد، وذلك بالرغم من اختلافهم، هو كونهم جميعا ينزعون منزعا طبيعيا مما جعلهم "لم يشعروا من الأسباب الأربعة إلا بالمبادئ الهيولانية فقط…" بينما أرسطو سينحو منحى مخالفا هو البحث عن الصورة الأولى لجميع الموجودات والغاية الأخيرة، لأن كل موجود يملك صورته الخاصة والتي بفضلها يوجد كوحدة أنطولوجية متميزة مكتفية بذاتها.










