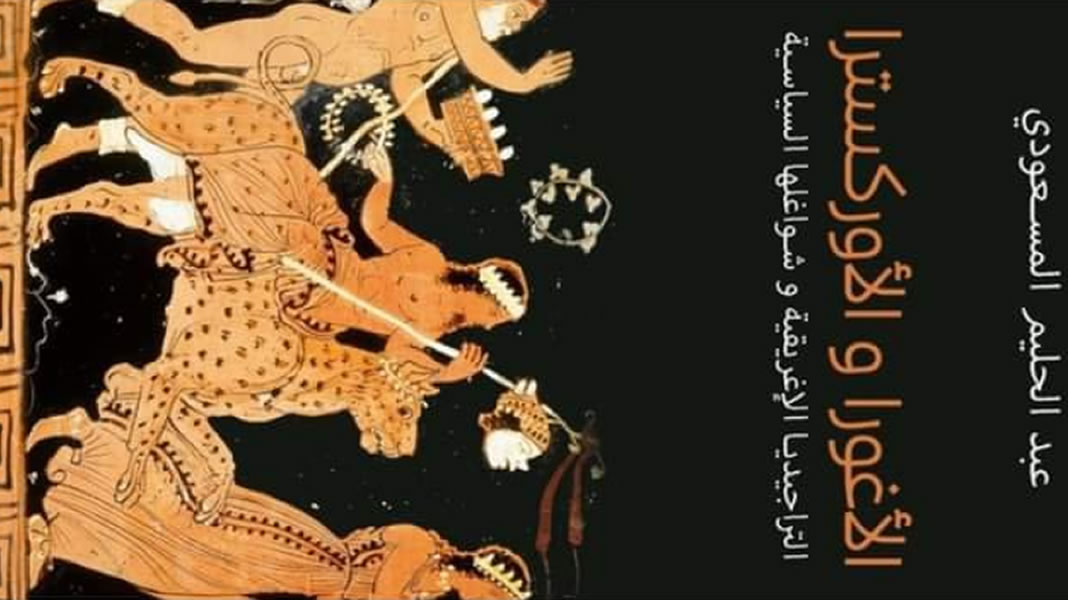الترجمة:
"ليس من السهل بالتأكيد تحليل هذا الكتاب الضخم، الكثيف، ضعيف التأليف - أو غير مؤلف على الإطلاق - والمكتوب بشكل سيء، والذي يُثير الإزعاج باستمرار تقريبًا بسبب مظهره المتعمد الذي يُصعّب مهمة القارئ، أو بسبب التناقض الذي نراه بين دقة التفاصيل السخيفة أو المتضخمة أحيانًا والغموض التام لإطاره وبنيته. هل نُكافأ في النهاية على صبرنا الطويل؟ لا نعلم حقًا. بعض الأفكار الحاسمة، سواءً فيما يتعلق بطبيعة الموضوع أو بأسس فكر سارتر، لا تُزيل خيبة أمل كبيرة. وهذه الخيبة لا تُجنّب جوهر العمل. ففي النهاية، بعد الانتهاء من هذه القراءة، وهذه القراءة المُعادَة لأكثر القراء إصرارًا، أين نحن؟ سيستغرق الأمر مئات الصفحات الأخرى لإلقاء نظرة خاطفة عليه. ولكن دعونا نحاول أن نُقيّم الوضع. ماذا يريد سارتر؟ تُخبرنا صفحتان من المقدمة. الماركسية هي الفلسفة الحية الوحيدة في عصرنا. لنفهم أنها وحدها تُجمّل هذه المرة وتجعلها مفهومة لنا. هي وحدها التي تُعبّر عن نفسها عن حركة الوجود والمعرفة التي تُشكّل عصرنا؛ عصر هو أيضًا، كأي عصر، تكرارٌ لكل العصور الأخرى. ومع ذلك، تفتقر الماركسية إلى أنثروبولوجيا أساسية، تختلف عن الطبيعية الساذجة والعقائدية التي غالبًا ما تُشكّلها. كما تفتقر - وهي مفارقة لا تقل إثارة للدهشة ولكنها مفهومة - إلى المفكرين الأصيلين والنشطين الذين سيسمحون لها بمواصلة العمل التأملي للشمولية في العصر الناشئ. ما يُطلق عليه سارتر، دون أوهام، "الأيديولوجية" الوجودية تنبع من هذه الثغرات التي يجب أن تُسدها. ولكن إذا كانت عيوب الماركسية قد ولّدت الوجودية، فإن الماركسية - لأنها "أيديولوجية" - يجب أن تُكافح الوجودية بنفس القدر. وهذا، علاوة على ذلك، هو ما يفعله. سيشرح الكتاب كيف يمكن التوفيق بين هذه الأطروحات، وكيف يمكننا في آنٍ واحد التأكيد على أن الماركسية هي حقيقة عصرنا، وأنها تفتقر إلى الأنثروبولوجيا، وأنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في حد ذاتها، وأن الأيديولوجية الوجودية، بتأسيسها واستكمالها، لا تنوي سوى الانغماس فيها، لا بل تغييرها. وستكون النقطة التي تتضح عندها هذه التأكيدات جليةً هي أيضًا نقطة إزالة الغموض التام. بل إننا نتساءل إن لم تكن كاملةً لدرجة أن لا شيء يفلت من هذا الوضوح. ومع ذلك، هل كان لكل هذه الطرق الملتوية، والتسويف، والعبثيات هدفٌ سريٌّ يتمثل في تأخير هذه الكارثة النهائية إلى أجلٍ غير مسمى تقريبًا: فالشر، في النهاية، لا يُقهر. كل ما تبقى هو محاربته ما استطعنا، وبكل الوسائل المتاحة. يبدأ الكتاب بسلسلة من المقالات، كانت في الأصل مخصصةً لمجلة بولندية، وأعادت نشرها مجلة "الأزمنة الحديثة". في الواقع، تفترض هذه المقالات أن المشكلات النظرية التي تناولها نقد العقل الجدلي نفسه قد حُلّت. بل إنها تهاجم فلسفة التاريخ التي تُمارسها الماركسية "المبتذلة" والمتصلبة اليوم؛ لذا تنطلق من فرضية إمكانية وجود فلسفة أخرى للتاريخ (وفلسفة تاريخ عامة)، فلسفة تاريخ لا تندرج، دون التخلي عن الماركسية، في فخ القبلية والشكلية ومثالية الأنماط الصرفة، أو بكلمة واحدة ، في فخ "المدرسية" التي كرّس لها لوكاش وغارودي وغوران، وغيرهم. ولكن هذا هو الاحتمال الذي يجب على نقد العقل الجدلي إثباته، وليس من المؤكد أنه سينجح. وأخيرًا، سيتذكر قراء سارتر المحنكون أنه، وفقًا لكتاب "الوجود والعدم"، يُعرّف مشروع الوجود في ذاته لذاته شغفًا لا طائل منه. ووفقًا لهذا المنظور نفسه، لا يُمكن تصوّر أي توافق نهائي بين الداخل والخارج. وهو ما يكفي - على ما يبدو - لجعل أي فلسفة "تجميعية" "تجميعية" على حد سواء "تجميعية" وعبثية. فكيف لنا أن نستغرب إذًا أن تكون "التجميعيات" مجردة، مقيدة، ثابتة، تزدري الملموس، "مثالية"، و"مدرسية"؟ صحيح أن الأمر بالنسبة لسارتر لا يتعدى "تجميعية" في طور التقدم، كليات في حالة اندماج، يجب استعادتها دائمًا. في أي ظروف تكون ممكنة؟
التراجيديا ومحن الولادة الغريبة: قراءة أولى في الأغورا والأوركسترا لعبد الحليم المسعودي - عبدالفتاح الكامل
الكتابة الأركيولوجية: تقويض الجدران واستنطاق التربة الأولى.
لم تكن التراجيديا الإغريقية ثمرة ولادة جمالية خالصة، إذ ظلت منذ نشأتها محاطة بالغموض والمفارقة. فهي لا تلوح إلينا كبداية فنية نقية، ولا كحالة تلقائية في المجتمع الأثيني، وإنما كحدث تأسيسي مضطرب، مشدود إلى إله مشبوه ومرفوض: ديونيزوس. كما أن صعوبة النفاذ إلى نواتها الأولى تعود إلى تشابك معطيات متباعدة حدَّ التناقض: تقاليد طقسية، تحوّلات سياسية، أشكال فرجوية، وممارسات ثقافية متداخلة، إذ تضافرت جميعها، رغم تنافرها، لتنتج التراجيديا كضرورة نفسية وجودية للفرد الإغريقي، وكتمثيل رمزي يتجاوز الذاتي والحسي ليبلغ تخوم السياسي وشروط الحكم.
في كتابه الأغورا والأوركسترا، يقترح عبد الحليم المسعودي قراءة مغايرة لهذا التأسيس، معتبرًا التراجيديا واقعة سياسية وثقافية قبل أن تكون فنًّا. فالعودة إلى هذا الشكل المسرحي لا تروم استعادة جوهر جمالي مفقود، بل تسعى إلى تفكيك سيرورة تأسيس هشّة، موسومة بالخوف من الأصل.
بهذا المعنى، لا تُفهم التراجيديا إلا ضمن محنة الظهور الأول، حيث تتقاطع الأسطورة مع السياسة، والمقدّس مع الخطر. ولعل هذا التأسيس المرتبك هو ما يجعل من سؤال الولادة مدخلًا نقديًا لا غنى عنه. فالمسرح لم ينبثق من مسار فجئي أو تراكم تاريخي فحسب، وإنما نشأ من ارتباك رمزي عميق لا يزال يشتغل فينا ويؤسّس وعينا إلى اليوم.
وقبل الولوج في أطروحة الأغورا والأوركسترا، تقتضي الضرورة الوقوف عند طبيعة الأداة والمنهج اللذين اعتمدهما المؤلّف في تشييد خطابه. فهو لا يقدّم عبر صفحات كتابه مقاربة تأريخية أو تأويلًا سرديًا خطيًا تقليديًا، متبنيا نمطًا من الكتابة يمكن وصفه بـ"الأركيولوجي"، مستلهمًا حفريات ميشيل فوكو وتقويضات ما بعد البنيوية. وبهذا التوجّه، يمتنع الباحث عن إعادة سرد تاريخ نشأة التراجيديا، ويتجه بدلًا من ذلك إلى مساءلة ما يُعتقد أنه تأسيس راسخ لها كفنّ "نبيل"، مرتبط بالفعل الأخلاقي والتطهير الأرسطي. ومن خلال تفكيك الطبقات التي راكمها العقل المسرحي الغربي، يعمل على كشف التوترات الأصلية التي طمسها النسق الكلاسيكي، وذلك عبر مساءلة أصول المعنى لا ظواهره.
وهو إذ يتبنّى هذا النمط من التشريح، لا يفعل ذلك بقصد إعادة البناء وفق سرد بديل، وإنما بهدف تقويض منطق التجانس الذي فرضه العقل الكلاسيكي، وفتح المجال أمام تشظّي المعاني وتعدّد القراءات. إنها كتابة تُفكّك التصوّرات المؤسِّسة التي رسّخت صورة التراجيديا كأداة للسمو الأخلاقي والتهذيب السياسي، من خلال تعرية التوترات التي طُمست تحت ركام التأويلات التقليدية. وبهذا المنظور، تُفهم التراجيديا لا كمجرّد شكل فنّي جمالي أو طقس جماعي، بل كبنية حاملة للعنف والقلق، تؤسّس لمساحات رمزية تضبط بها الجماعة ذاتها وتعيد إنتاج نظامها.
الطبيعة ونزعة التدّين البدائي - علي محمد اليوسف
يقول احد الفلاسفة المعاصرين في معرض حديثه عن تعالق الدين واللغة عند الفيلسوف بروديكوس، ( ان الانسان البدائي والذي بدا له ان كثيرا من الظواهر الطبيعية معادية له، ومع ذلك كان معجبا جدا بالهبات التي تزوده بها الطبيعة لتسهيل حياته ورفاهيته).(1)، وفي تعبير ظريف ليوربيدوس: ان الارض يجب ان تثمر شيئا لاطعام قطيعي سواء اكانت الطبيعة راضية ان تفعل ذلك ام لا.
هذه الطبيعة المادية في مجموع تكويناتها وتنوعاتها الارضية، لم تكن طبيعة جامدة (روحيا) بمعنى الثبات والسكون الفيزيقي الذي يعدم تساؤلات ما وراءها، تساؤلات الانسان الكائن النوعي في ذكائه المتفرد به عن باقي المخلوقات والكائنات، (عقليا - روحيا) خياليا تأمليا ميتافيزيقيا في ماوراء ظواهر الطبيعة المادية.
(ان مصير الانسان هو ارادته وتفكيره، وبمجرد ان يتخطى المرحلة البدائية، ويصبح كائنا يقرر مصيره على اسس وقوانين تتسم بالحكمة والعقل، عندئذ تظهر له الطبيعة والعالم كشيء يعتمد على فكره وارادته وتاثره بهما). (2)
وبحسب فيورباخ : حين يرتقي الانسان بفكره واداته فوق الطبيعة، فانه يصبح خارقا للطبيعة، ويصبح الاله ايضا خارقا للطبيعة.(3) هنا يتوجب التنبيه ان لا الخالق الغيبي في السماء، ولا الاله الانساني مجسدا بالانسان نفسه في محاولته تسيّد الطبيعة، يستطيع خرق قوانين الطبيعة لتلبية رغائب الانسان، ماعدا ماجاء كمعجزات منسوبة على ايدي الانبياء لتدعيم ايمان الناس بهم.اما الانسان العادي الذي لا يمتلك معجزة او معجزات فانه سيكون محكوما بقوانين الطبيعة في الزمان والمكان ولا يقوى على خرقها منذ بدء الخليقة.
فواصل فلسفية - علي محمد اليوسف
1. كثيرا ما ادين كوجيتو ديكارت " انا افكر اذن انا موجود" انه تغافل عن الموضوع، وعمد الى تجسيد الذات انطولوجيا على حساب تغييب الموضوع. ولما اراد منتقدوه تصحيح ما بدا لهم خطأ لدى ديكارت، قالوا بالوعي القصدي، بمعنى الوعي لا يكون الا حاملا لهدفه المرسوم سلفا. وعمدوا بذلك ضرورة ووجوب فصل الوعي عن فعالية التفكير وهو خطأ اشد فداحة من ادانة الكوجيتو الديكارتي في تغييبه الموضوع المفكر به. ونحن نجد ان الوعي وفعالية التفكير فعالية متداخلة لا يمكن الفصل بينهما، فالعقل لا يعقل تفكيريا واعيا شيئا لا معنى له. معنى ذلك ان فعالية التفكير تنعدم في تغييب الموضوع. لكن فعالية التفكير التي لاتنفصل عن موضوعها هي بحد ذاتها تحتوي موضوعها سواء افصحت بذلك ام لم تفصح كما فعل ديكارت. عليه ان الكوجيتو الديكارتي كاملا غير منقوص لا يمكن الطعن به.
من الطريف ان يقول رائد الفلسفة الوجودية الدانماركي سورين كيركجورد بغضب انا لا افكر اذن انا موجود. ونسبها الباحث الفلسفي جان فال الى روسو فهل هي زلة قلم ام تجنّي على كيركجورد في سرقة افكاره.
2. من خلال مقولة انجلز الدوغمائية اعتباره قوانين الطبيعة تعمل بآلية جدلية ديالكتيكية، بعيدا عن رغائب الانسان. نفس الخطأ وقع به هيجل قوله طبيعة العقل التفكيرية جدلية بالفطرة. التي ساناقشها لاحقا. ما معنى مقولة انجلز ان قوانين الطبيعة جدلية ديالكتيكية ثابتة كمعطى وجودي؟
- معناه مساواة قوانين الطبيعة مثل الجاذبية وسرعة الصوت وسرعة الضوء ودوران الارض الخ الخ، هي ذاتها قوانين الديالكتيك التي تحكم المادة والتاريخ التي هي ، قانون وحدة وصراع الاضداد، وتحول التراكم الكمي الى تراكم نوعي، وثالثا قانون نفي النفي. وهذا خطأ جسيم. لا يمكننا القول مطلقا ان قوانين الطبيعة يحكمها الجدل الديالكتيكي.
- قوانين الجدل الديالكتيكي متحركة التي يراد لها ان تعمل بنفس آلية عمل قوانين الطبيعة الثابتة، وهذا خطأ / فقوانين الطبيعة هي قوانين (فيزيائية) بخلاف قوانين الجدل الديالكتيكي فهي تعمل وفق شروط موضوعية معينة وهي ليست قوانين فيزيائية. بل هي تحكم المادة والتاريخ ولا تحكم الطبيعة ولا حتى في بعض تجليّاتها.
التوسير وكتاب راس المال - علي محمد اليوسف
بعدما جعلت الماركسية من الميراث المادي الهيجلي، فلسفة مثالية ابتذالية في تفسير المادة والتاريخ، وبعد ان اعتمدها ماركس بمنهج مادي جدلي مغاير محسن، اطلق مقولته الشهيرة بانه – ماركس – اوقف التفسير المثالي الهيجلي للتاريخ على قدميه بعد ان كان اوقفه (هيجل) مقلوبا على راسه. مختتما ماركس وصف (هيجل) بعبارة لاذعة، اوردها المفكر المجري جورج لوكاتش في فصل الكتاب الذي نعرض فيه الافكار: (ان تنبيه ماركس كي لانعتبر (هيجل) كلبا فاطسا، ظل حرفا ميتا للكثير من الماركسيين المخلصين)(1)، بهذه العبارة القاسية نعت ماركس الفيلسوف الذي انار له الطريق لاول مرة في التاريخ الفلسفي في تفسيره المادة والتاريخ ماديا جدليا، وساعد هيجل بمهمته الفلسفية الرائدة الخصبة ما اطلق على تسميتهم الشبان الالمان الهيجليين من ابرزهم فويرباخ، الذي لم يخلص هو الاخر من شتائم ماركس.
يمكننا ان نقرر منذ الان وهو ما سيتوضح معنا لاحقا بأن التوسير وما صدر عنه من افكار فلسفية واراء، اعتمدناها من كتاب محمد علي الكبسي/ قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر/ الفصل الأول: التوسير ومنطق الاختلاف. متعكزاً مسندا ظهره في الهجوم على مثالية (هيجل) المدانة مع فيلسوفها منذ قرنين تقريبا، مقدما قدما، مرجعا اخرى في الوثوب على كتاب راس المال الذي وصفه (ان راس المال لم يعد شيئا منتجا، بل حاملا لمفعولات العلاقات باعتباره بنية، فهو ابعد من ان يشير إلى الواقع لانه منتج للواقع من خلال قوانينه)(2).
لابد من التنبيه بان مصطلح (بنية) لدى التوسير يعني حامل العلاقات المنفرزة عن واقع معين، أو فاعلية معينة، وليست (البنية) كما نتداولها في ادبيات ثقافاتنا انها تموضع اجتماعي في الواقع، فمرة (البنية) عنده تمثل علاقات الانتاج وفي ثانية كما مر بنا هي مرادف (كتاب راس المال)، وهكذا....
الفكر واللغة تواصل معرفي لا جدلي في التعبير عن الأشياء - علي محمد اليوسف
عندما نجد ان وسيلتي العقل في الادراك ومعاملته الاشياء لا تتم من غير اعتماد العقل للحواس والفكر واللغة في ادراكه الشيء والتفكير به سواء كان التفكيرداخليا (صامتا) على شكل حوارفكري ذاتي داخل العقل(الدماغ)، او افصاحا عنه في التعبير اللغوي عن وجود الاشياء المادية في الواقع او الموضوعات المتخيّلة كناتج علاقة الذاكرة بالعقل قبل كل شيء.
والوجود المادي والوجود الافتراضي التخيّلي لايختلفان في الماهية او الجوهر وحسب، وانما هما يختلفان بلغة التعبيرعن كليهما، فالوجود المادي الواقعي في عالم الاشياء والمحسوسات الخارجي تعّبر عنه اللغة المنطوقة او المكتوبة، في حين ان الوجود الخيالي الذي ابتدعته الذاكرة كموضوع او مادة تفكير العقل وتخليقه الجديد له، لا تعبّر عنه اللغة التداولية نطقا او كتابة كما في التعبير عن الوجود المادي للاشياء في العالم الخارجي، بل يبتدع العقل وسائل توصيل خيالية جمالية هي غير وسائل التواصل اللغوي التداولية المسموعة او المكتوبة، مثل لغة رسم لوحة او نحت تشكيلي في الفنون والجمال التي هي لغة الابداع الخيالي الذي تكون فيه اللغة والفكر وجود مضمر في مضمون اللوحة او التشكيل الجمالي.فالتعبيرالفني الجمالي لا يحتاج اللغة التعبيرية الفكرية التواصلية المجتمعية في التعبير عن وجوده المادي. ولغة الجمال والفنون التشكيلية هي ما يطلق عليه اصطلاحا ما فوق اللغة. كونها تعطي المتلقي ايحاءات ادراكية ومرموزات تلغي معها خاصية الصوت التي تلازم اللغة الابجدية في امتلاكها التعبيري خاصيتي الصوت والمعنى المعبّر عنه . عليه يمكننا ايجاز تعريف اللغة على انها صوت له معنى.
يصبح تساؤلنا كيف يفكّر العقل وما وسيلة التفكير التي يعتمدها، تقودنا الى طريق مسدود عند عدم الاقرار ان وسيلة العقل في التفكير وادراك الاشياء لا يمكن ان تتم خارج فعالية الدماغ بتخليق موضوعاته وفي توظيفه الفكر – اللغة وسيلة التعبير عن مدركات العقل من وجود الاشياء في العالم الخارجي المستقل التي هي نفسها في داخل الدماغ تكون تفكيرا تجريديا يقوم بصنع الوعي المفهومي للمدركات الواصلة اليه ايضا.
لا يمكننا تمييز الفكرعن اللغة داخل فعالية العقل تخليق الافكار بالصمت التفكيري داخل العقل، وانما يتاح لنا ذلك في الوجود المستقل لادراك الاشياء خارج العقل التي يصدر العقل والجهاز العصبي التعبير عن وجودها الفكري – اللغوي بعد تخليق العقل لها من جديد كناتج اجابته عما وصله عن طريق الحواس من مدركات.
جولة للبحث عن مفهومي الحقيقة والحرية في قارة الفلسفة (الجزء الثالث والعشرون) - أحمد رباص
في اليقين الحسي، يكون اليقين والحقيقة متساويين، في هوية مباشرة: ما أنا متأكد منه صحيح. هذه الهوية، التي سنرى تفككها، لن يُعاد اكتشافها، كوسيطة، إلا في نهاية كتاب "ظاهريات الروح". ذلك لأنه من الواضح أن المعرفة التي هي معرفة اليقين الحسي تبدو أفقر بكثير من كونها ثرية: “مما تعرفه لا تقول إلا هذا: هذا هو؛ وحقيقتها لا تتضمن إلا وجود الشيء [المعني]” (174/63). إن المحتوى الموضوعي لليقين الحسي هو بلا شك غني بالنسبة للوعي في اللحظة التي يدركه فيها بشكل وثيق، ولكن من هذا المحتوى يقول فقط: "هذا هو". إن الوعي متأكد من "الشيء [ die Sache ]" الذي يدركه، لكن حقيقة هذا اليقين، كما ذكرنا، تظل غير محددة تماما. لا خصائص، لا مفاهيم ولا وصف؛ يصر هيغل على أن الشيء المستهدف باليقين الحسي لا يعرف بواسطة الفكر.
جانب الذات، الأنا المتيقنة من هذا، تبدو أنها غير محددة تماما، لأنه لا يمكن وصفها بخلاف الذات المفردة الخالصة، في علاقة مباشرة مع وجود مفرد. وبلغة هيجلية: الأنا، هذا الكائن، متيقنة من هذا الشيء، من هذا. ولذلك فإن اليقين الحسي، في طرفيه، هو علاقة مباشرة وفردية بحتة، حيث يتناسب وفقر الحقيقة المعروفة والمعلنة مع الغنى الذي يعتقد المقصود الذاتي أنه يدركه.
ولكن هناك أيضا فرقا، في مباشرية اليقين الحسي، بين مقصودي الذاتي والوجود المتعارض-مع. عبر عنه هيغل بطريقة غريبة على ما يبدو: “إن اليقين الحسي الفعال ليس فقط هذه المباشرية المحضة، بل هو شيء يأتي ليقوم على نفسه كمثال لذاته” (175/64). ويضيف على الفور أن "التنوع الرئيس" (١٧٥/ ٦٤) يتعلق بالتنوع الذي يميز بين هذا الشخص والهذا، اللذين "ينفصلان على الفور عن الوجود الخالص" ( المرجع نفسه ). هناك إذن جانبان، أحدهما ذاتي، والآخر موضوعي، وكلاهما "مثالان" للوجود المفرد والمباشر.
مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي - جوزيف جابل – ترجمة: د.زهير الخويلدي
الترجمة
"إن تاريخ الطبيعة، أو ما نسميه "العلوم الطبيعية"، لا يهمنا هنا؛ ولكن "سيتعين علينا أن نتعامل مع تاريخ البشر، لأن الأيديولوجية بأكملها تقريبًا قد تم تقليصها إما إلى مفهوم خاطئ لهذا التاريخ أو إلى تجريد كامل من هذا التاريخ. " (كارل ماركس: الأعمال الفلسفية، المجلد السادس، ص 153-154).
تتعلق مشكلة الوعي الزائف بالتاريخ الألماني الحديث بطريقتين. ومن ناحية أخرى، يعود الفضل في وضع الأسس الفلسفية لهذه المشكلة إلى المنظرين الماركسيين غير التقليديين في ألمانيا في عهد جمهورية فايمار. علاوة على ذلك، فإن العقيدة الاشتراكية الوطنية تمثل بلا شك مثالاً نموذجياً للأيديولوجية بالمعنى الماركسي للمصطلح، أي على وجه التحديد نظام أفكار غريب عن الواقع وحامل لوعي زائف. ومن الواضح أن هذا التفسير للاشتراكية الوطنية باعتبارها وعياً زائفاً له تأثير على مسألة المسؤولية الألمانية التي أثارت الكثير من الجدل، ولكن ليس من شأننا الخوض في تفاصيل هذه المسألة هنا. ومن المؤكد أن النقاد الألمان لكتابنا سوف ينظرون فيه ويناقشونه. إن وضع الماركسية ككل فيما يتصل بمشكلة الوعي الزائف مماثل. إن نظرية الأيديولوجية ونتيجتها، نظرية الوعي الزائف، هي من أصل ماركسي؛ إنها تشكل فصلاً - بالنسبة لنا الفصل الرئيسي - من مجال الاغتراب العظيم. ولكن إذا كانت الماركسية قد قدمت المقدمة لموقف نظري بشأن هذه المسألة، فإنها قدمت أيضاً توضيحها غير الطوعي: فلم يكن اغتراب الروح الإنسانية في أي مكان أكثر عمقاً مما كان عليه في الستالينية، ولم يكن أي شكل من أشكال الوعي السياسي أكثر زيفاً من هذا. لكن النظرية التي أصبحت أيديولوجية سياسية لا تستطيع أن تدين نفسها. وإلى جانب الوعي الزائف، فقد أصبح هذا بمثابة تبلور للطلاق بين الماركسية النظرية والماركسية السياسية؛ نقطة اللاعودة التي قد تتحول عندها الماركسية إلى نظرية مدمرة للذات.
جملة من الاستفسارات الفلسفية مع الذكاء الاصطناعي - د.زهير الخويلدي
تحية عطرة
تحية عطرة لك أيضاً! أتمنى أن تكون قد استمتعت بالمحادثة التي دارت بيننا. إذا كنت ترغب في مواصلة النقاش أو طرح أسئلة جديدة، فأنا هنا لمساعدتك. شكراً لك على الوقت الذي قضيته معي!
لدي بعض الاستفسارات
أنا هنا لمساعدتك! ما هي الاستفسارات التي لديك؟ هل هي متعلقة بموضوع معين أو فكرة محددة؟ أو ربما لديك أسئلة عامة؟ أنا هنا للإجابة على أسئلتك ومساعدتك في أي شيء تحتاجه.
1.ما قيمة الرؤى الأخلاقية للعالم في زمن العدمية واللايقين؟
الرؤى الأخلاقية للعالم في زمن العدمية واللايقين تحمل قيمة كبيرة، حيث يمكن أن تساعد في:
1. *توجيه السلوك البشري*: الرؤى الأخلاقية توفر إطارًا أخلاقيًا يمكن أن يوجّه السلوك البشري في مواجهة التحديات المعقدة.
2. *تعزيز القيم الإنسانية*: تساهم الرؤى الأخلاقية في تعزيز القيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.
3. *توفير منظور أخلاقي*: في زمن اللايقين، يمكن للرؤى الأخلاقية أن توفر منظورًا أخلاقيًا يمكن أن يساعد في فهم وتفسير الأحداث والقرارات.
4. *تعزيز الحوار والتفاهم*: الرؤى الأخلاقية يمكن أن تعزز الحوار والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات المختلفة.
5. *توجيه القرارات السياسية والاجتماعية*: الرؤى الأخلاقية يمكن أن توجّه القرارات السياسية والاجتماعية، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.
في زمن العدمية واللايقين، يمكن أن تكون الرؤى الأخلاقية بمثابة مرشد أخلاقي يمكن أن يساعد في فهم وتفسير العالم من حولنا.
جولة للبحث عن مفهومي الحقيقة والحرية في قارة الفلسفة (الجزء الثاني والعشرون) - أحمد رباص
لذلك يتم تعريف مفهوم الوعي من خلال تعارضين: من ناحية، تعارض الوعي والمتعارض مع (ob-jet) في مقابل الذات (في الألمانية Gegenstand تعني حرفيا ما يتعارض مع، ويحوله المترجمون إلى "ob-jet" وهم يحتفظون ب "objet" لكلمة ألمانية أخرى:Objekt)؛ تعارض المعرفة والحقيقة من ناحية أخرى. كل تعارض من هذه التعارضين يعطي لمفهوم الوعي معنى مختلفا. يكون له معنى ذاتي عندما يشير إلى نشاط معين للعقل، النشاط الذي من خلاله تميز الذات معرفتها عن الأشياء التي تتعلق بها: وهذا ما يمكن أن نسميه، في اللغة الهوسرلية، النشاط "الإدراكي النيوماتيكي" للوعي، الترابط بين الفعل الفكري "القصدي" والموضوع المقصود. لكن يجب أن يفهم الوعي أيضا بالمعنى الإبستيمولوجي، بموجبه يكون فهما عفويا من قبل العقل لما يشكل حقيقة تمثلاته، أو معرفته. وفقا لهذا التصور للحقيقة، تُعتبر الأشياء الخارجية مستقلة في حد ذاتها عن المعرفة، وهي في ذاتها يجب أن تتوافق معها المعرفة حتى تكون صحيحة. نصادف المفهوم التقليدي عن الحقيقة باعتبارها "توافق" المعرفة مع موضوعها. لماذا ننسب هذا التصور عن الحقيقة إلى الوعي؟ لأنها تُخضع معرفتها تلقائيا لمثل هذا الطلب على الحقيقة، والاهتمام بالدقة ( Richtigkeit ) في الاصطلاح الهيجلي.
يتم إذن تعريف مفهوم "الوعي" من خلال ثنائية مزدوجة: تنضاف إلى ثنائية الوعي وموضوعه ثنائية المعرفة والحقيقة. فقط الثنائية الثانية، ذات الطبيعة الإبستيمولوجية، هي موضوع النقد الذي تطور عبر "الفينومينولوجيا" وأدى إلى النتيجة التي صيغت في فصل “المعرفة المطلقة”: إنما في عرض المعرفة على شكل مفهوم، وليس في ما وراء المعرفة، ينبغي البحث عما يشكل أعلى درجة من حقيقة المعرفة (الدقة هي فقط أدنى درجة من الحقيقة). في مرحلة المعرفة المطلقة، سيتم القضاء على التعارضات المكونة للوعي، بين المعرفة والموضوع، المعرفة والحقيقة، الوجود-من-أجل-الوعي والوجود في ذاته. سوف يفسح الوعي المجال للعلم، للمفهوم الذي يُفهم على أنه وحدة الفكر والوجود:
"إذا كانت كل لحظة، في فينومينولوجيا الروح، هي الاختلاف بين المعرفة والحقيقة، وكذلك الحركة التي يتم فيها إزالة هذا الاختلاف، في المقابل، لا يحتوي العلم على مثل هذا الاختلاف وإزالته، لكن، بما أن للحظة شكل المفهوم، فهي تجمع بين الشكل التعارضي (obj-ectivale) للحقيقة وشكل الذات التي تعرف في وحدة مباشرة" (890/432).
شكل الوعي
نظريات سياسية حديثة ومعاصرة - د.زهير الخويلدي
تمهيد
يتكون الفكر السياسي في نسخته الحديثة والمعاصرة من جملة من الفرضيات والمقدمات والتي يترتب عنها وفق المنهجية الفرضية الاستنتاجية مجموعة من الاستتباعات والقواعد ويمكن ذكر حالة الطبيعة والوضع الاصلي والحالة المدينة والعقد الاجتماعي وكذلك البديل الرأسمالي والبديل الاشتراكي ومحاولة تدارك الأخطاء الناتجة عن البديلين سواء في نسخة العدالة التوزيعية او الليبارتارية. فماهو النموذج السياسي الأكثر نجاعة في زمن التحولات والأزمات المالية والبيئية والطبية التي تعصف بالدول؟
نظرية العقد الاجتماعي
عندما تُبرم اتفاقيةً ذات أهمية، فإنك عادةً ما توافق على شروطٍ مُحددة: تُوقّع عقدًا. هذا لمصلحتك، ولمصلح الطرف الآخر: فتوقعات الجميع واضحة، وكذلك عواقب عدم الوفاء بها. العقود شائعة، وقد جادل بعض المفكرين المؤثرين في العصر الفلسفي "الحديث" بأن المجتمع بأسره يُنشأ ويُنظّم بموجب عقد. اثنان من أبرز "مُنظّري العقد الاجتماعي" هما توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704 .[نشرح في هذه المداخلة أصول هذا التقليد، ولماذا يُنير مفهوم العقد التفكير في بنية المجتمع والحكومة.
حالة الطبيعة والعقد الأول
لمعرفة سبب سعينا إلى عقد، تخيّل لو لم يكن هناك عقد، ولا اتفاق، على ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع: لا قواعد، ولا قوانين، ولا سلطات. هذا ما يُسمى "حالة الطبيعة". كيف ستكون الحياة في حالة الطبيعة؟ يعتقد معظم الناس أنها ستكون سيئة للغاية: ففي النهاية، لن يكون هناك مسؤولون لمعاقبة أي شخص أساء إلينا، مما يؤدي إلى عدم وجود رادع للسلوك السيئ: يبدو أن كل رجل وامرأة وطفل سيتحمل مسؤوليته بنفسه. وصف هوبز الحياة في حالة الطبيعة بأنها "منعزلة، فقيرة، بغيضة، وحشية، وقصيرة". يصفها لوك بأنها حيث يمكن للجميع أن يكونوا قضاة ومحلفين في نزاعاتهم الخاصة، مما يعني أنهم يستطيعون أن يقرروا شخصيًا متى ظُلِموا وكيف يعاقبون الجاني؛ من الواضح أن هذا قد يخرج عن السيطرة.
تاريخيًا، ربما لم نكن في حالة طبيعية قط، لكن منظري العقد يستخدمون هذه الفكرة لشرح سبب استحسان قواعد المجتمع، أي العقد. فهو يسمح لنا بالعيش بسلام مع ضمان أنه لا يمكن لأحد أن يؤذينا ببساطة أو يأخذ ممتلكاتنا دون عواقب. يجادل منظرو العقود بأن معظم الناس سيدخلون بحرية في عقود لتأمين هذه المنافع. مع ذلك، للعقد بعض التكاليف: فلكي يحصل الجميع على مزايا مجتمع منظم، يوافقون على التخلي عن بعض المنافع التي كانوا يتمتعون بها في حالة الطبيعة. يقول هوبز إنه يجب علينا التخلي عن "حق الطبيعة" أو القدرة على الحكم بأنفسنا على ما يُعتبر "حفاظًا على وجودنا". هذا يعني أنه بإمكاننا قتل شخص ما والادعاء بأنه ساهم في "حفظ وجودنا"، سواء صدقنا أم لا. ويجادل لوك بأنه يجب علينا التخلي عن حقنا في أن نكون قاضيًا ومحلفًا في نزاعاتنا. لنفترض، من أجل منفعة متبادلة، أن الناس تعاقدوا لتكوين مجتمع ما. ما هي تفاصيل هذا العقد؟
اتفاقية تشكيل الحكومة
يحتاج المجتمع حديث التكوين إلى آلية لاتخاذ القرارات: من سيضع القواعد وينفذها؟ لا بد من إرساء هذه السلطة إذا أُريد للمجتمع الجديد أن يعمل معًا بسلام. يجادل هوبز بأن سلطة اتخاذ القرار الوحيدة يجب أن تكون حاكمًا جبارًا، يُطلق عليه اسم "التنين"، يحكم بالقوة حتى يخشى المواطنون أي شيء يقوله الحاكم. وكما يُذكّر هوبز قراءه بنذير شؤم: "والعهود أو العقود، بدون سيف، ليست سوى كلمات، ولا قوة لها على الإطلاق لحماية الإنسان". يعني العقد أن تُطيع الحاكم وقوانينه وإلا ستُعاني من عواقب وخيمة، كالسجن أو حتى الموت. يعكس اقتراح لوك لإنشاء الحكومة نهجًا أكثر ديمقراطية بمعنى حكم الأغلبية: "... كل إنسان، بموافقته مع الآخرين على تشكيل هيئة سياسية واحدة تحت حكومة واحدة، يُلزم نفسه... بالخضوع لقرار الأغلبية." ووفقًا للوك، فإن الوظيفة الأساسية للحكومة هي إقرار القوانين من خلال تصويت الأغلبية فيما يتعلق بحماية الحقوق، وخاصة حق الفرد في الملكية: "الغاية العظمى والرئيسية من خضوع الناس للحكومة هي الحفاظ على ممتلكاتهم." تتطلب الحكومة خضوعنا لسلطة شخص آخر. أما خضوعك لحكم شخص آخر، فيتطلب تضحية: فنحن نتخلى عن حق سن القوانين، وتطبيقها، ومعاقبة من يخالفها. وننقل هذه الحقوق إلى فرد أو جماعة تقوم بها نيابةً عنا. تُشكل هذه الأنشطة الأساسية الثلاثة - وضع القوانين، وتطبيقها، ومعاقبة من يخالفها - أساس فروع الحكومة الثلاثة الشائعة في العديد من البلدان.
تعريف الرأسمالية والاشتراكية
هل ينبغي أن يكون مجتمعنا رأسماليًا، أم اشتراكيًا، أم شيئًا بينهما؟ للحكم في هذا النقاش، يجب أن نفهم تعريفي "الرأسمالية" و"الاشتراكية".
التعريفات الأكاديمية
يكمن الفرق الجوهري بين الرأسمالية والاشتراكية في ملكية السلع الرأسمالية والتحكم فيها، أي الأصول (عادةً الآلات والمباني، مثل جزازات العشب وأجهزة الكمبيوتر والمصانع) التي تزيد من إنتاجية العمل، أو توفير السلع والخدمات. وبالتالي، فإن التعريفات الأكاديمية لـ "الرأسمالية" و"الاشتراكية" كنظم اقتصادية هي كما يلي:
الرأسمالية: نظام تكون فيه معظم أو جميع السلع الرأسمالية مملوكة ومسيطر عليها بشكل خاص: مملوكة ومسيطر عليها من قبل أفراد معينين، وليس من قبل المجتمع أو الحكومة.
الاشتراكية: نظام تكون فيه معظم أو جميع السلع الرأسمالية مملوكة ومسيطر عليها اجتماعيًا: مشتركة في مجتمع ويسيطر عليها ذلك المجتمع، وربما من قبل الحكومة.
لاحظ أن هذه التعريفات تتعلق بالسلع الرأسمالية، أو "الملكية الخاصة"؛ يمكن أن تكون السلع الاستهلاكية أو الممتلكات الشخصية، مثل القبعات العالية والبوريتو، مملوكة ملكية خاصة في معظم أشكال الاشتراكية. على النقيض من ذلك، في بعض أشكال الشيوعية والفوضوية، لا يمتلك أي شخص أي سلع ملكية خاصة؛ بل يستخدمها أو يمتلكها فقط. لاحظ أيضًا أن كلا التعريفين متوافقان من حيث المبدأ مع وجود حكومة في المجتمع أو عدم وجودها. لذلك تتميز الأنظمة الرأسمالية الواقعية دائمًا بخصائص أخرى:
انتشار العمل المأجور: يعمل معظم الناس مقابل أجر أو راتب محدد (بدلاً من حصة من أرباح الشركة)؛
انتشار الملكية الغائبة: لا يعمل معظم مالكي معظم السلع الرأسمالية باستخدامها (على سبيل المثال، لا يعمل معظم مالكي أسهم تويوتا في تصميم أو تجميع سيارات تويوتا)؛
دخل الملكية الخاصة: من الممكن كسب المال بمجرد التملك الخاص للعقارات، وليس بالعمل. (قد يقوم بعض الناس "بعمل" في إدارة محافظهم الاستثمارية الخاصة، ولكن حتى من ورث مثل هذه المحفظة ولم يفكر فيها مرتين سيظل قادرًا على تحصيل دخل منها). في المقابل، تتضمن الأنظمة الاشتراكية عملاً مأجورًا قليلًا أو معدومًا، أو ملكية غائبة، أو دخلًا من الملكية الخاصة. بدلًا من العمل المأجور ودخل الملكية الخاصة، قد يعمل الناس مقابل حصة من أرباح شركاتهم، أو قد يحصلون ببساطة على حصة من أرباح ثروة المجتمع، أو قد لا يكون هناك مال على الإطلاق ويأخذ الناس ببساطة ما يحتاجونه.
الأسواق الحرة واللوائح التنظيمية
من الشائع وصف اقتصادات السوق الحرة بأنها أكثر رأسمالية، والاقتصادات الأكثر تنظيمًا بأنها أكثر اشتراكية. ومع ذلك، من الممكن وجود نظام شديد التنظيم، ومع ذلك يكون رأس المال بأكمله مملوكًا للقطاع الخاص: فهناك عمل مأجور، وملكية غائبة، ودخل من الملكية الخاصة، ولكن هناك أيضًا العديد من القوانين التي تحكم العمل، وضرائب مرتفعة. وبالمثل، من الممكن وجود نظام اشتراكي غير منظم في معظمه. وبالمثل، فإن الاشتراكية ليست مرادفة لـ "دولة الرفاهية"، لأن المصطلح الأخير يشير إلى نظام قوانين يهدف إلى إفادة الفقراء والطبقة المتوسطة، ولا يذكر شيئًا محددًا عن من يملك معظم رأس المال. أما النظام الذي يكون فيه رأس المال بأكمله مملوكًا للقطاع الخاص ولكن مع وجود ضريبة دخل عالية، تُستخدم لشراء الخدمات للفقراء، فيمكن اعتباره "رأسماليًا". في الواقع، يمكن القول إن الاشتراكية الأناركية لا تحتوي على أي "لوائح" ولا دولة رفاهية على الإطلاق. لذلك، مع أن اعتبار اللوائح وبرامج الرعاية الاجتماعية اشتراكية ليس مُضلِّلاً عمومًا، إلا أن هذا ليس جزءًا من التعريفات الأكاديمية لـ"الرأسمالية" و"الاشتراكية".
تعريفات خاطئة
حتى الآن، تناولنا التعريفات الأكاديمية لـ"الرأسمالية" و"الاشتراكية". لكن هاتين الكلمتين تُستخدمان أيضًا بطرق أخرى. فلننظر إذن في تعريفين خاطئين:
الرأسمالية: نظام شرير لا يعمل إلا لصالح الأغنياء؛ ينتشر فيه الفقر المدقع وعدم المساواة على نطاق واسع؛ الجميع تقريبًا مستهلكون وجشعون، ولا يسعون إلا إلى جمع المزيد من الثروة؛ العمال مستعبدون لرؤسائهم؛ ولا أحد يحمي البيئة من التدهور.
الاشتراكية: نظام شرير يكون فيه المجتمع ديكتاتوريًا شموليًا؛ الجميع كسالى لأنهم يعلمون أنهم سيحصلون على أشياء مجانية؛ الاقتصاد في حالة من الفوضى، مع انتشار الهدر والفساد في كل مكان؛ الجميع مضطرون لمشاركة فرشاة أسنانهم؛ ويتم استبدال الدين التقليدي والعائلات بعبادة الدولة والحياة في مجتمعات الهيبيز.
هذه التعريفات "خاطئة" لعدم حيادها الكافي؛ إذ يكاد لا أحد يُقر صراحةً أيًا من النظامين الموصوفين، لذا يُعدّ استخدام هذه التعريفات مضيعة للوقت. من الممكن أن تؤدي الرأسمالية (التعريف الأكاديمي) حتمًا إلى الرأسمالية (التعريف الخاطئ)، أو العكس بالنسبة للاشتراكية. لكن هذا سؤال مفتوح وتجريبي - وهذا لا يعني أنه يجب تعريف "الرأسمالية" أو "الاشتراكية" بهذه الطريقة.
أمثلة من الحياة الواقعية؟
جميع المجتمعات الكبيرة كانت لديها اقتصادات مختلطة: بعضها رأسمالي وبعضها اشتراكي. ونتيجةً لذلك، يصعب النظر إلى المجتمعات الواقعية والقول إن فيها جانبًا جيدًا أو سيئًا بسبب الرأسمالية أو الاشتراكية. فنحن لا نعرف دائمًا أي جانب ننسب إليه الفضل أو نلومه. على سبيل المثال، جادل البعض بأن السبب الرئيسي للركود الكبير في الولايات المتحدة كان عدم كفاية التنظيم؛ بينما قال آخرون إنه كان التدخل الحكومي المفرط في سوق الإسكان. وبالمثل، قد يُلقي الناس باللوم على الرأسمالية أو الاشتراكية في بعض الأضرار، عندما يكون النظام المعني رأسماليًا بشكل عام، لكن الضرر ناتج عن جانب اشتراكي، أو العكس. على سبيل المثال، إذا جادل اشتراكي بأن الرأسمالية سيئة لأن نظام العدالة الجنائية غير عادل أو غير فعال، فيمكن لمؤيد الرأسمالية أن يرد بأن نظام العدالة الجنائية خاضع لسيطرة اجتماعية. من ناحية أخرى، إذا جادل مؤيد للرأسمالية بأن الاشتراكية سيئة لأن العديد من المسؤولين في الأنظمة الاشتراكية استخدموا ممتلكاتهم الخاصة لإثراء أنفسهم، فيمكن للاشتراكي أن يرد بأن ذلك لم يحدث إلا لأن النظام لم يكن اشتراكيًا بما فيه الكفاية. عندما تكون المصطلحات المهمة موضع خلاف حول تعريفاتها، فمن الأفضل تحديد التعريفات التي نشير إليها صراحةً. بما أن السمة الأساسية لهذا النقاش هي مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون الناس قادرين على امتلاك رأس المال الخاص أم لا، فيجب أن نبدأ بالتعريفات الأكاديمية. من الإنصاف لكلا الجانبين استخدام تعريفات حيادية وواسعة الانتشار إلى أقصى حد، ثم محاولة الإجابة على السؤال الأخلاقي والاجتماعي المتعلق بأي الترتيبات أفضل.
حجج لصالح الرأسمالية والاشتراكية
لنفترض أن لديّ عصا سحرية تُمكّنني من إنتاج 500 دونات في الساعة. أقول لك: "لنعقد صفقة. استخدم هذه العصا لإنتاج الدونات، ثم بِعها مقابل 500 دولار، وأعطني العائد. سأعطيك 10 دولارات مقابل كل ساعة تقضيها في هذا العمل. سأقضي هذا الوقت في لعب ألعاب الفيديو." يبدو نشاطي - لعب ألعاب الفيديو - سهلاً للغاية. وظيفتك تتطلب جهدًا أكبر بكثير. وقد أحصل في النهاية على أكثر من 10 دولارات مقابل كل ساعة عمل. كيف يكون هذا عادلاً؟
في القصة، تُشبه العصا السحرية السلع الرأسمالية: الأصول (عادةً الآلات والمباني، مثل الروبوتات وماكينات الخياطة وأجهزة الكمبيوتر والمصانع) التي تزيد من إنتاجية العمل، أو توفير السلع والخدمات. تشير التعريفات المعيارية لـ "الرأسمالية" و"الاشتراكية" إلى أن الأنظمة الرأسمالية، بشكل عام، تسمح للناس بامتلاك السلع الرأسمالية والتحكم فيها بشكل خاص، بينما لا تسمح الأنظمة الاشتراكية بذلك.
تميل الأنظمة الرأسمالية إلى احتواء العمل المأجور على نطاق واسع، والملكية الغائبة، ودخل الملكية؛ بينما لا تشمل الأنظمة الاشتراكية ذلك عمومًا. تُعدّ السلع الرأسمالية ذات أهمية أخلاقية. فكما هو الحال مع العصا السحرية، تُمكّن ملكية السلع الرأسمالية المرء من جني أموال طائلة دون عمل. في المقابل، يضطر الآخرون إلى العمل لكسب لقمة العيش. قد يكون هذا ظالمًا أو ضارًا.
يستعرض هذا المقال ويشرح الحجج الرئيسية في هذا النقاش.
الرأسمالية
تميل حجج الرأسمالية إلى القول بأنه من المفيد للمجتمع وجود حوافز لإنتاج وامتلاك واستخدام السلع الرأسمالية كالعصا السحرية، أو أنه من الخطأ منع الناس بالقوة من ذلك. فيما يلي أربع حجج للرأسمالية، مُلخصة بإيجاز:
(١) المنافسة: "عندما يتنافس الأفراد على الأرباح، فإن ذلك يعود بالنفع على المستهلك".
النقد: قد تُشجع المنافسة أيضًا على السلوك الأناني والاستغلالي. وقد توجد المنافسة أيضًا في بعض الأنظمة الاشتراكية.
(2) الحرية: "منع الناس من امتلاك رأس المال يُقيد حريتهم. وقد يُشكل الاستيلاء على دخلهم على شكل ضرائب سرقة".
النقد: ربما يُقيد امتلاك الملكية، في حد ذاته، الحرية، بمنع الآخرين من استخدامها. إذا أعلنتُ أنني أملك شيئًا ما، فقد أُعلن بذلك أنني سأجبرك على عدم استخدامه. وربما تتطلب "الحرية" القدرة على السعي وراء أهداف المرء الخاصة، والتي تتطلب بدورها قدرًا من الثروة. علاوة على ذلك، إذا كان على الناس الاختيار بين العمل والجوع، فقد لا يكون اختيارهم للعمل "حرًا" حقًا على أي حال. ويمكن القول إن التوزيع العام للثروة هو نتيجة "يانصيب طبيعي" تعسفي أخلاقيًا، والذي قد لا يمنح في الواقع حقوق ملكية صارمة على ممتلكات المرء. لم أختر مكان ولادتي، ولا ثروة والديّ، ولا مواهبي الطبيعية، التي تسمح لي باكتساب الثروة. لذا ربما لا يكون انتهاكًا لحقوقي أن آخذ بعضًا من تلك الممتلكات مني.
(3) الخيرات العامة: "عندما يجب مشاركة الأشياء، بما في ذلك رأس المال، مع الآخرين، فلا يوجد أحد لديه دافع قوي لإنتاجها. في المقابل، يزداد المجتمع فقرًا ويزداد العمل صعوبةً لعدم كفاءة الإنتاج.
النقد: قد يكون الناس مدفوعين لإنتاج رأس المال لأسباب إيثارية، أو قد يُجبرون على ذلك في بعض الأنظمة الاشتراكية. بعض الأنظمة التي يُفترض أنها اشتراكية تسمح بإنتاج مربح للسلع الرأسمالية.
(4) مأساة الموارد المشتركة: "عندما يكون رأس المال أو الموارد الطبيعية أو البيئة خاضعةً لسيطرة عامة، لا أحد لديه دافع قوي لحمايتها."
النقد: كما في السابق، قد يكون الناس مدفوعين بالإيثار. مع ذلك، قد تُصنف بعض الأنظمة ذات السيطرة الخاصة الجزئية على رأس المال على أنها اشتراكية.
الاشتراكية
تميل حجج الاشتراكية إلى القول بأنه من الظلم أو الضرر وجود نظام مثل قصة العصا السحرية، نظامٌ يعتمد على العمل المأجور ودخل الملكية على نطاق واسع. إليكم أربع حجج للاشتراكية، مُلخصة:
(1) العدالة: "من الظلم كسب المال بمجرد امتلاك رأس المال، وهو أمرٌ لا يُمكن تحقيقه إلا في النظام الرأسمالي".
النقد: ربما لا يكون للعدالة أهمية أخلاقية تُضاهي أهمية الموافقة، والحرية، وحقوق الملكية، أو النتائج الإيجابية. وربما يوافق العمال المأجورون على العمل، ويتمتع أصحاب رؤوس الأموال بحقوق ملكية على رؤوس أموالهم.
(2) عدم المساواة: "عندما يتمكن الناس من امتلاك رأس المال بشكل خاص، يُمكنهم استخدامه لزيادة ثروتهم مقارنةً بالفقراء، ويُترك العمال المأجورون أكثر فأكثر فقرًا مقارنةً بالأغنياء، مما يُفاقم عدم المساواة القائم بالفعل بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال المأجورين".
النقد: هذا ادعاء تجريبي قابل للنقاش. ولعلّ القدرة على امتلاك رأس المال الخاص تُشجّع الناس على الاستثمار في بناء السلع الرأسمالية، مما يُخفّض أسعار السلع والخدمات. علاوة على ذلك، ربما تُسيطر المصالح الخاصة الثرية على الاحتكارات التي تُمنح عادةً من خلال السيطرة الاجتماعية على رأس المال، مما يُلحق الضرر بالفقراء من خلال سنّ قوانين رجعية.
(3) العمل: "يُعزل العمال المأجورون عن عملهم، ويُستغَلّون، ويُحرمون من الحرية لأنهم مُلزمون بإطاعة أوامر رؤسائهم".
الانتقادات: إذا كان هذا الاغتراب والاستغلال ضارّين بالعمال، فلماذا يُوافقون على العمل؟ إذا كان الجواب "لأنهم سيُعانون من مشقة شديدة إن لم يفعلوا"، فإن هذا، بالمعنى الدقيق للكلمة، نقدٌ للسماح بالفقر، وليس نقدًا للسماح بالعمل المأجور.
(4) الأنانية: "عندما يتمكن الناس من امتلاك رأس المال بشكل خاص، فإنهم يسعون بأنانية إلى الربح فوق كل اعتبار، مما يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة، والتدهور البيئي، والصناعات غير المنتجة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والاستعمار، والقتل الجماعي، والعبودية".
النقد: هذه أيضًا ادعاءات تجريبية قابلة للنقاش. ربما عندما يُمنح الناس السيطرة على رأس المال المملوك اجتماعيًا، فإنهم ينتزعون منه ثروات شخصية بأنانية. ربما عندما تكون البيئة خاضعة لسيطرة اجتماعية، يكون لدى كل فرد دافع فردي للإفراط في الحصاد والتلويث.
قد يكون تدخل الدولة في الاقتصاد سببًا رئيسيًا لوجود الصناعات غير المنتجة، والتلوث، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأخيرًا، بعض أسوأ مرتكبي الشرور التاريخية هي الحكومات، وليست الشركات الخاصة.
نظرية العدالة كانصاف لجون راولز
بعض الناس مليارديرات، بينما يموت آخرون لأنهم فقراء للغاية ولا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام أو الدواء. في العديد من البلدان، يُحرم الناس من حقوق حرية التعبير، والمشاركة في الحياة السياسية، أو السعي وراء مهنة، بسبب جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو عوامل أخرى، بينما يتمتع مواطنوهم بهذه الحقوق. في العديد من المجتمعات، فإن أفضل ما يتنبأ بدخلك المستقبلي، أو ما إذا كنت ستلتحق بالجامعة، هو دخل والديك. يبدو للكثيرين أن هذه الحقائق غير عادلة. ويختلف آخرون: حتى لو كانت هذه الحقائق مؤسفة، فهي ليست قضايا عدالة. يجب أن توضح نظرية العدالة الناجحة سبب كون الظلم الواضح غير عادل، وأن تساعدنا في حل النزاعات الحالية. كان جون راولز (1921-2002) فيلسوفًا من جامعة هارفارد، اشتهر بكتابه "نظرية العدالة" (1971)، الذي حاول تعريف المجتمع العادل. تشير كل مناقشة أكاديمية معاصرة تقريبًا حول العدالة إلى "نظرية العدالة". تستعرض هذه المقالة موضوعاتها الرئيسية.
"الوضع الأصلي" و"ستار الجهالة":
كثيرًا ما يختلف العقلاء حول كيفية العيش، لكننا بحاجة إلى هيكلة المجتمع بطريقة يقبلها العقلاء فيه. يمكن للمواطنين أن يحاولوا الاتفاق جماعيًا على قواعد أساسية. لسنا بحاجة إلى تحديد كل تفصيلة: قد نهتم فقط بالقواعد المتعلقة بالمؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسية، مثل النظام القانوني والاقتصاد، التي تُشكل "البنية الأساسية" للمجتمع. كما يُعدّ الاتفاق الجماعي على البنية الأساسية للمجتمع مثالًا مثاليًا جذابًا. لكن بعض الناس أقوى من غيرهم: قد يكون بعضهم أكثر ثراءً، أو جزءًا من أغلبية اجتماعية. إذا استطاع الناس الهيمنة على المفاوضات بناءً على صفات، كما يصفها راولز، تعسفية أخلاقيًا، فهذا خطأ. لا يكتسب الناس هذه المزايا، بل يحصلون عليها بالصدفة. إن استغلال أي شخص لهذه المزايا غير المستحقة لمصلحته الخاصة أمرٌ غير عادل، ومصدرٌ للعديد من المظالم. هذا يُلهم ادعاء رولز المحوري بأن علينا أن نتصور العدالة "كإنصاف". ولتحديد الإنصاف، يُطور رولز مفهومين مهمين: الوضع الأصلي وحجاب الجهل. الوضع الأصلي هو وضع افتراضي: يسأل رولز عن القواعد والمؤسسات الاجتماعية التي سيوافق عليها الناس، ليس في نقاش فعلي، بل في ظل ظروف عادلة، حيث لا أحد يعلم ما إذا كانوا محظوظين. يتحقق الإنصاف من خلال حجاب الجهل، وهو أسلوب مُتخيل حيث يمتلك الأشخاص الذين يختارون البنية الأساسية للمجتمع ("المُتداولون") سمات أخلاقية تعسفية مخفية عنهم: بما أنهم لا يعرفون هذه السمات، فلا يمكن أن يكون أي قرار يتخذونه متحيزًا لصالحهم. مع ذلك، فإن المُتداولين ليسوا جاهلين بكل شيء. إنهم يعلمون أنهم مهتمون بمصلحتهم الذاتية، أي أنهم يريدون أكبر قدر ممكن مما يُسميه رولز الخيرات الأولية (الأشياء التي نريدها، بغض النظر عن شكل حياتنا المثالية). كما أنهم مدفوعون بشعورٍ ضئيلٍ بالعدالة: فهم يلتزمون بالقواعد التي تبدو عادلة، حتى لو التزم بها الآخرون. كما أنهم على درايةٍ بالحقائق الأساسية عن العلم والطبيعة البشرية.
مبادئ رولز للعدالة
يعتقد رولز أن المجتمع العادل سيتوافق مع القواعد التي يتفق عليها الجميع في الوضع الأصلي. ولأنهم يتداولون وراء ستار الجهل، فإن الناس لا يعرفون ظروفهم الشخصية، أو حتى نظرتهم للحياة الكريمة. وهذا يؤثر على أنواع النتائج التي سيؤيدونها: على سبيل المثال، سيكون من غير المنطقي أن يوافق المتداولون على مجتمع يتمتع فيه المسيحيون فقط بحقوق الملكية، لأنه إذا رُفع الستار، وتبين أنهم ليسوا مسيحيين، فسيؤثر ذلك سلبًا على آفاق حياتهم. وبالمثل، يُفترض أن المتداولين لن يختاروا مجتمعًا به ممارسات عنصرية أو جنسية أو غيرها من الممارسات التمييزية الجائرة، لأنهم قد يقعون، وراء الستار، في الجانب الخطأ من هذه السياسات. هذا يُفضي إلى مبدأ رولز الأول في العدالة: لجميع الناس الحق في المطالبة بنفس القدر من الحرية الذي يتمتع به الآخرون. كما يزعم راولز أيضًا أنه نظرًا لجهلهم الذي يتضمن جهلًا بالاحتمالات، فإن المداولين سيكونون حذرين للغاية، وسيطبقون ما يسميه مبدأ "التعظيم": سيهدفون إلى ضمان أن يكون أسوأ وضع ممكن قد ينتهي بهم الأمر فيه هو الأفضل قدر الإمكان من حيث السلع الأساسية. إذا تخيلنا أنفسنا مداولين، فقد ننجذب إلى فكرة المساواة التامة في السلع الأساسية. هذا يضمن، على الأقل، ألا يكون أحد أفضل حالًا منك لأسباب تعسفية. ومع ذلك، قد يكون بعض التفاوت مفيدًا: فإمكانية كسب المزيد قد تحفز الناس على العمل بجد أكبر، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد، وبالتالي زيادة إجمالي الثروة المتاحة. هذا ليس تأييدًا كاملًا للرأسمالية، كما يوضح مبدأ راولز الثاني، الذي يتناول التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. يتكون المبدأ الثاني من شقين:
أولًا، لن يتسامح الأشخاص في الوضع الأصلي مع التفاوتات إلا إذا لم تُخصص لهم الوظائف ذات الأجور الأعلى بشكل غير عادل. هذا يُعطينا مثالًا للمساواة العادلة في الفرص: لا يُسمح بأوجه عدم المساواة إلا إذا نشأت من خلال وظائف يتمتع فيها الأشخاص ذوو المواهب المتساوية بفرص متساوية في الحصول عليها. يتطلب هذا، على سبيل المثال، أن يحصل الشباب على فرص تعليمية متساوية تقريبًا؛ وإلا، فقد يُعيق الفرد الموهوب بسبب نقص المعرفة الأساسية، سواءً بمواهبه الخاصة أو بالعالم.
ثانيًا، بما أن منطقهم يحكمه مبدأ "التعظيم"، فإن المداولين لن يتسامحوا إلا مع أوجه عدم المساواة التي تُفيد الفئات الأكثر تضررًا: وبما أنهم، على حد علمهم، قد يكونون الأكثر تضررًا، فإن هذا يُعظم جودة أسوأ نتيجة ممكنة لهم. وهذا ما يُسمى بمبدأ الاختلاف.
هذه المبادئ مُرتبة، وهو ما يُخبرنا بما يجب فعله في حال تعارضها: الحرية المتساوية هي الأهم، ثم تكافؤ الفرص، وأخيرًا مبدأ الاختلاف. لذا، لا تخضع الحريات ولا الفرص لمبدأ الاختلاف.
العدالة التوزيعية: كيف ينبغي تخصيص الموارد؟
بينما نكتب هذا، تبلغ ثروة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، 188 مليار دولار. أي ما يزيد بنحو مليار دولار عن اليوم السابق. وهذا المليار دولار هو مبلغ أكبر مما كنت ستحصل عليه لو كنت تكسب 1000 دولار يوميًا، كل يوم، منذ وفاة المسيح. في الوقت نفسه، يعيش مئات الملايين من الناس حول العالم في فقر مدقع. وبالنسبة للكثيرين، فإن الفقر المدقع لا يفصلهم سوى فاتورة مستشفى أو حصاد فاشل. هذا مثال على توزيع الثروة والموارد الاقتصادية. هناك سلع أخرى ذات صلة هنا أيضًا، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان. توزيع هذه السلع مهم لأنه يساهم في رفاهيتنا. ومع ذلك، فإن هذه السلع القيّمة نادرة: كيف ينبغي توزيع السلع التي تساهم في الرفاهية؟ هذا هو سؤال العدالة التوزيعية.
المساواة
أحد المقترحات هو أن يحصل الجميع على السلع التي تؤدي إلى قدر متساوٍ تقريبًا من الرفاهية. وهذا ما يُسمى بالمساواة. قد تبدو المساواة عادلة: فالناس متساوون أخلاقيًا، لذا يجب أن يتمتعوا بقدر متساوٍ من الرفاهية. ان المساواة لا تعني دائمًا امتلاك نفس السلع تمامًا: يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض الحقائق المتعلقة بالأشخاص: على سبيل المثال، قد يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية إلى مزيد من المال لتحقيق نفس مستوى الرفاهية، مثلاً لدفع ثمن كرسي متحرك أو مرافق رعاية المسنين. لكن الاعتقاد بأن المساواة التوزيعية في حد ذاتها قيّمة له بعض الآثار غير البديهية. هذا يعني أنه من الأفضل أحيانًا جعل الناس أسوأ حالًا دون تحسين حال أي شخص: على سبيل المثال، إذا دمرت عاصفة منازل في منطقة غنية من المدينة، مما جعل الأغنياء أقرب إلى مستوى رفاهية الفقراء، يبدو أن المساواة تشير إلى أن هذا أمر جيد لأنه يجعل الأمور أكثر مساواة. لتجنب مثل هذه التداعيات، يجادل كثيرون بأن التفاوتات قد تكون مبررة أحيانًا. على سبيل المثال، بدأت النقاشات المعاصرة حول العدالة التوزيعية فعليًا مع نشر نظرية راولز في العدالة. اقترح راولز أن التفاوتات تكون مبررة إذا - وفقط إذا - أفادت الفئات الأقل ثراءً في المجتمع. لا تزال هذه وجهة نظر مساواتية، حيث يُنظر إلى التوزيع المتساوي على أنه الأساس، ويجب تبرير أي انحراف عنه.
على عكس راولز، رفض آخرون فكرة أن المساواة التوزيعية هي الأساس الأخلاقي تمامًا. نستعرض هنا بعض المبادئ المؤثرة التي دافع عنها الفلاسفة ردًا على مبدأ المساواة وتقديره للمساواة في العدالة التوزيعية.
الأولوية
ينص أحد بدائل مبدأ المساواة على أنه كلما قلّت السلع القيّمة التي يمتلكها الفرد، زادت أهمية السلع الإضافية: على سبيل المثال، ألف دولار إضافية تُهمّ شخصًا فقيرًا أكثر من ملياردير. لذا، إذا كان بإمكاني تقديم منفعة واحدة لشخص ذي مستوى رفاهية منخفض أو لشخص ذي مستوى رفاهية مرتفع، فمن المنطقي منحها للشخص ذي مستوى الرفاهية الأقل. تُسمى هذه النظرة بالأولوية. لا تُعنى الأولوية بعدم المساواة في حد ذاتها: بل تعني أن إعادة التوزيع يجب أن تصبّ غالبًا في صالح الأقل ثراءً. يُعطي أصحاب الأولوية أولويةً مُرجّحة، وليست مُطلقة، للأقل ثراءً. ومع ذلك، هذا يعني أنه إذا استطعنا إفادة الأغنياء بشكل كبير بتكلفة زهيدة على الفقراء، فإن هذه المنفعة قد تفوق أسبابنا لإفادة الفقراء. ولكن في معظم الحالات الواقعية، يُساعد أصحاب الأولوية الأقل ثراءً أولًا. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أنه من المهم للغاية ألا يعيش الناس في فقر، وهو ادعاء يختلف عن إعطاء أولوية مرجحة لاحتياجاتهم. وهذا يقودنا إلى الاقتراح الثالث: الكفاية.
الكفاية
هذا الاقتراح الثالث هو أن على كل فرد أن يحقق حدًا أدنى أو حدًا أدنى من بعض السلع القيّمة، مثل الدخل أو التعليم أو الرعاية الصحية. يجب أن يكون لدى كل فرد ما يكفي على الأقل للوصول إلى هذا الحد. وهذا ما يُسمى بمذهب الكفاية. تعتمد معقولية هذا المذهب على كيفية تطويره: ما الذي يُعد "امتلاكًا كافيًا"؟ الإجابات الشائعة هي أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية أو أن يكونوا راضين بما لديهم. تثير هذه الإجابات تساؤلاتٍ خاصة، مثل غموض معنى "الكفاية". لذلك يدافع البعض عن مبدأ الكفاية على أساس أننا نهتم بعدم المساواة لأن بعض الناس في وضعٍ سيء للغاية: فعندما نجد حالاتٍ من عدم المساواة المُقلقة، مثل التشرد في مجتمعٍ غني، فإن ما يُثير الاعتراض ليس فارق الثروة، بل كون المشردين في وضعٍ سيءٍ للغاية. من الاعتراضات المهمة على مبدأ الكفاية أنه يُفضّل رفع مستوى معيشة الناس فوق الحد الأدنى على أي منفعةٍ أخرى مُمكنة للآخرين: على سبيل المثال، منفعةٌ لشخصٍ واحدٍ تحت الحد الأدنى مباشرةً تُفضّل دائمًا على منفعة ألف شخصٍ فوق هذا الحد مباشرةً. يُعارض الكثيرون هذا الرأي. وجهة نظر أخيرة حول العدالة التوزيعية هي أنه يجب التركيز على كيفية حدوث التوزيعات، وليس على التوزيع نفسه. وهذا ما تنادي به الليبرالية. يقدم روبرت نوزيك مثال ويلت تشامبرلين الشهير. يجعلنا نوزيك نتخيل أناسًا يعطون ويلت دولارًا واحدًا من أموالهم الخاصة مجانًا لمشاهدته يلعب كرة السلة. في هذه الحالة، يحق لويلت الحصول على هذا المال شرعيًا، وبالتالي سيكون من الظلم أن تأخذ الحكومة جزءًا من أمواله، تحت التهديد بالقوة، لإعادة توزيعها. يجادل نوزيك، إذًا، بأنه إذا حُرمت حقوق الناس في اكتساب ونقل السلع - مستبعدين، على سبيل المثال، اكتساب أو نقل السلع باستخدام القوة أو السرقة أو الخداع - فلا يمكننا الاعتراض على مثل هذه التوزيعات باعتبارها غير عادلة، مهما كانت النتيجة النهائية. تعرضت الليبرالية لانتقادات شديدة. ومن المشكوك فيه ما إذا كان التوزيع الحالي للدخل والتعليم والرعاية الصحية، على سبيل المثال، ناتجًا عن أنواع المعاملات الطوعية التي يتطلبها الليبرتاريون.
حجة روبرت نوزيك "ويلت تشامبرلين" لدعم الليبارتارية
بعض الناس أغنياء، والبعض الآخر فقراء. هل هذا أمرٌ سيء؟ يجادل كثيرون بأنه من الظلم أن يكون المجتمع يعاني من تفاوتٍ عميق، وأن على الحكومة التدخل لتوزيع الثروة من فاحشي الثراء على الجميع. يخالف الفيلسوف روبرت نوزيك (1938-2002) هذا الرأي. فرغم أن إعادة توزيع الثروة قد تبدو منطقية، إلا أن نوزيك يعتقد أن قصة نجم كرة السلة ويلت تشامبرلين (1936-1999) تُظهر لماذا لا ينبغي للحكومة أن تأخذ من الأغنياء لمساعدة الآخرين. تشرح هذه المقالة حجة نوزيك التي يستخدمها لدعم "الليبرالية"، وهي وجهة نظره القائلة بأن دور الحكومة ليس إعادة توزيع الثروة، بل تعزيز الحرية.
. قصة ويلت تشامبرلين
تخيل أن تشامبرلين وقّع عقدًا مع فريقه لكرة السلة. يمنح العقد تشامبرلين ٢٥ سنتًا عن كل تذكرة مباعة للمباريات التي يشارك فيها. خلال موسم كرة السلة، يحضر مليون شخص لمشاهدة تشامبرلين. في نهاية الموسم، يصبح أغنى بمقدار ٢٥٠ ألف دولار عن ذي قبل. لا يبدو أن أحدًا يرتكب أي خطأ بدفعه لمشاهدة تشامبرلين. يحق للناس إنفاق أموالهم كما يحلو لهم. لا أحد يتضرر من هذا. لذا، إذا سمحت الحكومة للناس بإنفاق أموالهم بحرية، فلن يكون هناك ما يمنع أي شخص من تحقيق أقصى ثراء ممكن بناءً على موهبته أو اجتهاده أو حظه أو أي شيء آخر.
لا حدود للتفاوت
يجادل نوزيك بأنه بما أن أشخاصًا مثل تشامبرلين يمكنهم الثراء دون حدوث أي مكروه، فلا ينبغي أن يكون هناك حد لمدى تفاوت المجتمع. لا ينبغي للحكومة أن تتدخل لأخذ المال من أي شخص طالما أنه مُنح له بحرية من شخص امتلكه عن حق في المقام الأول. لذا، طالما لم يسرق أحد المال لإعطائه لتشامبرلين، فلا ينبغي للحكومة أن تأخذ أموال تشامبرلين.
منع التفاوت يُخنق الحرية
يجادل نوزيك بأن ضمان المساواة في الثروة يتطلب انتهاكًا غير مبرر للحرية. أي قدر من التفاوت نعتبره "مفرطًا" هو مستوى يمكن الوصول إليه بشيء مثل مثال تشامبرلين. لمنع المجتمع من الوصول إلى هذا التفاوت، يتعين على الحكومة منع المعاملات الحرة، أو إلغاؤها فورًا. سيتعين عليها إما أن تجعل توقيع تشامبرلين على صفقته أمرًا غير قانوني، أو أن تأخذ المال بمجرد كسبه. يعتقد نوزيك أن هذا التنظيم الصارم، أو الاستعادة المستمرة، سيكون ظالمًا. سيتعين على الحكومة أن تمنع الناس من القيام بأشياء مقبولة تمامًا، مثل دفع مبالغ إضافية لمراقبة تشامبرلين، وإلا سيتعين عليها مصادرة أمواله بمجرد كسبها. لكن من الخطأ تقييد الحرية بهذه الطريقة، أو مصادرة دخل تشامبرلين بهذه الطريقة. انه لا ينبغي للحكومة أن تحاول إعادة توزيع الثروة. وهذا صحيح حتى لو كان الوضع الناتج غير متكافئ للغاية، مثل تشامبرلين ثري في مجتمع فقير.
الليبارتارية
حجة نوزيك حول ويلت تشامبرلين هي إحدى الحجج التي يستخدمها للدفاع عن وجهة نظره القائلة بأن أفضل أنواع الحكومات هي تلك التي لا تتدخل في الحرية. دور الحكومة هو تعزيز حرية الجميع، وليس إعادة توزيع الثروة أو تعزيز المساواة الاقتصادية. لذلك، يُعرف نوزيك بأنه "ليبرالي". أحيانًا تُستخدم كلمة "ليبرالي" بمعنى آخر. لكن في الفلسفة السياسية، تشير إلى من يعتقدون أن على الحكومة تعزيز الحرية.يجادل بعض الليبرتاريين بأننا نحتاج إلى المساواة الاقتصادية للحفاظ على الحرية. لكن نوزيك يختلف معهم. تهدف حجة ويلت تشامبرلين التي يقدمها إلى إظهار أن تحقيق المساواة الاقتصادية من شأنه أن يتدخل في الحرية. تتناقض الليبرتارية مع الرأي الذي دافع عنه الفيلسوف جون راولز. يعتقد راولز أن الحكومة أكثر من مجرد مدافع عن الحرية. إنها أيضًا مشروع تعاوني. وبالتالي، يجب أن نوزع منافع هذا التعاون بشكل عادل، وهذا يشمل الدخل الذي يجنيه الناس في المجتمع. يرى رولز أن هذا يتطلب توزيعًا أقرب إلى المساواة، بدلًا من ترك الأغنياء يزدادون ثراءً.
الاعتراضات
وُجّهت اعتراضات عديدة على حجة نوزيك. أحد هذه الاعتراضات هو أن نوزيك مخطئ في ادعائه بأنه طالما تصرف الجميع بحرية، فلا حرج في النتيجة. ربما تؤدي بعض الخيارات الحرة إلى نتائج غير مقبولة. على سبيل المثال، عندما يصبح ويلت تشامبرلين أغنى بكثير من أي شخص آخر، يصبح قويًا ومؤثرًا. يمكنه شراء جميع الشقق وفرض إيجارات علينا للسكن فيها، مما يزيده ثراءً ويزيدنا فقرًا. يمكنه استثمار الأموال في مشاريع مربحة، واستخدام العائدات لتوسيع استثماراته. يمكنه نقل هذه الأموال إلى أبنائه الذين يفعلون الشيء نفسه. قد تكون النتيجة انقسامات طبقية عميقة تستمر قرونًا.لذا، يجادل البعض بأنه لمنعه من امتلاك سلطة مفرطة، يجب على الحكومة إعادة توزيع ثروته الزائدة. وإلا، فلن يكون الناس أحرارًا. سيُسيطر على حياتهم رجال أعمال مثل تشامبرلين وذريته.هناك اعتراض آخر يتمثل في أن نوزيك مُخطئ في ادعائه بأن التصرفات الحرة ستُفسد أي توزيع مُفضل للموارد. ربما يكون صحيحًا أننا لا نستطيع جميعًا الحصول على ثروة متساوية بعد خمس دقائق من انتهاء موسم كرة السلة إلا إذا استخدمت الحكومة يدًا غليظة لإعادة توزيع الأموال. ولكن ربما يكون من الأنسب ضمان تساوي الثروة على مدى فترة زمنية أطول. على سبيل المثال، ربما ينبغي على الحكومة ضمان حصولنا جميعًا على ثروة متساوية تقريبًا طوال حياتنا، بدلًا من تساويها في جميع الأوقات، بما في ذلك بعد موسم كرة السلة مباشرةً. يُمكن للحكومة فرض ضريبة إضافية بسيطة على ويلت تشامبرلين كل عام. ثم يُمكنها إنفاق هذه الأموال على أمور تُفيد الأقل ثراءً، مثل إعانات البطالة. بمرور الوقت، ستعود أموال تشامبرلين الإضافية من كرة السلة إلى الآخرين، مما يضمن المساواة طوال حياة الجميع، بدلًا من أن تُدفع مباشرةً بعد موسم كرة السلة. أثارت حجة ويلت تشامبرلين جدلاً واسعاً حول أنواع العلاقات القائمة (أو التي ينبغي أن تكون قائمة) بين الحكومة والحرية والموارد.ولأن هذا المثال يُبرز بفعالية مواضيع رئيسية، مثل كيفية تعارض الحرية مع التوزيعات المحددة، فقد ظلّ مثالاً خالداً في الفلسفة السياسية.
الخاتمة
يُرجّح أن العيش في ظل عقد أفضل من العيش في حالة الطبيعة. مع ذلك، تبقى بعض التساؤلات.
أولاً، عادةً ما نوافق صراحةً على العقود، لكننا لم نفعل شيئًا كهذا للمجتمع. إذا قيل إننا نوافق ضمنيًا، أي أننا وافقنا ضمنيًا، يُجيب لوك: "تكمن الصعوبة فيما يجب اعتباره موافقة ضمنية، وإلى أي مدى يُنظر إلى أي شخص على أنه قد وافق، وبالتالي خضع لأي حكومة، حيث لم يُبدِ أي تعبير عن ذلك على الإطلاق." لم نوافق صراحةً على أي عقد اجتماعي. هل يوافق المواطنون بمجرد التمتع بمزايا الأشياء التي لا تُتاح إلا بالعيش في المجتمع؟ على سبيل المثال، تُعدّ القدرة على القيادة على الطرق العامة ميزة. لكن هذا لا يتحقق إلا بوجود طرق ممولة حكوميًا. ما لم يرفض شخص ما القيادة على الطرق العامة، بقبوله هذه الميزة، فهل يُعتبر "موافقًا" ضمنيًا؟
يُعد مفهوم لوك للموافقة الضمنية إشكاليًا لأنه يفترض موافقةً مبنيةً على تلقينا منافع. ومع ذلك، تُعد الموافقة الصريحة مهمةً لأن هذا النوع من الموافقة هو علامةٌ على الدخول طواعيةً في عقد. غالبًا ما تكون الموافقة الصريحة بالغة الأهمية - لنأخذ الموافقة في العلاقات الجنسية - ولكن لا يتم الحصول عليها، أو حتى السعي إليها، للمشاركة في المجتمع والحصول على منافع منه.
وهناك مشكلةٌ ثانيةٌ أعمق في مفهوم العقد الاجتماعي، وهي من استُبعد ومن استُبعد. من لم يُسمح له بتوقيع العقد أو المساعدة في صياغته؟ في العديد من المجتمعات، تم استبعاد النساء وغير الأوروبيين عمدًا، وبالتأكيد لن يوافق العديد من الأفراد والمجموعات على الكثير من سياسات وممارسات الحكومات، سواءً في الماضي أو الحاضر.
يمكننا الآن أن نرى كيف يُمكن لنظرية راولز أن تُقيّم القضايا التي طُرحت سابقًا. على الأقل في مجتمعات محددة، يبدو أن كلاً منهما ينتهك مبادئ العدالة الأساسية، وبالتالي يُدان بالظلم. لذا، حتى لو رفضنا في نهاية المطاف نهج راولز، فإنه على الأقل يبدو أنه يقدم إجابات صحيحة بديهيًا في عدة قضايا مهمة، ولأسباب معقولة. من الصعب استخلاص استنتاجات عامة مبررة حول ماهية الرأسمالية أو الاشتراكية الصرفة عمليًا. لكن دراسة مزايا وعيوب كل نظام تُعطينا بعض التوجيهات حول ما إذا كان ينبغي لنا توجيه المجتمع في أيٍّ من الاتجاهين. بغض النظر عن وجهة النظر التي نؤيدها بشأن العدالة التوزيعية، فإن عالمنا الحالي لا يرقى إلى مستوى هذا المثل. عالمنا عالمٌ يسوده عدم المساواة وعدم الكفاية، ولكنه أيضًا عالمٌ يسوده الهدر والإسراف. ورغم اختلاف هذه النظريات، فإنها تتفق جميعها على أن التوزيعات الحالية بعيدة كل البعد عن العدالة، وبالتالي فإن تناول هذه القضايا بوعي وحكمة من شأنه أن يُسهم في تقريبنا من العدالة. فأين الحكمة في التبرير القانوني للنظام السياسي الاقتصادي الذي يعيد انتاج التفاوت بين الأفراد والجهات والدول والشعوب ويعيد تصدير الظلم الحضاري والأزمات الى الأمم المهزومة؟
كاتب فلسفي
المراجع
Beitz, Charles (1979) ‘Bounded Morality: Justice and the State in World Politics’ International Organization, 33: 405–424.
Carole Pateman, The Sexual Contract (Stanford University Press, 1988)
Charles W. Mills, The Racial Contract (Cornell University Press, 1997)
Daniels, Norman (2007), Just Health: Meeting Health Needs Fairly Cambridge University Press
Gauthier, David (1986) Morals by Agreement Oxford University Press
Gilbert, Margaret (2006) ‘Reconsidering Actual Contract Theory’ in A Theory of Political Obligation: Membership, Commitment, and the Bonds of Society. Oxford University Press. 215-238
Glover, Jonathan (1990) Utilitarianism and its Critics Macmillan Publishing
Harsanyi, John (1975) ‘Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality? A Critique of John Rawls’ Theory’ America Political Science Review 69(2): 594-606
Kant, Immanuel (1793) ‘On the common saying: this may be true in theory but it does not apply in practice’ in Kant’s Political Writings (1970), edited by Hans Reiss, translated by H. B. Nisbet. Cambridge University Press (61-93)
Hume, David (1738) A Treatise of Human Nature
John Locke, Second Treatise of Government (1690), ed. C.B. Macpherson (Hackett, 1980)
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (1762) (Penguin Books, 1968)
Jean-Jacques Rousseau, Discourse on the Origin of Inequality (1754) (Indianapolis: Hackett, 1992)
Mills, Charles (2009) ‘Rawls on Race/Race in Rawls’ The Southern Journal of Philosophy (2009): 161-184
Moller Okin, Susan (1989) Justice, Gender and the Family New York: Basic Books
Narveson, Jan (2001) The Libertarian Idea Broadview Press
Nozick, Robert (1974) Anarchy, State and Utopia Wiley-Blackwell
Nussbaum, Martha, (2006), Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge: Harvard University Press.
Rawls, John (2002) The Cambridge Companion to Rawls edited by Samuel Freeman. Cambridge: Cambridge University Press
Rawls, John (2005) Political Liberalism: Expanded Edition Columbia University Press
Rawls, John (1971) A Theory of Justice Cambridge, MA: Harvard University Press
Rawls, John (1999a) The Law of Peoples Cambridge, MA: Harvard University Press
Rawls, John (1999b) A Theory of Justice: Revised Edition Cambridge, MA: Harvard University Press
Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement Erin Kelly ed. Cambridge, MA: Harvard University Press
Rowlands, Mark (1997) ‘Contractarianism and Animal Rights’ Journal of Applied Philosophy 14 (3):235–247
Shelby, Tommie (2013) ‘Racial Realities and Corrective Justice: A Reply to Charles Mills’ Critical Philosophy of Race 1(2): 145-162.
Sen, Amartya, (1980), ‘Equality of What?’ in Tanner Lectures on Human Values, S. MacMurrin (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Sandel, Michael (1998) Liberalism and the Limits of Justice Cambridge: Cambridge University Press
Sen, Amartya (1992) Inequality Re-examined Cambridge, MA: Harvard University Press
Taylor, Charles (1985). ‘The nature and scope of distributive justice’ in Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2 Cambridge: Cambridge University Press: 289-317
Wenar, Leif, (2017) ‘John Rawls’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
Thomas Hobbes Leviathan (1651), ed. Michael Oakeshott (Simon and Schuster, 1962)
كاتب فلسفي