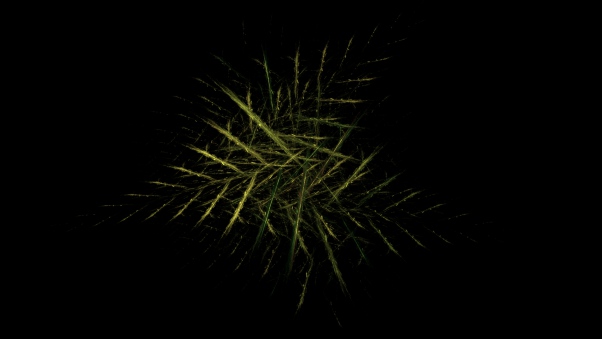 تقديم
تقديم
هناك إجماع حول أهمية الترجمة في حياة الشعوب والأمم، ودورها في التقريب بين الحضارات والثقافات وتفاهمها. لذلك نلاحظ تزايد الإهتمام بالترجمة، سواء من طرف أفراد ذاتيين أو مؤسسات رسمية. لكن عملية الترجمة تطرح إشكالات حقيقية حول دوافعها ومقتضياتها وغاياتها، الشيء الذي جعل منها قضية فلسفية. تجلى ذلك في النقاشات والجدالات التي ركزت حول أسئلة الأمانة والخيانة أثناء الترجمة، و الترجمة النهائية والنسخة طبق الأصل، واستعداد لغات لاستضافة نصوص ومتون لغات أجنبية متعددة ومختلفة. لكن ما يثير في قضية الترجمة، هو الهوة الفاصلة بين إعداد نصوص وكتب، وطبيعة التفاعل معها والتفكير بها، لا أقصد هنا القارئ فقط، بل المترجم ذاته. لهذا لا أستسيغ مقدمات وإهداءات وتعليقات عدد من المترجمين، التي تستبق عزيمة القارئ، لتذكره بهويته وثقافته وأخلاقه، وبتفوق حضارته وأبطالها، وبالتالي تقطع الطريق أمام قيام أي تفاعل أو توظيف أو إعمال فكر.
سأحاول في مقالتي هذه، إثارة ثلاث مواقف من الترجمة، وهي كالتالي: موقف الكاتب المترجم عبد السلام بنعبد العالي من المغرب، وموقف الأستاذ المترجم فتحي المسكيني من تونس، وموقف الأديب المترجم فيليكس فارس من لبنان.
عبد السلام بنعبد العالي: زهو الفكر في ازدهار الترجمة
في كل مرة يتناول فيها عبد السلام بعبد العالي قضية الترجمة، تجده متحمسا لسرد فضائلها البيداغوجية والتربوية والفلسفية، بل يجعل من الترجمة قضية الفلسفة. ففي كتابه "في الترجمة"، يؤكد على أن قضية الترجمة هي بلا منازع قضية الفلسفة...، هي هم الفكر في محاولته لإعادة قراءة تراثه وتجاوزه(1). فبالترجمة يتم تحويل النصوص والمتون، الشئ الذي يضمن حياتها وحياة اللغة والفكر في نفس الآن. وهي ما ينفخ الحياة في النصوص وينقلها من ثقافة إلى أخرى، من لغة إلى أخرى(2). وبهذا المعنى، تصير الترجمة استراتيجية لتوليد الفوارق، وإقحام الآخر في الذات، ووسيلة انفتاح وتحرر(3).
موت الفلسفة وحياتها ـ هادي معزوز
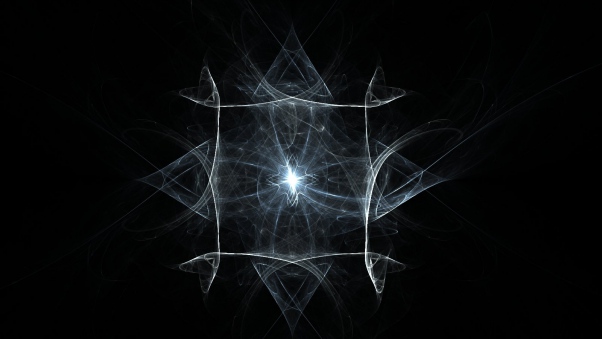 ليست الفلسفة ترفا كما يعتقد عامة القوم، بقدر ما أنها ليست فكرا أضحى من التراث الإنساني كما يرى بعض النقاد، لا وليس الفكر الفلسفي أداة نستعملها متى شئنا ثم نرفضها عندما نريد... إن أول إساءة للفلسفة كفكر تتجلى في اعتبارها تطاحنات فكرية أو عبارة عن أقاويل تسبح في بحر من المتناقضات التجريدية المحضة، بينما اعتبرت الفلسفة وعلى مر العصور تثمينا لمجهودات فكرية وعلمية وأدبية، وتتويجا لعصارة حضارة بعينها، الفكر الفلسفي فكر راق جدا، من ثمة كان من الصعب استيعابه لدى الحضارات التي لا تؤمن بتحرير العقل، ومنه فثقافة العبيد هي من عملت دوما على الحط من قيمة الفلسفة، هذا وإنه ليست في حاجة إلى من يدافع عنها، بقدر ما أنها تصور واقع ونمط وبنية تفكير كل ثقافة وكل فرد.
ليست الفلسفة ترفا كما يعتقد عامة القوم، بقدر ما أنها ليست فكرا أضحى من التراث الإنساني كما يرى بعض النقاد، لا وليس الفكر الفلسفي أداة نستعملها متى شئنا ثم نرفضها عندما نريد... إن أول إساءة للفلسفة كفكر تتجلى في اعتبارها تطاحنات فكرية أو عبارة عن أقاويل تسبح في بحر من المتناقضات التجريدية المحضة، بينما اعتبرت الفلسفة وعلى مر العصور تثمينا لمجهودات فكرية وعلمية وأدبية، وتتويجا لعصارة حضارة بعينها، الفكر الفلسفي فكر راق جدا، من ثمة كان من الصعب استيعابه لدى الحضارات التي لا تؤمن بتحرير العقل، ومنه فثقافة العبيد هي من عملت دوما على الحط من قيمة الفلسفة، هذا وإنه ليست في حاجة إلى من يدافع عنها، بقدر ما أنها تصور واقع ونمط وبنية تفكير كل ثقافة وكل فرد.
إن كل رافض للفلسفة إنما يرفض ضمنيا روح النقد، وحس المغامرة الفكرية، وتحرير العقل من التبعية والقصور الفكري، هذا علما أن نفس الفكر ليس بمثابة بضاعة قد نختارها أو نرفضها وفق اختياراتنا، ومنه فبدل أن تضعنا الفلسفة بين الرفض والقبول، يمكن أن تسقطنا في ثنائية الخوف والإقدام، الفلسفة إقدام وشجاعة، إنها انفلاتات الفكر نحو التأسيس لفكر آخر، وبناء للهوية كاختلاف وليس كثبات، وتقويض للنموذج الواحد لصالح النماذج المتعددة، وخلخلة للمركز نحو العودة إلى الهامش، ودحض للخطاب الوحيد نحو الخطابات المتعددة، وتفكيك للنص المستبد لصالح النص المنفتح المتغير، وهدم للطمأنينة إرساءً لمنطق الانتقال والترحال نحو المجهول، ربما لهذا الأمر يخاف منها المفكر التوتاليتاري، مثلما يتوجس منها العاجز عن التفكير، وبقدر ما يرتعب منها حارس وقاضي الفكر، بقدر ما توقظ مضجع الجاهل فكريا، ومنه فقد توجب التذكير بأنه كلما عم الجهل غابت الفلسفة، وكلما ساد التخلف كنا بحاجة إليها، وكلما حلمنا أكثر كلما كان حضورها أكبر.
العدالة عند باسكال: القوة (ملكة العالم)، و المخيلة ، و العادة ـ حميد الساكر
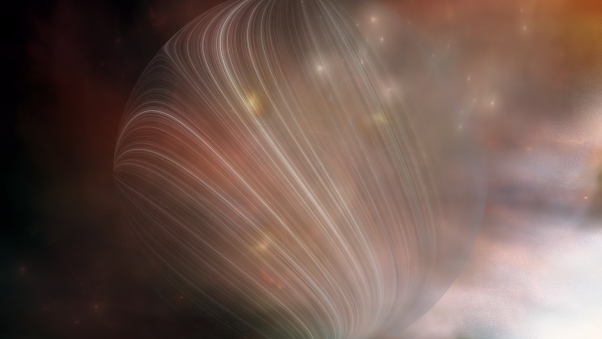 من النافل القول بادئ ذي بدئ، أنه لا يمكن أن نفصل الآراء السياسية لباسكال عن سياقها التاريخي_السياسي الذي أنشأها، و تأسيسا على ذلك، سنعمل في الجملة الأولى من هذا القول على استعراض هذا السياق، على أن نتحرى في ذلك أوجز القول و أخصره، لنصرف الاهتمام في الجملة الثانية لاستعراض آراء باسكال السياسية من خلال "الخواطر"، و المرتبطة هاهنا بالمفاهيم السالفة الذكر، على أن نعمل في الجملة الأخيرة على بلورة خلاصة ممكنة لهذا القول.
من النافل القول بادئ ذي بدئ، أنه لا يمكن أن نفصل الآراء السياسية لباسكال عن سياقها التاريخي_السياسي الذي أنشأها، و تأسيسا على ذلك، سنعمل في الجملة الأولى من هذا القول على استعراض هذا السياق، على أن نتحرى في ذلك أوجز القول و أخصره، لنصرف الاهتمام في الجملة الثانية لاستعراض آراء باسكال السياسية من خلال "الخواطر"، و المرتبطة هاهنا بالمفاهيم السالفة الذكر، على أن نعمل في الجملة الأخيرة على بلورة خلاصة ممكنة لهذا القول.
إذا كانت الحرب المدنية هي أسوء المآسي بالنسبة لباسكال، فذلك يمكن أن يرد ، بشكل جزئي، إلى أن أحزمة البنادق قد احتدمت ما بين (1648-1652 ) ،كما أنه إن كان يدافع بمرارة عن الأخلاق المسيحية، فلأن " لويس 14" ، بدعم اليسوعيينJésuites، حارب "بوررويال" الذي كان يُتصور كمكان للنقاد وللعداء، و للاستقلال المطلوب ضدا على سلطته الشخصية المطلقة.[1]
من جهة أخرى، هناك كتابين اثنين أثرا بشكل كبير في باسكال: " المحاولات"Essais" لمونتين، و بالخصوص[ " الدفاع عن "وريمون سبوند"Raymond Sebond ]، و" مدينة الله" للقديس أوغسطين. الأول، يذهب إلى أن القوانين و العادات هي نسبية و مستقلة عن كل عقلانية، ذلك أن " مونتين" يندرج ضمن تيار الشكوكيين الجدد « Néosceptique »لعصره، الذي يعيد التساؤل حول الوصية الأرسطية، المتمثلة في اكتشاف عالم جديد و حروب الأديان[2]، أما الثاني؛ فيعيد فكرة أن المدينة الحقيقية الوحيدة هي المدينة المسيحية، أي مدينة الله.
مفهوم الحقيقة عند تشالز ساندرس برس : الحقيقة المجتمعية ـ مفتاح محمد
 تمهيد :
تمهيد :
حينما يريد الباحث أن يشخص مفهوم الحقيقة عند ش. س. برس فإنه يقع في مسالك ضيقة نظرا لأن هذا المنطقي والرياضي والميتافيزيقي متعدد الأبعاد متنوع التفكير كثير الكتابة، فإذا أجمع الباحثون على أنه أهـم فلاسفة أمريكا في العصر الحديث، أو على الأقـل من أهمهم فإنـهم لا يتفقون في تشخيص آرائه وإثبات تماسكها وانسجامها.
إلا أن ما كاد الرأي يستقر عليه هو أن برس تَبَنَّـى موقفا نقديا مناوئا للميتافيزيقا التقليدية، وأنه هو مؤسس المذهب الذرائعي أو الذرائعاني، وخصوصا في أعماله الأخيرة، مع التنبيه إلى أن تحقيب تفكيره يختلف من باحث إلى آخر. على أن كثيرا من الآراء تميل إلى أن برس يتميز تفكيره الذي صاغـه فيما بعد 11907عما قبل هذا التاريخ، وما دام إشكالنـا هو البحث عن الموقف من ميتافيزيقيا الحقيقة فإننا سنَتَبَنَّـى هذا التقسيم. وسندعو المرحلة الأولى بالاسمية، والمرحلة الثانية بالواقعية مع التسليم بامتداد تفكير المرحلة الأولى في المرحلة الثانية.
I ـ المرحلة الاسمية
يمكن اعتبار هذا التحقيب قسمة كبرى يحتوي كل طرف منها على حقب صغرى. وهذا ما فعله كثير من الباحثين. ولـهذا رصدت ثلاث حقب أساسية :
1 ـ الحقبة الأولى:
الحقبة الأولى هي الكانتية (1855 ـ 1870) حيث راجع فيها المقولات الكانتية مثل العلاقة والكمية والكيفية، والجهة، وهي مقولات مستمدة من المنطق الأرسطي القديم، وهي تتشاكل مع الكلية، والإثبات، والجزم، والإمكان. ولكن مراجعته بقيت ضمن الإطار المنطقي الأرسطي فأبقى على مقولة العلاقة ومقولتي جهتي الإمكان والضرورة، ومقولة الشـيء في ذاته، ولكنه رفض مقولة الجزم، ومهما يكن فإن "كانت" مـن أهم المؤثرين في برس الذي كان يخصص ساعات عديدة مدة سنـوات لمدارسة نقد العقل الخالص، حتى كاد يحفظه2.وتبنى أطروحة "كانت" المركزية التي تدعي: أن "وظيفة الوعي هي اختزال تعدد الانطباعات الحسية إلى وحدة"3.
عن ملامح الفكر الفلسفي في مطالع القرن 21 ـ عبد الرزاق الدواي
 يا "إلهي، ما أروع هذا القرن الذي أراه ينفتح
يا "إلهي، ما أروع هذا القرن الذي أراه ينفتح
أمامنا،كم أتمنى فيه لو يعود إلي شبابي… !".[1]
إنـها صيحة إعجاب بالقرن الجديد أطلقها المفكر الإنساني الهولندي إرازم (Erasme, 1469-1536)، في مستهل القرن السادس عشر. وهي تعـبّر بوضوح عن مدى افتتان المفكرين في عصر النهضة بعصرهم وشعورهم بأنـهم يشاركون بالفعل في مغامرة مثيرة وفريدة من نوعها تقدم عليها البشرية بفضل ما تحقق من تقدم آنذاك على صعيد الفكر والفن والثقافة والمعارف. ترى هل يستقبل المفكرون والفلاسفة اليوم تباشير القـرن الجديـد الذي ينفتح أمامنا بنفس الحماس والإعجاب والتفاؤل ؟
ولا نظن أن حالة إرازم تشكل حالة استثنائية فقد وجد في جميع العصور مفكرون وفلاسفة آمنوا بأن حكمة جديدة ستنبثق في الفكر الفلسفي للمستقبل، وتنبأوا باحتمال حدوث "انطلاقة جديدة" للفكر وللفلسفة استنادا على ما حدسوه من خلال استقراء وتشخيص نقدي لحـال الفلسفة في عصورهم، ذلك الحال الذي غالبا ما يكون من ثوابته بداية ظهور علامات تصدع في المنظومات الفلسفية الكبرى المهيمنة. ويمكن أن نذكر في هـذا السياق مثلا الفيلسوف الألماني لودفيج فويرباخ (1804 ـ 1872) الذي كتب سنة 1843 "مبادئ فلسفة المستقبل"، ويتعلق الأمر بكتاب يضم خلاصة مصاغة على شكل مبادئ لأهم المآخذ والإنتقادات التي وجهت إلى المذهب الفلسفي المثالي عند هيجل، وكانت قد بدأت تظهر عليه أعراض التفكك. والفكرة الناظمة للكتاب هي أن الفلسفة الجديدة ستجدد المذهب المادي وتغنيه؛ وستجعل من الإنسان والطبيعة الموضوع الوحيد والكلي والأسمى للفلسفة؛ وإنـها ستنظر إلى الإنسان لا باعتباره كائنا عاقلا ومفكرا فحسب بل باعتباره أيضا كائنا طبيعيا وحسيا ؛ كما أنـها ستعلي من قيمة المحبة والمشاعر والعواطف الإنسانية وستكون نزعة إنسانية جديدة.[2]
مفهوم الجسد وانفعالاته في فلسفة سبينوزا ـ ادريس شرود
 يحتل الجسد في فلسفة باروخ سبينوزا موقعا مركزيا، فرغبته في تكوين فكرة عن الطبيعة البشرية، دفعته إلى الإنخراط في عمل فلسفي رائد يهم معرفة الجسد وما يقدر عليه. فالإنسان حسب سبينوزا، يتكون من نفس وجسم، وهو موجود كما نحس به، كما يتعذر علينا الحصول على فكرة تامة ومتميزة عن هذا الإتحاد إذا لم نعرف قبل ذلك طبيعة جسمنا(1). لذلك دعا سبينوزا إلى ضرورة السعي إلى المعرفة الدقيقة بتركيب الجسد، واكتساب معرفة تامة وكاملة بانفعالاته، وتنظيمها وترتيبها وفق نظام ملائم للذهن.
يحتل الجسد في فلسفة باروخ سبينوزا موقعا مركزيا، فرغبته في تكوين فكرة عن الطبيعة البشرية، دفعته إلى الإنخراط في عمل فلسفي رائد يهم معرفة الجسد وما يقدر عليه. فالإنسان حسب سبينوزا، يتكون من نفس وجسم، وهو موجود كما نحس به، كما يتعذر علينا الحصول على فكرة تامة ومتميزة عن هذا الإتحاد إذا لم نعرف قبل ذلك طبيعة جسمنا(1). لذلك دعا سبينوزا إلى ضرورة السعي إلى المعرفة الدقيقة بتركيب الجسد، واكتساب معرفة تامة وكاملة بانفعالاته، وتنظيمها وترتيبها وفق نظام ملائم للذهن.
طبيعة الجسم البشري
يعرف سبينوزا الجسم بمقدرته على التأثر بعدد أكبر من الأوجه، وبالتأثير في الأجسام الخارجية بعدد أكبر من الأوجة...، وكلما كان للجسم قابلية من هذا النوع، كانت النفس أقدر على الإدراك(2). تشير عملية التأثير والتأثر إلى طبيعة الجسد من حيث مقدار قوته وكمية شدته، وإلى خاصية الحركة أو السكون والسرعة أو البطء التي تميزه، ومدى استعداده لإقامة علاقات ممتدة في الزمان مع الأجسام الأخرى.
يشدد سبينوزا على كل ما يحافظ على نسبة الحركة والسكون والسرعة والبطء التي تربط بين أجزاء الجسم البشري، في علاقته بذاته وبالأجسام الخارجية. فكل ما يحافظ على نسبة الحركة والسكون التي تربط بين أجزاء الجسم البشري إنما هو حسن، وكل ما يغير من نسبة الحركة والسكون بين أجزاء الجسم إنما هو سيء(3). ويترتب عن هذا التحديد السبينوزي للجسم البشري، استبعاد تميز الأجسام من حيث الجوهر. فالجسم البشري، يقول جيل دولوز بصدد سبينوزا، لا يتحدد بواسطة جنسه أو نوعه، أو بواسطة أعضائه ووظائفها، وإنما بواسطة ما يكون قادرا عليه، وبواسطة العواطف التي يكون قادرا عليها، سواء كان ذلك في الإنفعال أو في الفعل. لهذا ينبغي، جعل الجسد قوة لا تختزل في الجهاز العضوي، وجعل الفكر قوة لا تختزل في الوعي(4).
الكونية ووهم الكونية ـ هادي معزوز
 يسعى العالم الرأسمالي اليوم مثل البارحة إلى الترويج لخطاب يعتبر جزءا لا يتجزأ من رهاناته وأهدافه، ألا وهو خطاب العولمة، وذلك باسم المشترك بين الإنسان، وأيضا تحت يافطة المصير العام، وهو ما يجعل من نفس الخطاب ذلك الساهر دوما على تحقيق غرض ربما ليس في وسعنا اليوم الحكم عليه إن من باب السلبية أو الإيجابية، لسبب يكاد يكون إشكاليا محضا، وهو حاجتنا إلى الكونية وفي نفس الوقت رفضنا لكل أشكال التبعية، إذ أن نفس الخطاب الرامي إلى مد الجسور بين الثقافات هو نفس الخطاب الذي يسعى إلى تكريس الثقافة الوحيدة، ونفس الخطاب الساعي إلى نبذ الهوية الوحيدة لصالح الاختلافات المتكررة، هو نفسه الذي يوقظ شرارة التقوقع وما يرافقها من تعصب وغياب للتسامح وهيمنة الجهل على المعرفة، وسيادة الخنوع على الإبداع والتغيير الإيجابي.
يسعى العالم الرأسمالي اليوم مثل البارحة إلى الترويج لخطاب يعتبر جزءا لا يتجزأ من رهاناته وأهدافه، ألا وهو خطاب العولمة، وذلك باسم المشترك بين الإنسان، وأيضا تحت يافطة المصير العام، وهو ما يجعل من نفس الخطاب ذلك الساهر دوما على تحقيق غرض ربما ليس في وسعنا اليوم الحكم عليه إن من باب السلبية أو الإيجابية، لسبب يكاد يكون إشكاليا محضا، وهو حاجتنا إلى الكونية وفي نفس الوقت رفضنا لكل أشكال التبعية، إذ أن نفس الخطاب الرامي إلى مد الجسور بين الثقافات هو نفس الخطاب الذي يسعى إلى تكريس الثقافة الوحيدة، ونفس الخطاب الساعي إلى نبذ الهوية الوحيدة لصالح الاختلافات المتكررة، هو نفسه الذي يوقظ شرارة التقوقع وما يرافقها من تعصب وغياب للتسامح وهيمنة الجهل على المعرفة، وسيادة الخنوع على الإبداع والتغيير الإيجابي.
لا مفر من فكرة مفادها أن الخطاب القوي هو الخطاب الذي يهيمن، في انتظار ظهور خطاب أقوى له أسسه ورهاناته الخاصة، كما أنه لا هروب من الإشارة إلى أن كل خطاب هو خطاب إرادة قوة أولا وأخيرا، أي أنه في الخطاب الوحيد نجد أنفسنا أمام ثنائية الظاهر والباطن، أي أمام خطاب البراءة وخطاب تحقيق الربح مهما كانت الطريقة، لهذا قد لا نتعجب مثلا عندما نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول دعوة إلى السلام وفي نفس الوقت هي أكثر منتج ومصدر لأفتك الأسلحة، لهذا فخطاب الترويج يكاد يتناقض تماما وخطاب الغاية الرئيسية، على العموم هذه هي بنية كل قوة تسعى إلى الهيمنة مهما كانت أسسها، إن باسم العولمة أو الكونية أو حوار الثقافات، حيث تم تزيين هذا الأمر بتلك العبارات الداعية إلى التسامح وقبول الاختلاف دون أن نجد هذا الأمر على أرض الواقع.
إنا بأنفسنا نحن ما نحن لا بأجسادنا ـ نادية عبد الجواد
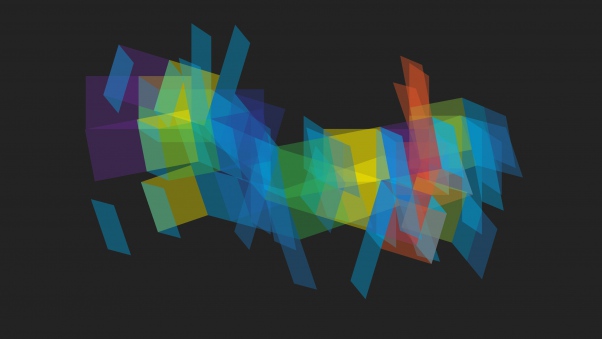 إن السؤال عن الإنسان هو من المسائل العريقة في الفلسفة إلى درجة تكاد تتحول فيها الفلسفة إلى أنثروبولوجيا على حدَ تعبير كانط و لذلك فان كل تعريف للإنسان هو صياغة لهيئة فلسفيَة مخصوصة سواء كان ذلك في إطار البحث عن الوجود بحيث يكون الإنسان مرتبطا بنظام يسوس الكون (لوغوس) أو في مجال عمليَ يكون فيه الإنسان و نمط وجوده محورا البحث.
إن السؤال عن الإنسان هو من المسائل العريقة في الفلسفة إلى درجة تكاد تتحول فيها الفلسفة إلى أنثروبولوجيا على حدَ تعبير كانط و لذلك فان كل تعريف للإنسان هو صياغة لهيئة فلسفيَة مخصوصة سواء كان ذلك في إطار البحث عن الوجود بحيث يكون الإنسان مرتبطا بنظام يسوس الكون (لوغوس) أو في مجال عمليَ يكون فيه الإنسان و نمط وجوده محورا البحث.
إن التناول الأنتولوجي للإنسان إذا يختلف عن التناول الذي يقصده في حيثياته العمليَة المتغيَرة و كذلك انفتاحه عن العالم و هو ما يفتح الموضوع على لحظتين : تعنى الأولى بالكشف عن العنصر الماهوي في الإنسان الذي هو نفس ارتكازا على مقاربتين تتمثل إحداهما في النفس باعتبارها ماهية ثابتة ترجعنا إلى ما به نكون نحن ما نحن و تلامس الأخرى عنصر الزمن في الماهية أي ما يجعل من الأنا دائم الحضور الأمر الذي يفتحنا على اللحظة الثانية و التي تعيد السؤال في الإنسان لا باعتباره نفسا و إنما جسدا مفتوحا على كلَ الإمكانيات.
إن غرضنا من السؤال عن ماهيتنا أي ما به نكون نحن ما نحن هو الإقرار بأن ذلك منوط بالنفس وحدها فهي ما يشير إلى الماهية المبنيَة على أساس أنتولوجي لا إلى الجسد الذي هو مغاير لها و متميَز عنها.
مدخل للمنطق المحمولي: الاستدلال المباشر في المنطق التقليدي ( الجزء 1) ـ أ. مصطفى قشوح
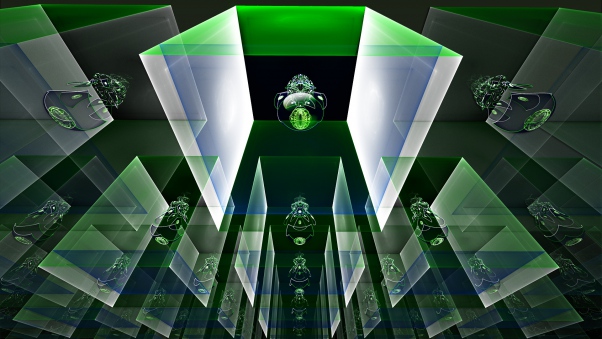 نهدف من خلال هذا المقال إلى الوقوف عند مفهوم الاستدلال المباشر عند أرسطو والمنطق التقليدي، ثم نبين مدى حضور هذا النمط من الاستدلال في البناء البرهاني للعقلانية الأرسطية، على المستوى المنهجي سننتهج منهجا أكسيوميا في البناء والتحليل حيث سننطلق في البداية من تعريفات ثم نمر للبديهيات ونخلص للعمليات استدلالية خاضعة لقواعد استنتاجية محددة . أما مسألة بناء المبرهنات سنؤجلها للحديث عن الجزء الثاني الذي سنتطرق فيه لبرهانية نظرية القياس.
نهدف من خلال هذا المقال إلى الوقوف عند مفهوم الاستدلال المباشر عند أرسطو والمنطق التقليدي، ثم نبين مدى حضور هذا النمط من الاستدلال في البناء البرهاني للعقلانية الأرسطية، على المستوى المنهجي سننتهج منهجا أكسيوميا في البناء والتحليل حيث سننطلق في البداية من تعريفات ثم نمر للبديهيات ونخلص للعمليات استدلالية خاضعة لقواعد استنتاجية محددة . أما مسألة بناء المبرهنات سنؤجلها للحديث عن الجزء الثاني الذي سنتطرق فيه لبرهانية نظرية القياس.
1) تعريفات
- الاستدلال
نسمي استدلالا كل عملية عقلية تنطلق من مقدمات(على الأقل واحدة) لتصل إلى نتائج، وقد عرفه أرسطو بأنه سير العقل من المعلوم إلى المجهول قصد الكشف عن المجهول وتبيانه . ويهدف الاستدلال عند أرسطو إلى بناء المعارف على قاعدة منطقية كلية. ويرى أرسطو أن الطريق الذي يسمح بتحقيق هذا الهدف يتمثل أساسا في نوعين من الاستدلالات وهما: الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر .
- الاستدلال المباشر
نسمي استدلال مباشر كل استدلال يسمح باستنتاج قضية من أخرى دون اللجوء إلى واسطة، ففي الاستدلال المباشر نكون في غنى عن قضية ثالثة تتوسط المقدمة الأولى بالنتيجة ، لأننا نستنتج بطريقة مباشرة نتيجة القضية من مقدماتها أو نحكم على صدق أو كذب النتيجة من خلال مقدمة وحيدة فقط إذا كانت معلومة لدينا .
دولوز وفن الرواية ـ ادريس شرود
 إلى أستاذي الكبير.. ادريس الكريوي.
إلى أستاذي الكبير.. ادريس الكريوي.
تقديم
عبر الفليسوف الفرنسي جيل دولوز في عدة مناسبات، عن تخوفه من أفول نجم الفلسفة، اعتبارا لتراجع دور الجامعة في الإهتمام بالعلوم الإنسانية، وبروز منافسين جدد. طبعا وجدت الفلسفة أمامها دائما منافسين، منذ منافسي أفلاطون إلى مهرجي زرادشت، مرورا بالإبستمولوجيا والماركسية واللسانيات والتحليل النفسي. الآن هناك الإعلاميات والتواصل والدعاية التجارية، حيث فعل التسويق يعتبر كأرقى فكر رأسمالي، كوجيطو السلعة. هكذا راحت الفلسفة، تواجه من تجربة لأخرى منافسين وقحين أكثر فأكثر، وشتامين أكثر فأكثر، حتى أن أفلاطون نفسه لم يكن ليتصورهم في أشد لحظاته هزلا(1). أضف إلى ذلك، تهافت حقودي عصر الفراغ، من دعاة نهاية الفلسفة وموتها. في ظل هذه الظروف، انخرط دولوز في إعادة الإعتبار للفلسفة عن طريق خلق لقاءات جديدة مع فروع معرفية وفنية، ومنها الرواية.
التباسات الفكر في مرحلة ما بعد التحرير
منذ عمله الأول حول هيوم(2)، ودولوز يبحث عن طريقة جديدة لاستئناف القول الفلسفي في ظروف ما بعد التحرير، حيث الإنغلاق في تاريخ الفلسفة والإكتفاء بمداخل إلى هيغل وهوسرل وهايدغر. هكذا شكل تاريخ الفلسفة عاملا سلطويا تكونت عبره صورة عن الفكر تدعى الفلسفة تمنع الناس تماما من التفكير(3). شكل هذا الإحساس القوي بالإنغلاق، تحريضا لإرادة دولوز لطرح مصير الفلسفة ومستقبلها، خاصة وانه لم يكن يميل إلى الوجودية ولا إلى الفينومينولوجيا. ففي ظل هذه الظروف، انطلق دولوز في البحث عن أشكال تعبير فلسفية جديدة، وكان محرضه الرئيسي لركوب هذه التجربة، هو الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه. فكان من الضروري متابعة ما بدأه فيلسوف العلم المرح، في علاقة مع تجديد بعض الفنون الأخرى، مثل المسرح والسينما...(4).
مفهـوم الوعي الطبقي عند فيلهلم رايش ـ ياسين إيزي
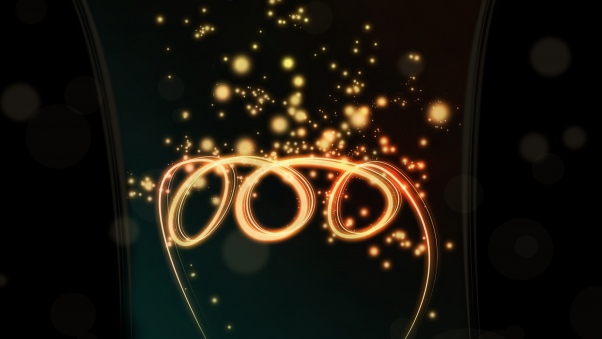 سيتقصى هذا المقال أحد أهم المفاهيم التي اشتغل بها وعليها فيلهلم رايش، و جعل منها مفاتيح لمشروعه لا سواء على المستوى النظري أو الممارساتي و المتمثـل في إنشـاء علم نفس ماركسي، هذا العلم الذي أراده أن يجاور الإقتصاد السياسي الماركسي، و كذا علمي الإجتماع و التاريخ الماركسيين، و هو العلم الذي لم يكن ليبرز لولا مدرسة التحليل النفسي و منهجها، فهذه الأخيرة و على حد تعبير رايش هي البذرة التي سينبت عليها علم نفس مادي-جدلي، فالمقاربة الخلاقة التي قام بها رايش كانت متميزة أشد التميز عن باقي المحاولات الأخرى، تلك التي كانت تفرض بعض القراءات تحت لواء الماركسية أو التحليل النفسي أكثر منها محاولة لنقد القراءات الميتافيزيقية اللاجدلية، بغية تأسيس علم نفس مادي-جدلي، يعطي قراءات علمية للظواهر النفسية أكثر دقة، و التي من غير الممكن أن تصير قراءات علمية بدون الإحاطة بكل العوامل ذات التأثير المباشر و الغير مباشر و مراعاتها، قس على ذلك أن هذا المشروع الذي أراده رايش، قد هدم فكرة أساسية أو بالأحرى تصورا أساسيا في المثالية و المتمثل في اللأدرية و تؤسس له بشكل مضمر بعض الفلسفات اللاعرفانية التي تظهر بزي العلم و العلمية.
سيتقصى هذا المقال أحد أهم المفاهيم التي اشتغل بها وعليها فيلهلم رايش، و جعل منها مفاتيح لمشروعه لا سواء على المستوى النظري أو الممارساتي و المتمثـل في إنشـاء علم نفس ماركسي، هذا العلم الذي أراده أن يجاور الإقتصاد السياسي الماركسي، و كذا علمي الإجتماع و التاريخ الماركسيين، و هو العلم الذي لم يكن ليبرز لولا مدرسة التحليل النفسي و منهجها، فهذه الأخيرة و على حد تعبير رايش هي البذرة التي سينبت عليها علم نفس مادي-جدلي، فالمقاربة الخلاقة التي قام بها رايش كانت متميزة أشد التميز عن باقي المحاولات الأخرى، تلك التي كانت تفرض بعض القراءات تحت لواء الماركسية أو التحليل النفسي أكثر منها محاولة لنقد القراءات الميتافيزيقية اللاجدلية، بغية تأسيس علم نفس مادي-جدلي، يعطي قراءات علمية للظواهر النفسية أكثر دقة، و التي من غير الممكن أن تصير قراءات علمية بدون الإحاطة بكل العوامل ذات التأثير المباشر و الغير مباشر و مراعاتها، قس على ذلك أن هذا المشروع الذي أراده رايش، قد هدم فكرة أساسية أو بالأحرى تصورا أساسيا في المثالية و المتمثل في اللأدرية و تؤسس له بشكل مضمر بعض الفلسفات اللاعرفانية التي تظهر بزي العلم و العلمية.










