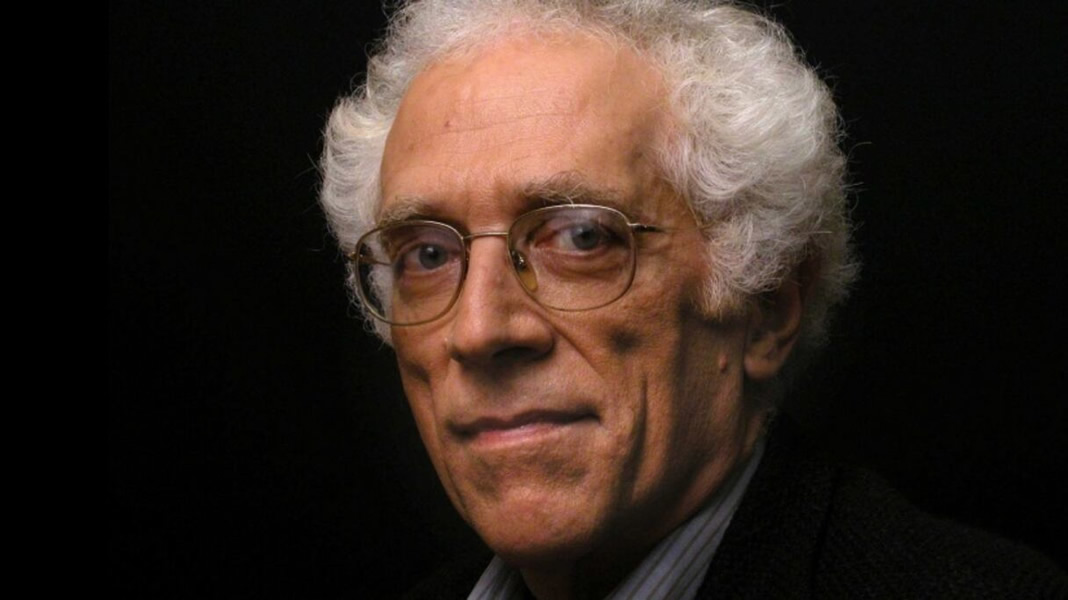إننا لا ندرك المحايث. ولا يوجد شيء مشترك ولا أكثر عرضة للتجاهل مثل تجربة القراءة. أن نقرأ أمر يبدو بديهيا إلى حد يبدو معه للوهلة الأولى أن لا شيء يمكن قوله بصدد هذا الموضوع.
في الدراسات حول الأدب، تم طرح مشكل القراءة نادرا أحيانا، من زاويتين متباينتين: الزاوية الأولى تهتم بالقراء في تنوعهم التاريخي والاجتماعي، الجماعي والفردي؛ الزاوية الثانية تهتم بصورة القارئ كما تم تمثيلها في بعض النصوص: القارئ كشخصية، أو كمسرود له. لكن يبقى مجال آخر لم يتم استكشافه هو منطق القراءة الذي لا يتم عرضه في النص، رغم كونه سابقا على الفروق الفردية.
هناك عدة أنواع من القراءات. وسوف أتوقف هنا عند صنف واحد، وهو ليس أقلها أهمية، وأقصد قراءة النصوص التخييلية الكلاسيكية، وبالضبط النصوص التي تنعت بأنها نصوص تمثيلية. فهذه القراءة هي وحدها القراءة التي تنجز كبناء.ورغم أننا توقفنا عن اعتبار الفن والأدب محاكاة، فإننا نجد صعوبة في التخلص من طريقة في الرؤية متأصلة حتى في عاداتنا اللغوية ، والتي تتمثل في تصورنا للرواية كتمثيل وتحويل لواقع سابق عليها. ورغم أن هذه الرؤية لا تهدف إلى وصف عملية الإبداع، فإنها تطرح مشكلا مبدئيا؛ إنها تقوم بتشويه علني حين تحيل على النص نفسه. إن ما يوجد في البداية هو النص، ولا شيء غيره؛ ولا تستطيع هذه الطريقة أن تبني عالما متخيلا انطلاقا منه إلا بإخضاعه لنوع خاص من القراءة التي نقوم نحن ببنائها. إن الرواية لا تحاكي الواقع، بل تخلقه: هذه الصيغة السابقة على الرواية ليست مجرد تجديد اصطلاحي؛ وحده منظور البناء يسمح لنا بفهم سليم لاشتغال النص المدعو نصا تمثيليا.
إن قضية القراءة تتقلص إذن بالطريقة التالية: كيف يقودنا نص ما نحو بناء عالم متخيل؟ ما هي مظاهر النص التي تحدد البناء الذي ننجزه أثناء القراءة ، وبأي طريقة؟
لنبدأ بالأٍسهل.
الخطاب المرجعي
وحدها الجمل المرجعية تسمح بالبناء؛ إلا أننا نعرف أن ليست كل الجمل مرجعية بالضرورة. هذا أمر معروف لدى اللسانيين والمناطقة؛ وليس ضروريا أن نتوقف عنده مطولا.
الفهم عملية مختلفة عن عملية البناء. لنأخذ مثلا هاتين الجملتين لأدولف ( 1 ): " كنت أشعر أنها أحسن مني؛ وكنت أحتقر نفسي لأنني لا أستحقها. إنه لبؤس كبير أن لا تكون محبوبا حينما تحب. ولكنه أمر جيد أن تكون محبوبا بشغف حين تكف عن أن تكون عاشقا". الجملة الأولى هنا مرجعية: إنها تستحضر حدثا ( مشاعر أدولف)؛ أما الجملة الثانية فليست كذلك: إنها حكم. ويتم توضيح الفرق بينهما بواسطة مؤشرات نحوية: الحكم يستلزم استخدام المضارع، وضمير الغائب ولا يتضمن إحالات قبلية.
إن جملة ما تكون مرجعية أو لا تكون، فليس هناك درجة وسطى. ولكن ليست كل الكلمات التي تشكلها متساوية في هذا الصدد؛ إن الاختيار الذي يقوم به الكاتب ضمن القاموس سيؤدي إلى نتائج شديدة الاختلاف. هناك تعارضان مستقلان يبدو أنهما مناسبان لهذا السياق: التعارض بين المحسوس وغير المحسوس؛ وبين الخاص والعام. بهذا الشكل سيعود أدولف مثلا إلى ماضيه: "وسط حياة جد فوضوية"؛ هذه العبارة تستدعي إلى الذهن أحداثا ملموسة ولكن بشكل بالغ التعميم؛ ويمكننا أن نتخيل بسهولة مئات الصفحات التي يمكن أن تصف نفس هذا الحدث. بينما في هذه الجملة الأخرى :" كنت أجد في والدي، لا رقيبا ، ولكن ملاحظا باردا وقاسيا، يبدأ بابتسامة مشفقة، ثم ينهي الحوار فورا وهو في حالة استياء"، نجد هنا تجاورا بين أحداث ملموسة وأخرى ليست كذلك: الابتسامة والصمت واقعتان قابلتان للملاحظة؛ أما الشفقة والضيق فهما افتراضان ـ قابلان للتبرير بالتأكيد ـ متعلقان بمشاعر لا يمكننا إدراكها مباشرة.
عادة نجد في نفس النص التخييلي نماذج من سجلات الكلام هاته ( ولكننا نعلم أن كيفية توزيعها تختلف باختلاف العصور والمدارس ـ تختلف حسب البناء العام للنص). إننا لا نهتم بالجمل غير المرجعية حين نكون بصدد القراءة كبناء ( إنها تنتمي لقراءة أخرى). إن الجمل المرجعية تقود إلى بناءات ذات قيمة متباينة، حسب ما إذا كانت عامة نسبيا، أو تستحضر أحداثا ملموسة نسبيا.
المرشحات السردية
إن سمات الخطاب، كما تم الحديث عنها حتى الآن، قابلة للتحديد خارج أي سياق: إنها محايثة للجمل نفسها. إلا أننا نقرأ نصا لا جملا. وهكذا فإننا نقارن بين الجمل من زاوية العالم المتخيل الذي تساهم في بنائه؛ ونكتشف حينها أنها تختلف من عدة زوايا، أو حسب عدة مقاييس. ويبدو أنه قد تم التوافق في حقل التحليل السردي، على اعتماد ثلاثة معايير: الزمن، الرؤية والصيغة. هنا أيضا نجد أنفسنا ضمن ميدان معروف نسبيا ( حاولت إنجاز جرد له في كتابي " الشعرية")؛ ويكفي الآن أن نتناوله من زاوية القراءة.
الصيغة: الأسلوب المباشر هو الوسيلة الوحيدة لإلغاء أي مسافة بين الخطاب السردي والعالم الذي يستحضره هذا الخطاب: إن الكلمات تشبه الكلمات، والبناء مباشر وفوري. وليس الأمر كذلك بالنسبة للوقائع غير اللفظية ولا بالنسبة للخطاب غير المباشر. هناك جملة يتلفظ بها أدولف: "قال لي مضيفنا الذي كان قد تحدث مع خادم نابولتاني كان يخدم هذا الأجنبي دون معرفة اسمه، إنه لا يسافر البتة بدافع الفضول، لأنه لا يزور لا الآثار ولا المواقع ولا المعالم ولا الأشخاص". يمكننا هنا أن نتخيل الحوار بين السارد والمضيف، رغم أن لا شيء يثبت أنه استخدم، ولو بالإيطالية، جملة مطابقة لتلك التي تتلو عبارة: "قال لي". إن بناء الحوار بين المضيف والخادم، والذي تم استحضاره أيضا، لا يمكن أن يتحقق بدقة: إننا نتمتع إذن بحرية أكبر إذا أردنا إعادة بنائه في تفاصيله. وأخيرا فإن الحوارات والأنشطة المشتركة بين الخادم وأدولف غير محددة في مجموعها؛ نتوفر فقط على انطباع عام بهذا الصدد.
يمكن أن نعتبر كلام السارد بدوره أسلوبا مباشرا، وإن من مستوى أعلى؛ خاصة إذا كان هذا السارد ( كما في حالة أدولف) ممثلا في النص. إن الحكم، الذي استبعدناه سابقا من القراءة كبناء، سوف تتم استعادته هنا ، ليس كملفوظ ولكن كتلفظ. إن الحكم الذي صاغه أدولف كسارد حول المحب غير المحبوب يكشف لنا عن مزاجه وبالتالي عن جانب من العالم المتخيل الذي يشارك فيه.
على المستوى الزمني: يتم تنظيم زمن العالم المتخيل (زمن الحكاية) بشكل كرونولوجي؛ إلا أن الجمل داخل النص لا تخضع لهذا التنظيم، ولا يمكن أن تخضع له؛ وبالتالي فإن القارئ يقوم، بشكل غير واع، بإعادة ترتيب الأحداث. كذلك فإن بعض الجمل تستحضر عدة أحداث متمايزة، ولكن متشابهة ( الحكي الترددي)؛ وخلال القراءة، فإننا نستعيد الصورة المتعددة للأحداث.
"الرؤية": إن الرؤية التي نمتلكها حول الأحداث المحكية عنصر حاسم في عملية البناء. فحين يتعلق الأمر برؤية تقييمية مثلا، فإننا نهتم بدرجة متساوية بـ أ) الحدث المنقول، و ب) موقف من "يرى" الحدث المنقول. نستطيع أيضا أن نميز بين المعلومة التي تنقلها إلينا جملة ما حول موضوعها، والمعلومة التي تقدمها حول المتلفظ بها؛ هكذا إن "ناشر" رواية أدولف قد لا يفكر إلا في الاحتمال الثاني، وهو يعلق على الحكي الذي قرأناه للتو: "إنني أكره هذا الغرور المتمركز حول ذاته حين يحكي عما ارتكبه من سوء، ويدعي أنه يثير التعاطف وهو يصف نفسه، ويحلق دون عقاب وسط الخراب، محللا نفسه بدل أن يعبر عن الندم". إن الناشر يبني إذن شخصية الفاعل في المحكي ( أدولف السارد) لا موضوع حديثه ( أدولف الشخصية وإيلينور).
إننا ندرك بصعوبة عادة مقدار التكرار في النص التخييلي، أو إن شئنا مقدار الإطناب فيه. يمكن أن نزعم دون أن نخشى الخطأ أن كل حدث في الحكاية يتم حكيه مرتين على الأقل. هذه التكرارات يتم تنويعها غالبا بواسطة المرشحات التي ذكرناها للتو: إن حوارا ما يمكن إعادته حرفيا تارة، وتارة أخرى يتم استحضاره بشكل مختصر؛ وإن حدثا ما قد تتم ملاحظته من زوايا مختلفة؛ وقد يستحضر من زاوية المستقبل، أو الحاضر أو الماضي. وكل هذه المحددات يمكن تركيبها مع بعضها.
إن التكرار يشتغل بقوة في عملية البناء: إذ علينا أن نبني حدثا واحدا انطلاقا من عدة محكيات. إن العلاقات بين المحكيات التكرارية تختلف بين التطابق والتناقض؛ وحتى التطابق المادي لا يؤدي بالضرورة إلى تطابق المعنى ( نجد مثالا جيدا على ذلك في الفيلم الأخير المحادثة لكوبولا). وظائف هذه التكرارات متنوعة : إنها تساهم في تقرير الوقائع ( الواردة في تحقيقات الشرطة) أو في نفيها. كذلك في رواية أدولف يمكن لنفس للشخصية في أوقات جد متقاربة، أن تتوفر على رؤى متناقضة حول نفس الحدث، وهو ما يجعلنا نفهم أن الحالات النفسية لا توجد مستقلة، بل توجد دائما في ارتباط مع مخاطب ومع شريك. وقد صاغ كونستان بنفسه قانون هذا العالم: "إن الموضوع الذي يفلت منا يختلف بالضرورة عن الموضوع الذي يطاردنا".
ولكي نتمكن من بناء عالم متخيل أثناء قراءة نص، يجب بداية أن يكون هذا النص مرجعيا؛ حينئذ، وبعد قراءته، فإننا نسمح لمخيلتنا بـ "الاشتغال" عن طريق ترشيح المعلومة المتلقاة، وذلك من خلال أسئلة من قبيل : إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الوصف مخلصا ( الصيغة)؟ وما هو الترتيب الذي خضعت له الأحداث ( الزمن)؟ وإلى أي حد يمكن أن نراعي التعديلات التي ينجزها "ناقل" المحكي ( الرؤية )؟ لكن من هنا تبدأ عملية القراءة.
الدلالة والترميز
كيف نتعرف على ما يحدث أثناء القراءة؟ بواسطة الاستبطان ؛ وإذا أردنا أن نتأكد من انطباع معين، يمكننا الاستعانة بشهادات قراء آخرين حول قراءاتهم. إلا أن شهادتين حول نفس النص لا تتطابقان أبدا. كيف يمكن أن نفسر هذا الاختلاف؟ إنه يفسر بكون هذه الشهادات لا تصف عالم الكتاب ، وإنما تصف العالم المحول ، كما يوجد في وجدان كل فرد. ويمكننا أن نعرض خطاطة لمراحل هذا المسار بالطريقة التالية:
1 ـ محكي المؤلف ــــــــــ 2ـ العالم المتخيل كما بناه المؤلف ـــــــــ 3ـ العالم المتخيل كما بناه القارئ ــــــــــــ 4ـ محكي القارئ
يمكن أن نتساءل إن كان الفرق بين المرحلتين 2 و 3 كما تتجلى في هذه الخطاطة، يوجد فعلا. هل هناك بناءات أخرى غير البناءات الفردية؟ من السهل أن نبين أن الجواب عن هذا السؤال يجب أن يكون إيجابيا. لا يوجد أي شك في أن أي قارئ لرواية أدولف سيدرك أن إلينور قد عاشت في البداية مع الكونت دو بي، وأنها افترقت عنه كي تعيش بعد ذلك مع أدولف؛ وأنهما انفصلا، ثم لحقت به بباريس؛ الخ. وفي المقابل، لا توجد أي وسيلة تثبت بنفس اليقين أن أدولف ضعيف الشخصية أم مجرد شخص وفي.
السبب في هذه الثنائية هو أن النص يستحضر الأحداث وفق صيغتين، اقترحت تسميتهما: الدلالة والترميز. إن سفر إلينور إلى باريس قد تمت الدلالة عليه بكلمات النص. أما ضعف الشخصية ( المحتمل ) فقد تم الرمز إليه بواسطة وقائع أخرى من العالم المتخيل تمت الدلالة عليها بواسطة كلمات. إن عجز أدولف مثلا عن الدفاع عن إلينور في خطاباته هو مدلول. وبدورها ترمز هذه الواقعة إلى عجز أدولف عن الحب. إن الوقائع المدلولة وقائع تفهم: ويكفي لهذا أن نعرف اللغة التي كتب بها النص. إن الوقائع المرموزة هي موضوع تأويل؛ والتأويلات تختلف من شخص إلى آخر.
العلاقة بين المرحلتين 2 و3 المشار إليهما أعلاه، علاقة ترميز ( بينما العلاقة بين 1 و2 ، أو بين 3 و4 علاقة دلالة). فضلا عن ذلك لا يتعلق الأمر بعلاقة وحيدة، بل بعده علاقات غير متجانسة. أولا ، نقوم بعملية اختصار: فالعنصر 4 يكاد يكون دائما أقصر من 1، وبالتالي فإن العنصر 3 أيضا أكثر فقرا من 2. ثانيا نحن نخطئ. ففي كلتا الحالتين ، فإن الانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 يقودنا إلى سيكولوجية الإسقاط: إن التحويلات المنجزة تخبرنا عن القارئ: لماذا يحتفظ ( أو يظيف ) وقائع بدل أخرى؟ ولكن هناك تحويلات أخرى تخبرنا عن مسلسل القراءة نفسه، وهذه التحويلات هي ما يشغلنا هنا بالدرجة الأولى.
من الصعب أن أقول إن كانت وضعية ما أتناوله من أمثلة شديدة التنوع للنصوص التخييلية واقعة مطلقة، أم هي مشروطة تاريخيا وثقافيا, إلا أن الترميز والتأويل في كل هذه الأمثلة ( الانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 ) يستلزم وجود حتمية متحكمة في الأحداث. ربما اقتضت قراءة نصوص أخرى كالنصوص الشعرية الغنائية، أن ننجز عملية ترميز ترتكز على فرضيات أخرى ( التناظر المطلق) ؟ لا أدري؛ وفي جميع الأحوال، فإن الترميز في النص التخييلي يرتكز على القبول الضمني أو المعلن بوجود مبدأ السببية. الأسئلة التي نطرحها إذن على الأحداث التي تشكل الصورة الذهنية للمرحلة 2 هي من نوع: ما هو السبب في ذلك؟ و ما هي نتيجته؟ والإجابات عن هذه الأسئلة هي ما سنضيفه للصورة الذهنية كما نجدها في المرحلة 3.
لنفرض أن هذه الحتمية مطلقة؛ ما ليس مطلقا بالتأكيد هو الشكل الذي ستتخذه في هاته الحالة أو تلك. الشكل الأبسط ، ولكن الأٌقل انتشارا في ثقافتنا كمعيار للقراءة يتمثل في بناء واقعة أخرى من نفس الطبيعة. يمكن أن يقول القارئ في نفسه: ما دام جان قد قتل بيير ( وهي واقعة حاضرة في الرواية) فإن بيير كان عشيقا لزوجته ( وهي واقعة غير مذكورة في الرواية). هذا المنطق النموذجي في التحقيق القضائي، لا ينطبق بجد على الرواية: إننا نقبل ضمنيا أن الكاتب لا يخدعنا وأنه ينقل إلينا ( ينتج دلالة ) كل الأحداث اللازمة لفهم الحكاية ( حالة أرمانس تشكل استثناءا). كذلك الشأن بالنسبة للنتائج: هناك كتب تشكل امتدادا لكتب أخرى ، وتكتب خاتمة للعالم المتخيل الذي يمثله النص الأول؛ إلا أن مضمون الكتاب الثاني لا يعتبر عادة محايثا لعالم الكتاب الأول. وهنا أيضا تختلف ممارسات القراءة عن ممارسات الحياة اليومية.
إننا نتصرف عادة وفق سببية أخرى حين ننجز قراءة بنائية. إن أسباب ونتائج الحدث يجب البحث عنها ضمن مادة لا تجانسها. هناك حالتان يبدو أنهما الأكثر ترددا ( كما أشار إلى ذلك أرسطو) : إننا ننظر للحدث كنتيجة ( و/ أو كسبب ) إما لسمة من سمات الشخصية، أو كقانون عام غير متعلق بشخصية معينة. تحتوي رواية أدولف على أمثلة كثيرة للتأويلين معا، الواردين في النص نفسه. إليكم كيف يصف أدولف والده: " لا أذكر أن حوارا جمعني معه يوما... لم أكن حينها أعرف معنى الخجل...". الجملة الأولى تدل على حدث ( غياب الحوار المطول ). الجملة الثانية تقودنا إلى اعتبار هذا الحدث كرمز لسمة شخصية هي الخجل: إذا كان الأب يتصرف بهذا الشكل فهذا يعني أنه خجول. إن السمة الشخصية هي سبب السلوك. وإليكم مثالا للحالة الثانية : " أقول في نفسي : يجب ألا أتسرع، وأن إيلنور غير مستعدة لما أود البوح به، وأنه يستحسن أن أتريث قليلا. يكاد يحدث دائما، لكي نعيش بسلام مع أنفسنا، أن نحول ضعفنا وعجزنا إلى حسابات وأنساق : هذا يرضي فينا الجانب المتفرج في الجانب الآخر، إن صح التعبير". هنا تصف الجملة الأولى الحدث، بينما تقدم الجملة الثانية تفسيرا له، ويتعلق الأمر بقانون كوني للسلوك البشري، وليس بسمة فردية. أضف إلى ذلك أن هذا النوع الثاني من السببية هو المهيمن في رواية أدولف: هي إذن رواية تبرز قوانين سيكولوجية لا سيكولوجيات فردية.
بعد أن نقوم ببناء الأحداث التي تشكل الحكاية، نقوم بإعادة تأويل يسمح لنا ببناء سمات الشخصيات من جهة، ومن جهة أخرى ببناء منظومة الأفكار والقيم المحايثة للنص. إعادة التأويل هاته ليست اعتباطية؛ إنها خاضعة للمراقبة بواسطة سلسلتين من الإكراهات. السلسلة الأولى توجد في النص نفسه: ويكفي أن يعلمنا الكاتب خلال فترة وجيزة، كيف نؤول الأحداث التي ينقلها إلينا. كذلك الشأن بالنسبة للمقاطع المذكورة قبل قليل، والمأخوذة من رواية أدولف: فبعد أن قدم بضع تأويلات حتمية، يمكن لكونستان أن يتوقف عن ذكر سبب الحدث؛ فقد تعلمنا الدرس، وسنواصل التأويل بالطريقة التي علمنا إياها. مثل هذا التأويل الحاضر في متن الكتاب يؤدي وظيفة مزدوجة: فمن جهة أولى يخبرنا عن سبب الواقعة الخاصة ( وظيفة تفسيرية)؛ ومن جهة أخرى، يدربنا على النسق التأويلي الذي سيلتزم به الكاتب على طول النص ( وظيفة ميتا تفسيرية). السلسلة الثانية من الإكراهات تأتي من السياق الثقافي. فإذا أخبرنا بأن أحدهم قطع جسم زوجته إربا، فإننا لسنا في حاجة إلى إشارات في النص تخبرنا بأن هذا الشخص متوحش. هذه الإكراهات الثقافية، التي ليست سوى معتقدات مشتركة في مجتمع ما ( حقائق محتملة بالنسبة لهذا المجتمع )، تتغير مع مرور الوقت، وهو ما يفسر اختلاف التأويلات المقدمة لبعض النصوص المنتمية للماضي. وكمثال على ذلك أن العلاقات غير الشرعية لم تعد دليلا على فساد الروح، ولذلك أصبحنا نجد صعوبة في قبول العقوبات التي تعرضت لها بطلات روايات في الماضي.
السمات والأفكار: عناصر من هذا النوع يتم الرمز لها بواسطة الأفعال. ولكن يمكن أن تتم الدلالة عليها. ذلك هو بالضبط حال المقاطع التي استشهدت بها من رواية أدولف: فقد رمز الفعل لخجل الأب؛ لكن أدولف دل عليه بقوله: كان والدي خجولا. ونفس الأمر ينطبق على الحكم العام. إن السمات والأفكار يمكن عرضها إذن بطريقتين: طريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة. إن المعلومات المستخلصة من المصدرين ستتم مقارنتها من طرف القارئ، خلال عملية البناء؛ ويمكن أن تتطابق أو لا تتطابق. إن المقدار النسبي لهذين النوعين من المعلومات قد عرف تنوعا كبيرا خلال تاريخ الأدب، وهو أمر بديهي: إن هيمنغواي لا يكتب مثل كونستان.
يجب أن نميز بين السمات حين تصاغ بهذا الشكل وبين الشخصية. ليست كل شخصية مرادفة لسماتها. إن الشخصية مقطع من العالم الزمكاني المعروض، لا غير؛ تظهر في النص شخصية بمجرد ظهور شكل لساني مرجعي ( اسم علم، بعض المركبات الاسمية، الضمائر) يتعلق بكائن مشخص. وباعتبارها كذلك، فإن الشخصية لا مضمون لها: هناك تحديد لكائن ما دون وصفه. يمكن أن نتخيل نصوصا يقتصر فيها وجود الشخصية على هذا الأمر، وهي موجودة فعلا: إنها الفاعل لسلسلة من الأفعال. ولكن بمجرد ظهور محددات سيكولوجية، فإن الشخصية تتحول إلى سمات: إنها تتصرف بهذا الشكل لأنها خجولة، ضعيفة، شجاعة، الخ. ودون محددات (من هذا النوع)، لا وجود لأي سمات.
إن بناء السمات عملية توفيق بين الاختلاف والتكرار. فمن جهة، يجب أن نضمن الاستمرار: يجب أن يقوم القارئ ببناء نفس الشخصية. هذه الاستمرارية تقدمها هوية الاسم، وتلك هي وظيفته الآساسية. وانطلاقا من هنا تصبح كل عمليات المزج ممكنة: كل الأفعال يمكن أن تبرز نفس السمة الشخصية، أو يمكن أن تدل على شخصية تتناقض في سلوكها، أو تتغير ظروف حياتها، أو قد تتعرض لتغيرات عميقة في سماتها... ليس ضروريا أن نقدم أمثلة على ذلك، فهي كثيرة ومن السهل على القارئ استحضارها؛ وهنا أيضا فإن الاختيارات يمليها تاريخ الأساليب أكثر مما يمليها مزاج الكتاب.
البناء كتيمة
إحدى صعوبات دراسة عملية القراءة تأتي من صعوبة ملاحظتها: فالاستبطان لا يمكن التحقق منه، وتقصي الميدان النفسي الاجتماعي فعل معرض للتضليل. لذلك نشعر بالارتياح حين نكتشف أن عملية البناء ممثلة داخل النصوص التخييلية نفسها، حيث تمكن دراستها بسهولة.
يجعل النص التخييلي من عملية البناء تيمة له لأنه يستحيل ببساطة أن نتحدث عن حياة بشرية دون أن نسلط الضوء على هذه العملية الأساسية. فكل شخصية ملزمة ببناء الوقائع والشخصيات المحيطة بها، انطلاقا من المعلومات التي تحصل عليها؛ وهنا تجسد بشكل صارم عنصرا موازيا للقارئ الذي يقوم ببناء العالم المتخيل انطلاقا من المعلومات الخاصة به ( النص ، العالم المحتمل)؛ وهكذا تصبح القراءة (بالضرورة ) إحدى تيمات الكتاب.
ومع ذلك، فإن هذه التيمة قد تحظى بالاهتمام أو تستثمر بدرجة أعلى أو أدنى. ففي رواية أدولف مثلا، تتحقق بدرجة جزئية جدا: إذ يتم التركيز فقط على صعوبة الحسم في الأفعال الأخلاقية. وإذا أردنا أن نستخدم النصوص التخييلية كمادة لدراسة عملية البناء، يجب أن نختار النصوص التي النصوص حيث تصبح هذه العملية إحدى التيمات الأساسية. وتمثل رواية أرمانس لستاندال مثالا على ذلك.
فالحبكة كلها في هذه الرواية خاضعة عمليا للبحث عن المعرفة. ونقطة انطلاقها هي بناء خاطئ يقوم به أوكتاف: إنه يعتقد أن أرمانس تثمن المال، بسبب سلوك ما ( تأويل ينطلق من الفعل وينتهي إلى السمة الشخصية)؛ وبمجرد تبديد سوء الفهم هذا، يتلوه سوء فهم آخر يوازيه ويعاكسه: فأرمانس هي التي تعتقد الآن أن أوكتاف يقدر المال كثيرا. هذا التبدل البدئي يؤسس صورة البناءات اللاحقة. لقد صححت أرمانس فيما بعد بشكل صحيح مشاعرها تجاه أوكتاف؛ أما هذا الأخير فقد احتاج إلى عشرة فصول قبل أن يكتشف أن ما يكنه لأرمانس لا يسمى صداقة بل حبا؛ وخلال خمسة فصول، ظلت أرمانس تعتقد أن أوكتاف لا يحبها. وظل أوكتاف يعتقد طيلة الخمسة عشر فصلا المركزية في الكتاب أن أرمانس لا تحبه؛ ونفس سوء الفهم يتكرر في نهاية الكتاب. إن الشخصيات تقضي حياتها في البحث عن الحقيقة، أي في بناء الأحداث والوقائع التي تحيط بها. إن النهاية المأساوية للعلاقة الغرامية لا ترجع إلى العجز، كما قيل غالبا، ولكن إلى انعدام المعرفة. لقد انتحر أوكتاف بسبب بناء سيء: لقد اعتقد أن أرمانس لم تعد تحبه. وقد قال عنه ستاندال في جملة دالة: "كان ينقصه عمق الفهم لا قوة الشخصية".
من هذا الملخص السريع يتضح أن عدة مظاهر من عملية البناء يمكن أن تتنوع. فقد يكون أحدها ذاتا أوموضوعا، مرسلا أو متلقيا لمعلومة ما، وقد يكون الإثنين معا. إن أوكتاف يمثل ذاتا حين يخفي أو يكشف؛ ويمثل موضوعا حين يعرف أو يخطئ. يمكننا أن نبني واقعة ( من "الدرجة الأولى") أو نصوغ بناء طرف آخر لهذه الواقعة ( من "الدرجة الثانية"). كذلك الشأن بالنسبة لأرمانس حين تتخلى عن فكرة زواجها من أوكتاف لأنها تتخيل ما سيتصوره الآخرون في هذه الحالة. "سيعتقدون أنني امرأة مبتذلة قامت بغواية ابن الدار. أكاد أسمع من هنا ما قد تقوله السيدة دوقة انكر وحتى النساء الأحثر احتراما، مثل ماركيزة دوسيسسنس التي ترى في أوكتاف زوجا لإحدى بناتها". وكذلك تخلى أوكتاف عن فكرة الانتحار لأنه صاغ بناءات محتملة يقوم بها الآخرون. "إذا قتلت نفسي، فإن أرمانس ستتعرض للمضايقات؛ سيبحث الجميع بفضول خلال ثمانية أيام عن أصغر تفاصيل تلك الليلة؛ وكل واحد من هؤلاء السادة الذين كانوا حاضرين سيسمح لنفسه بتقديم صيغة مختلفة للأحداث".
ما نتعلمه من رواية أرمانس بالدرجة الأولى هو أن البناء قد يكون صائبا أو خاطئا. وإذا كانت كل حالات الصواب متشابهة ( حيث يتعلق الأمر بالحقيقة)، فإن حالات الخطأ تتنوع كما تتنوع أسبابها: نقص المعلومات المقدمة. وأبسط حالة هنا هي حالة الجهل التام: فحتى وقت معين من الحبكة، كان أوكتاف يخفي سرا شخصيا ( دور فاعل)، بينما كانت أرمانس تجهل هذا السر ( دور المنفعل). بعد ذلك قد يصبح السر معروفا، ولكن دون معلومة إضافية؛ ويمكن للمتلقي حينها أن يستجيب عن طريق تخيل الحقيقة ( تفترض أرمانس أن أوكتاف قد قتل شخصا ). هناك درجة تالية يمثلها الوهم: إن الفاعل لا يخفي ولكن يسيء الفهم، والمنفعل لا يجهل ولكن يخطئ. وهذه هي الحالة الأكثر حضورا في الكتاب: إن أرمانس تخفي حبها لأوكتاف وتدعي أنها ستتزوج شخصا غيره؛ ويعتقد أوكتاف أن أرمانس لا تكن له سوى مشاعر الصداقة. وقد يكون أحدهم فاعل وموضوع سوء الفهم: هكذا كان أرمانس يتجاهل حبه لأرمانس. وأخيرا فإن الفاعل يمكن أن يكشف الحقيقة، ويطلع عليها المنفعل.
الجهل، التخيل، الوهم، الحقيقة: يمر مسلسل المعرفة بثلاث مراحل على الأقل قبل أن تصل الشخصية إلى بناء نهائي. ونفس المراحل ممكنة طبعا ضمن مسلسل القراءة. عادة يكون البناء المعروض في النص مجانسا للبناء الذي يتخذ من هذا النص نقطة انطلاق له. إن ما تجهله الشخصيات يجهله القارئ أيضا؛ وهناك طبعا تركيبات أخرى ممكنة. إن واتسون، في الرواية البوليسية، ينجز بناء شبيها بالبناء الذي ينجزه القارئ؛ ولكن شرلوك هولمز ينجز بناء أحسن: وهما معا دوران ضروريان.
القراءات الأخرى
إن عيوب قراءة البناء لا تشكك البتة في مصداقيتها: إننا لا نكف عن البناء حتى وإن كانت المعلومات ناقصة أو خاطئة. فعلى العكس من ذلك، فإن هذه العيوب، لا تزيد عملية البناء إلا نشاطا. ولكن من الممكن ألا تتحقق عملية البناء، وأن تأتي أنواع أخرى من القراءات لتعوضها.
إن الاختلافات من قراءة لأخرى لا توجد بالضرورة حيث نتوقعها. يبدو مثلا ألا فرق كبيرا بين البناء انطلاقا من نص أدبي ومن نص آخر، مرجعي ولكن غير أدبي. هذا التقارب كان حاضرا ضمنيا في الاقتراح الوارد في الفقرة السابقة، ونعني أن بناء الشخصيات انطلاقا من مادة غير أدبية مشابه للبناء الذي يقوم به القارئ ( انطلاقا من نص روائي). إننا لا نبني العالم المتخيل بطريقة مغايرة لبناء "الواقع". إن المؤرخ، وهو ينطلق من وثائق مكتوبة، أو القاضي وهو يعتمد على شهادات شفهية، من أجل إعادة بناء "الوقائع"، لا يتصرفان بطريقة مخالفة ، من حيث المبدأ، لما يقوم به قارئ رواية أرمانس؛ لكن هذا لا ينفي وجود فروق أخرى في الجزئيات.
هناك قضية أكثر صعوبة، تتجاوز إطار هذه الدراسة، وتهم العلاقة بين البناء انطلاقا من معلومات لفظية والبناء انطلاقا من مدركات أخرى. فبعد أن نشم رائحة فخذ الخروف فإننا نقوم ببناء فخذ الخروف. ونفس الأمر يحدث مع موضوعات مسموعة أو مرئية،الخ؛ وهو ما يسميه بياجيه "بناء الواقع". ويمكن للفروق أن تكون هنا بحجم أكبر.
ولسنا في حاجة إلى الذهاب بعيدا عن الرواية لنجد مادة تفرض علينا القيام بنوع آخر من القراءة. هناك نصوص أدبية لا تقودنا إلى أي بناء، نصوص غير تمثيلية. يجب التمييز هنا بين حالات كثيرة. أكثرها وضوحا هي حالة نوع من الشعر المسمى عادة شعرى غنائيا، والذي لا يصف أحداثا، ولا يستدعي شيئا آخر خارجه. والرواية الحديثة، بدورها تفرض علينا قراءة مختلفة: فالنص مرجعي فعلا، ولكن البناء غير ممكن لأنه، بمعنى ما غير قابل للحسم. وهذه النتيجة تحدث بسبب اختلال في ميكانيزم من الميكانيزمات الضرورية للبناء، كما تم وصفها في الفقرات السابقة. نكتفي بمثال واحد: رأينا أن هوية الشخصية ترتكز على تطابق ووضوح تسميتها. ولنتخيل الآن أن نفس الشخصية في نص ما، يشار إليها بتسميات متعددة، تارة جان، وتارة بيير، وأخرى "الرجل ذو الشعر الأسود"، ومرة غيرها "الرجل ذو العيون الزرق"، دون أي شيء يشير إلى وجود إحالة مشتركة بين العبارتين؛ ولنتصور أيضا أن الاسم "جان" يحيل لا على شخصية واحدة بل على ثلاث أو أربع شخصيات؛ وفي كل حالة نصل إلى نفس النتيجة: سيكون البناء عملية مستحيلة، لأنه لا يمكن الحسم في تمثيلية النص. نرى هنا الاختلاف مع عيوب البناء المشار إليها أعلاه، حيث ننتقل من غير المعروف إلى ما هو غير قابل للمعرفة. هذه الممارسة الأدبية الحديثة لها ما يقابلها خارج مجال الأدب: إنه خطاب حالة الفصام. فهذا الخطاب يحتفظ بنية التمثيل، لكنه يجعل عملية البناء مستحيلة، بواسطة سلسلة من الإجراءات الخاصة ( تحدثنا عنها في الفصل السابق).
سيكون كافيا في الوقت الراهن أننا بينا قيمة هذه القراءات الأخرى إلى جانب القراءة كبناء. إن الاعتراف بمثل هذا التنوع الأخير أمر ضروري، خاصة وأن القارئ الفردي وهو البعيد عن الإحساس بالتمييزات النظرية التي يتخذها أمثلة، يقرأ نفس النص بطرق مختلفة في نفس الوقت، أو بالتتابع. إن نشاطه هذا يبدو له أمرا طبيعيا إلى حد أنه لا يستطيع إدراكه. يجب إذن أن نتعلم كيف نبني القراءة، سواء كبناء أو كهدم.
"La lecture comme construction", in Tzvetan Todorov, Poétique de la prose, éditions du seuil, 1971, 1978, pp 175-188.