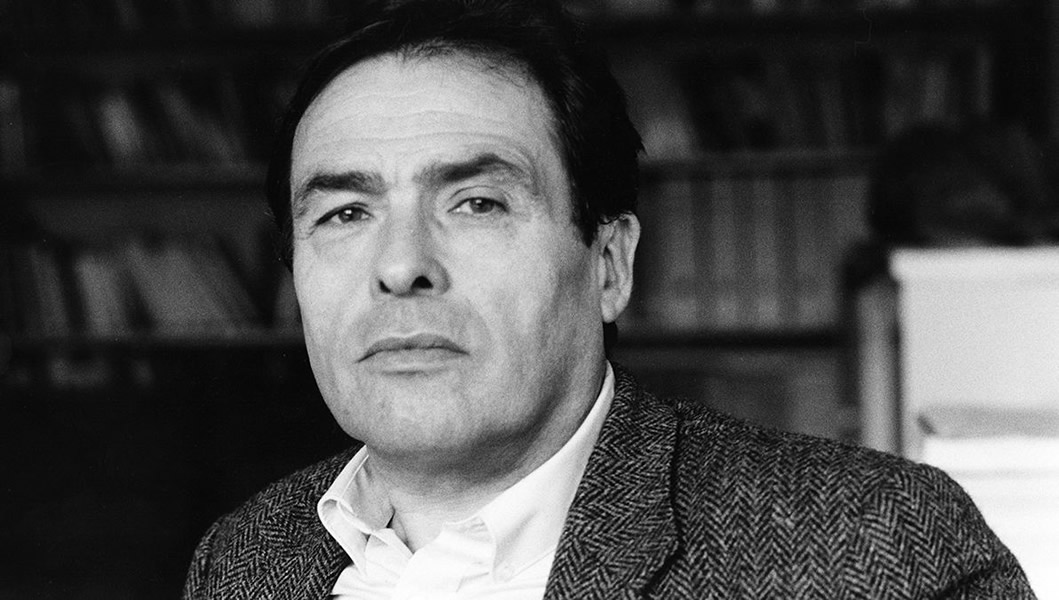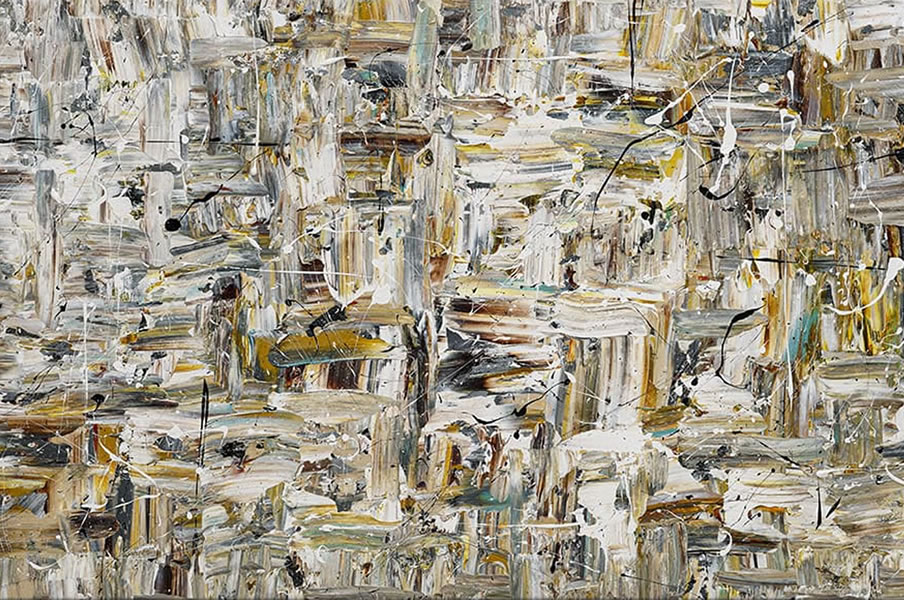تناول عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (1 أغسطس 1930 - 23 يناير 2002) السلطة في سياق "نظرية مجتمعية" شاملة، والتي - كما هو الحال مع نظرية ميشيل فوكو - لا يمكننا هنا إنصافها، أو التعبير عنها بسهولة من خلال مناهج تطبيقية. ورغم أن موضوعه كان في الغالب المجتمع الجزائري والفرنسي، فقد وجدنا أن منهج بورديو مفيد في تحليل السلطة في عمليات التنمية والتغيير الاجتماعي. في حين يرى فوكو السلطة "موجودة في كل مكان" وتتجاوز نطاق الفاعلية أو البنية، يرى بورديو السلطة كعنصر ثقافي ورمزي، يُعاد إضفاء الشرعية عليه باستمرار من خلال تفاعل الفاعلية والبنية. والطريقة الرئيسية لتحقيق ذلك هي من خلال ما يسميه "الهابيتوس" أو المعايير أو الميول الاجتماعية التي توجه السلوك والتفكير. "الهابيتوس" هو "الطريقة التي يترسخ بها المجتمع في الأفراد على شكل ميول دائمة، أو قدرات مُدرَّبة وميول مُهيكلة للتفكير والشعور والتصرف بطرق مُحددة، تُوجِّههم". يتشكل "الهابيتوس" من خلال عملية اجتماعية، لا فردية، تُؤدي إلى أنماط دائمة وقابلة للانتقال من سياق إلى آخر، ولكنها تتغير أيضًا تبعًا لسياقات مُحددة ومع مرور الوقت. "الهابيتوس" "ليس ثابتا أو دائم، ويمكن تغييره في ظروف غير متوقعة أو على مدى فترة تاريخية طويلة": "الهابيتوس" ليس نتيجة إرادة حرة، ولا تُحدَّد بالهياكل، بل ينشأ من نوع من التفاعل بينهما على مر الزمن: ميول تُشكِّلها أحداث وهياكل الماضي، وتُشكِّل الممارسات والهياكل الحالية، والأهم من ذلك، تُحدِّد إدراكنا لها . بهذا المعنى، تُخلق الهابيتوس وتُعاد إنتاجها لا شعوريًا، "دون أي سعي متعمد لتحقيق التماسك... دون أي تركيز واعٍ". ومن المفاهيم المهمة الثانية التي طرحها بورديو مفهوم "رأس المال"، الذي يتجاوز مفهوم الأصول المادية ليشمل رأس مال قد يكون اجتماعيًا أو ثقافيًا أو رمزيًا. قد تكون هذه الأشكال من رأس المال بنفس الأهمية، ويمكن تراكمها ونقلها من مجال إلى آخر. يلعب رأس المال الثقافي - والوسائل التي يُنشأ بها أو يُنقل من أشكال رأس المال الأخرى - دورًا محوريًا في علاقات السلطة المجتمعية، إذ "يوفر وسيلة لشكل غير اقتصادي من الهيمنة والتسلسل الهرمي، حيث تتميز الطبقات من خلال الذوق".
مآدب المآتم في تونس:"مطبخ المعنى"* - الحبيب النهدي**
"العناية الجنائزيّة ، واختيار المدافن، وموكب مأتمّي بهيج، أقل ضرورة لسلام الموتى منه من تعزية الأحياء" أوغسطينوس St Augustin, La cité de Dieu 1,12[1]
"ان الواقع هو طعام قبل كل شيء"[2] باشلار
الكلمات المفتاحية: مآدب المآتم – طقوس الانتقال - استئناس الموت – التبادل الرمزي –– الروابط الاجتماعيّة – المخيّال الجماعي - التخاصصية
تقديم عام:
لا تنحصر مسألة الأطعمة فيما هو طبيعي وبيولوجي فحسب بل هي ممارسة ثقافية وذات دلالة سيمائية ورمزية اكتسبها الانسان لحظة "الأكل من الشجرة"[3] فمن لحظة خروجه من الجنّة إلى حين لحظة جوعه وبحثه عن سدّ رمقه، بدأ في اكتشاف النبات وتعلّم قطف الثّمار والقنص والصيد (برا وبحرا وجوا)، وتسمّى هذه المرحلة من تاريخ البشرية بمرحلة القطّافين الصيّادين (Les pécheurs cueilleurs ). ومنذئذ تفنّن في إعداد المطبخ بحسب مراحل تطوره لأدوات الطبخ واستعمالاتها وفق ما اكتسبه من أنساق الثقافة وأنظمة الاجتماع[4] والتي حدّدت سلوكه الغذائي ونمطته وفق حاجياته، من أجل سدّ رمقه بما توفّره بيئته، وذلك في إطار توافق مع اعتقاداته ومعيشه اليومي من جهة، ومع المقدس والمتخيّل من جهة أخرى (بما فيه من سرديّة وردت عن طعام أهل الجنّة او عن طعام الميت[5]). ولقد اتضح ذلك أساسا في طقوس الانتقال/العبور (الولادة-الزواج-الموت)[6] فتتمايز حينئذ استعمالات الأطعمة بحسب تنوع الأديان (حلال/حرام) وتختلف بحسب الأمكنة والأزمنة وتعكس تفاوتا طبقيا بين الأفراد والجماعات والأمم. وهذه اللّامساواة أمام الحق في الغذاء، مثلت تهديدا للأمن الغذائي فنشبت حروب لم تتوقف. وآلت إلى نزف ثروات. ومايزال الاستعمار ينهب خيرات الشعوب، مما أدى إلى تحوّلات في السلوكيات الغذائية. وانتقلنا من التدبير الاقتصادي المنزلي الممركز حول ذاته، إلى التبذير التّابع لاقتصاد السوق. (انتقال من منتوجات بيولوجية بمورثات أصلية إلى معلبات بمورثات هجينة -من الاكتفاء الذاتي بالضروريات إلى التبعية للكماليات- ممن يمتلك فائض اللّذات إلى غيره الذي يعاني فائض الحرمان- ممن يموت بالتخمة إلى غيره ممّن يموت من الجوع-
فالاستعمار الفرنسي مثلا في تونس[7] أرسى نمطا استهلاكيا وعادات ذوقية غذائية جديدة (فكّكت ثقافة التدبير المنزلي واستبدلها باقتصاد السوق الاستهلاكي. فحول استعمالات الأطعمة المحليّة والصحيّة إلى سلوك غذائي سريع ومضرّ بالصحة وفاقد للمعنى). مما ساهم في تدمير وحدة الربط بين الأطعمة والأنظمة الرمزية الخصوصية، أي هويّة الطعام التونسي، واستبدالها بقيم مستوردة باسم الحداثة. وحدَّثت أساليب المطبخ، مما جعل ما عُرف بالجلاء الزراعي لم يكن جلاء في المطبخ التونسي ولا حفاظا على أمّننا الغذائي (لأنّ رهان الطعام هويّة شعب وتنمية مستدامة). لكن ما هو مثير للانتباه أن المجتمع في ظلّ الاحتفالات الدينية يستعيد ما يميزه عن غيره، ويجعله يتشبث بعاداته وتقاليده، مما يعني أنّ الطقوس الجماعية للطعام هي مناسبة يحرص فيها المجتمع على أن يبقى وفيا لخصوصيته ويستهلك التقليدي من الأشياء، ذلك أن طعام المناسبات الدينية أو الاحتفالات العائليّة ما هي إلاّ " تعابير هوية تعزز الشعور بالانتماء وتعيد تشكيل التضامن وليس طابعها الإلزامي مجرد مسرحية وإنما هو شكل من أشكال الخطاب الذي يتوجه المجتمع به إلى نفسه."[8] ويمكن لنا أن ندرج مآدب المآتم في هذا السياق الذي يحتاج منا تفكيرا وتدقيقا في كيفية عيش المجتمع التونسي الحالي لطقوسه من أجل فهم مدى محافظته على خصوصيته في الحداد والاحتفاء بالميت في ظلّ تحولات اجتماعيّة متسارعة مسّت كلّ مظاهر حياته.
النخب، أو مجتمع النفاق المعرفي – عبد الحفيظ أيت ناصر
إن التفكير في الإنسان في مثل هذه اللحظات شيء مخيف، التفكير في الوضع البشري الذي لا يبعث على التفاؤل أبدًا، بله، يكون التفاؤل سخرية من الوضع، لكن يا لشقاء الإنسان إذا لم يكن قادرا على طرح السؤال، فذلك يعني أنه لم يعد بمقدوره أن يمارس الرفض، أي أن يفكر أي أن يقول لا.
مالذي يُعدِم الإنسان في الإنسان؟ ليس هذا الذي نسميه انسانا سوى الكائن الوحيد القادر على قول لا، القادر على ممارسة الرفض، ومتى توقف عن ذلك فقد انسانيته، لقد نَاصَب سقراط-افلاطون الكتابَة العداءَ، لأنها العنصر الذي كان يحفظ النظام الإجتماعي، فمتى شاعت، شاعت الحكمة وفقد مجتمع القلة أفضليته بحصول المشاركة في ما يمثل القوة على البروز والتعبير عن الذات وتحققها، بعنصر الكتابة يدخل الكائن مجتمع الأنداد لأنه يصبح شخصا، شخصا لأنه مارس الرفض، وقد كان قبل ذلك مجرد أداة، مجرد تعبئة داخل المدينة، إنه الحطب الذي يسمح لشعلة النظام الاجتماعي بالاتصال.
هذه هي أعظم قضية من قضايا المدينة إن لم تكن موضوعتها الأساس، كيف يتم الحفاظ على النظام الإجتماعي، كيف يتم انتاجه، وكيف يصبح الإنسان مجرد حطب وتعبئة للحفاظ على هذا النظام
لقد سمحت الكتابة دائما بنزول المتعالي إلى الساحات العامة، فقد كانت دائما قائمة في ضدية المطلق قائمة في ضدية الميتافزيقا، إن الكتابة هي العملية التي يتم من خلالها خلخلة كل سلطة وكل هيمنة، فهي التي سمحت بنزول التعاليم السرية إلى الساحة العامة، إنها ما يمنح القانون أحقيته ليكون على رأس المدينة تحفظ سلطته وتحفظه هو نفسه (فرنان 1962 )، وبذلك فإن الحدث الأكثر جلالا في تاريخ أي حضارة إنسانية هو الخروج من الشفاهة والدخول في عرف الكتابة، ذلك أن الشطط كل الشطط في ممارسة السلطة دائما ما كان لصيقا بالشفاهة وبالخطابة، غير أن البئيس جدا هو الدخول في الكتابة دون التخلي تماما عن ذهنية الخطاب وشطط الكلام.
إن مجتمع القلة هو مجتمع الإقتران الحاصل بين السلطة والرأسمال، هو نفسه قضية خلق مجتمعين أو أكثر داخل ما يُفترض فيه أن يكون مجتمعا واحدا، وتغيب فيه الندية والشخصية، ثم إن قيمة الشخص لا تقوم إلا داخل مجتمع الأنداد بوصفه مجتمع الفرص المتكافئة، أما مجتمع القلة ولكونه يتكون من مجتمعين فإن الذين يكونون دون ندية القلة في الغالب هم نفسهم أداة حفظ هذا النظام وهذا التراتب، وهم في الغالب يسيرون في طريق فقدان انسانيتهم، حشد من الناس لا يستطيع أن يمارس الرفض، يتم افراغهم بمختلف الكيفيات من شخصياتهم وحملهم على الدخول والانخراط في الدفاع عن حقائق لا تمثل شخصيتهم ولا مصالحهم.
في مجتمع القلة يحصل الإنسان على ما دون الكفاف، ويعيش دائما على حافة الفاقة والعوز، إن المحرك الأساسي له هو الحاجة، وبذلك لا تتعدى أقصى مطالبة مجرد العيش، مجرد الاستمرار على قيد الحياة، وقد تم بذلك تعريضه للحصر، للقمع، للكبث، كلما أراد أن يقول لا، توجس خيفة من شبح الحاجة، إن أغلى ما يملك هو مجرد العيش وهو ليس مستعدا للتنازل على هذا المِلك، وهو بذلك انسان عارٍ من الإنسانية.
تحولات الأفكار في الإنسان والمجتمع والحياة - إبراهيم أبو عواد
الأفكارُ المُتكاثرةُ في المنظومة الثقافية تُمثِّل إنتاجًا مُستمرًّا للعلاقاتِ الاجتماعية ، وَتَوْليدًا دائمًا للعملية الإبداعية على الصَّعِيدَيْن : الإنسانيِّ والماديِّ ، مِمَّا يَدْفَع باتِّجاه تَطوير رُؤيةِ الإنسانِ لذاته ، ورُؤيته لِمُجْتَمَعِه . وَهَذه الرُّؤيةُ المُزْدَوَجَةُ للذاتِ وَالمُحِيطِ تُؤَسِّس نظامًا فلسفيًّا تَراكميًّا يَفْحَصُ التَّصَوُّرَاتِ الحَيَاتِيَّة ، ويَخْتَبِر التأمُّلاتِ الوُجودية ، وَيَمْتَحِن الظُّروفَ المَعيشية. وهَذا يُؤَدِّي إلى تَقْويةِ الصِّلَةِ بَيْنَ الفِكْرِ والتَّطبيقِ مِنْ جِهَة ، وَتَفْعِيلِ الوَعْي بأهمية الحَياة الثقافية للفردِ والجَماعةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى .
وإذا كانت الأفكارُ تَتَحَوَّلُ مَعَ مُرورِ الوَقْت إلى مَواقف حَياتية وحَالاتٍ إبداعية ، فَإنَّ عَناصر الحياة الثقافية تَتَحَوَّلُ مَعَ ضَغْطِ الواقع الاستهلاكيِّ إلى رُموز كامنة في المَشَاعِرِ المَقموعةِ ، والأحلامِ المَكبوتة ، والذكرياتِ المُسْتَتِرَة . وَوَظيفةُ الإنسانِ الأسَاسِيَّةُ هِيَ استخراجُ هَذه الرُّموزِ الكَامنةِ ، وحَقْنُها بالحُرِّيةِ والحَيويةِ ، وإعادةُ بَعْثِها إلى الحَياةِ ، وهَذا يَعْني تَحَوُّلَ الثقافةِ إلى حَياةٍ دَاخِلَ الحَياةِ ، وانتقالَ القِيَمِ الإبداعيةِ مِنَ الهَامِشِ إلى المَركَز ، مِمَّا يَحْمِي المُجْتَمَعَ مِنَ الفَجَوَاتِ المَعرفية، وَالثَّغَرَاتِ المَخْفِيَّة في مَصادر الوَعْي الاجتماعيِّ .
إنَّ الوَعْي الاجتماعيَّ لا يُحرِّر الإنسانَ مِنَ الخَوْفِ والعَجْزِ فَحَسْب ، بَلْ أيضًا يَمْنَعُ المُجْتَمَعَ مِنَ الوُقُوعِ في الفَراغِ ، ويَحْمِي الحَضَارَةَ مِن انتحارِ المَعْنَى ، وَيَحْرُسُ التَّنَوُّعَ الثقافيَّ مِنَ العَدَمِ ، وَيَحْفَظُ الشُّعُورَ مِنَ الاستلابِ ، وَيُبْعِد الشخصيةَ الفرديةَ والسُّلطةَ الاعتبارية للكَينونةِ الإنسانيةِ عَن الاغترابِ .
وَالوَعْيُ الاجتماعيُّ يُولَدُ مِنْ رَحِمِ اللغة ، وَيَتَشَكَّلُ في الأُطُرِ المَرجعيةِ لِمَصادرِ المَعرفةِ تاريخيًّا وحَضاريًّا . وإذا كانَ التاريخُ يَكتبه المُنتصِر ، والحَضارةُ يُهَيْمِن عَلَيْهَا الطَّرَفُ الأقْوَى ، فَإنَّ اللغة يُفَجِّرُ طَاقَتَهَا الرَّمزيةَ الطَّرَفُ الأكثرُ إبداعًا . والإبداعُ لا يَتَكَرَّسُ كَحقيقةٍ واقعية إلا إذا تَخَلَّصَ مِنَ الجُمودِ ، وَتَحَرَّرَ مِنَ الانكماشِ ، وَأَفْلَتَ مِنَ الانغلاقِ . والإبداعُ لا يَتَجَذَّرُ كَمعرفةٍ جَمَاعِيَّة خَلَاصِيَّة إلا في ظِلِّ الانفتاحِ المَدروسِ ، والتواصلِ المَنطقيِّ ، وتَلاقُحِ الأفكار معَ التَّطبيقات، مِمَّا يُسَاهِمُ في تَشْييدِ الهُوِيَّةِ الإبداعية عَلى الخُصوصيةِ ، وتأسيسِ السُّلطةِ المَعرفية عَلى الذاتيةِ الثقافية، بعيدًا عَن الحُلولِ المُسْتَوْرَدَةِ ، وَعُقْدَةِ الشُّعُورِ بِالنَّقْصِ، والشُّعُورِ بِالدُّونِيَّةِ.
وَالحِفَاظُ عَلى مَفاهيمِ الهُوِيَّة والسُّلطةِ والذاتيةِ في المَنظومةِ الثقافية ذات التطبيقات الاجتماعية ، لا يَعْني العُزلةَ والتَّقَوْقُعَ عَلى الذاتِ وَالخَوْفَ مِنَ الآخَرِين ، بَلْ يَعْني اعتمادَ الثقافة المُجتمعية كَنِظَامِ حَيَاةٍ مُمَيَّز وأُسلوبِ عَيْشٍ فَعَّال ، انطلاقًا مِنْ مَبْدَأ الخُصوصيةِ ، وَالمَعاييرِ الأخلاقيةِ ، وَالتَّكَيُّفِ مَعَ القُدراتِ الفردية وَخَصَائصِ الجَماعةِ الإنسانية ، وَالتَّأقْلُمِ مَعَ الفِعْلِ الحَضَاريِّ المُنْبَثِق مِنَ الواقعِ المُعَاشِ ، وَالمَضمونِ التاريخيِّ النابعِ مِنْ أدواتِ اللغةِ وآلِيَّاتِهَا .
عولمة الجمال - سميرة احيزون
الحديث عن موضوع الجمال جعلني أقف وقفة تأملية حائرة ،كيف سأتحدث عن هذا الموضوع الذي يندرج في السهل الممتنع، نظرا لكونه متداخل و عميق و يمكن مناقشته من أكثر من زاوية و مرجعية، وغالبا ما نجده من المواضيع الفلسفية الحاضرة بقوة. وقد كان الاهتمام به بالغا لدى اليونان عبر تاريخ الفلسفة، لكنه مع ذلك يظل منتسبا لمجال المعرفة النظرية و السلوك الأخلاقي أي أنه متعالي عما هو ملموس.
لكن الحديث هنا سيكون عن الجمال شكلا ، بالرغم من أني على إيمان تام بوقع الجمال الداخلي، و الروحي الموجود بسجية الإنسان و فطرته، و انعكاسه على الجمال الخارجي و ربما يجعله يطغى و يغطي رؤية و رأي من حولنا، لننتصر لقول ديفيد هيوم "الجمال ليس خاصية في ذات الأشياء بل في العقل الذي يتأملها".
الإنفلات من المعايير الثابثة و المحلية للجمال
لطالما كان الجمال محل إهتمام بني البشر منذ سالف الأزمنة باختلاف الحضارات، الإنسانية المتعاقبة و المختلفة.
و الاهتمام بالشكل ليس وليد اللحظة أو العصر الحالي فقط، و إنما وجد منذ عصور غابرة، لكن بطرق و تقنيات متباينة،بالإعتماد على الطبيعة و عادات و تقاليد المجتمعات و الحضارات، كالحضارة اليونانية أو الرومانية ،المصرية القديمة و أيضا الصينية و الهندية القديمة، فكل واحدة منها كانت تعتمد على معايير معينة تعتبر مقياسا للجمال آنذاك ،كلون البشرة الفاتح مثلا و العيون الواسعة أو الكمال الجسدي و لون الشعر و شكل الشفاه و الجبهة ، و هذا طبعا دون إغفال الجانب الروحي في المسألة، و بالتالي كان هناك نمط معين للجمال بأوصاف محددة و ثابثة، يجب توفرها في المرأة المنتمية لإحدى الحضارات،و هو أيضا ما يمكن أن نلمسه في المجتمعات الصحراوية التي تعتبر السمنة رمزا للجمال ، حيث يتم إخضاع الفتيات لعملية التسمين منذ صغرهن.
عادة ما يتم تقسيم الشعوب إلى ثلاثة أقسام، حسب التنوع الجيني البيض "القوقاز " و الآسيويون "المغول" و السود "الزنوج"، و تتميز كل سلالة بمواصفات متفردة للوجه و العيون و الأنف و لون البشرة ، تجعل لنا القدرة على اكتشاف جنسية الشخص أمامنا بمجرد النظر إلى تقاسيم وجهه و ملامحه ... مما يحيلنا على مميزات للجمال محلية، تحمل طابع الخصوصية و الإنتماء.
ويليام دو بوا.. إعادة بناء الهوية الاجتماعية للأمريكيين الأفارقة – د. حسن العاصي
كانت الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام 1928 فترة أزمات واضطرابات اجتماعية مفاجئة في الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن سوى القليل من الهروب من المفارقات المؤلمة التي رافقت العصر الجديد. لا شك أن هذه السنوات من المعاناة التي عاشها البيض والأميركيون من أصل أفريقي على حد سواء كانت أشد وطأة على الأميركيين السود. وعلى أية حال، لم يدخر زعيمها "ويليام إدوارد بورغاردت دو بوا" William Edward Burghardt Du Boisأي جهد في اقتراح رؤية جديدة للعالم على شعبه، والتي كانت تتمثل في الالتزام دون تحفظ بإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لفترة ما بعد الحرب.
وُلِد وليام دو بوا في 23 فبراير 1868 في "جريت بارينغتون" Great Barrington,وهي بلدة صغيرة في غرب "ماساتشوستس" Massachusetts ولذلك لم يشهد دو بوا أهوال العبودية. كان جده لأبيه هوغونوتيًا" huguenot من أصل "فلاندرز،" Flandres هاجر إلى أمريكا الشمالية عبر هولندا وجزر الأنتيل في بداية القرن الثامن عشر. لا يقدم دو بوا الكثير من التفاصيل حول هذا الفرع من شجرة عائلته. ومن ناحية أخرى، فإنه يعطينا الكثير من المعلومات عن الفرع الأمومي، عائلة "بورغاردت" Burghardt. وصل هؤلاء إلى غريت بارينغتون في القرن الثامن عشر، ومثل البيض، اندمجوا مع تقاليد المدينة وتاريخها. وفي الأمور الدينية، كانوا أحياناً من الأسقفيين، وأحياناً أخرى من الطائفة الكنسية. لم يكن آل بورغاردت أغنياء جداً. ومع ذلك، كانوا يمتلكون منازلهم وبعض الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة. لقد عرفوا الحياة المنزلية والفقر أحياناً. وكان الجد، " أوتو بول بورغاردت" Otto Paul Burghardt قد حصل على حريته وحريه نسله كمكافأة على شجاعته خلال حرب الاستقلال. باختصار، نشأ ويليام الصغير على الجانب المشرق من الفقر.
لقد نشأ في مجتمع متسامح ومتكامل نسبياً. بعد إكماله للدراسات العليا في جامعة فريدريش فيلهلم Friedrich Wilhelm University في برلين وجامعة هارفارد Harvard University، حيث كان أول أمريكي من أصل أفريقي يحصل على درجة الدكتوراه، برز دو بوا على المستوى الوطني كزعيم لحركة نياجرا، وهي مجموعة من نشطاء الحقوق المدنية السود الذين يسعون إلى المساواة في الحقوق. عارض دو بوا وأنصاره تسوية أتلانتا. وبدلاً من ذلك، أصر دو بوا على الحقوق المدنية الكاملة والتمثيل السياسي المتزايد، والذي كان يعتقد أنه سيتم تحقيقه من قبل النخبة الفكرية الأمريكية من أصل أفريقي. وأشار إلى هذه المجموعة باسم العُشر الموهوب، وهو مفهوم تحت مظلة الارتقاء العنصري، وكان يعتقد أن الأمريكيين من أصل أفريقي يحتاجون إلى فرص التعليم المتقدم لتطوير قيادتهم.
كان دو بوا أحد مؤسسي الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في عام 1909. استخدم دو بوا منصبه في NAACP للرد على الحوادث العنصرية. بعد الحرب العالمية الأولى، حضر مؤتمرات عموم إفريقيا، واعتنق الاشتراكية وأصبح أستاذاً في جامعة أتلانتا. بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، انخرط في نشاط السلام واستهدفه مكتب التحقيقات الفيدرالي. أمضى السنوات الأخيرة من حياته في غانا وتوفي في أكرا في 27 أغسطس 1963.
التقاطعية والأبعاد المتعددة للهوية – د. حسن العاصي
التقاطع مفهوم اكتسب اهتماماً كبيراً في علم الاجتماع، وخاصة عند معالجة القضايا المتعلقة بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية. التقاطعية هي إطار تحليلي اجتماعي لفهم كيف تؤدي الهويات الاجتماعية والسياسية للمجموعات والأفراد إلى مجموعات فريدة من التمييز والامتياز. تشمل أمثلة هذه العوامل الجنس، والطبقة، والعرق، والإثنية، والجنسانية، والدين، والإعاقة، والطول، والمظهر الجسدي، والعمر، والوزن. قد تكون هذه الهويات الاجتماعية المتقاطعة والمتداخلة تمكينية وقمعية في نفس الوقت.
نشأ التقاطع كرد فعل على كل من النسوية البيضاء وحركة التحرير السوداء التي يهيمن عليها الذكور آنذاك، مستشهدة بـ "القمع المتشابك" للعنصرية والتمييز على أساس الجنس والمعيارية الجنسية. إنها توسع نطاق الموجتين الأولى والثانية من النسوية، والتي ركزت إلى حد كبير على تجارب النساء البيض والطبقة المتوسطة، لتشمل التجارب المختلفة للنساء الملونات، والنساء الفقيرات، والنساء المهاجرات، وغير ذلك من المجموعات، وتهدف إلى فصل نفسها عن النسوية البيضاء من خلال الاعتراف باختلاف تجارب النساء وهوياتهن.
صاغت الأكاديمية الحقوقية الأمريكية "كيمبرلي كرينشو" Kimberlé Crenshaw مصطلح التقاطعية في عام 1989 وهي تصف كيف تؤثر أنظمة القوة المتشابكة على أولئك الأكثر تهميشاً في المجتمع. يستخدم الناشطون والأكاديميون هذا الإطار لتعزيز المساواة الاجتماعية والسياسية. تعارض التقاطعية الأنظمة التحليلية التي تعالج كل محور من محاور القمع بمعزل عن الآخر. في هذا الإطار، على سبيل المثال، لا يمكن تفسير التمييز ضد النساء السود على أنه مزيج بسيط من كراهية النساء والعنصرية، بل كشيء أكثر تعقيداً. والتقاطعية تصف الطرق التي تتقاطع بها الفئات الاجتماعية المختلفة - مثل العرق والجنس والطبقة والجنسانية - لخلق تجارب فريدة من التمييز أو الامتياز. وبدلاً من النظر إلى هذه الفئات بمعزل عن بعضها البعض، يسلط التقاطع الضوء على كيفية تفاعل أبعاد متعددة للهوية لتشكيل حياة الأفراد والمجموعات. يساعدنا هذا النهج على فهم كيف يمكن لأنظمة القمع - مثل العنصرية والتمييز على أساس الجنس والطبقية - أن تتداخل وتعزز بعضها البعض.
لقد أثرت التقاطعية بشكل كبير على النسوية الحديثة ودراسات النوع الاجتماعي. يقترح أنصارها أنها يعزز نهجاً أكثر دقة وتعقيداً لمعالجة القوة والقمع، بدلاً من تقديم إجابات مبسطة. يقترح منتقدوه أن المفهوم واسع جداً أو معقد، ويميل إلى تقليص الأفراد إلى عوامل ديموغرافية محددة، ويُستخدم كأداة أيديولوجية، ويصعب تطبيقه في سياقات البحث.
الوظائف السخيفة والارتباك الأخلاقي - د.حسن العاصي
هل لديك وظيفة تعتقد سرا أنها لا معنى لها؟ إذا كان الأمر كذلك، فلديك ما يسميه عالم الأنثروبولوجيا والناشط اللاسلطوي الأمريكي "ديفيد غريبر" David Graeber "وظيفة هراء". قام غريبر، وهو أستاذ في كلية لندن للاقتصاد وزعيم حركة احتلال وول ستريت المبكرة، بتأليف كتاب بعنوان: وظائف الهراء: نظرية" Bullshit Jobs: A Theory.
يفترض غريبر وجود وظائف لا معنى لها ويحلل ضررها المجتمعي. ويؤكد أن أكثر من نصف العمل المجتمعي لا معنى له ويصبح مدمراً نفسياً عندما يقترن بأخلاقيات العمل التي تربط العمل بقيمة الذات. فهو يزعم أن هناك الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم ــ الموظفون الكتابيون، والإداريون، والاستشاريون، والمسوقون عبر الهاتف، ومحامو الشركات، وموظفو الخدمات، وكثيرون غيرهم ــ الذين يكدحون في وظائف لا معنى لها وغير ضرورية، وهم يعرفون ذلك. ويجادل بأن ربط العمل بالمعاناة الفاضلة هو أمر حديث في تاريخ البشرية، ويقترح النقابات والدخل الأساسي الشامل كحل محتمل.
يقول غريبر: لم يكن من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو. لقد تقدمت التكنولوجيا إلى حد أن معظم الوظائف الصعبة التي تتطلب عمالة كثيفة يمكن أن تؤديها الآلات. ولكن بدلاً من تحرير أنفسنا من أربعين ساعة عمل أسبوعية خانقة، اخترعنا عالماً كاملاً من المهن غير المجدية وغير المرضية مهنياً والفارغة روحياً.
يعد الكتاب امتداداً لمقال شهير نشره غريبر في عام 2013، والذي تُرجم لاحقًا إلى 12 لغة وأصبح فرضيته الأساسية موضوع استطلاع أجرته شركة YouGov. طلب غريبر مئات الشهادات من العمال الذين يعملون في وظائف لا معنى لها وقام بمراجعة قضية مقالته في شكل كتاب نُشر بواسطة "سايمون وشوستر" Simon & Schuster في مايو 2018.
الوظائف التافهة
كيف يحدد غريبر "الوظيفة الهراء"؟ إنها في الأساس وظيفة خالية من الهدف والمعنى. إنها مختلفة عن "الوظيفة القذرة"، وهي وظيفة يمكن أن تكون مهينة وشاقة وذات تعويض ضعيف، ولكنها تلعب في الواقع دورًا مفيداً في المجتمع. بل يمكن أن تكون الوظيفة التافهة مرموقة ومريحة وذات أجر جيد، ولكن إذا اختفت غداً، فلن يفشل العالم في ملاحظة ذلك فحسب، بل قد يصبح مكاناً أفضل بالفعل. الوظائف التافهة "تأخذ" أكثر مما "تعطي" للمجتمع.
قام غريبر بتحسين تعريفه من خلال تقديم تصنيفه المضحك للوظائف الهراء. هناك "أتباع"، يُعرفون أيضاً باسم "الخدم الإقطاعيون"، الذين يتم تعيينهم خصيصاً من قبل المديرين لجعلهم يبدون أكثر أهمية. "الحمقى" هم تلك القوة العدوانية المستأجرة التي توجد بشكل متكرر في فرق التسويق عبر الهاتف ووكالات العلاقات العامة، والتي يتم توظيفها فقط لإقناع الناس للقيام بشيء يتعارض مع منطقهم السليم. "التناقص التدريجي للقنوات" وهم موظفون يتم تعيينهم فقط لإصلاح مشكلة لا ينبغي أن تكون موجودة. "مؤشرات الصندوق"، التي لا نحتاج إلى مقدمة لها، و"سادة المهام"، الذين تتمثل وظيفتهم الوحيدة في إنشاء أنظمة بيئية جديدة كاملة للهراء (يمكن وصف الأخير أيضاً باسم "مولدات الهراء"). وهناك مجموعات مختلفة مما سبق، والتي يصفها غريبر بأنها "وظائف هراء معقدة ومتعددة الأشكال".