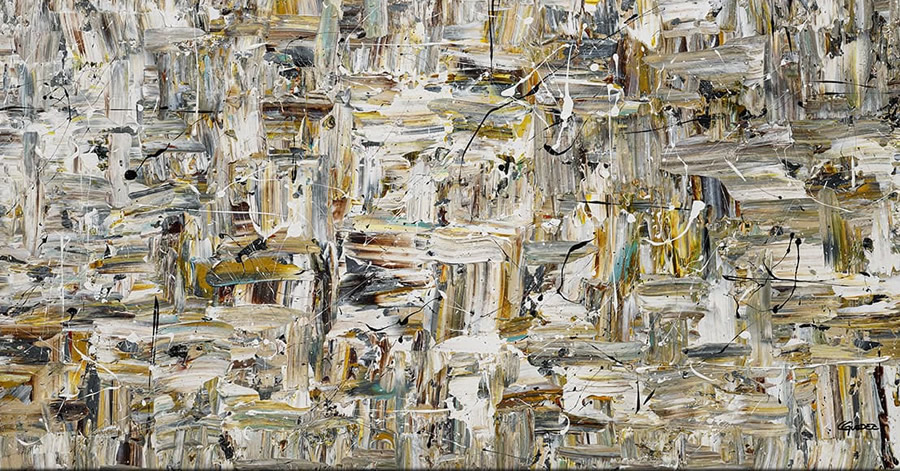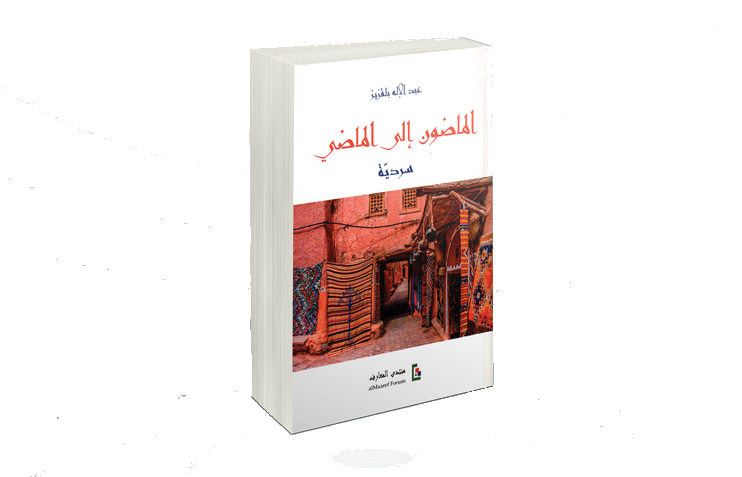لا يمكن اختصار منزلة السّؤال في كونه شكلاً وحيداً ومستقلاًّ من أشكال الخطاب الأدبي في مدوّنة التوحيدي، فهو يخترقُ أكثر من شكل فنجده في التّناظر كما في المنافرة وقد يكون أيضاً مُنطلقاً للرّواية والتّذاكر وغيرها. وليس المقصود هنا بالسّؤال مجرّد السّؤال العاديّ ذي البُعد التّواصلي بالأساس وإنّما السّؤال المُولّد للتّفكير ذي البعد التبصّري، فهو آليّة تفكير وأكثر منه مجرّد أداة تواصل وتبليغ، وهو الحامل لمُشكل معرفي قد يتجاوز الاستخبار ولا يتطلّب بالضّرورة إجابة مُحدّدة أو إجابة واحدة. هو تقريباً شبيه بالسّؤال التّوليدي* بالمعنى السّقراطي أي في معنى المُساءلة المستمرّة لتوليد المعارف والوصول إلى نتيجة مفادها أنّه لا توجد إجابة نهائيّة. وفي الكتاب الثامن من "المواضع " لأرسطو والمُخصّص لـ"ممارسة المُحادثة الجدليّة "نجدُ تنظيراً مخصوصاً بمنطق الأسئلة وتمشّياتها باعتبارها آليّة ضروريّة تسبق الفهم وإطلاق الأحكام وسمّاه "علم السّؤال*" وهو علمٌ واصفٌ للطّرق والآليات التي تُطرحُ بها الأسئلة على المُحاور.
ولا يخفى أيضاً أهميّة السّؤال بالنّسبة للمفكّرين والفلاسفة ما بعد أرسطو، فـ"كارل يسبرز" مثلاً اعتبر الأسئلة أهمّ من الأجوبة في عمليّة التّفلسف، دون اعتبار طبعاً أنّ كلّ إجابة مفترضة تتحوّل بدورها إلى سؤالٍ فلسفيّ جديد، ومنه يُستنتج أنّ السّؤال الحامل لمشكل معرفي، بالقدر الذي يبعثُ فينا الدّهشة والتّفكير، يظلّ حاملاً في نفس الوقت لقوّته وحيويّته ومُتأبّياً عن الانغلاق والفناء في الإجابة. "والقُدرة على السّؤال تعني القُدرة على الانتظار ولو كان ذلك مدى الحياة كلّها"([1]) على حدّ عبارة هايدغر، ويقصد بذلك أنّ السّؤال الأصيل يظلّ متجذّراً في الجواب إلى ما لانهاية وهو ما يؤكّده في سياقٍ آخر مشابه قائلاً: "كلّما زاد اقترابنا من الخطر تبدأ الطّرق إلى المُنقذ تلمعُ بجلاء أكبر، ونُصبحُ أكثر تساؤلاً، ذلك أنّ التّساؤل هو قمّة التّفكير"([2]). ويذهبُ "موريس ميرلوبونتي" بعيداً في تناول فلسفة السّؤال بأن يمنحه بُعداً أنطولوجيّاً، أي أنّ الوجودَ الإنساني في حدّ ذاته سؤالٌ ومنذ أوّل سؤال يبدأ الإنسان في تخطّي عتبة الحيوانيّة ففي "المرئي واللاّمرئي" يقول: "إنّ الأسئلة مُحايثة لوجودنا، لتاريخنا، فهي تولد بداخلها، وتموت بداخلها كلّما حصلتْ إجابةٌ ما، وفي غالب الأحيان فإنّها تتحوّل بداخلنا"([3]).فكأنّما الأسئلة لا تموت باعتبارها جوهر الإنسان، وحتّى الإجابات لا تُنهي المساءلة بل تظلّ مستكنّة فيها، فهي في النهاية أسئلة مُقنّعة وإن ظهرتْ بمظهر الإجابات.