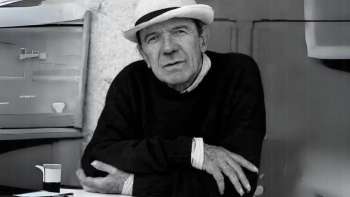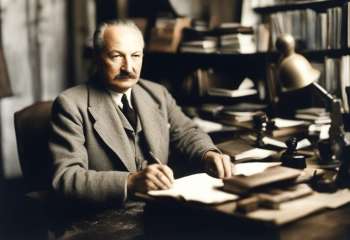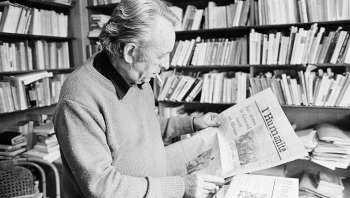آخر مقالات الترجمة والسياسة
المزيد
ترجمة وسياسة
يحمل الصمود أو ما يمكن ترجمته حرفياً بـ "الثبات" ـ بصفته مفهوماً وطنياً فلسطينياً ـ معنى العزيمة القوية، والإصرار على البقاء في الوطن والتمسك بالأرض. ويُرجّح أن الصمود كان جزءًا من الوعي الفلسطيني الجماعي بالنضال من أجل الأرض والتشبث بها، يعود تاريخه على الأقل إلى عهد الانتداب البريطاني. إلا أن الصمود، كرمز وطني استخدم في ستينيات القرن الماضي. وأصبح جزءًا من إحياء الوعي الوطني الفلسطيني بعد نشوء حركات المقاومة الفلسطينية كمنظمات رائدة في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان. حيث كان اللاجئون المقيمون في المخيمات يُعرفون بالصامدين، إذ كان النضال من أجل الحياة اليومية والحقوق الوطنية في تلك المجتمعات يتطلب مستوى عالياً من الصمود. لقد عزز الصمود رسالة الكفاح المسلح التي سيطرت على خطاب الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك. وكان الحاضر الأكبر حين تغيرت الأدوات من النضال المسلح إلى المقاومة اللاعنفية
الصمود هو أكثر من مجرد سمة شخصية، فهو أداة ثقافية ونفسية تربوية فعّالة، وقد أصبح سمة مميزة للمقاومة اللاعنفية في فلسطين. يأتي صمود النساء الفلسطينيات خاصة كنموذج حيّ وعالمي للصمود في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة. لهذا النموذج إمكانات تعلّمية هائلة، لا سيما في فلسطين، كما يُجسّد الصمود سرديةً فلسطينيةً راسخةً تتحدى المحاولات العديدة لقمعها أو تشويهها، كما هو الحال في كثيرٍ من الخطاب الغربيّ الشعبيّ حول فلسطين. الصمود إذن فعلٌ من أفعال الوجود والتأكيد على الحق في الحياة على أرض الأجداد.
لقد شهدت المئة عام الأخيرة من التاريخ الفلسطيني ندوباً من النزوح، والتشريد، والنفي، والفقدان. فبالإضافة إلى التطهير العرقي ومصادرة أراضيهم، واجه الفلسطينيون أيضاً تشويهاً متعمداً لتاريخهم وإنسانيتهم. يشعر السكان المدنيون الفلسطينيون يوماً بعد يوم بآثار احتلال عسكري يُعدّ الآن من أطول الاحتلالات في التاريخ المُدوّن، إذ تمتد جذور هذا الظلم إلى عام 1948 حين طردت إسرائيل وهجرت بقوة السلاح حوالي مليون فلسطيني مما أصبح فيما بعد يُعرف بدولة إسرائيل. يتعرض الفلسطينيون الباقون لتمييز ترعاه الدولة، يؤثر على كل جانب من جوانب حياتهم. ومما زاد الطين بلة، أن الواقع الكئيب للمحنة الفلسطينية قد خيم عليه خطاب "سلام" هش وغير فعال خلال العقود القليلة الماضية، لم يترك مجالاً للقصص اليومية عن معاناة الفلسطينيين.
ونظراً لطول المدة التي تحملوا فيها هذا القمع والظلم الصهيوني، فإن هناك عقلية معينة تربط الفلسطينيين ببعضهم البعض. غالباً ما تُغفل، وبالتأكيد لا يتشاركها الجميع، ولكن لا يزال يُنظر إليها على أنها سمة فلسطينية أصيلة. إنها تتعلق بشعور مشترك بالهوية، والحفاظ على القوة الداخلية في مواجهة كل الصعاب - التكامل في مواجهة التشرذم، والحياة في مواجهة الموت. هذا ما يعنيه الفلسطينيون عندما يتحدثون عن الصمود والثبات.
ليس اللجوء مجرّد ظاهرة اجتماعية أو نتيجة حتمية لنزاع سياسي؛ ولا هو ملفّ حقوقيّ يمكن تدبيره بقرارات المنظمات الدولية أو بلاغات التضامن الموسمية. لا، إنّ اختزال أزمة اللاجئين في أبعادها الإدارية أو الإغاثية لا يفعل سوى تعميق الجرح، لأنّه يتعامى عن الطابع البنيوي لهذه المأساة. فاللاجئ ليس شذوذاً عن النظام العالمي، بل هو نتاجه المباشر، مرآته المعتمة، وضحيّته التي تفضح هشاشته.
من هنا، يكون دور الفلسفة غير قابل للتأجيل، لأنّ الفلسفة، حين تخرج من برجها العاجي وتتمرّد على مقامها الأكاديمي، تصبح فعلاً مقاوماً، وموقفاً تحررياً، وصوتاً للذين لا صوت لهم. إنّها، كما أرادها بعض حكمائها، صوت المقموع في حضرة المنتصر، وصرخة المعنى في وجه السيولة التي تحوّل الإنسان إلى فائض وجوديّ.
الحديث عن اللاجئ، إذن، ليس حديثاً عن ضحيّة، بل عن جهاز إنتاج للضحيّة، عن منظومة تصنع المنفيّ كما تصنع البضائع، وعن حداثة لم تعد قادرة على توفير مأوى حتى للإنسان الذي أنتجته.
ليست بداية أزمة اللجوء كما توهّم البعض مرتبطة فقط بتاريخ الهجرة من المستعمرات نحو المركز الأوروبي، بل كانت منذ بداياتها الأولى دليلاً على انهيار العلاقة العضوية بين الفرد والمكان، بين الذات والتاريخ، بين الهوية والوطن. لم تكن المسألة مسألة انتقال جسدي، بل تفكك رمزي، وتشظٍّ وجوديّ جعل من الشتات شرطاً إنسانياً جديداً.
يُعدّ التفكير النقدي ـ وهو مهارة متجذرة في التقاليد الفلسفية الغربية ـ حجر الأساس للابتكار والديمقراطية والتقدم لقرون. وبينما نواجه تعقيدات القرن الحادي والعشرين، يبدو أن هذه القدرة التي كانت ثمينة في السابق تفقد تأثيرها على الوعي الجماعي. فمن الفصول الدراسية إلى قاعات الاجتماعات، غالباً ما تُطغى ردود الفعل الانفعالية والمعلومات المضللة والتفكير الجماعي، على قدرة التفكير والتحليل والتساؤل. إن تراجع التفكير النقدي في الغرب ليس مجرد مشكلة أكاديمية مجردة، بل هو أزمة ثقافية ذات عواقب واقعية.
إن التأمل في أصل التفكير النقدي يقود إلى اليونان القديمة كمهد لهذا النهج الفكري، بفضل مفكرين مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو. تحدى سقراط، بأسئلته الثاقبة، الافتراضات، وحثّ أتباعه على البحث عن الحقيقة بدلاً من الاكتفاء بالإجابات السهلة. وقد أرسى منهجه السقراطي، وهو شكل من أشكال الحوار الجدلي التعاوني، أسس التفكير الغربي.
ومع حلول عصر التنوير، عاد التفكير النقدي إلى الواجهة. فقد أكد فلاسفة مثل جون لوك وإيمانويل كانط وفولتير على العقل كأداة لفهم العالم وتحسين الظروف الإنسانية. وقد ألهمت هذه الأفكار الثورات، والتقدم العلمي، وصعود قيم الديمقراطية.
ولكن مع ازدياد تعقيد المجتمعات، ازدادت الحاجة إلى المهارات المعرفية للأفراد. فالمهارات التي كانت تُمكّن الجماهير من المشاركة في الحكم والابتكار آخذة في التراجع. لماذا؟ لأن الحياة العصرية أدخلت عوامل تشتيت وتشوهات، ومجموعة من الإخفاقات المنهجية التي تُضعف قدرتنا على التفكير النقدي.
التهديد الصامت للتكنولوجيا
في العصر الرقمي، تُعدّ التكنولوجيا معجزة وتهديداً في آنٍ واحد. فبينما تُتيح وصولاً غير مسبوق للمعلومات، فإنها تُهيئ بيئةً يُمكن فيها تجاوز التفكير النقدي بسهولة. فعلى سبيل المثال، يُغرد الناس بمحتوى قصير مُصغّر مُصمم لإثارة ردود فعل عاطفية بدلاً من الاستجابات المدروسة. فكّر في كيفية عمل الخوارزميات. تُعطي الأولوية للتفاعل، ما يعني غالباً عرض محتوى يُعزز معتقدات المستخدمين. بدلاً من استكشاف وجهات نظر مُتنوّعة، ينتهي الأمر بالناس في غرف صدى، حيث نادراً ما تُناقش آراؤهم. لا تقتصر هذه الظاهرة على السياسة فحسب، بل إنها مُنتشرة في جميع جوانب الحياة، من الثقافة والسلوكيات مروراً بالنصائح الصحية إلى خيارات المُستهلكين.
عادة ما يُنظر إلى الهجرة الأفريقية إلى أوروبا على أنها موجة عارمة من الناس اليائسين الهاربين من الفقر والحروب في أوطانهم محاولين الدخول إلى جنة الأوروبية المراوغة. تشمل "الحلول" النموذجية التي يقترحها الساسة زيادة الضوابط الحدودية، أو تعزيز التنمية الأفريقية "القائمة على البقاء في الوطن". ولكن هذه الآراء تستند إلى افتراضات خاطئة جوهرياً بشأن حجم الهجرة وتاريخيها، وطبيعة وأسباب هذه الهجرة. وتتجاهل الخطابات السائدة أن الهجرة الأفريقية إلى أوروبا يغذيها الطلب البنيوي على العمالة المهاجرة الرخيصة في القطاعات غير الرسمية. وهذا يفسر لماذا فشلت سياسات الهجرة التقييدية دائماً في وقف الهجرة وخلفها تأثيرات ضارة مختلفة. كما أن التنمية الأفريقية من غير المرجح أن تحد من الهجرة لأنها ستمكن وتلهم المزيد من الناس على الهجرة. وعلى الرغم من الخدمة الشفهية التي يتم تقديمها لـ "مكافحة الهجرة غير الشرعية" لأسباب سياسية ودبلوماسية، فإن الدول الأوروبية أو الأفريقية ليس لديها الكثير من الاهتمام الحقيقي بوقف الهجرة.
الفيضان القادم
في السنوات الأخيرة، حظيت الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا باهتمام واسع النطاق. إن التقارير الإعلامية المثيرة والخطابات الشعبية تؤدي إلى ظهور صورة كارثية لموجة أو "هجرة" من الأفارقة "اليائسين" الفارين من الفقر في وطنهم بحثاً عن "النعيم" الأوروبي، محشورين في سفن مهترئة منذ زمن بعيد لا تكاد تطفو على سطح الماء. ومن المعتقد عموماً أن الملايين من الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ينتظرون في شمال أفريقيا العبور إلى أوروبا، الأمر الذي يغذي الخوف من الغزو.
إن الحكمة التقليدية التي تقوم عليها مثل هذه الحجج هي أن الحرب والفقر هما السببان الجذريان للهجرة الجماعية عبر أفريقيا ومنها. وتختلط الصور الشعبية للفقر المدقع والمجاعة والحرب القبلية والتدهور البيئي في صورة نمطية لـ "البؤس الأفريقي" باعتبارها الأسباب المفترضة لموجة المد المتضخمة من المهاجرين الأفارقة المتجهين شمالاً.
غالباً ما ينظر الأوروبيون إلى أفريقيا باعتبارها مكاناً شاقاً للعيش، حيث يسعى سكانها للهجرة إلى القارة العجوز. وتصور وسائل الإعلام والسياسيون والعلماء أنفسهم الحركة في القارة على أنها تدفق من الجنوب إلى الشمال عر شمال إفريقيا كبوابة إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن هذا الخطاب غير مستنير ولا يعمل إلا على ترسيخ فكرة "الغزو الأفريقي" في المجتمع الأوروبي، والتي توفر في الوقت نفسه الأساس لتأمين الهجرة وإخراجها.
إن الساسة ووسائل الإعلام على جانبي البحر الأبيض المتوسط يستخدمون عادة مصطلحات مثل "الغزو الشامل" و"الطاعون" لوصف هذه الظاهرة. في يوليو/تموز 2006 حذر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من أن الأفارقة "سيغرقون العالم" ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لتطوير اقتصاد القارة. ولا تلجأ وسائل الإعلام والسياسيين فحسب إلى سيناريوهات يوم القيامة كثيراً لإثبات وجهة نظرهم، بل وأيضاً العلماء. على سبيل المثال، صرح عالم البيئة البريطاني "نورمان مايرز" Norman Myers مؤخراً بأن التدفق الحالي للاجئين البيئيين من أفريقيا إلى أوروبا "سيُنظر إليه بالتأكيد على أنه مجرد قطرة إذا ما قورن بالفيضانات التي ستحدث في العقود المقبلة".
في الدنمارك يريد حوالي ثلثي الدنماركيين وقف الهجرة. وفي ألمانيا حيث يعد موضوع الهجرة ديناميتاً سياسياً. وفقاً لاستطلاع رأي أجري في أكتوبر 2024 من البوابة الإلكترونية Statista، صنف حوالي 35٪ من المشاركين موضوع "الهجرة واللجوء والأجانب" باعتباره المشكلة المجتمعية الأكثر أهمية في ألمانيا - أكثر من أولئك الذين كانوا أكثر اهتماماً بالاقتصاد أو تغير المناخ. في جميع أنحاء أوروبا، ازدادت حدة الخطاب حول الهجرة.
رغم مرور أكثر من مئة عام على خطاب الرئيس الأمريكي “ودرو ويلسون” الذي ألقاه في العام 1916 بمناسبة بداية ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينسب إليه مقولة “أن عَلَمَ أمريكا ليس علَمهَا وحدها، بل هو عَلَم الإنسانية جمعاء” إلا أن هذه النبوءة لم تتحقق، ولم يصبح علم الولايات المتحدة علماً للإنسانية، بل أصبح علماً للشر وقتل الشعوب والغطرسة ونهب خيرات الدول. صار وجهاً قبيحاً للعنصرية والتمييز لم تنجح أفلام هوليود في تجميله.
نزعة السيطرة على العالم، والاعتقاد أنهم وحدهم المهيئين لقيادة العالم، كانت وما زالت في العقيدة الأمريكية منذ الاستقلال. ظهرت هذه النزعة بوضوح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة منتصرة، فيما بقية الأطراف إما مهزومة أو منهكة اقتصاديا، وعسكرياً، واجتماعيا، وسياسياً. تُظهر تصريحات السياسيين الأمريكيين درجة عالية من الفوقية والاستعلاء والترفُّع على الآخرين، والتكبُّر والعجرفة، والزُهوّ. وتصريحات رونالد ترامب المستمرة تؤكد هده الحقيقة بصورة جلية، حين يواصل القول إنه يتمتع “بتواضع أكبر كثيرا مما يتصور الكثير من الناس”. لكن ادعاءاته بأنه يتمتع بـ “عقل جيد جدًا”، وأنه يمتلك “أفضل الكلمات”، وأنه يعرف “أكثر من الجنرالات”، وتذكيره المستمر بأنه “الفائز” كلها تعزز فكرة أن التواضع هو فضيلة لا يعرفها ترامب.
منفلت من عقاله
بينما يستمر اقتراحه الصادم في إثارة الإدانة الدولية، أصر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن "الجميع يحبون" فكرته لطرد الفلسطينيين من غزة والسماح للولايات المتحدة بتولي المسؤولية عنها. حيث قال للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن رد الفعل على خطته: "الجميع يحبونها". مقترح ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة من أراضيهم ونقلهم إلى مناطق أخرى، مع سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وامتلاكه لفترة طويلة من أجل تنميته وتهيئته لعيش آخرين عليه، أثار العديد من ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والعالمية الرافضة لهذا المقترح، بينما أيده مسؤولون وسياسيون إسرائيليون. وكان دونالد ترامب قد قال إنه يريد أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد نزوح الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وتطوير المنطقة حتى يعيش "شعوب العالم" هناك.
اقتراحات الرئيس الأمريكي بشأن غزة، والتي تعكس غطرسته، أثارت ردود فعل من مختلف الأطراف. حيث اعتبرتها حركة حماس في بيان قائلة إن خطط ترامب هي "وصفة لخلق الفوضى والتوتر في المنطقة. لن يسمح شعبنا في قطاع غزة لهذه الخطط بالمرور". جميع الفصائل الفلسطينية أدانت تصريحات ترامب واعتبرتها "طرفة تافهة".
يعيش ملايين الفلسطينيين تحت سيطرة مزيج من السلطات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في العقود الأخيرة، سيطرت السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية، وأدارت حركة حماس قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، مارست إسرائيل السلطة على كلتا المنطقتين بطرق مختلفة. يحكم مزيج معقد من السلطات حوالي 5.5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية. ولا زال الفلسطينيون أصحاب الأرض الأصليين ليس لديهم دولة معترف بها عالمياً. وتعتمد تطلعاتهم إلى إنشاء دولة ليس فقط على القيادة الفلسطينية، بل وأيضاً على الكيان الصهيوني، والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي.
تمثل منظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينيين رسمياً في جميع أنحاء العالم في المحافل الدولية، في حين يُفترض أن تحكم السلطة الفلسطينية، وهي مؤسسة أحدث تقودها حركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. في الواقع، طغت السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير الفلسطينية، ومارست إسرائيل سيطرة كبيرة على الأراضي الفلسطينية، بحكم الأمر الواقع.
من المسؤول في قطاع غزة والضفة الغربية؟
وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في التسعينيات، على اتفاقيات أوسلو واتفاقية غزة أريحا، وهي الصفقات التي قسمت مناطق السيطرة في غزة والضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تم إنشاؤها حديثًا، على أمل أن تشكل المنطقتان في النهاية دولة فلسطينية. ولكن مع استمرار التغول الإسرائيلي المستمر منذ عقود تظل الأراضي مقسمة رسمياً إلى ثلاث مناطق سيطرة:
المنطقة أ، التي تتكون من معظم غزة وحوالي %17 من الضفة الغربية، هي الأكثر كثافة سكانية وتحضراً. وهي مصنفة على أنها خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة بموجب أوسلو، بما في ذلك الشؤون المدنية وقضايا الأمن الداخلي. ومع ذلك، شنت إسرائيل عدة حملات عسكرية واسعة في غزة بهدف القضاء على حماس، وبالتالي فرضت ضوابط حركة أكثر صرامة في المنطقة.
تغطي المنطقة ب ما يقرب من ربع الضفة الغربية وتتكون في الغالب من القرى والمناطق الريفية. يتعاون الإسرائيليون والفلسطينيون في مجال الأمن هنا، لكن السلطة الفلسطينية تدير جميع الشؤون المدنية. كما تسيطر إسرائيل أيضاً على حركة البضائع والأشخاص. يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في المنطقتين أ وب مجتمعين حوالي 2.8 مليون نسمة.
تشكل المنطقة ج الأراضي المتبقية وتتكون في الغالب من مناطق رعوية. تحتوي غزة على معظم الموارد الطبيعية في الضفة الغربية وهي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية توفر التعليم والخدمات الطبية لسكان المنطقة البالغ عددهم 150 ألف فلسطيني. المنطقة هي موطن لمعظم المستوطنين الإسرائيليين، الذين يبلغ عددهم حوالي 700 ألف شخص منتشرين في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية. يعيش معظمهم بالقرب من الحدود مع إسرائيل، على الرغم من أن القانون الدولي يصف مستوطناتهم بأنها غير قانونية.
رسم خريطة المشهد الذي تعيشه الأقليات في العالم العربي ليس سهلاً، وتحليل الوضع المعاصر الذي تواجهه هذه الأقليات أمر بالغ التعقيد، والنماذج أو الأساليب المتاحة لإدارة التنوع تحتاج مناهج مختلفة بما في ذلك الفكر الإسلامي التقليدي والحديث، والتعددية الثقافية الليبرالية، والتوافقية. ورغم أن لكل منها حدوده، فإننا نتبنى النموذج الذي يجمع بين نقاط القوة في كل منها، فهو لا يقدم الحماية القوية للأقليات فحسب، بل ويضمن أيضاً دمجها في بناء هوية وطنية متداخلة ومتقاطعة في الدول العربية. وعلى أساس التسامح والاعتراف، يسعى هذا النموذج إلى تقديم عملية قابلة للتطبيق من التكيف وإدارة الاختلاف، وهو الأمر الذي سيكون مطلوباً بشدة من أجل تيسير نظام أكثر ديمقراطية وتعددية في العالم العربي.
إن قضية الأقليات العرقية والدينية والمذهبية واللغوية بشكل عام تتسم بدرجة عالية من الحساسية، وينظر لها رغم أهميتها على أنها مسألة خطيرة، لذلك فإن مقاربة هذا الموضوع الشائك يحتاج الكثير من الدقة والروية والموضوعية والانضباط المنهجي، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد عولمة اقتصادية وتوحش الرأسمالية الصناعية التي حولت أربعة أخماس سكان الكون إلى مستهلكين يلهثون خلف توفير مقومات الحياة التي حددت أنماطها ديكتاتورية الأسواق العالمية، بذريعة تحقيق الديمقراطية في المجتمعات الناشئة، وتحت شعارات حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأقليات بشكل خاص.
إن العناصر المتشابكة والتعقيدات التاريخية في مسألة الأقليات تشكل واحدة من أهم الصعوبات أمام أي باحث يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل، ويضعه أمام تحديات وخيارات دقيقة، فإما أن تكون مع الليبرالية الجديدة في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأقليات بشكل خاص، من خلال تبني براغماتية منفعية مقترنة مع دوغمائية لا تريد أن ترى إلا جانب واحد من الموضوع، وإما أن تكون في مواجهة التحديات، وأن تكون ضد إعادة ترتيب المجتمعات البشرية بما يتوافق مع المفاهيم الجديدة التي ينتجها الاقتصاد العابر للقارات، وبذلك قد تجد نفسك متهماً بتجاهل حقوق الأقليات والتفريط بها، أو التوجس منها في الحد الأدنى.
مع استمرار العولمة في اكتساب الزخم، يغادر المزيد والمزيد من الناس ديارهم سعياً وراء أحلامهم بحياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم. يمثل المهاجرون المسلمون الذين يتدفقون على أوروبا من مجتمعات متباينة على نطاق واسع منتشرة في جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الثقافات والتقاليد المحلية. تشكل الشبكات عبر البحر الأبيض المتوسط أساس طرق الهجرة وتشكل عوامل رئيسية في وجهات هؤلاء المهاجرين وفي عملية الهجرة الإجمالية، سواء كانت نحو أوروبا أو دول إسلامية أخرى. تتشابك التدفقات من الجنوب إلى الشمال مع التدفقات من الجنوب إلى الجنوب، ومن بينها تبرز دول الخليج العربية كوجهة رئيسية، ليس فقط للعمالة منخفضة المهارة. تنشأ مواقف مختلفة، ضمن خطاب متنوع حول التعايش والتكامل والاستيعاب والحفاظ على الهوية. إن تبني هذا البعد العابر للحدود الوطنية الذي يضم كلاً من الوجهة ونقاط المنشأ، يمكّن التحقيق في الهجرة من تجاوز النهج الأوروبي المركزي البحت. وبالتالي، يتم تحليل الأنماط الوطنية المختلفة مع التركيز على عدد من دراسات الحالة المهمة. ومن خلال مناقشة السياسات والنهج الثقافية، فإن الهدف هو إضافة الدراسات المبتكرة إلى تحدي التكامل. إن التعددية الثقافية من جانب الدول القومية التي تشكل الاتحاد الأوروبي هي أحد السبل لتحريك الحوار بين الأطر الثقافية المختلفة نحو شكل أكثر توافقاً.
تحديات التكامل
يعيش ما يزيد قليلاً على 5% من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة في أوروبا الغربية البالغ عدد سكانها حوالي 450 مليون نسمة، ومع ذلك كان لهذه الأقلية تأثير غير متناسب على الدين والسياسة في موطنها الجديد. في غضون خمسين عاماً فقط، تضخم عدد السكان المسلمين من عشرات الآلاف إلى 16مليوناً في عام 2010 إلى ما يقارب 26 مليون حالياً، أي ما يقرب من واحد من كل 20 من سكان أوروبا الغربية.
من ناحية أخرى، هناك اعتقاد متزايد بين السكان الأوروبيين الأصليين بأن الإسلام، الذي سُمح له ذات يوم بالازدهار دون رادع في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، يجب إيقافه. تحث هذه النظرة العالمية الأوروبيين على الاستيقاظ من سباتهم وهزيمة "أوروبا العربية". في مقابل هذا السرد، هناك وجهة نظر يتبناها بعض زعماء الجالية المسلمة، مفادها أن الحكومات الأوروبية قمعية وغير متسامحة مع التنوع بشكل موحد. والروايتان غير كافيتين، والأهم من ذلك أن كل منهما يتجاهل الاتجاه الأوسع لما يحدث بالفعل على الأرض.
لقد وجهت انتقادات عديدة للقائلين بأن معاهدة سلام وستفاليا لسنة 1648، تشكل الأصل التاريخي للمنظومة الدولية الحديثة، مثلما نجد في السردية المهيمنة على نظرية العلاقات الدولية. غير أن تلك الانتقادات رغم أهميتها الكبيرة، سواء بالنسبة لنظرية العلاقات الدولية أو من أجل بناء سردية تحظى بالإجماع، فهي لم تفض إلى صياغة بديل لما اعترضت عليه. فقد شكلت وستفاليا، على ما يبدو، نوعا من العائق المعرفي، في شكل بناء أيديولوجي، يقف أمام فهم موضوعي للمنظومة الدولية الحديثة التي ظهرت إثر الحرب العالمية الثانية. ويهدف هذا المقال إلى اقتراح بعض المعالم التي يمكن أن تمهد الطريق باتجاه تصور جديد للمنظومة الدولية الحديثة. ولذا سأحاول أن أبين، أولا، كيف أن الخصائص الأساسية للمنظومة الدولية الحديثة، وتحديدا مبدأ السيادة وارتباط الدولة بحدود جغرافية، لم تتجسد شروط إمكانها التاريخية-الاجتماعية إلا في القرن العشرين. وفي خطوة ثانية، سأشدد على الأصالة والدرجة العالية من الانتظامية للمنظومة الدولية التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مع تحليل أسسها. وفي قسم ثالث أخير، أسعى إلى البرهنة على أن تلك المنظومة ربما كانت أقل ليبرالية وبعيدة عن صفة اللاسلطوية التي يلصقها بها الكثيرون.
جدير بالملاحظة، ابتداء، أنه لا نص معاهدة وستفاليا لسنة 1648 ولا سياق ذلك العصر، يسمح باعتبارها أصلا للمنظومة الدولية الحديثة. فالأبوة المزعومة ليست مستندة إلى حجج متينة. لقد كانت تلك المعاهدة، في المقام الأول، بمثابة وثيقة دستورية لـ "الامبراطورية الرومانية المقدسة"، لم يرد فيه أصلا مصطلح "السيادة" (دي كارفالو، ليرا، هوبسون، 2011) (1)، بل هي تتحدث في واقع الأمر عن "ممتلكات". كل ما يمكن قوله عن تلك الاتفاقيات أنها كانت تطلعا للسلام لدى جماعة معينة وضمن إقليم محدد في ذلك الوقت (أروبا المسيحية). فاتفاقيتا وستفاليا بتاريخ 24 أكتوبر 1648 تتحدثان في الحقيقة "باسم الثالوث الأقدس الواحد" وتأسفان لـ"سفك الدم المسيحي" وتنشدان "المجد الإلهي والنفع للعالَم المسيحي" (2). ولذا فقد اعتُبرت بمثابة "السلام المسيحي الأخير" (كروكستون، 2013). إن مسألة الأصول التاريخية للمنظومة الدولية الحديثة ربما وقع الإفراط في تقديرها وحظيت باهتمام أكثر مما تستحق. فلا جدوى من البحث عن "شجرة نسب" أو "انفجار كبير" نشأ عنه عالم جديد، أو ابتداع أساطير، والحال أن الأمر يتعلق بنظام دولي حديث أصيل وغير مسبوق تاريخيا، يبقى مستقلا تماما ومتحررا من ماضيه أو تأثيراته المحتملة. أما إن كان هناك "انفجار كبير" حقا، نشأت عنه المنظومة الدولية الحديثة، فمن المرجح أن يكون منبثقا من رماد الحرب العالمية الثانية.
وربما كان من الوهم أصلا، في كل الأحوال، أن نبحث عن شجرة نسب لفكرة السيادة الإقليمية، باعتبارها قاعدة كونية، في اتفاقيات وستفاليا، لأن "حق الدول في التحرر من التدخل الخارجي قد تأسس في القانون الدولي لأول مرة خلال القرن العشرين" (غلانفيل، 2013) . وحتى لو نظرنا خارج اتفاقية وستفاليا، فيمكن للمرء أن يرى أن فلسفة القانون في القرن السابع عشر كانت تعتمد على مفاهيم مثل "الحق في العلوية"، وتتحدث عن "العبيد" كمفهوم قانوني (غروسيوس، 2001). وخلاصة القول فإن مفهوم وستفاليا كان نوعا من "النموذج-المثال الذي تحول إلى ما يشبه الكاريكاتور." (شميدت، 2011).
ج. كولومبال :- قمت بنشر كتابين، " الاختلاف والمعاودة" و" سبينوزا ومشكل التعبير" . وكتابا جديدا أيضا : " منطق الحسّ"الذي سيظهر حتما قريبا جدا. من يتكلّم في هذا الكتب؟
- ج. دولوز:
حينما نكتب في كلّ مرّة، فنحن نجعل شخصا ما يتكلّم، ونجعل شكلا ما أوّلا يتكلّم. من يتكلّم مثلا، في العالم القديم، هم أفراد. إنّ العالم القديم كلّه مؤسس على شكل الفردية؛ فالفرد يقوم فيه جنبا إلى جنب مع الكائن ( نراه جيدا في موقع الإله بوصفه كائنا مُفَرّدا للغاية). وفي العالم الرومنطيقي، تتكلّم شخصيات، وهذا جدّ مختلف: فالشخص محدّد في هذا العالم بوصفه موجودا مع التمثّل. لقد كانت قيما جديدة للغة والحياة. إنّ التلقائية اليوم، قد تفلت عن الفرد مثلما تفلت عن الشخص؛ لا بموجب قوى مجهولة فحسب. لقد احتفظوا بنا طويلا داخل تناوب؛ إماّ آن تكونوا أفرادا وشخصيات، أو تلتحقون بعمق مجهول غير متميّز. نكتشف مع ذلك عالم فرديات ماقبل فردية، لا شخصيّة. فرديات لا تردّ لا إلى أفراد ولا إلى شخصيات، ولا إلى عمق بلا تمّيز. إنها فرديات متحرّكة، مقتحمة وسائرة، تمرّ من واحد إلى آخر، تقوم بالاقتحام، وتشكّل فوضويات بارزة، تقيم في فضاء متنقّل. يوجد فرق كبير بين تقسيم فضاء ثابت بين أفراد مستقرين وفق حواجز أو أسيجة، وتوزيع فرديات في فضاء مفتوح بلا سياج ولا ملكية. يتحدّث الشاعر فارلونغيتي عن الشخص المفرد الرابع : هو الذي نستطيع محاولة جعله تتكلّم.
ج.ك- هل تعتبر هكذا إذن الفلاسفة الذين تؤوّلهم، بوصفهم فرديات في فضاء مفتوح؟ لقد وددت غالبا إلى حدّ الآن التقريب بين الإضاءة التي تسلطها عليها وما يمنحه مُخرج معاصر لنصّ مكتوب. بيد أنه في كتاب " الاختلاف والمعاودة" كانت العلاقة منزاحة، فلم تَعُدْ مؤوّلا بل مبدعا.
هل تستقيم المقارنة دائما؟ أم هل أن دور الفلسفة مختلف؟ هل هو " هذا الإلصاق" collageالذي ترجوه والذي يعيد تجديد المشهد أو أيضا " الاقتباس " المدمج في النصّ؟
- ج. دولوز:
نعم، للفلاسفة غالبا مشكل عويص مع تاريخ الفلسفة . تاريخ الفلسفة مرعب، لن ننفذ منه بسهولة. فاستبداله كما قلت بعملية إخراج، هو ربما طريقة حسنة لحلّ المشكل. فالإخراج، يعني أنّ النص المكتوب ستقع إنارته بقيم أخرى، بقيم غير نصيّة ( أو على الأقلّ في معنى مألوف) : الاستعاضة عن تاريخ الفلسفة بمسرح للفلسفة، هو أمر ممكن. تقول إنني بحثتُ، فيما يخصّ الاختلاف، عن تقنية أخرى، أقرب لعملية " الإلصاق" collage منها إلى المسرح. ضرب من تقنية الإلصاق أو حتى خلق مسلسل للعباقرة ( مع تكرار بشيء من الاختلاف)مثلما نرى في " الفنّ الشعبي أو الجماهيري" ( بوب آرت). لكن تقول بانّي في هذه النقطة، لم أنجح تماما. أعتقد أني اذهب أبعد من ذلك في كتابي عن " منطق الحسّ".
نريد في هذا المقال أن نتشاطر بعضا من مجموعة نتائج توصلنا إليها أثناء محاولتنا النفاذ إلى فكر هذا الفيلسوف الذي أثار الجدل وصار يُعد كل من قرن اسمه باسمه إن ترجمة أو ((شرحا)) متصدرا بهذا القدر أو ذاك لائحة الفكر والثقافة في العالم العربي، وتتعلق هذه النتائج بمجموعة من الاختيارات الخاطئة في نقل المفاهيم الفلسفية المستخدمة من طرف هيدغر وذلك من طرف عدة مترجمين الأمر الذي صيّر ترجمات أعماله إلى لغة الضاد أقرب إلى الهِذر والهتر وكلام المحمومين منه إلى الفلسفة حيث لا نظفر فيها بأي معنى واضح يستحق الوقوف عنده فأحرى الالتذاذ به كما هو الأمر مع كل فلسفه حقة ! وهو ما سنقيم عليه الحجة ويقف عليه القارئ بنفسه من خلال مقارنة ما قصده هيدغر حقا وبين تلك الترجمات رغم أن الدارسين والمهتمين مستمرون في الحديث عن فكر الرجل من خلال تلك النقول والمفاهيم الخاطئة مدعين الفهم والتفاهم ! وبعبارة واحدة فإن تلك الترجمات قد تكون أي شيء إلا أن تكون فلسفة. وسأقف عند أهم تلك الأخطاء نظرا لهدفي الحالي وهو تنبيه الدارسين والمهتمين بفلسفة هيدغر الذين ينجزون ترجمات حالية وأطاريح حوله أنهم يسيرون في طرق لا تؤدي إلى أي مكان وأن يراجعوا ما خطّت أناملهم قبل إصداره لأننا لو استمرينا في إبراز تلك الأخطاء في محاضرة "في ماهية الحقيقة" -كما كان هدفنا في البداية- لوحدها للزمنا وقت غير يسير إذا ما تحرينا الدقة وأردنا استيفاء أغراضنا ولاحتفظنا بتلك النتائج لأنفسنا إلى غايه الفراغ منه في الوقت الذي يهيم الناس في الأخطاء ظانين أن ما يأتونه فلسفة ! وإن جزءا كبيرا مما أدى إلى نقل ما تم نقله بشكل خاطئ يعود في نظرنا الى عدم الانتباه الى تشابه بل مطابقة ما هو موجود عند أرسطو وفي التراث الفلسفي الممتد من الفلسفة العربية الإسلامية إلى العصور الوسطى الأوربية فإلى الفلسفة الحديثة ثم المعاصرة بحيث تم نقل الاصطلاحات الفلسفية إلى العربية في عصر التدوين العربي بوضع مقابلات تؤديها على التمام فتم شرح فلسفة المعلم الأول بأدق ما يكون، لكن المحدثين أعادوا ترجمتها بألفاظ لا فلسفية بعيدة كل البعد عن المقصود معتقدين ربما أنها تستعمل لأول مرة وأنها من اجتراح هيدغر فتاهوا وتاه معهم الجم الغفير، وأخص بالذكر ترجمة اسماعيل المصدق وعبد الغفار مكاوي ومحمد سبيلا لمحاضرة "في ماهية الحقيقة" كمثال وترجمة فتحي المسكيني لكتاب الوجود والزمان بمراجعة إسماعيل المصدق، وهي كلها ترجمات/أخطاء أضاعت تاريخ الفلسفة والانطولوجيا بأكمله كما سنرى. أما الجزء الآخر في سبب هذه الأخطاء هو أن مترجمينا قد تعاملوا مع فلسفه هيدغر وكأنها خارجة عن أفقنا وشرطنا الإنساني كعرب وأنه لا يمكن الإحاطة بها ! في حين أن ما قاله هيدغر قد قيل في فلسفة أرسطو وجان جاك روسو وهيغل وانطلق منه هيدغر وليس من إبداعه رأسا.
التصور والفهم أم التصرف والسلوك:
سنرى في هذا العنوان كيف أفسد نقل مفهوم verhalten الألماني وcomportment الإنجليزي، comportement الفرنسي، بالتصرف والسلوك في العربية بدل "التصور" و"الفهم" كل ترجمات المحاضرة الهامة "في ماهيه الحقيقة" في ترجماتها الثلاث التي ذكرناها أعلاه وكيف أفسد ترجمة كتاب "الوجود والزمان" بترجمة فتحي المسكيني ومراجعة إسماعيل المصدق كاملا. تتكون محاضرة في ماهيه الحقيقه من ثمانية فصول مع ملاحظة/ضميمة أضافها هايدجر سنة 1949.[1] في الفصلان الأولان "التصور الدارج للحقيقة" والإمكان الجواني للمطابقة" يتعرض هيدغر بالأساس لمعيار "مطابقة الفكر للواقع" كمعيار يحدد الحقيقة بحيث نقول عن شيء ما أنه حقيقي حين يكون القول/لوغوس statement/ logos الصادر عنا مطابقا لشخص الشيء المتعين في الخارج ويعطي هيدغر مثالا عن قطعتان نقديتان موضوعتان فوق طاولة، فنتكلم هكذا عن المطابقة حينما نقول عن قطعة نقدية من فئة خمس ماركات (عملة المارك Mark): "هذه القطعة النقدية مستديرة". فما وظيفة القول إذن علما أن كل قول يتركب من موضوع ومحمول بعد أن نتمثل الشيء الموجود في الخارج (القطعة النقدية) في أذهاننا أو نحضره (التمثل والاستحضار)؟ إن دوره هو إيقاع تصور الشيء وفهمه أو إفهامه ولهذا سمي كذلك بالقول الشارح، أي لأُنه يظهر ويبيِّن ويوضِّح ويكشف ويُبرِز أجزاء ماهية الشيء وخواص الشيء وبالتالي حقيقته.
فيستنتج هيدغر بناء على ما سبق هذه النتيجة التي قالها قبله أرسطو وكل شراحه المسلمين والمسيحيين:
"إن علاقة القول الشارح بالشيء هو إقامة التصور باعتباره ما يرِد دائما وبالأساس كفهم".
وفي النص الإنجليزي الذي نعتمد عليه:
« The relation of the presentative statement to the thing is the accomplishment of the bearing [Verhaltnis] which originally and always comes to prevail as a comportment [Verhalten].»[2]
لكن الترجمات العربية لـ "في ماهية الحقيقة" حادث عن الصواب سواء كانت عن الألمانية مباشرة أم عن الانجليزية والفرنسية، فجاءت غريبة وشاذة وبعيدة كل البعد عما يمكن أن يكون فلسفة، فنقرأ على التوالي في ترجماتها:
ترجمة عبد الغفار مكاوي:
"والعلاقة بين العبارة المتمثلة وبين الشيء هي تحقق تلك الإحالة التي تتم في الأصل كما تتم في كل مرة على صورة مسلك".[3](ص 262-263).
وفي ترجمة إسماعيل المصدق:
"إن علاقة القول المتمثل بالشيء هي إنجاز تلك الرابطة التي تنبثق أصليا وكل مرّة كتصرف".[4]
وفي ترجمة محمد سبيلا، وهي أكثر شذوذا وبعدا:
"إن علاقة التعبير الاستحضاري بالشيء هي إكمال هذه المرجعية، وهذه تتحقق في الأصل، وفي كل مرة، كخلخلة للسلوك". [5]
لكن كيف اهتدينا نحن إلى أن ما يعنيه Verhalten/ Comportmentونحن نقرأ لهيدغر عن الترجمة الانجليزية ونقارنها بالعربية هو التصور والفهم وليس التصرف أو السلوك؟ أولا، لا يمكن أن يكون لكلام هيدغر منحى وسياق معين متعلق بالحقيقة والفكر والمطابقة، بالنفس/الذات والقدرة على التمثل استنادا إلى القول الشارح ثم ينتقل فجأة إلى الحديث عن السلوك أو التصرف وثانيا أن العباره تصبح غير مفهومة غريبة وشاذة في حين أن ميزة ومزية الفلسفة هي أنها تخرج الأشياء من غموضها والتباساتها إلى الوضوح متغيية الفهم والإفهام وهذا ما جعلنا نتأكد بالتالي أنه لا يمكن أن يكون ذلك هو مقصود هيدغر والجدير هو التوقف لا متابعة القراءة مع ادعاء الفهم بدون فهم ومحاولة تجلية المقصود إذا كان غرض المرء الإلمام بالفلسفة صِدقا. ويتأكد الأمر حين نواصل القراءة فنقرأ في الترجمات العربية على التوالي:
"أن المسلك منفتح على الموجود".[6]
"إن التصرف يقوم منفتحا على الكائن".[7]
"إن السلوك منفتح على الموجود" (محمد سبيلا)
هذه عبارات لا يمكن أن يكون لها معنى ! كيف يمكن أن نفهم أن التصرف ينفتح على الموجودات؟؟ لذلك فإننا حينما تكلمنا عن الهِذر والهتر وكلام المحمومين لم نكن نقصد الإساءة بقدر ما نصف واقعا.
عدنا الى المعاجم ثم عثرنا على معنى من معاني Comportement في أصوله اللاتينية يدل على التضمُّن والاحتواء والحمل ضمن كتاب مفاهيم التفلسف الغربي، معجم تحليل عربي[8] لـ حمو النقاري فكان ذلك مؤكدا لما حدسناه من أنه لا يمكن أن يأتي في ذلك السياق بالتصرف والسلوك وأنه يعني على الأغلب الاحتواء أو الاستيعاب خاصة في ظل الشبكة المفاهيمية المتعلقة بسياق الفصلين الأولين من محاضرة "في ماهية الحقيقة": الفكر/العقل/الذات/التصور/الانفتاح/الحقيقة/المطابقة/القول الشارح/الحدّ/ الشيء. لكن المعنى لا يستقيم رغم ذلك إذا ما جربنا بـ استيعاب او احتواء في الجملة. انتبهنا فيما بعد إلى أن نفس ما يقوله هيدغر مطابق تماما لما قاله الفلاسفة المسلمون كالفارابي وابن سينا والغزالي وهم يشرحون المعلم الأول وعلى وجه التحديد منطق أرسطو والجزء المتعلق منه بالعلم بالجزئيات أو بعبارة الغزالي بذوات الأشياء أو العلم التصوري، يعني الأشياء المتميزة بذاتها، فمتى ما تصورنا/تمثلنا الشيء الموجود ي الخارج/الواقع في أذهاننا وقمنا بحدّه من خلال الاتيان على ما يشكل ماهيته في قول شارح جازم أي النوع والفصل/ أو الذاتيات، إلا ونكون قد علمنا به وحصلت حقيقته في أذهاننا وهذا بالضبط مدار حديث هيدغر وسياق المثال الذي أعطى بالقطعتين النقديتان ذلك أن القطعة النقدية شيء جزئي ومفرد وشخص متعين وعلاقة القول الشارح كما في كلامه بالشيء هو "إقامة التصور باعتباره ما يرد كفهم".
وهاكم عبارات فلاسفتنا المسلمين: يقول ابن سينا "والحكماء... يريدون من التحديد أن ترتسم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة"[9]. وعند الغزالي نقرأ: "والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا"،[10] كذلك: "وما يُفهم الشيء هذا الضرب من التفهيم يسمى حدا". "والفهم الحاصل من التحديد يسمَّى علما ملخصا مفصلا".[11] ولابد أن القارئ قد انتبه إلى التطابق بينما يقوله هايدجر والغزالي خاصة فمن أسماء الحد القول الشارح والمطابقة التي يتحدث عنها هيدغر بين القول والشيء هي ما يقصده الفلاسفة المسلمون بالمساواة بين المعنى الحاصل بالحدّ/القول الشارح لحقيقة/ماهية الشيء الموجود في الخارج وذلك هو صدق القضية التي يتحدث عنه هيدغر ونقله المصدق بالصواب ومكاوي بالصدق. كما أنه قد غاب عن مترجمينا ان ما يقصده هيدغر بـ presentative statement هو القول الشارح كما عند الأسلاف فنقلوه بـ "العبارة المتمثلة" و"القول المتمثل" او "الحكم المتمثل" و"التعبير الاستحضاري" كما عند محمد سبيلا. فالقول الشارح سمي شارحا لأنه يعرفنا أجزاء الشيء المكونة له وحينما نتمثل شيئا فنحن نتمثله من خلال خصائه/فصوله/ذاتياته التي نأتي عليها من خلال اللغة/القول. (بل يبدو لي وهي فرضية يجب التأكد منها أن القول الشارح كمرادف للحد والقول الجازم قد مر إلى لغة هيدغر عبر الترجمات اللاتينية للفلسفة العربية الإسلامية لأننا إذا ما عدنا إلى الأعمال الكاملة لأرسطو في الإنجليزية[12] لا نجد أبدا عبارة Presentative Statement أي القول الشارح بينما نجد "الحد" Definition والقول الجازم أو القول الموجب Affirmative Statement وهو غالبا وفي الأصل اقتراح ترجمي عربي للحد والقول الموجب، ما يمكن معه تفنيد "الوحدة التاريخية" التي يدعيها هيدغر للعقل العربي خاصة إذا اتضح وجود مفاهيم أخرى نفذت إلى لغة التفلسف الغربي عبر المسلمين).
انطلاقا من كلام الغزالي إذن نستخلص أن قول الشارح يوصل إلى التصور ويحقق الفهم والفهم إذا ما عدنا إلى كتاب الحدود للكندي نجد أنه "هو ما يقتضي الإحاطة بالمقصود إليه"[13] والملاحظ هو ترادف معنى الإحاطة هنا بمعاني التضمن والاحتواء التي نجدها ضمن المعاني التي أثبتها حمو النقاري لمفهوم comportment ذي الأصل اللاتيني. وما قاله الغزالي هو نفسه ما تقوله عبارة هيدغر. وبإمكان القارئ المقارنة:
هيدغر:
"إن علاقة القول الشارح بالشيء هو إقامة التصور باعتباره ما يرد دائما وبالأساس كفهم"
الغزالي:
"والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا"، كذلك: "وما يُفهم الشيء هذا الضرب من التفهيم يسمى حدا". "والفهم الحاصل من التحديد يسمَّى علما ملخصا مفصلا".
وقد ذكرنا أن القول الشارح في عُرف فلاسفتنا المسلمين هو الحدّ.
فيستقيم بناء على ما سبق أن نقول "إن الفهم يظل منفتحا على الموجودات." لأن الفهم الإنساني منفتح دوما على صور الموجودات التي ترده في كل لحظة كنقل للجملة في النص الإنجليزي لِـ "ماهية الحقيقة":
« Comportment stands open to beings ».[14]
ويبدو أن هذا القدر كاف في التّدليل على أن المقصود هو الفهم والتصور وأن ترجمته بسلوك وتصرف قد أفسد محاضرة "ماهية الحقيقة" كاملة فقد انجذب مترجمونا للأسف للمعنى الأول الذي تبادر إلى أذهانهم من هذه الكلمة الأجنبية ولم يدر بخلدهم احتمال ورودها بالمعنى الذي أبرزناه ولكي لا نقسو على مترجمينا تجدر الإشارة إلى أن هذا وقع فيه كذلك الأنجلوساكسون كما يتضح من خلال شرحهم لما أراده هيدغر بها في معاجمهم.[15] ولننظر الآن كيف أفسد نفس النقل معاني كتاب الوجود والزمان فضيع تاريخ الأنطولوجيا والوجود وأفسد الترجمة العربية كاملة وسيؤكد ما سنراه مجددا أنه لا يمكن أن يأتي Verhalten/Comportment بسلوك وإنما المقصود بها هو التصور والفهم ولننظر كذلك كيف سيستقيم المعنى ويفي بمقصود هيدغر ومقصود أرسطو من العلم التصوري أو الأنطولوجيا بحيث سيزول ذلك الغموض الذي يكتنف ترجمة فتحي المسكين الذي حذا حذو إسماعيل المصدق حذو النعل بالنعل كما يُقال.
نقرأ في الترجمات الإنجليزية على التوالي ومن بينها الترجمة التي اعتمد عليها فتحي المسكيني،
أي ترجمة (Robinson and Macquarrie):
«it is held that being is of all concepts the one that is self-evident. Whenever one cognizes anythings or makes an assertion, whenever ones comports oneself towards entities, even towards oneself, some use is made of being ; and this expression is held to be intellegible without further ado, just as everyone understands The sky is blue I am merry.»[16]
وفي ترجمة Stambaugh:
«Being is the self-evident of all concepts. Being is used in all knowing and predicating, in every relation to beings, and every relation to oneself, and the expression understable without further ado. Every body understands, the sky is blue, I am happy.»[17]
وفي الترجمة الفرنسية:
« l’Etre est le concept évident. Dans toute connaissance, dans toute énoncé, dans toute comportement par rapport à l’etant, dans tout comportement par rapport à soi-meme, il est fait usage de l’etre, et l’expression est alors « sans plus » compréhensible. Chacun comprend : « le ciel et bleu ». « je suis jouyeux ».[18]
وفي ترجمة فتحي المسكيني:
"إن الكينونة هي التصوّر المفهوم-بنفسه. فإن في كل معرفة وتلفظ، في كل سلوك إزاء الكائن، في كل سلوك -إزاء- ذات- أنفسنا إنما يتم استعمال الكينونة، والعبارة هي بذلك مفهومة "بلا أي زيادة". فكل يفهم "السماء جميلة"، "أنا إنسان سعيد" وما شاكل ذلك."[19]
لقد ارتأى Robbinson and Macquarrie أن يترجما Verhalten الألماني حسب السياق كما أشارا إلى ذلك في هامشة فترجماه هنا بـ comports oneself وبذلك بقيا قريبين من comportment واختار Stambaughتأديته بـ "علاقة" relation ونقله المترجم الفرنسي ضمن الترجمة التي اعتمد عليها المسكيني في نقل الكتاب بـ Comportement وإذا بدا أن ترجمة روبنسون وماكيري تستعصي قليلا فإن ترجمة ستامبوغ وإيمانويل مارتينو تضيئانها وتجعلانها قابلة للنقل ويتحقق الفهم انطلاقا من كل الترجمات ولو أننا نفضل الترجمة الفرنسية لأنها تميزت بالبساطة والوضوح وجمعت ما تفرق في الترجمتين الانجليزيتين أي بساطة ترجمة ستامبوغ ومفهوم Comportment الذي احتفظت به الترجمة الأولى نوعا ما وسقط من ترجمة ستامبوغ حيث عوضه بـ "علاقة".
مقابل نص روبنسون وماكوَري:
"إن الوجود هو التصور البين بذاته من بين كل التصورات. فمتى ما عرف المرء شيئا أو قام بإثبات شيء لشيء، متى ما تصور نفسه إزاء الموجودات، أو تصور ذاته حتى، فإن هناك استخداما ما للوجود، فيعقِل القول في الحين تماما كما يعقل كل شخص "السماء زرقاء" و"أنا مبتهج" وما شابه ذلك من أقاويل".
مقابل نص ستامبوغ:
"إن الوجود هو التصور البين بذاته. إن الوجود يستخدم في كل علم [بالشيء] وفي كل قول، في كل علاقه بالموجودات وفي كل علاقه بالذات، فيكون القول مفهوما بدون مزيد شرح، فالكل يفهم "السماء زرقاء" وأنا سعيد" ".
مقابل الترجمة الفرنسية:
"إن الوجود هو التصور البين بذاته. ففي كل علم [بالشيء]، وفي كل قول، في كلّ تصوّر يخصُّ الوجود وفي كل تصور يتعلق بالذات هناك استعمال للوجود، وتكون العبارة مفهومة بدون مزيد شرح، فالكل يفهم "السماء زرقاء" و"أنا مبتهج" ".
لا بد أن القارئ رأى كيف يزيل نقل Verhalten بالتصور غموض ترجمة فتحي المسكيني، لكن ما الذي يؤكد بشكل أكبر أن الأمر يتعلق بالتصور لا السلوك أو التصرف؟
ما يؤكد ذلك هو العبارتان الأخيرتان في الفقرة "السماء زرقاء" و"أنا مبتهج"، فكلاهما عبارتان خبريتان تثبتان محمولا لموضوع وكل واحده تعبر عما قيل قبلهما مباشرة، فكل واحدة تحمل تصورا معينا، الأولى تحمل تصورا عن موجود هو السماء، "السماء زرقاء" والثانية تحمل تصورا عن الذات/حال الذات في لحظة معينة "أنا سعيد"، فهما مثالان ضربهما هايدغر ليؤكد ان الوجود متضمن/مستخدم في كل تصور إما في إطار الإخبار عن علاقتنا بالوجود أو عن علاقتنا بذواتنا: "في كل تصور يخص الوجود وفي كل تصور يتعلق بالذات هناك استعمال للوجود" أو في ترجمة ستامبوغ: "في كل علاقه بالموجودات وفي كل علاقه بالذات هناك استخدام للوجود". ولا مجال بالتالي مطلقا لنقل Verhalten/ Comportment هنا بسلوك. ولا نعرف كيف فات المسكيني والمصدق الذي راجع بعده أن ينتبها إلى علاقة العبارتين/المثالين بما قاله هيدغر قبلهما !
ولابد أن القارئ قد اكتشف ما قلناه من أن هذه الترجمة أفسدت كتاب الوجود والزمان وضيعت تاريخ الانطولوجيا خاصة إذا ما علمنا أن المسكيني أثبت "سلوك" كمقابل لِـ Verhalten على طول الكتاب فيما مجموعه كما أثبت ذلك هو نفسه في فهرس المصطلحات 27 مرة ناهيك عن عدد المرات الذي استعمل فيها سلوك ولم يُحصها ضمن هذا المجموع. ولنا أن نتخيل والأمر هكذا المعاني التي ضاعت على طول الكتاب (بل الكتاب ضاع). وقد أحال المسكيني على Verhalten/ Comportment في تبث المصطلحات بدل المقابلات التي اختارها روبنسون وماكيري له في الإنجليزية والتي تتنوع بين comports oneself/ comports itself/ relate oneself/ relate itself/ conduct/ behaviour بمقابل وحيد هو Behaviour ما يجعلنا نتساءل إذا ما كان المسكيني قد اطلع حقا على الترجمة الإنجليزية التي أثبتها ضمن مصادره.
ولابد أن القارئ الكريم قد انتبه كذلك إلى أننا نقلنا هذه المرة Verhalten/ Comportment بدل فهم بتصور، وإن ذلك لراجع إلى السياق من جهة وإلى التطابق الضمني بين المفهومين (فهم وتصور) من جهة أخرى كما أشرنا إلى ذلك سابقا فالفهم هو "جودة أو حسن تصور الشيء"، أو "الإحاطة بحقيقة الشيء" بعبارة الكندي، فالفهم هو تصور. ومفهوم Verhalten قد نقله ستامبوغ كما رأينا أعلاه بـ "علاقة" بدل تصور أو فهم في حين أن الفعل المشتق منه Verhaltnis هو الذي يدل عادة على "العلاقة" وبها تم نقله إلى العربية كما عند أبي يعرب المرزوقي في نقله لميتافيزيقا أرسطو إلى العربية عن الألمانية أو ما يقوم محلها كـ "الرابطة" إسماعيل المصدق ويدل كذلك على "الحمل" في المنطق « Bearing » ويأتي كذلك بمعنى "التصور" حسب السياق، ويبدو أن هناك تواشجا بين المفهومين في الألمانية بحيث يمكن أن يدلا على نفس المعنى فلو نقلنا عبارة هيدغر كالتالي: "إن العلاقة بين القول الشارح والشيء هي إقامة الحمل الذي يرد دائما وبالأساس كتصور"، فوضعنا الحمل بدل التصور والتصور بدل الفهم لاحتفظنا بالمقصود إذ أن ذلك التواشج حاصل في العربية أيضا بين الحمل والتصور (فالقول الشارح لا يكون كذلك إلا بإضافة محمول لموضوع ليتمّ التصور) من جهة وبين التصور والفهم من جهة ثانية. ولننظر كيف سيستقيم معنى إحدى ترجمات المترجم الكبير فؤاد زكرياء حينما ننقل « Bearing » الذي أداه ب "أهمية" بالتصور بدل ذلك. يقول زكريا في نقله لإحدى عبارات هربرت مركيوز في ترجمته لكتابه العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية:
"وعلى يد ديكارت اتخذت الأهمية العملية للفلسفة شكلا جديدا، يتمشى مع التقدم الساحق للأساليب الحديثة."[20]
وفي النص الذي كتبه هربرت مركيوز في الانجليزية:
«With Descartes, the practical bearing of philosophy assumed a new form, which accorded with the sweeping progress of modern technics.»[21]
وهذه ترجمتنا:
"ومع ديكارت اتخذ التصور العملي للفلسفة شكلا جديدا يتماشى والتقدم الشامل والكاسح للتقنيات المعاصرة".
وإذا كان من الواضح أن نقل « bearing » هنا بالتصوّر هو الأصوب فإن ما يزيده رجحانا هو أننا نعرف أن هناك تصوران عن الفلسفة: تصور نظري (الفلسفة النظرية) وتصور عملي (الفلسفة العملية). فيتضح أن اختيار فؤاد زكريا لم يكن موفقا.
الوجود أم الكينونة:
إن من المثير للتعجب والاستغراب كيف انتقل لفظ الكينونة الذي كان يأتي دائما في ترجمة فؤاد زكريا كمرادف للوجود وكمحاولة لتقريب المعنى فقط بحيث يثبته بين قوسين بعد كلمة وجود، هكذا: "... الوجود (أو الكينونة)"[22] ليحتل الصدارة في نقل Sein الألماني، بدون استفاضة في الشرح أو توضيح للدوافع والأسباب، فقد استعاره عبد الغفار مكاوي الذي كان يُجِل فؤاد زكريا وهو يترجم نصوص هيدغر في كتاب جامع لعدد من نصوصه بعنوان نداء الحقيقة الذي أهداه إلى فؤاد زكريا[23] ثم صارت كينونة تقال على الوجود وعلى الوجود الإنساني معا كما في ترجمات إسماعيل المصدق وفتحي المسكيني ثم ما فتئ أن استعمل المصدق "كائن"، من كينونة، ليدل على الموجود المتعين حتى حينما يأتي بصيغة الجمع في النصوص الأجنبية seiendes/beingsوهو نفس حال المسكيني في حين أن مكاوي ظل يؤديها بـ موجودات رغم استعماله كينونة واحتفظ ب "الآنية" للدلالة على الإنسان. وفي حين احتفظ الأنجلوساكسون مثلا بـ Being كمقابل لـ Sein والفرنسيون بِـ Etre وفي حين أيضا احتفظ الأنجلوساكسون في لغتهم بـ Dasein الدّال على الوجود الإنساني كما الفرنسيون (اللهم بعض الاجتهادات) فبقي التمايز قائما بين المفهومين نجد أنه انتفى في ترجمات إسماعيل المصدق وفتحي المسكيني إذ لا يحفظ لفظ الكينونة ما يختص به الإنسان ويميز وجوده عن مجرد وجود الموجودات الأخرى، وهو بالضبط ما دفع هايدغر إلى صياغة مفهوم الدازاين، خاصة في المرات -وهي كثيرة- التي تأتي غير مقرونة بحرف "هناك" (الكينونة هناك) الدال على ما يختص به الإنسان، فصارت الكينونة مقولة على الوجود وعلى الوجود الإنساني وعلى الوجود الذي للإنسان "عندما يصير ما هو" Existenz[24] !
ويبدو أن هذا التّوجه لم يجد اعتراضا من أحد باستثناء محمد محجوب، في مقال له في صرخة لم يسمعها أحد ربما منذ ذاك، متسائلا: ما هي التكلفة التي يتعيّن علينا بوصفنا متفلسفة منخرطين ضمن تقليد فلسفي واصطلاحي عربي طويل أن ندفعها للتخلي عن "الوجود" والانخراط في تقليد "الكون" و"الكينونة"؟[25] وباستثناء كذلك عبد الجليل الكور الذي اعترض على نقل Da-sein بـ "كينونة"[26] - ومعه في ذلك حق، رغم أنه ظل يؤدي Sein بوجود وكينونة في نفس الوقت (الوجود/الكينونة) – بعد اعتراضه على مصطلح الأنية، في نفس السياق، والذي اختاره عبد الرحمن بدوي انطلاقا من تراثنا الصوفي لتأدية دازاين في العربية، ذلك أن ما ينطبق حسبه على أنية ينطبق على كينونة، "فأنية لا تُظهر انفتاح الإنسان في علاقته بالوجود/الكينونة" (وهو أمر أشار إليه المسكيني كذلك في الكشاف المفهومي في آخر ترجمة كتاب الكينونة والزمان 2012 ) و"لا تشمل جهات الزمن الثلاث كما الدازاين". ونضيف نحن أن ما يجب مراعاته في وضع مصطلح عربي يدل على الدازاين زيادة على ما سبق أن يدلّ، كما نفهم من خلال كتابات هيدغر، على أفعال النفس وعلى حركة الفكر المستمرة - إذ أن كينونة تشير إلى نوع من الثبات وإلى عمقنا الفطري (عواطف ومشاعر وأفكار)، أكثر مما تشير إلى الحركة، فنقول شعريا "كياني" و"كينونتي" -، وأن يدلّ كذلك على التزام الذات الإنسانية أخلاقيا تجاه ذاتها، مراقبتها لأفعالها، والتزامها تجاه الوجود والطبيعة وبالتالي رعاية الوجود والانهمام بسؤال الوجود أو سؤال المعنى[27] وعلى إضاءة الموجودات وبالتالي على استعارة النور وعلى إشفاف الوجود الإنساني، ولا يؤدي كل معاني الدازاين التي أتينا عليها واشتقاقاته كذلك في نظرنا إلا مصطلح "البصيرة" والأفعال المشتقة منه (تبصّر، استبصر، استبصار، تباصر...)، فوجود الإنسان وجود باصر، واشتقاقه الاستبصار، بعد تضمينه معاني معينة مرتبطة بالبصيرة بعد تضمينها معاني مرتبطة بالإشفاف الذي للوجود الإنساني، هو ما يمكن أن يؤدي فعل EK-sistenz المشتق من Existenz بدل تخارج ،البعيد عن كينونة، والذي وضعه عبد الرحمن بدوي للدلالة على "الوجود خارج الذات) وتبعه في ذلك مكاوي والمصدق والمسكيني. وهذا أمر نرجئ توضيحه إلى عمل لاحق إن أنسأ الله في العمر.
وبالعودة إلى موضوع هذا العنوان، أي اختيار الكينونة كمقابل لِـ Sein، نقول، إذا كان نفس ما يقوله هيدغر عن الوجود Sein هو نفس الموجود في تراثنا، إذ هو ما شرحه فلاسفتنا بالضبط وأثبتوه لِـ "الوجود" بعبارات مطابقة لعبارات هيدغر في كتابه "الوجود والزمان"، فلماذا هذه الخطوة التي لم تكن أبدا ضرورية وتمثل ارتكاسا أكثر منه اكتشافا لم يكتشفه إلا محدَثونا؟ وما وصف المسكيني للمعترضين على الكينونة بـ "العناد الخطابي"[28] إلا هروبا أكثر منه إفحاما مبنيا على استدلال وتقليدا لما قاله الغير لا استقلالا فلسفيا (يحتج المسكيني بريمي براغ كونه كما يقدمه عارفا بالمصطلح العربي واليوناني والحديث[29] وكأن غيرنا ملم بلساننا أكثر منا أو أنه يستطيع أن يطلع في تراثنا على ما لا نستطيعه نحن أبناءه!). وبالتالي أليس إحياء نقاش من قبيل أن "الوجود" ليس لفظا أنطولوجيا ووجب استبداله بالتالي شبيها بمناقشة النقطة التي أثارها المستشرقون والمتعلقة بغياب "الرابطة" في اللغة العربية واعتبارها بالتالي لغة لا يستقيم التفلسف بها فاعتُقد أنها اكتشاف استشراقي في حين أن الفلاسفة المسلمين من أصل فارسي هم من أثارها إذ توجد في الفارسية فلاحظوا أنها غائبة في العربية وكل ما في الأمر أنها مُضمرة)، أما إن كان الأمر متعلقا بتمييز Sein عن Da-sein و existence فقد أشرنا إلى أن ما يجب هو وضع مصطلح يعوض "كينونة" كمقابل لِـ Da-sein و existence لأنها لا تفي بالغرض بدل التخلي عن وجود حتى حينما يأتي دالا على Sein. (ولا يعني هذا دعوة للتخلي عن "الكينونة" نهائيا إذ قد يتطلبها السياق أحيانا للدلالة على الذات الإنسانية.).
وفي هذا السياق أيضا، نتساءل: هل الأهم هو المعاني التي تسبق إلى ذهن المرأ من كلمة "وجود" كما استقرت بفضل الاصطلاح عليها والمواضعة والعادة أم المهم هو اللفظ في نفسه كيف هو ومما تم اشتقاقه بالأصل؟ أليس المعاني التي سنضمنها لـ كينونة بعد إحلالها محل وجود هي التي لـ "وجود" بالأصل؟ ألا يتعلق الأمر إذن بالتصور بناء على المعنى أكثر منه بتقديم لفظ على لفظ؟ !
ولنثبت الآن ولو بطريق قد يبدو معكوسا أن "تصور" فلاسفتنا للوجود هو نفس ما يقوله هيدغر عنه لأن مصدر الجميع هو أرسطو، أما من يطمع في أن يُحصّل معنى جديدا للوجود بقراءة الوجود والزمان فهو لن يجد ذلك إذ كان رهان هيدغر من إحياء سؤال الوجود مختلفا.[30]
يقول هيدغر عن الوجود بأنه "التصور الأكثر كلّية" بينما يُخرجه الغزالي من الكليات، فهل غاب عن الغزالي أن الوجود هو الأكثر كلّية؟ أما الجواب فبالنفي، وسنرى ذلك بعد إيراد عبارة هيدغر، يقول في ترجمة فتحي المسكيني وسنكتفي بها دون المقابل الإنجليزي لأنها تفي بالغرض:
"إن الكينونة هي التصور الأكثر كلية."[31]
وإذا عدنا إلى معيار العلم للغزالي فإننا نجد هذا المعنى في فهم الوجود حيث أن الوجود ليس هو التّصوّر الأكثر كلية على الحقيقة وإنما الجنسgenus هو الأكثر كلية على الحقيقة إذا ما أردنا إجراء الحدّ، لذلك نورده أولا في أفق إيقاع تصور الشيء/الموجود من خلال النوع والفصول فيحصل بحقيقته في الذهن، أما وصف الوجود في عبارة هيدغر بأنه الأكثر كلية فإن ذلك لا يكون صحيحا إلا على سبيل التجوّز لأن الوجود يقال على كل شيء موجود ولا يصلح بالتالي في الحدّ لأنه لا ينفع في تمييز شي عن شيء، أما الجسم مثلا فهو الكلي الأعلى على الحقيقة ولا يوجد فوقه كلي آخر لأن ذكره في الحدّ يساعد على إيقاع التّصور في الذهن ومن تم فهم الشيء والعلم به بعد الإتيان بالنوع والفصل، يقول الغزالي: ... وأما الأعم من جميعها، فهو الموجودة، وقد ذكرنا أنه ليس جنسا".[32] ونجد نفس هذا الفهم عند ابن طفيل في حي ابن يقظان من كون أن ما تشترك فيه الأشياء هو الجسمية وأنها تفترق لمعاني زائدة عن الجسمية.[33] ونقرأ كذلك عند الغزالي في نفس السياق: "...اعلم أن هذه الذاتيات التي هي أجناس وأنواع تترتّب متصاعدة إلى أن تنتهي إلى جنس الأجناس، زعم المنطقيون أنها عشرة. واحد جوهر. وتسعة أعراض وهي الكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل.
فـالجوهر مثل قولنا: إنسان وحيوان وجسم".[34]
إن الوجود غير قابل للتحديد ولا نعلم ما هو على وجه الدقة بما أننا لا نستطيع تصوره كما أوضحنا أعلاه، وهو مفاد مقطع أفلاطون الذي ورد في السفسطائي وصدر به هيدغر كتابه "الوجود والزمان":
"فالواضح أنكم مدركون لما كنتم تعنونه طويلا من كلمة وجود حينما تستخدمونها، أما نحن الذين ألفنا الاعتقاد بأننا نفهمها فقد صرنا الآن في حيرة من معناها".
قارن مع ترجمة المسكيني:
"من الجلي أنكم قد ألفتم بعد طويلا، ما تعنونه على وجه الدّقة متى استعملتم لفظ "كائن"، على أن ما ظننا أننا فهمناه على الحقيقة، إنما نحن في حرج شديد منه."[35]
وفي الانجليزية في كلا الترجمتين المعتمدتين في هذا المقال:
« For manifestly you have long been aware of what you mean when use the expression « being ». we, however, who used to think we understood it, have now become perplexed.»
إن قولنا إذن عن "متعين ما" أنه موجود أو أنه شيء لا ينفع في العلم به وهو غرض الفلسفة بما هي "العِلم بحقائق الأشياء" بتعبير الفارابي. يقول الغزالي: " ... كذلك إذ ذكرنا في تحقيق الفصل، ودخوله في الماهية، ما يخرج هذه الأمور عن الفصول، كما خرج الوجود والشيء عن الأجناس بحكم ما سبق في الاصطلاح."[36]
إن الوجود خارج عن الأجناس وبالتالي عن الكليات اللهم على سبيل التجوّز.
والدّليل على ذلك موجود كذلك عند هيدغر إذ أنه مدرك بأن كلية الوجود ليست هي نفسها كلية الجنس، نقرأ في ترجمة المسكيني:
"إن فهما ما للكينونة متضمّن بعدُ في كل مرة ضمن ما يدركه المرأ من الكائن. غير أن كلية الكينونة ليست كلية الجنس."[37]
ونقرأ في ترجمة روبنسون وماكواري:
« An understanding of being is already included in conceiving any thing which one apprehends as entity. But the universality of being is not that of genus.»[38]
وفي ترجمة ستامبوغ:
« An understanding of being is always already contained in every thing we apprehend in beings. But the universality of being is not that of genus.»[39]
وهذه ترجمتنا:
"إن فهما ما للوجود هو متضمّن قبليا في تصوّر كل شيء يُلم به المرأ من الموجودة (الوجود)، على أن كلية الوجود ليست هي كلية الجنس".
وكلية الجنس ليست هي كلية الوجود لأن الجسم معروف لدينا في حين أن الوجود غير معروف لنا كما أسلفنا، وهاهي عبارة هيدغر التي تؤكد ذلك، بحيث أن الوجود غير قابل للتحديد حسبه، يقول هيدغر في ترجمة فتحي المسكيني:
"إن تصوّر الكينونة إنما هو غير قابل للتعريف، وهذا ما نستنتجه من كليته القصوى."[40]
وفي ترجمة روبسون وماكواري:
« … The concept of being is indefinable. This is deduced from its supreme universality.»[41]
وقد جاءت ترجمة ستامبوغ مطابقة لها فلا حاجة لإيرادها.
وهذه ترجمتنا:
"إن تصوّر الوجود غير قابل للتحديد وذلك ما يُستنبط من كونه المقول بإطلاق".
هذا إن شئنا ترجمة تأويلية، أما إن شئنا أن نلتزم الحرفية فالجدير أن نقول، و"وذلك ما يُستنبط من كونه الكلي الأعلى"، بما أنه أعلى من الجسم أو، لا "الأقصى" كما ذهب إلى ذلك المسكيني، وفي نفس السياق فنحن نقول مثلا "المحكمة العليا" Supreme Court لا "المحكمة القصوى".
كما نجد مضمون كلام أفلاطون وهيدغر بخصوص التحيّر من معنى الوجود وعدم قابليته للتعريف عند الفارابي كذلك وهو يحدثنا عن الجوهر/الوجود، فالجوهر يقال على الأحق باسم الموجود كما هو معروف:
"وليس ينبغي أن تُخيّل إلى نفسك معنى الجوهر أنه شبه شيء ثخين مكتّل مصمّت أو صلب لأجل ما تسمعه من قوم قد اعتادوا أن يقولوا ((إنه هو القائم بنفسه)) و((قوامه بنفسه)) وأشباه هذه العبارة التي تّخيِّل في الجوهر ما ليس هو الجوهر المحمول الذي لا يُحمل على موضوع أصلا إلا على طريق ما هو". "والسبب في هذا التّخيّل أذهاننا وأفكارنا الصامتة، كأنّا إذا لم يدافع لمسنا جسم مّا بل كان سهل الاندفاع والانحراف وهواناً لنا حين نرجمه، هان علينا أمر وجوده... وكل هذه خيالات فاسدة مغلطة عليك أن تحذرها. وتصوّر الجوهَر في نفسك."[42]
الوجود أم الأيس/البتق:
ومن الأخطاء الشنيعة أن عبد الغفار مكاوي وإسماعيل المصدق كلاهما نقل مفهوم Seyn الذي يكتبه هيدغر بـ Y بدل i (Sein) وذلك ليقطع مع المضمون الميتافيزيقي الذي يحيل عليه sein - ففعل الأنجلوساكسون نفس الأمر مع Being بحيث رسموها Beyng للدلالة على Seyn-، قلت كلاهما نقلاه بـ "وجود" و"كون" في نهاية محاضرة "في ماهية الحقيقة"، أي بنفس ما نقلا به Sein، وإذا كان مكاوي قد نبّه في هامشة إلى أن هيدغر يكتب sein كما كانت تُرسم في الألمانية قديما،[43] وهو نفس الأمر بالنسبة للإنجليزية، فإنهما معا لم ينبها إلى ما ذكرناه من فرق بينهما ولم يحاولا وضع مقابل في العربية يحفظ التمايز بين sein و seyn ، ولو تعاملا بذكاء لانتبها إلى أن في العربية أيضا يوجد لفظ يدل على الوجود ولم يعد مستعملا ولاسترجعوه ووضعوه كمقابل لـ seyn مع تضمينه المعاني التي يضمنه إياها هايدغر وهذا اللفظ هو "الأيس" ولحفظوا الفرق في العربية بين وجود sein وseyn ولاستثمروا اشتقاقاته حسب السياق (أيّس، ... كما يمكن الاجتهاد لوضع مقابل جديد لـ seyn وهو البتق في نظرنا والتي تدل على تكون ونمو جسم من جسم آخر/ أكبر ويشير بالتالي إلى الفرق Between/Zwischen الذي يتوسط الوجود والموجود أي إلى نوع من الفاعلية التي للـ Beyng والتي تجعل الأشياء تتأيس أو تنبثق عن الوجود وتتعين[44]...
ولنلاحظ الفساد الذي لحق ترجمة المصدق وكذلك مكاوي حينما أوردا Seyn وSein بنفس المقابل الذي هو "الكون" و"الوجود":
"... الكون das Seyn بصفته الاختلاف القائم بين الكون das Sein والكائن..."[45]
"... الوجود بوصفه الفارق الكائن بين الوجود والموجود..."[46]
فكيف يوجد الكون بين الكون والكائن وكيف يوجد الوجود بين الوجود والموجود؟ ولو انتبها إلى أن السياق لا يقبل هذا لعادا إلى المعاجم ولبحثا علة رسم هيدغر لـ Seyn بـ Y بدل i)) ... خاصة وأن من المفترض أن تكون الكتابات والشروح والمعاجم بالألمانية حول هايدغر موجودة وأكثر من أي لغة أخرى...
وهاكم ترجمتنا:
"... يُتفكّر البتق باعتباره ما يشغل البَين القائم بين الوجود والموجودات..."
« Beyng is thought as the difference that holds sway between Being an beigns.»[47]
***
وهناك فكرة ضمنية ربما يستخلصها القارئ إذا ما أعار المقال كامل وجدانه، وهي أن التمكن من الفلسفة العربية الإسلامية ولو في حدود أمر لازم إذ لا توجد قطيعة نهائية بين الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة الحديثة والمعاصرة، وفلسفة هيدغر تُفهم بالاطلاع على الفلسفة الإسلامية لأن المشترك بينهما هو التراث الإغريقي الذي سبق أن نُقل جزء كبير منه إلى العربية لكن التخصص مباشرة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة يجعل من لم يطلع على الفلسفة الإسلامية يعتقد أن ما قاله المحدثون والمعاصرون جديد كل الجدة فيفوته أن يستثمر الترجمات العربية في نقل ما يعيد قوله المحدثون والمعاصرون وكان قد قاله الإغريق وعرفه الفلاسفة المسلمون ووضعوا مقابلات له.
المراجع:
بالعربية:
- عبد الغفار مكاوي، نداء الحقيقة، دار الثافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1977
- مارتن هايدغر، كتابات أساسية (الجزأ الثاني)، ترجمة إسماعيل المصدق، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002.
- مارتين هيدغر، في ماهية الحقيقة، ترجمة محمد سبيلا، منشور على موقع الإنترنت: الحداثة وما بعد الحداثة، 2015.
- مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الأولى، 2012.
- حمو النقاري، مفاهيم التفلسف الغربي، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، الطبعة الأولى، 2018.
- عبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، 2009.
- الغزالي، معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2017.
- هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1979.
- محمد محجوب، هايدغر والعربية في مهبّ الترجمات، مؤمنون بلا حدود، يناير 2023.
- عبد الجليل الكور، تساؤلات التفلسف وتضليلات اللغوى، عالم الكتب الحديث، إربد-الأردن، الطبعة الأولى، 2013.
- ابن طفيل، حي بن يقظان، تحقيق أحمد أمين، آفاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2019.
- الفارابي، كتاب الحروف، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006.
بالأجنبية:
- Martin Heidegger, Basics Writings, ed. David Krell (New York : HarperCollins, 1993).
- Martin Heidegger, Being and Time, trans. Macquarrie and Robison (Oxford : BlackWell, 2001).
- Martin Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh (New York : SUNY Press, 1996).
- Martin Heidegger, Etre et Temps, trad, Emmanuel Martineau, Edition Numérique Hors-comerce.
- A companion to Heidegger, Hubert Dreyfus and Mark Warthal, (Bodmin : Blackwell, 2005).
- Richard Rorty, Essays on heidegger and others, Philosophical Papers Vol 2 (New York : Cambridge University Press, 2008).
- Herbert Marcuse, Reason and Revolution (New York : Routledge, 2023).
- The Cambridge Heidegger Lexicon, Mark Warthal (Cambridge : Cambridge university press, 2021).
- Aristotle, The Complete Works of Aristotle, edited by Jonathan Barnes (the revised oxford translation : Digital Edition 1995).
[1] Heidegger, on the essence of truth, in Basics Writings, ed. David Krell (New York : HarperCollins, 1993), p115-138.
[2] BW, P. 121.
[3] عبد الغفار مكاوي، نداء الحقيقة، دار الثافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1977، ص 262-263.
[4] مارتن هايدغر، كتابات أساسية (الجزأ الثاني)، ترجمة إسماعيل المصدق، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002، ص 62.
[5] مارتين هيدغر، في ماهية الحقيقة، ترجمة محمد سبيلا، منشور على موقع الإنترنت: الحداثة وما بعد الحداثة، 2015.
[6] عبد الغفاري مكاوي، مرجع سابق، ص 263.
[7] كتابات أساسية، مرجع سابق، ص 63.
[8] حمو النقاري، مفاهيم التفلسف الغربي، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، الطبعة الأولى، 2018، ص66.
[9] ابن سينا، كتاب الحدود، ضمن عبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، 2009، ص 233-234.
[10] الغزالي، معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2017، ص65.
[11] المرجع نفسه، ص 260.
[12] Aristotle, The Complete Works of Aristotle, edited by Jonathan Barnes (the revised oxford translation : Digital Edition 1995).
[13] الكندي، كتاب الحدود والرسوم، ضمن: عبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، 2009، ص
[14] BW, P.122.
[15] لم يحل "إينوود" إلا مرة واحدة على Verhaltenبمعنى الموقف في حين أورده في غالب الأحيان بمعاني السلوك الإنساني المفكر فيه والواعي (التصرف) في مقابل سلوك الحيوانات والعلاقة والتقييد، بينما أحال عليه "وارتهل " بمعاني الانخراط الذي يكون ذا معنى في العالم والأفكار والمعتقدات والقصود لكنه تكلم عنها أيضا بمعنى السلوك وردود الفعل والموقف العملي وحينما أحال على المفهوم في محاضرة "ماهية الحقيقة" بقي هناك غموض بحيث لم يربطه بالتصور Conception أو ما يدل عليه في هذه المحاضرة من الحمل أو القول أو الحد أو القول القضوي Prositional Statement
See, Michael Inwood, A heidegger dictionary (Bodmin : Blackwell, 1999), P. 3-120- 121- 134.
Also, The Cambridge Heidegger Lexicon, Mark Warthal (Cambridge : Cambridge university press, 2021), P. 167-168.
[16] Martin Heidegger, Being and Time, trans. Macquarrie and Robison (Oxford : BlackWell, 2001), P. 23.
[17] Martin Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh (New York : SUNY Press, 1996), P. 3.
[18] Martin Heidegger, Etre et Temps, trad, Emmanuel Martineau, Edition Numérique Hors-comerce. P 26.
[19] مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الأولى، 2012، ص 52.
[20] هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1979، ص 40.
[21] Herbert Marcuse, Reason and Revolution (New York : Routledge, 2023), P. 14.
[22] كما يتضح ذلك من خلال هذا المقطع من ترجمته لكتاب ماركيوز حول هيغل: "وهكذا فإن كتاب المنطق يبدأ، كما بدأت الفلسفة الغربية بأسرها، بتصور الوجود.. وكان السؤال: ما الوجود؟ يبحث عما يجمع كل الأشياء في التجربة ويجعلها على ما هي عليه... وتصور الوجود يفترض مقدما التمييز بين الوجود المتعين (أعني شيئا ما، أو شيئا موجودا Seiendes) والوجود بما هو كذلك (أو الكينونة) Sein دون تعينات. واللغة اليومية تميز الوجود (أو الكينونة) من الوجود المتعين في كل ضروب الحكم... والرابطة ((يكون)) تدل على الوجود (أو الكينونة)...". ضمن كتاب العقل والثورة، مرجع سابق، ص 139.
[23] جاء في الإهداء "إلى فؤاد زكريا.. الصديق الكبير، والفيلسوف الحق". وصدرت الطبعة الأولى من ترجمة فؤاد زكريا للعقل والثورة عن الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 1970 بينما صدر نداء الحقيقة (مرجع سابق) لـ عبد الغفار مكاوي سنة 1977.
[24] The Cambridge Heidegger Lexicon, Mark Warthal (Cambridge : Cambridge university press, 2021), P. 297.
[25] محمد محجوب، هايدغر والعربية في مهبّ الترجمات، مؤمنون بلا حدود، يناير 2023. ولو أن محمد محجوب أيضا ارتكب خطأ في مقاله: العنصر الإغريقي في أنتولوجيا هايدغر الأساسية من أرسطو إلى بارمنيدس. المنشور بمؤمنون بلا حدود بتاريخ 21 دجنبر 2023 حيث ترجم استعارة النور الشهيرة التي يستعملها هيدغر Lichtung بـ "الخلوة" فتحول كلامه في المقال المذكور إلى طلاسم: "يعمد هايدغر، ضمن واحد من نصوصه المتأخرة إلى التضييق على الآليثيا الإغريقية بأنها لم تكن غير اسم لفظت فيه الخَلوة Die Lichtung". هكذا !.
[26] عبد الجليل الكور، تساؤلات التفلسف وتضليلات اللغوى، عالم الكتب الحديث، إربد-الأردن، الطبعة الأولى، 2013، ص 126.
[27] See, Dasein, in, A companion to Heidegger, Hubert Dreyfus and Mark Warthal (Bodmin : Blackwell, 2005), P. 193-213.
[28] الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص 763.
[29] المرجع نفسه، ص 762.
[30] Richard Rorty, Heidegger, Contingency, and Pragmatim, in Essays on heidegger and others, Philosophical Papers Vol 2 (New York : Cambridge University Press, 2008).
[31] الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص 50.
[32] معيار العلم، مرجع سابق، ص 102.
[33] ابن طفيل، حي بن يقظان، تحقيق أحمد أمين، آفاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2019، ص من 112-116.
[34] المرجع نفسه، ص 101.
[35] الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص 47.
[36] معيار العلم، مرجع سابق، ص 307.
[37] الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص 51.
[38] Macquarrie and Robinson, P. 22.
[39] Joan Stambaugh, P. 2.
[40] الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص 51-52.
[41] Macquarrie and Stambaugh, P. 23.
[42] الفارابي، كتاب الحروف، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006، ص 107-108.
[43] نداء الحقيقة، مرجع سابق، ص 299.
[44] The Cambridge Heidegger Lexicon, Mark Warthal, (Cambridge : Cambridge university press, 2021), P.119.
[45] كتابات أساسية، مرجع سابق، ص 76.
[46] نداء الحقيقة، مرجع سابق، ص 298.
[47] BW, P.137.
الترجمة:
"من غير المرجح أن يكون أي منا واضحًا بشأن علاقتنا بالمال. وبدلا من استنكار ذلك، يجب علينا أن نعترف بأنه لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، لأن هذه العلاقات شديدة التنوع والتناقض والتشابك. إنها تراث عصور مختلفة، ولم يتم إلغاء أي منها بشكل نهائي. وليس من المؤكد حتى أن مثل هذا الموقف الذي يتميز به الماضي البعيد لن يجد شرعية جديدة، في ظروف يصعب التنبؤ بها.
سأفكر في ثلاث طبقات في مخيلتنا فيما يتعلق بالمال: طبقة أخلاقية، وطبقة اقتصادية، وطبقة سياسية. إذا لم يكن من الخطأ أن نقول إن المشاعر والمواقف المتعلقة بالثانية لم تنضج إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وإذا كان اليوم هو ما نفترضه أكثر من غيره، على الرغم من أن المشاكل تندرج تحت المستوى الثالث، فإن الارتباك الحالي لدينا وتنتج المشاعر من حقيقة أن السلوكيات المكتسبة في أوقات مختلفة تظل بطريقة ما معاصرة لبعضها البعض في عمق الحاضر.
أولا: المستوى الأخلاقي
لقد كان ذلك المال مناسبة لردود فعل أخلاقية قوية تستحق شرحاً مفصلاً. للوهلة الأولى، يبدو المال غريبًا بحكم تعريفه على المجال الأخلاقي. كوسيلة للدفع، وبعبارة أخرى، باعتبارها المال، فهي مجرد إشارة مجردة، وسيلة بسيطة للتبادل. ومن ثم فإننا نميل إلى القول إن السلع المتبادلة، وهي الأشياء الحقيقية لرغبتنا في الاستحواذ والحيازة، هي وحدها التي ينبغي أن تخضع للحكم الأخلاقي وأن يطلق عليها اسم الخير أو الشر. كوسيط محايد وعالمي، ألا يقتصر المال على التعبير عن القيمة السوقية المشتركة للسلع المتبادلة، حيث يكون السعر هو مقياس هذه القيمة؟ محايدة اقتصاديا، لماذا لا تكون محايدة أخلاقيا؟ أو بالأحرى، ألا ينبغي اعتبارها مجرد سلعة جيدة، ما دامت، على النقيض من المقايضة، تفتح مساحة مزدوجة من الحرية للمشتري والبائع؟
" هل من الصدفة حقّا أن تكون الفلسفة فعلا، مرتبطة إلى هذا الحدّ بتدريسها، وبأولئك الذين يدرّسونها؟ وهل من الصدفة أن لا تصلح الفلسفة سوى لتعليمها الخاص فحسب، ولا لشيء آخر؟ وإذا كانت لا تصلح فقط إلا لتعليمها الخاص، فما يعني ذلك يا ترى؟"( ل. ألتوسير)
"في أي معنى يستقيم القول بأنّ : كل إنسان فيلسوف"؟
" ماذا يصنع إذن أستاذ الفلسفة؟ إنه يعلّم تلاميذه التفلسف، بتأويل النصوص الكبرى أمامهم أو المؤلفين الكبار للفلسفة، بان يلهمهم الرغبة في التفلسف. وإذا ما التمس في نفسه قوّة، أمكنه أن يتقدّم درجة ويمرّ إلى التأمّل الشخصي، أي إلى مخطّط فلسفة أصيلة."(ل. ألتوسير)
****
ما ذا يقول " غير الفلاسفة" ؟
يتوجه هذا الكتاب إلى كلّ القرّاء الذين يعتبرون أنفسهم، أصابوا أم أخطئوا، من " غير الفلاسفة"، والذين يريدون مع ذلك أن يكوّنوا فكرة عن الفلسفة. ماذا يقول " غير الفلاسفة"؟ العامل والفلاح والأجير:" لا نعرف شيئا من الفلسفة، لم تخلق لأجلنا. إنما هي لمثقفين مختصين. إنها جدّ صعبة. ولا أحد حدّثنا عنها قط: لقد غادرنا المدرسة قبل أن نتعلمها." بينما يقول الإطار والموظّف والطبيب، الخ:" نعم تابعنا درس الفلسفة. لكنه مفرط في التجريد. والأستاذ عارف بصنعته، لكنه كان غامضا. فلم نحتفظ بشيء منها. وبالمناسبة، فيم تصلح الفلسفة ؟ " ويقول آخر:" عفوا! لقد اهتممت بالفلسفة كثيرا. يجب أن نقول بأنه كان لنا أستاذ أخّاذ. وكنا نفهم الفلسفة بصحبته. لكن، انصرفت منذ ذلك الحين إلى تحصيل لقمة العيش ماذا نفعل إذن، ليس لليوم سوى 24 ساعة: لقد فقدت صلتي بها. مع الأسف. " وإذا ما سألتهم جميعا:" لكن عندئذ، بما أنكم لا تعتبرون أنفسكم فلاسفة، فمن من الناس في نظركم من يستحقّ اسم فيلسوف؟"، فسيجيبون، بصوت واحد:" إنما هم أساتذة الفلسفة!". وهذا عين الصواب : فبخلاف الناس الذين، لأسباب شخصية، أي من أجل متعتهم أو لنفع ما، يستمرّون في القراءة لكتّاب فلسفة، في" ممارسة الفلسفة"، فإنّ من يستحقّ اسم فيلسوف هم فعلا أساتذة الفلسفة. يطرح هذا الأمر بالطبع سؤالا أول، أو بالأحرى أثنين.
1. هل حقّا من الصدفة أن تكون الفلسفة فعلا، مرتبطة إلى هذا الحدّ بتدريسها، وبأولئك الذين يدرّسونها؟ يجب أن نعتقد أن الأمر ليس كذلك، إذ في النهاية،لا يعود هذا الزواج فلسفة - تعليم إلى أقسام الفلسفة عندنا، لا يعود إلى الأمس: فمنذ بدايات الفلسفة، كان أفلاطون يدرّس الفلسفة، وأرسطو يدرس الفلسفة ... وإذا كانت هذه الزيجة فلسفة - تعليم ( تدريس) ليست نتاج الصدفة، فهي تعبّر عن.ضرورة خفيّة. وسنحاول اكتشافها.
غونفور ميديل (Gunvor Mejdell) هي باحثة ومترجمة نرويجية لعبت دورًا محوريًا في تقديم الأدب العربي إلى العالم الغربي، وخاصة القارئ النرويجي. تعتبر من أبرز المتخصصين في اللغة العربية والدراسات العربية في النرويج. من خلال ترجمتها وإعدادها لأنطولوجيا بعنوان "العالم العربي يروي" التي نشرت عام 1997، أسهمت بشكل كبير في مد جسور ثقافية بين الثقافتين العربية والنرويجية.
"العالم العربي يروي": أنطولوجيا الأدب العربي
تحت عنوان "العالم العربي يروي" (Den arabiske verden forteller)، قدمت غونفور ميديل أنطولوجيا للأدب العربي، مكونة من 620 صفحة تحتوي على 75 قصة قصيرة من تأليف 71 كاتبًا عربيًا. تمثل هذه المجموعة تشكيلة متنوعة من الأدباء الذين يمثلون مختلف دول العالم العربي، بدءًا من المغرب الأقصى وصولاً إلى منطقة الخليج. عملت ميديل على تقديم القارئ النرويجي إلى كتاب عرب مشهورين مثل نجيب محفوظ، يوسف إدريس، غسان كنفاني، وغيرهم ممن أثروا الساحة الأدبية العربية بأعمالهم الأدبية المتميزة.
التحديات في الترجمة الثقافية
واحدة من أبرز التحديات التي واجهتها غونفور ميديل وفريق المترجمين الذين عملوا معها كانت كيفية الحفاظ على جوهر وروح النصوص الأصلية مع مراعاة الخصوصيات الثقافية العربية. تناولت ميديل قضايا تتعلق بالتعبير اللغوي والأدبي الخاص بالثقافة العربية، وقدرتها على إيصال هذه الرسائل للقارئ النرويجي. وبفضل خبرتها الواسعة في اللغة العربية والثقافة العربية، تمكنت ميديل من تقديم ترجمة تتسم بالدقة والحساسية الثقافية، مما جعل النصوص سهلة الفهم للقارئ النرويجي دون أن تفقد هويتها الأدبية.
الليتي Léthè النسيان، بيوس bios الحياة وكرونوس chronosالزمن : جدلية الحفظ والفقد.
نحن نعلم أيضا بأنّ الزمن المستعاد le temps retrouvé، حتى نستخدم معجمية بروست، لا يمكن تحديدا أن يُستعاد إلاّ إذا فقدناه. تثبت تجربة الذاكرة اللارادية (تجربة نكهة المادلين الشهيرة مثلا) استمرارية الهوية الفردية عبر الزمن، لكنها تثبت أن إيجادها لا قيمة له إلاّ بعد النسيان. إنها تبيّن كيف أن عمق النسيان هو الأصل الجيولوجي للذاكرة: هو ما يذكّرنا بشكل أفضل بالماضي، هو بالضبط ما نسيناه، يقول بروست.
إنّ هذا الشكل من التذكّر موجود في كل موضع من "البحث عن الزمن الضائع" ونحن نفكّر في صوناتا فانتوي sonate de Vinteuil الشهيرة ،هذه الموسيقى التي يبدو انه قد نُسيت دون أن تكون قد استُمع إليها بما أنّ شارل سيوان قد تعرّف عليها لحظة التقى بها : مثال جيد عن الحميميّة العفوية والمُرْبِكة مع شيء من العالم يبدو انه آت من عالم آخر. يمكننا ملاحظة هذه الظاهرة بالقيام بتجربة إعادة قراءة كتاب ما سبق أن قرأناه ثمّ نسيناه. فسنكتشف إذن أن " إعادة القراءة" هو أن نحيا من جديد دون توقّع، وهي تحصيل الانطباع بما سبقت رؤيته دون التوقّف عن رؤيته قادما"، وانطلاقا من هذه التجربة الخاصّة للغياب، نشعر في الآن نفسه " بلطف العودة ولذّة الانتظار" ( 44). كان لدى أفلاطون بعدُ تحليلا أوليا للنسيان الأصليّ مع أسطورة " آير البافيلي التي ينتهي بها الكتاب العاشر للجمهورية. مات آير على ساحة المعركة، وقد وضع على حطبٍ كي يحرق، فيقدر على رؤية ما سيحدث للأرواح بعد الحياة وقبلها. وفي إجراء معقّد يفضي إلى التناسخ، تتوقّع مرحلة تختارها كل نفس بدورها، من بين مصائر مقترحة، حياتها الجديدة. بقدر ما تسلك الطريق نحو سَهْل الليتي Léthè النسيان) للشرب من ماء النهر( 45).ويجعلها هذا الماء تنسى ذكرى الحياة الماضية، قبل أن تُنقل نحو مكان ولادتها الموالية، أي في الأجساد حيث تُنْسَخ. لقد اختارت النفس بحرية مصيرها الجديد قبل نسيان حياتها الماضية، ويقول النص بأنّ نَفْسَâme اوليس (46) قد اختارت اختيار صائبا، مستلهمٍ من التجربة الثرية المكتسبة من مغامرات الأوديسا. غير أن النسيان وحده يسمح بإيجاد مكان للجديد والفعل من جديد، وفي هذا المعنى، فإن شرب ماء نهر أميليس، الليتي Léthè، وبتعبير آخر القدرة على النسيان، هي الشرط الحقيقيّ للحريّة : أن أكون حرّا، هو أن لا نخضع لما سبق. وفي ذات الوقت، تظلّ آثار حياة قديمة ربّما، تظهر من جديد بوصفها علامات إلغازية في الوجود الجديد. وبالفعل فإنّ البدء أو البدء من جديد " يمثّل تجربة لا تقبل طعن " كما يقول بول ريكور: فمن دونها لن نفهم ما يعنيه الاستمرار والدوام والبقاء والانتهاء". (47) كل عود على بدء محكوم بماض منسيّ. كل بداية جديدة مشروطة بماض منسيّ، للماضي الذي، بعبارة سارتر، "ينتظر التصديق"(48)، النسيان بوصفه فعل ماض. وفي هذا المعنى، يبني النسيان الماضي ويسمح، من وراء الماضي وحده، باحتلال المسافة الزمنية وبالتالي هيكلة كليّة الزمن. يعرف المؤرخون بالخصوص، بأنّ الذاكرة، سواء أكانت "جماعية أو فردية هي أيضا نسق تنظيم للنسيان. لكن، كان برجسون في شأن بناء الماضي، أوّل من تساءل في حال تكوّن الذكرى، عن اللحظة التي يختفي فيها الإدراك ويترك المكان للذكرى. لقد طرح هذا السؤال غير المألوفوالجوهري سنة 1908 في تذكر الحاضر والاعتراف الكاذب( 49)، حيث بيّن بأنّ نسيان الإدراك ضروري كي تظهر الذكرى." إن تشكلّ الذكرى ليس مابعديا بالنسبة إلى ذكرى الإدراك، يقول برجسون، إنه متزامن معها".( 50)، لكن مع نسيان هذه الذكرى، التي هي بالضرورة بعدية، فإنّ الزمن هو الذي يمرّ".
"إنّ إصلاح الحياة هو في الآن نفسه مغامرة داخلية ومشروع حياة ومشروع جماعيّ." ( إ. موران)
"إنّ التطلّع إلى هذا الفنّ الجديد للعيش هو بصدد الظهور في المجتمع بموجب الشرور الناتجة بالذات عن أنماط حياتنا الراهنة. إنه انطلاقا من هذا الانتظار يمكننا رسم ما يمكن أن يكون إصلاحا للحياة." (إ. موران)
" المهم أكثر هو أن نعيش حياتنا لا أن نلهث وراءها" (موران).
" يقوم " العيش الكريم " على بعض المبادئ : أولوية الكيفية على الكميّة، والكائن على الملكية، ويجب أن تكون الحاجة إلى الاستقلالية والحاجة إلى الجماعة مجتمعة، وعلى شعرية الحياة وفي النهاية الحبّ الذي هو قيمتنا ولكنه أيضا حقيقتنا الأسمى." ( موران).
لا تمثل عبارة " تغيير الحياة "، شعار الشاعر أرتيير ريمبو، اليومَ، تطلّع فرد بل يجب أن يكون شعار عصرنا. تواجه الإنسانية تحديا كبيرا :هي تدعو إلى سياسة حضارة تفترض أيضا إصلاحا للحياة.
تخصّصُ جانبا كبيرا من مؤلفك " الطريق" لتعريف " إصلاح الحياة" الذي يصاحب ويبرّر سياسة التحديّات الكبرى للإنسانية. ماذا تعني بذلك؟
إ.موران:
فعلا، يرسم " الطريق" الذي أقترحه أفقا آخر غير الأفق الذي يقودنا إليه التاريخ المعاصر. إنّ كوكب الأرض منخرط في مسار جهنمي يقود الإنسانية نحو كارثة متوقّعة. يمكن لتحوّل تاريخي وحده أن يسمح بحلّ الأزمات- الكبرى والمتعدّدة- الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدّد وجود حضاراتنا بالذات التي هي في طريق التوحيد.
لا أرسم في كتاب " الطريق" " برنامجا" سياسيا، بالمعنى الحرفي للكلمة، بل مسلكا، طريقا مصنوعا من ترابط عدّة طرق يجب علينا التوجّه نحوها من أجل مجابهة تحدّي أزمة الإنسانية.تمرّ " سياسة الإنسانية " هذه عبر إصلاحات اقتصادية وسياسيّة وتربويّة وإعادة تكوين الفكر السياسي وهو ما أحاول رسم حدوده. تعني هذه الإصلاحات للمجتمع أيضا " إصلاحا للحياة". إنّ التطوّر مكنة فتاكة للإنتاج / الاستهلاك / التدمير تهرع بنا نحو أزمات إيكولوجية واقتصادية. يجد هذا المسار ما يوازيه على الصعيد الفردي : تطوّر الفرد المنظور إليه بوصفه بالأساس كمّيا وماديا، والذي يؤدّي لدى الميسورين إلى سباق محموم نحو " الأكثر دوما" وحتى إلى شعور بالضيق داخل رغد العيش، مقولة انحطت إلى الرفاهية فحسب. وأيضا، هل ينبغي أن نروّج للرفاه الذي يتضمّن في الآن نفسه الاستقلالية الذاتية والاندماج في إحدى المجموعات، والتحكّم في التوقيت الذي ينحطّ بزمننا الحيّ، ويختزل تلوّثنا الحضاري الذي يجعلنا مرتهنين للتفاهات والمنافع الوهميّة.لقد اعتبرت المجتمعات الغربية لوقت طويل مجتمعات " متحضّرة" بالنسبة إلى مجتمعات أخرى، ينظر إليها بما هي بربرية. وبالفعل، فإنّ الحداثة الغربية أنتجت هيمنة بربرية جليدية، مجهولة، بربرية الحساب والمصلحة والتقنية ولم تقدر على إخماد بربرية داخلية إلاّ قليلا، بربرية هي صنيعة عدم فهم الآخر، والكراهية واللامبالاة.
إنّ المجتمعات الراهنة قد حققت ما كان يعتبر حلما بالنسبة إلى أجدادنا: الرفاه المادّي و رغد العيش. وقد اكتشفنا في نفس الوقت بأنّ الرفاه المادّي لا يجلب السعادة. بل الأسوأ ! فقد اتضح أنّ الثمن الذي يجب أن ندفعه مقابل الوفرة المادّية تكلفته البشرية هائلة : توتّر وسباق مع الزمن وإدمان وإحساس بالفراغ الداخلي ....
لقد ظللنا، إلى جانب ذلك، وعلى الصعيد الإنساني في بربريّة: يعبّر العمى عن الذات وعدم فهم الآخر عن نفسه، على صعيد المجتمعات والشعوب مثلما يعبّر عن نفسه على صعيد العلاقات الشخصية، بما في ذلك صلب الأسر والأزواج. كثير من الأزواج ينفصلون وتتمزّق علاقاتهم ؛ وتشبه هذه النزاعات، النزاعات الحربية القائمة على الكراهية، ورفض فهم الآخر. بينما لا يفعل أزواج آخرون سوى التواجد.
لا شك أنّ العالم اليوم يواجه جملة من القضايا المتنوّعة، آثارها جلية على البشرية جمعاء منها: مستحقّات التعدّدية، بوجهيها الديني والثقافي، ومستوجَبات السلم في العالم، ومراعاة الأقليات في مجتمعاتها الأصيلة، واحترام نظيرتها في المجتمعات التي طرأت عليها الهجرة، وغيرها من القضايا. وهي قضايا لا يمكن التعاطي معها بمثابة أخبار عابرة، في وسائل الإعلام؛ بل ينبغي تطارح آثارها وأبعادها بعمقٍ، وإمعان النظر فيها وحولها بالبحث والدراسة والترجمة.
ومهما بدا المرءُ معزولا عن تلك القضايا الكبرى، حين يرزح تحت وطأة المشاكل الفردية، فالثابت والجليّ أنّ ثمة جدلية وصِلة بين مشاكل الفرد الشخصية وقضايا العالم الجماعية، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن مشاكل الفرد هي قضايا العالم وقضايا العالم هي مشاكل الفرد. ولعلّ هذا ما يجعل الترابط بين القضايا الإنسانية وصناعة النشر اليوم من أوكد ما نحتاج لمعالجته لإدراك ذواتنا وللإحاطة بقضايا العالم.
الصناعة الثقافية وقضايا العالم
لعلّ من الصائب، لو شئنا عنوانا لمداخلتنا في قالب تساؤل لقلنا: من يصنع الفكر والثقافة اليوم؟ ومن تشغله قضايا العالم؟ مجالات النشر والقضايا الإنسانية هما مسألتان تسائلان أوضاعنا الراهنة، المعرفية والحضورية في العالم، بَيْد أنهما تشكوان من المعالجة السوية والمعمَّقة. ذلك أن الجانب الأول، "النشر والترجمة"، هو عملٌ غالبا ما تعكف على الاشتغال به مؤسسات خاصة لدينا، وهي مؤسسات في أوضاعها الحالية قاصرة عن بلوغ المرجو، لأنها باختصار تلاحق تحقيق الربح للحصول على عائدات مادية لا غير، وقلّما يرتبط عملا النشر والترجمة في تلك المؤسسات الخاصة بمعالجة قضايا ذات أبعاد إنسانية.
ذلك أنّ دُور النشر العربية، في الغالب الأعمّ، ليست امتدادا لمراكز أبحاث أو مؤسسات دراسات، أو هيئات علمية ومعرفية، معنيّة بالاشتغال على نطاق محلي أو دولي، بل هي شبه دكاكين تجارية محدودة الأنشطة، لم تتحوّل إلى ما يشبه المغازات أو المولات الثقافية. ومحدودية النشاط هذه فرضت عليها نمطا خُلقيا في التعامل مع الكتّاب والباحثين والمبدِعين، غالبا ما كان محكوما بمعادلتَيْ الاستغلال، وأدخلها في منظور للنشر والترجمة محصورا بأهداف مستعجَلة وخاضعا لسياسات ربحية. لذلك يبقى دَوْر الانشغال بالقضايا الإنسانية بعيدا عن خياراتها وملقى على عاتق مؤسسات ذات صبغة مقاصدية تتجاوز الهدف التجاري إلى هدف حضوري وتأثيري في العالم. ونقصد بالأساس مؤسسات معرفية وعلمية غير ربحية، تتمتّع بمستوى من الاستقلالية حتى تقدر على التحرك والتأثير.
ألمحنا بعجالة، في ما سبق، إلى نوعي المؤسسات المنشغلة بالنشر والقضايا الإنسانية في آن، ضمن السياق العربي، وبيّنا أن التعويل على دُور النشر العربية في هذا الجانب هو من باب حلم اليقظة، لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه. فالمسألة أكبر من قدراتها وإمكانياتها، ولذا تبقى المؤسسات الجماعية الفاعلة، أو ما بات يُعرف بـ (الثينك تانك/ Think tank) هي المقتدرة على تولّى هذه المهمّة وتطويرها. فالفكر العملي اليوم، والتأثير الثقافي بوجه عام، ما عادا صناعة فردية بل صناعة مؤسسة جماعية.
أي لغز هذا؟ انظروا، إنه حيوان أقرب إلى بلح البحر منا. لكنه يلعب، ويستخدم أدوات، وله ذاكرة، ويحل مشكلات. إنه يمتلك ذهنا وحياة عقلية، باستثناء أنها مختلفة تماما عن حياتنا العقلية، ومن الصعب تكوين فكرة عنها. هل يتعلق الأمر بكائن فضائي؟ لا! إنه الأخطبوط. هذا الحيوان لا يكف عن إدهاش العلماء بعضويته وقدراته، وبفضله أعيد ابتكار نظرية تطورية في الوعي.
هل أنتم حقا واثقون من إرادة الخوض في هذا الملف؟ هناك مخاطرة في الأمر: ما من أحد من أولئك الذين لم يسبق لهم أن اقتربوا قط من هذه الرخويات المذهلة، وداعبوا أطرافها، وسبروا نظرتها، من خرج من ذلك كما دخل. فبعد الفضول تنبثق الدهشة، ثم الإحساس بتعقيد مزعج... يتحول إلى مساءلة عميقة لما نكونه، نحن، باعتبارنا نوعا. وهذا ما يقر به لودوفيتش ديكل Ludovic Dickel المختص في علم الأعصاب والسلوك المعرفي الحيواني لرأسيات الأرجل céphalopodes بجامعة كاين Caen: "ليس من المطَمْئِن جدا دراسة الأخطبوط".
لماذا دراسة الأخطبوط مزعجة بهذا القدر؟ احتمالا لأننا لا يمكن أن نتخيل حيوانا أكثر اختلافا عنا: سلالته وسلالتنا افترقتا منذ ما يناهز 650 مليون سنة. وينتمي الأخطبوط إلى الصنف الفرعي للرخويات، مثل المحارات أو الحلزونات أو البزاقات. وداخل هذا الصنف الفرعي، توجد فصيلة رأسيات الأرجل، التي يشترك فيها الأخطبوط مع الحبارات seiches والنوتيلوسات nautiles، هذه الحيوانات ذوات الجسم الرخو، والمزودة رؤوسها بأذرع متحركة. والأخطبوط الذي تقدر أنواعه بثلاثمائة نوع، يمتلك ثمانية من هذه الأذرع، كل منها يتضمن مئات من الماصات. وأسفل رأسه يوجد منقار حاد بواسطته يلتهم سلطعونات وصدفيات.
ولاستكمال هذه العدة الأصيلة، الحيوان مزود بثلاثة قلوب، وبعينين بشبكيتين مستطيلتين- عموديتين على الأرض مهما تكن وضعيته- وبدم يميل إلى الزرقة عند تعرضه للهواء، وبقدرة مدهشة على التجدد.
وبالرغم من هذه العضوية الغريبة، وبالرغم من مئات الملايين من السنين من التطور التي تفصل بيننا، فإن الأخطبوط يظهر سلوكا بديعا ومألوفا بصورة مدهشة. يقول عالم الأعصاب البيولوجية الأمريكي دافيد إيدلمان David Edelman: "أتذكر دائما لقائي الأول مع الأخطبوط. فقد قامت طالبة بتقديم وجبة غذاء، سلطعون حي، لأخطبوط أكواريوم مختبر بحث نابولي. وبينما توجه الحيوان نحو وجبته دخلت الغرفة، فأوقف حركته وشرع في ملاحظتي في عيني مباشرة، وظللنا ننظر إلى بعضنا البعض لمدة ربع ساعة! وعندما تظاهرت بأنني أهم بالمغادرة، تمسك بي واضعا ذراعه على ذراعي: فقوته على التركيز، وقدرته على التحكم في شهيته، وتأخير وجبته من أجل الإبقاء على الاتصال بيني وبينه، كل ذلك أذهلني".
مزحة الأخطبوط الخاصة
الباحثون لا يكتفون من سرد حكايات أخطبوطات تنفث الماء أو المداد، بل وتحيك دسائس محكمة. وهكذا عرف الأخطبوط أوتو Otto المقيم بأكواريوم سي-ستار Sea-Star بمدينة كوبوغ Cobourg بألمانيا، بميله إلى قذف الماء على مصابيح القاعة، محدثا دارات صغيرة مغرقة المكان في الظلام. من الممكن أن تكون مجرد مزحة، أو انتقام أخطبوط: سلوكات مشابهة سجلت بجامعة أوتاغو Ottago بزيلاندا الجديدة.
وإذا كانت هذه الطرائف تبعث على الضحك، فإنها تثير أيضا أسئلة محيرة: كيف يشتغل هذا الذكاء؟ وكيف تدرك هذه الحيوانات نفسها؟ وكيف ترى الأفراد الآخرين، من نوعها أو من نوع آخر؟ وماذا يعني أن يكون الكائن أخطبوطا؟ كل أولئك الذين جاوروا الأخطبوطات كانوا على يقين من أن هذه الكائنات لها قدرات معرفية متطورة وتشعر بانفعالات. لنذهب إذن للقاء شكل آخر من الوعي على كوكب الأرض.