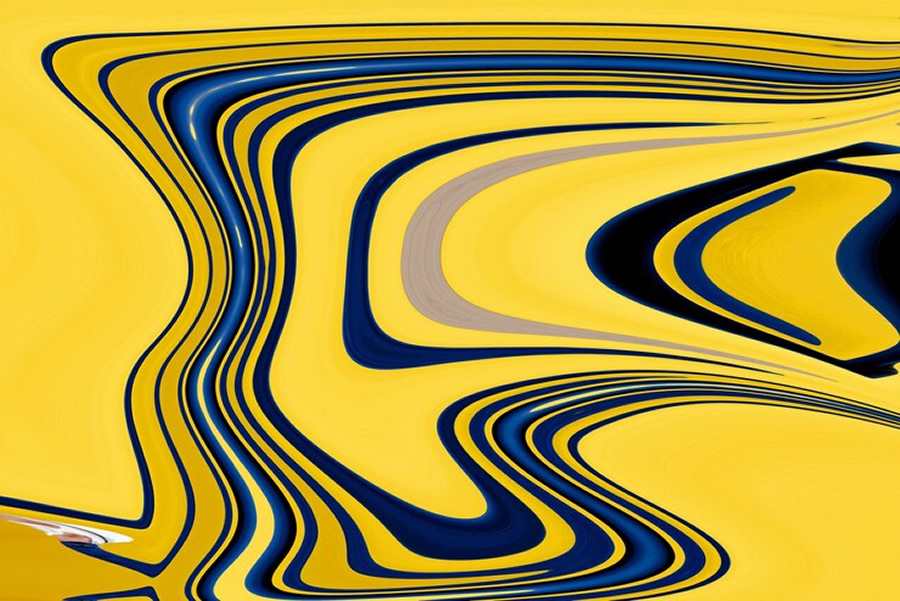في مثالية ساذجة يذهب هوسرل الى "ان الموضوع ليس معطى غفلا بل هو حقيقة تستمد معناها من القصد". في العبارة نجد بسهولة اول خطأ مثالي سطحي هو تغليب هوسرل اولوية وقبلية الوعي القصدي على بعدية الموضوع. وثانيا لايمتلك الموضوع المستقل انطولوجيا خاصيّة ان يكون (حقيقة) بل ان يكون الوعي الادراكي له (معرفة) ليست محايدة بل تغييرية. وهذا التفريق بين الحقيقة والمعرفة ليس على صعيد اختلاف المصطلح بين الاثنين فقط بل على صعيد المعنى المحتوى لكليهما.
الثابت في الادبيات الفلسفية ومثله في التفكير العلمي الذي لا يمكن تجاهله هي أن مصطلح (الحقيقة) يلتقي مع مصطلح (المعرفة) في أن كليهما مصطلحان نسبيان بمعنى هما سيرورتان تقبلان الاضافة التراكمية الكميّة والنوعية لكن ايضا باختلاف جوهري بينهما. فالتراكم الذي تتقبله الحقيقة هو قفزة نوعية ناسخة لما قبلها اما التراكم المعرفي فهو خبرة كميّة مضافة تعتمد ماقبلها ولا تلغيه.
كما أن الفرق بين الحقيقة انها مفهوم مطلق مثلما نقول الوجود هو مفهوم مطلق غير متعيّن بابعاد معرفية تجعل منه مصطلحا متفقا عليه فهو ليس موضوعا بل دلالة وكذا الحال مع الزمن. فالوجود يكون مصطلحا بمحتوياته الموجودية فيه فقط في حالات موجوديتها المستقلة انطولولوجيا داخل كليّة الوجود الذي هو مفهوم تبحث فيه الميتافيزيقا منهجا ماجعل نيتشة يسخر سخرية شديدة قوله ليس هناك شيء لاندركه لا بصفاته ولا بماهيته وندعوه الوجود.. وكذا فعل بعده هيدجر أنه لا شيء يدعى وجودا وكان يقصد مطلق الوجود كمفهوم وليس الموجود الانسان.
ليس غريبا أن نجد بالفلسفة مثل هذه المفاهيم التي نعتبرها متناقضة لا يقبلها العقل لكنها ليست بعيدة المصداقية التسليم بها. مثال آخر حينما الغى الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم (العقل المعرفي) التجريدي كماهية خاصيتها التفكيروليس العقل البيولوجي. سرعان ما تلقف هذه المقولة الفيلسوف الانجليزي جلبرت رايل 1900- 1976 قائلا من السخرية الفلسفية أن نقر بوجود عقل انساني ابدا.
علما أن ديكارت في القرن السابع عشر سبق وقال العقل جوهر خالد خلود النفس وهو يقصد العقل المجرد الذي ماهيته التفكير وليس العقل البيولوجي عجينة الدماغ بتركيبة ما تحتويه الجمجمة. نفس الشيء تكرر مع التشكيك بوجود الزمن (المفهوم) عدا الدلالة المعرفية لملازمة الزمن للمكان. وابرز من أنكر حتى عدم حاجتنا ملازمة الدلالة الزمانية للمكان هو برجسون واجاز لنفسه الادراك المكاني في عدم تعالقه الافتراضي مع الزمن. ودبّت الحياة بالتشكيك بوجود الزمن على يد ثلاثة فلاسفة اميركان معاصرين ذهبوا نفس المنحى انكارهم وجود الزمن حتى كدلالة ادراكية للمكان.(لي مقالتان منشورتان اؤيد فيه هذه النظرية الفلسفية غير الفيزيائية علميا ان الزمن مفهوم مطلق لا يمكننا البرهنة اليقينية عليه خارج ملازمته الافتراضية الحيادية للمكان).