 نستهل الحديث عن تأويليات الفيلسوف و اللاهوتي الألماني فريدريش دانيال أرنست شلايرماخر (Friedrich Daniel Erns schleiermacher ( (1834-1768) بمقتبس من محاضرته في الهرمينوطيقا إذ يقول " الهرمينوطيقا بوصفها فن الفهم لا وجود لها كمبحث عام ، فليس هناك غير كثرة من الأفرع الهرمينوطيقية المنفصلة. "
نستهل الحديث عن تأويليات الفيلسوف و اللاهوتي الألماني فريدريش دانيال أرنست شلايرماخر (Friedrich Daniel Erns schleiermacher ( (1834-1768) بمقتبس من محاضرته في الهرمينوطيقا إذ يقول " الهرمينوطيقا بوصفها فن الفهم لا وجود لها كمبحث عام ، فليس هناك غير كثرة من الأفرع الهرمينوطيقية المنفصلة. "
إذا وقفنا قليلا على هذا القول وأمعنا النظر نلاحظ بأن هرمينوطيقا شلايرماخر تعنى في المقام الأول بمسألة الفهم ، وليس أي فهم وإنما يحددها بوصفها فن الفهم (l’art de compréhension ) وهذا الوصف يحيلنا إلى أن الفهم عملية إبداعية بالدرجة الأولى ، فالفن هو قدرة على الإبداع ، وليس تطبيق حرفي آلي هنا نميز بين الفن ، والآلية (le mécanisme ) في الفهم .
وكما أشرنا سلفا بأن تعريف شلايرماخر للهرمينوطيقا باعتبارها فن الفهم وكل فهم فهو فهم خاص مثال: فهم قصيدة فهم رواية ... ، و كل فن لابد له من قواعد؛ إذن فالفن إبداع في فهم النصوص مع احترام القواعد.
بينما الآلية فهي تطبيق حرفي ميكانيكي فالآلية تقتل الفن وهما من هذا المنظور متعارضان بالنسبة لشلايرماخر مثال فالكل لا يساوي مجموع أجرائه وإنما الكل هو تلك القيمة المضافة .
قراءة في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال لأبي الوليد ابن رشد ـ مريم بناصر
 قراءة في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لأبي الوليد ابن رشد- مريم بناصر
قراءة في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لأبي الوليد ابن رشد- مريم بناصر
يعد كتاب"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" من أضخم ما ألف الفيلسوف المسلم ابن رشد، حيث استحضر فيه جدلية العقل والنقل التي ظل يتخبط فيها الفكر العربي الإسلامي.
وقد أراد من خلاله الفصل بين خطابين غير متجانسين: خطاب شرعي مقام على الوحي والإيمان، وخطاب فلسفي مؤسس على الاستدلال والعقل والبرهنة.وطرح العلاقة بين الدين والمجتمع مخاطبا المتكلمين و الفقهاء خاصة الذين نهوا عن النظر العقلي في الموجودات وقاموا بتكفير الفلاسفة.
أكد ابن رشد على أن الشرع حث وأوجب النظر العقلي في الموجودات،مستدلا بقوله تعالى في سورة الحشر فاعتبروا يا أولي الألباب﴾ ،وبقوله في سورة آل عمران ﴿ويتفكرون في خلق السماوات والأرض﴾، و على أن الفلسفة ليست إلا حكمة ونظرا إلى الموجودات، وبالتالي معرفتنا بمن أوجدها وهو الله تعالى. مما يؤكد انه لا تعارض بين الفلسفة والشريعة ، وكلاهما يعتبر سبيلا للتعرف على الخالق الذي حث على وجوب استعمال النظر العقلي أو البرهان كما سبق الذكر.
الكتب والصداقة ـ هادي معزوز
 عندما نتأمل مطولا تلك العبارة الشهيرة التي حفظناها عن ظهر قلب ونحن لا نزال صغارا في الصف الابتدائي : "خير جليس الكتاب." أو النسخة الموازية لها "الكتاب خير صديق وأنيس" نرى أنفسنا مجبرين على وضع الصداقة كطرف في مقابل الكتاب، إذ الكتاب صداقة والصداقة كتاب، من ثمة وبكثير من الحرص اللغوي والفلسفي توجب علينا تمحيص هذا الحكم الغيبي، ولم لا طلب استئنافه لعل المراجعة تنفع ما اعتقدناه حكما ثابتا قبل اليوم.
عندما نتأمل مطولا تلك العبارة الشهيرة التي حفظناها عن ظهر قلب ونحن لا نزال صغارا في الصف الابتدائي : "خير جليس الكتاب." أو النسخة الموازية لها "الكتاب خير صديق وأنيس" نرى أنفسنا مجبرين على وضع الصداقة كطرف في مقابل الكتاب، إذ الكتاب صداقة والصداقة كتاب، من ثمة وبكثير من الحرص اللغوي والفلسفي توجب علينا تمحيص هذا الحكم الغيبي، ولم لا طلب استئنافه لعل المراجعة تنفع ما اعتقدناه حكما ثابتا قبل اليوم.
إن من بين المواضيع الشيقة التي أبدعت فيها الفلسفة نجد موضوع الصداقة، هكذا لن نتعجب أبدا عندما نرى أن كبار الفلاسفة وفي منطقتهم الحميمة قد أعطوا كبير نصيب لهذا المفهوم، والحال أن أبرزهم لن يكون إلا أفلاطون وأرسطو وشيشرون وأبي حيان التوحيدي وجلال الدين الرومي وجون جاك روسو وديدرو ودوبرويار وجيل دولوز... بيد أن الصداقة عند هؤلاء الأهرام لم تقتصر إلا على الجانب الذي يربط الإنسان بالإنسان، وليس الإنسان بالأشياء، هكذا ألفيت نفسي وأنا أتأمل مكتبتي ذات يوم رفقة سؤال طالما حيرني: كيف يكون الكتاب صديقا؟
المشرع الفينومينولوجي:الأصول والتحولات ـ بريس بيكو ـ ترجمه: الحسين بوتبغة
 كان لشيوع لفظ الفينومينولوجيا في ميدان الآداب، أن صار المعنى الحقيقي لهذا المفهوم واضحا أكثر. فعبارة "علم الظواهر" تعني -ولا تعني- الكثير. فهي من جهة لا تعني الكثير بالنظر إلى كون عموميتها يمكن أن تجعلها تنطبق على أي بحث عن الحقيقة حتى داخل حقل العلوم التجريبية التي تلجأ إليها في بعض الأحيان. وهي من جهة ثانية تعني الكثير لأنها تفترض منذ الوهلة الأولى طريقة جديدة في فهم طبيعة الظواهر.
كان لشيوع لفظ الفينومينولوجيا في ميدان الآداب، أن صار المعنى الحقيقي لهذا المفهوم واضحا أكثر. فعبارة "علم الظواهر" تعني -ولا تعني- الكثير. فهي من جهة لا تعني الكثير بالنظر إلى كون عموميتها يمكن أن تجعلها تنطبق على أي بحث عن الحقيقة حتى داخل حقل العلوم التجريبية التي تلجأ إليها في بعض الأحيان. وهي من جهة ثانية تعني الكثير لأنها تفترض منذ الوهلة الأولى طريقة جديدة في فهم طبيعة الظواهر.
بداية، ليس من المؤكد أن للاسم في حد ذاته أية أهمية كما يؤكد على ذلك في كثير من الأحيان هوسرل [صاحب المذهب] الذي يعتبر أن المفاهيم الفينومينولوجية هي أولا وقبل كل شيء أدوات مرنة قابلة لإعادة التشكل بهدف الوصول إلى التجربة الحدسية التي تشير إليها. واعتبارا لذلك، فإن البحث في الأصل الاشتقاقي سيكون قليل الفائدة. وبالفعل، فإن "لفظ" الفينومينولوجيا" سابق في الوجود على تعيينه لتيار فلسفي مخصوص. فقد استعمله لامبير Lambert لأول مرة في القرن 18، ثم كانط الذي فكر لحظة ما في توظيفه كعنوان ممكن لكتاب "الاستطيقا المتعالية". وبعد ذلك استعمله هيجل كعنوان، لأكبر برنامج، لأحد أهم وأكبر مؤلفاته وهو "فينومينولوجيا الروح". وكان لا بد من انتظار مطلع القرن 20 مع ظهور مؤلف "أبحاث منطقية" لهوسرل سنة 1901، كي يظهر اللفظ من جديد في ساحة الفلسفة ويتخذ بشكل نهائي دلالته المعاصرة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كثيرين منا يعرفون الدعوى الشهيرة لهوسرل : "العودة إلى الأشياء ذاتها"، لكننا نجد صعوبة كبرى في تحديد دلالتها الفعلية.
وباختصار شديد فإن السمة العامة التي تميز تعاليم هوسرل الفينومينولوجية تتمثل دون شك في اعتبار أن الظواهر ليست ما نظن أنها عليه، أي أن البداهة لا تتواجد حيث ننتظرها. وهذا ما يجعل ضروريا القيام بعمل إعدادي يتمثل في إجلاء حقل التجربة الظاهراتية نفسها. لهذا السبب فإن الفينومينولوجيا هي للوهلة الأولى منطق ظواهر، وذلك بالمعنى الذي تسعى فيه إلى تحديد منطق الظواهر وماهيتها وطريقة فهمها، وأيضا بالمعنى الذي تستخدم فيه منطقا منهجيا مخصوصا وحده الكفيل بالوصول إلى الظاهرة كما هي. وعلى نقيض الفكرة المسبقة الشائعة عن فلسفة ساذجة وغير جدية، تكتفي بجمع الظواهر من أجل استخلاص معناها (أي نوع من الشعر الواصف للعالم المحيط بنا)، فإن الفينومينولوجيا كانت دائما مهتمة بالوسائل الكفيلة بإنجاز التحليل الظاهراتي. لذلك فإنها وظفت باستمرار منهجية جد دقيقة تضمن الوصول إلى الظواهر كيفما كان نوعها، دون التخلي عن اقتضاء البحث عن معقولية شاملة للتجربة.
عن أي حداثة خاصة يتحدث بول ريكور؟ ـ د.زهير الخويلدي
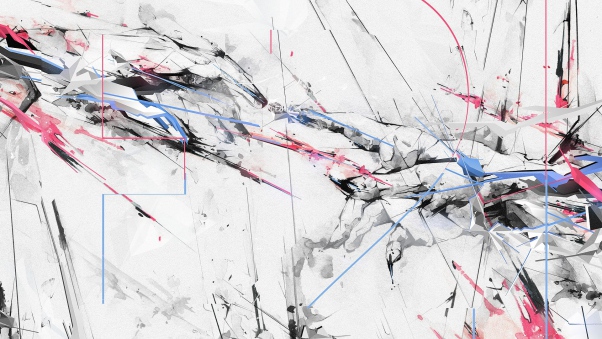 " لقد أخذت الحداثة تقترب من تعريف نفسها عن طريق تعارضها مع نفسها عينها "[1].
" لقد أخذت الحداثة تقترب من تعريف نفسها عن طريق تعارضها مع نفسها عينها "[1].
لقد اتفق غالبية الشُرَّاح على منح بول ريكور لقب "الفيلسوف المسيحي" وهي تسمية كثيرا ما كان يرفضها في محاوراته ويعتذر لكل من يطلقها على فلسفته وذلك لكونه يعتبر نفسه من طينة المفكرين الذين لا يعيرون أي اهتمام وثوقي في قراءاته الدينية بل يحاول قدر الإمكان التمييز بين سجل التفكير التأملي ومجال الإيمان الشخصي ويعرف تفكيره بوصفه فلسفة دون مطلق بل نراه يعول بشدة على هذا التمييز الصارم قصد التخلص من النزعة الألوهية واحترام مفاهيم البنية والاختلاف والغيرية والعلمنة.
لقد وقع اتهام ريكور من قبل بعض المتابعين مثل ( Rainer Rochlitz و Annette Wiework وAlain Badiou ) بأنه يثبت وجهة النظر المسيحية للذات التاريخية ضد وجهة النظر الفلسفية التاريخية التي تنحدر من أصول يهودية وخاصة في مسألة سياسة الذاكرة العادلة. صحيح أن الفلسفة الريكورية هي مجال الحجاج والدقة ولكنها لا تدعي بلورة الحقيقة المطلقة وصحيح أنها عادت في بعض الأحيان إلى مشاكل الإثم والغفران والخطيئة الأصلية والعطوبية والتناهي وهي مفاهيم مشتقة من الفضاء الديني ، إلا أن ذلك لم يكن مراده عقلنة اللاهوت وبناء تأويلية لاهوتية بقدر ما يتعلق الأمر بالكشف عن صعوبات وإمكانيات الصفح وتهيئة سياقات الغفران وتحديد الاستراتيجيات من أجل تحقيق اندماج الذاكرة في محيطها الثقافي والتعامل معها كمطية لبلوغ وضعية إيتيقية متصالحة مع نفسها والتفاعل مع قيم الإيثار والمسؤولية والعيش المشترك.
منطق فلسفة العقل الخالص 3/2 ـ هادي معزوز
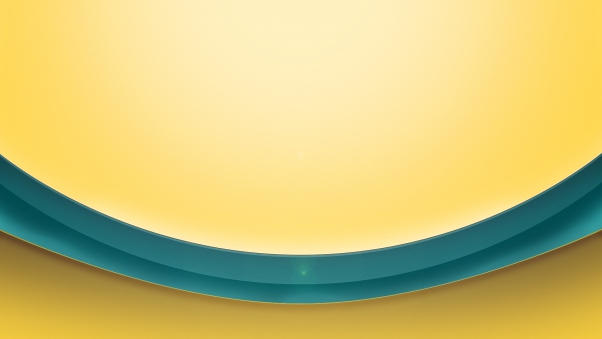 إن الميتافيزيقا كفلسفة، شأنها شأن باقي الأبحاث الفلسفية، يمكن النظر إليها كميتافيزيقات، des métaphysiques وليس كميتافيزيقا واحدة، فإذا كان كبير الفلاسفة ديكارت قد مهد للتأسيس إلى ميتافيزيقا الذات، فإن هيجل كرس ميتافيزيقا الحضور، فيما عمل نيتشه ـ من حيث لا يدري ـ على غرس أولى نباتات ميتافيزيقا إرادة القوة وهلم جرا، لكن أين سنصنف من كل هذا ميتافيزيقا كانط؟ هل سننظر إليها كميتافيزيقا النقد، أم كميتافيزيقا ترنسندنتالية، أم كميتافيزيقا العقل الأخلاقي العملي؟ الحال أن الوقوف عند بنية تفكير العقل الخالص، من شأنها أن توجهنا نحو فهم الميتافيزيقا الكانطية، وأبرز تبلوراتها في هكذا فلسفة.
إن الميتافيزيقا كفلسفة، شأنها شأن باقي الأبحاث الفلسفية، يمكن النظر إليها كميتافيزيقات، des métaphysiques وليس كميتافيزيقا واحدة، فإذا كان كبير الفلاسفة ديكارت قد مهد للتأسيس إلى ميتافيزيقا الذات، فإن هيجل كرس ميتافيزيقا الحضور، فيما عمل نيتشه ـ من حيث لا يدري ـ على غرس أولى نباتات ميتافيزيقا إرادة القوة وهلم جرا، لكن أين سنصنف من كل هذا ميتافيزيقا كانط؟ هل سننظر إليها كميتافيزيقا النقد، أم كميتافيزيقا ترنسندنتالية، أم كميتافيزيقا العقل الأخلاقي العملي؟ الحال أن الوقوف عند بنية تفكير العقل الخالص، من شأنها أن توجهنا نحو فهم الميتافيزيقا الكانطية، وأبرز تبلوراتها في هكذا فلسفة.
تتأسس الميتافيزيقا الكانطية على منطق الثنائيات على غرار جل الميتافيزيقات ابتداءً من أرسطو حتى هايدغر، والحال أن ميتافيزيقا كانط لم تسلم هي الأخرى من هذا المنطق، إذ يعمل فيلسوف كونكسبرغ في عمليته النقدية على التمييز بين عالمين، عالم مادي محسوس، وعالم عقلي خالص، أي عالم التجربة الحسية وعالم الفهم، بيد أن الجديد الذي أضفاه فيلسوفنا يكمن أساسا في رسم تخوم ومعالم كل عالم على حدة، عكس الميتافيزيقات السابقة، والتي انتصرت دوما لعالم على حساب آخر، حيث انتصر ديكارت مثلا للذات على حساب الموضوع، وللفكرة على حساب المادة، بينما انتصرت قبله الميتافيزيقا الأفلاطونية للمثال على حساب المادة، وللأيقونة عل حساب السيمولاكر... هكذا يعمل كانط في بداية نقده على الدعوة إلى تجاوز هذا التمييز الذي عصف بتاريخ الفلسفة، مبرزا أن للمادة أهميتها وأن كل إفراط فيها من شأنه أن يسقطنا في العماء، في حين أن للعقل هو الآخر دوره الرئيسي، بيد أن الإفراط في تبويئه المكانة الأساس في فعل التفلسف يجعل من الفكر شيئا أجوفا.
م.هايدغر : الهرمينوطيقا الوقائعية ـ أيوب كوش
 مارتين هايدِغر Martin Heidegger ، 1889) ـ 1976( مفكر وفيلسوف ألماني معاصر ترك ر مؤلفات كثيرة كان أهمها: «الوجود والزمان» (1927)، «كانْط ومشكلة الميتافيزيقا» (1929)، «ماهية الحقيقة» (1943)، «رسالة في النزعة الإنسانية» (1947)، «ما الميتافيزيقا» (1953). نال مؤلفه «الوجود والزمان» شهرة كبيرة لتطبيقه الرائع للظاهراتية Phénoménologie وتأسيسه لعلم الوجود وقد اعتبر أول من أحيا الانطولوجيا في القرن العشرين، بالإضافة الى اسهامه الكبير في التأسيس الهرمينوطيقي الذي يعد أكبر اسهام فلسفي استقام به حال الهرمينوطيقا.
مارتين هايدِغر Martin Heidegger ، 1889) ـ 1976( مفكر وفيلسوف ألماني معاصر ترك ر مؤلفات كثيرة كان أهمها: «الوجود والزمان» (1927)، «كانْط ومشكلة الميتافيزيقا» (1929)، «ماهية الحقيقة» (1943)، «رسالة في النزعة الإنسانية» (1947)، «ما الميتافيزيقا» (1953). نال مؤلفه «الوجود والزمان» شهرة كبيرة لتطبيقه الرائع للظاهراتية Phénoménologie وتأسيسه لعلم الوجود وقد اعتبر أول من أحيا الانطولوجيا في القرن العشرين، بالإضافة الى اسهامه الكبير في التأسيس الهرمينوطيقي الذي يعد أكبر اسهام فلسفي استقام به حال الهرمينوطيقا.
فهو شأنه شأن ديلتاي في سعيه نحو تأسيس منهج موضوعي في العلوم الإنسانية، لفهم الحياة في ضوء الحياة ذاتها ، والسعي جاهدا الى الارتقاء بالهرمينوطيقا الى مركز التأمل الفلسفي. من خلال كتابه العمدة "الوجود و الزمن" عمل على رد الاعتبار للوجود من منظور تأويلي؛ بمعنى العودة الى الأشياء في بداياتها الأولى .
لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن هايدغر لم يتكئ على جهود هوسرل الفينومينولوجية (...)،فالفينومينولوجيا الهوسرلية بما استحدثته من آليات اجرائية لإقرار الموضوعية، وتأسيس منهج فلسفي لا يرضى بغير الفصل الإجرائي بين الذات و الموضوع وبين الذات فردانية ومتعالية ،تجسيدا لفكرة الرد الماهوي وتعليق الأفكار ،وإشاعة مقولة العودة الى الأشياء ذاتها بغية الوصول الى الحقيقة ( المعرفة / النص) تأويلا و فهما كما أنها لم توجد إلا في تلك اللحظة ،كانت بذلك فتحا فلسفيا جديدا اتاح للهرمينوطيقا إمكانية بناء نظرية في التأويل تقوم على فهم النصوص / الظواهر فهما مختلفا عن التصورات الذهنية، وسابقا عليها في الآن. هذه الإجراءات المنهجية كانت بمثابة الأساس الذي أخد بيد هايدغر ليبني صرح مشروعه الفينومينولوجي، لا على سبيل المطابقة أو المماثلة ،بل تجاوزا واختلافا وتأويلا غيريا. (1)
بيير بورديو فيلسوفا إنسانيا شرسا ـ ديرار عبد السلام
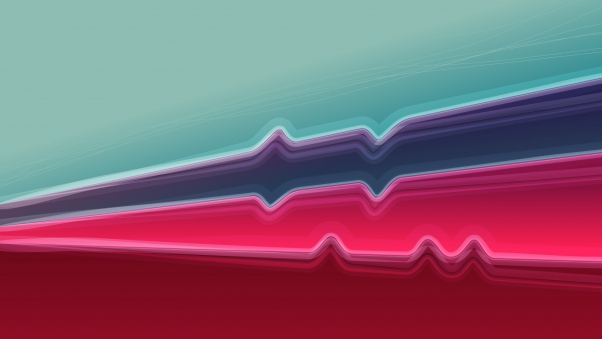 ا- توضيحان أساسيان و قناعة:
ا- توضيحان أساسيان و قناعة:
أ- التوضيح الأول:
يتعلق الأمر بالالتباس الذي قد يستشعره البعض أمام تصنيفنا لبورديو فيلسوفا في الوقت الذي اشتهر فيه سوسيولوجيا لامعا. وهنا نشير إلى الهزة العنيفة التي عرفتها الفلسفة في القرن العشرين و بالضبط بعد سارتر، إذ بات من العسير التمييز بين الفيلسوف و المؤرخ و الناقد الأدبي و الأنتروبولوجي و عالم النفس و السوسيولوجي... و إلا ففي أية خانة نضع ميشيل فوكو و جيل دولوز و فيليكس غاتاري و رولان بارت و بيير بورديو... و معظم الفلاسفة المعاصرين...إننا نجدهم في كل الحقول السابقة.
ب- التوضيح الثاني:
يتعلق الأمر بالمعنى الذي نعطيه ل"الفلسفة الإنسانية" ضمن هذا العرض. فهي فلسفة عقلانية و موقف تقدمي في الحياة (progressive lifstance). بعيدا عن المافوق- طبيعي، تعلن قدرتنا نحن معشر البشر على سلك حياة أخلاقية ذات معنى، حياة قادرة على إضافة خير للإنسانية.
وبإعلانها كرامة كل كائن إنساني قيمة قصوى، فإن النزعة الإنسانية تأخذ على عاتقها إعلان الحريات الفردية و المسؤولية الاجتماعية، بل و الكونية إلى أقصى درجة ممكنة. إنها بهذا
المعنى عمل من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية...و الحب...و الخير و الجمال...، و كل ما من شانه أن يرفع من منسوب إنسانية الإنسان.
ميتافيزيقا الفلسفة الماركسية ـ هادي معزوز
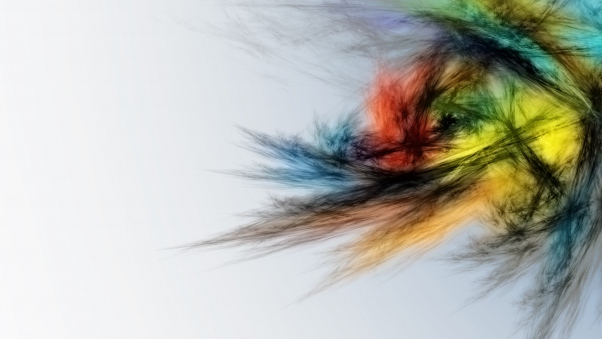 إذا حدث أن قلت لماركسي أنك ميتافيزيقي، وأن الميتافيزيقا أساس كل تفكير مهما كانت نوعيته، من العلوم إلى الطب مرورا بالفلسفة والفن... فإنه سينظر إليك بعين الارتياب، وسيصنفك ضمن التيار المثالي الذي أرست دعائمه فلسفة أرسطو إلى حدود المثالية الألمانية، وعندما ستطرح عليه علة هذا التصنيف، سيجيبك بطريقة ميكانيكية كون أن الصراع الفلسفي منذ مدة طويلة، هو صراع بين المادية والمثالية، بين من يعطي الأسبقية للفكر وبين من يعتبر الواقع أساس كل تفكير وإدراك، بين العقل والمادة، وبين الواقع والروح "l’esprit" وأن الحقيقي في هاته المعادلة الطويلة، هو الانتصار لكل ما هو مادي، أي انتصار للواقع أولا، بما أننا نوجد بداية، حيث تعمل آلة الواقع على تحديد وصنع وعينا، ثم بعد ذلك نفكر انطلاقا من واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، أما المثالية فإنها ستقف معدومة أمام هذا القول، لأنه يستحيل أن تُصنع قبليا كي توجد، كلا إذ ما تؤخذ هذه الأمور بهاته البساطة الساذجة، أي أن حقيقة الأمر هي أننا نوجد بعديا "a postériori"
إذا حدث أن قلت لماركسي أنك ميتافيزيقي، وأن الميتافيزيقا أساس كل تفكير مهما كانت نوعيته، من العلوم إلى الطب مرورا بالفلسفة والفن... فإنه سينظر إليك بعين الارتياب، وسيصنفك ضمن التيار المثالي الذي أرست دعائمه فلسفة أرسطو إلى حدود المثالية الألمانية، وعندما ستطرح عليه علة هذا التصنيف، سيجيبك بطريقة ميكانيكية كون أن الصراع الفلسفي منذ مدة طويلة، هو صراع بين المادية والمثالية، بين من يعطي الأسبقية للفكر وبين من يعتبر الواقع أساس كل تفكير وإدراك، بين العقل والمادة، وبين الواقع والروح "l’esprit" وأن الحقيقي في هاته المعادلة الطويلة، هو الانتصار لكل ما هو مادي، أي انتصار للواقع أولا، بما أننا نوجد بداية، حيث تعمل آلة الواقع على تحديد وصنع وعينا، ثم بعد ذلك نفكر انطلاقا من واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، أما المثالية فإنها ستقف معدومة أمام هذا القول، لأنه يستحيل أن تُصنع قبليا كي توجد، كلا إذ ما تؤخذ هذه الأمور بهاته البساطة الساذجة، أي أن حقيقة الأمر هي أننا نوجد بعديا "a postériori"
والحاصل مما تقدم في هذا الحكم، هو أن الميتافيزيقا تفكر قبليا، وبما أنها على هاته الشاكلة فإنها مثالية بطبيعة الحال، بل إن هناك مثاليات مادية أيضا أرست دعائمها فلسفة فويرباخ الساذجة، حيث كل الأشياء تلبس معطفا ماديا ثقيلا إلى درجة الإفراط...
الدفاتر السوداء : هايدغر الفيلسوف الخائب ـ ترجمة : حمودة إسماعيلي
 نُشرت المؤلفات الأربعة الخاصة بسلسلة "الدفاتر السوداء" لمارتن هايدغر، بين سنوات 2013 و2015 بألمانيا، محدثةً ضجة بجل أرجاء العالم، طالما أنها أتت لتؤكد بأن الفيلسوف الشهير كان متحمسا لصعود النازية، مبرزة كذلك بعض السمات المميزة لمعاداة السامية. يظهر بإسبانيا حاليا الجزء الأول من هذه السلسلة، مذكرات الفيلسوف التي تضم العديد من الأفكار المتنوعة، والمدوَّنة بين سنوات 1931 و1938.
نُشرت المؤلفات الأربعة الخاصة بسلسلة "الدفاتر السوداء" لمارتن هايدغر، بين سنوات 2013 و2015 بألمانيا، محدثةً ضجة بجل أرجاء العالم، طالما أنها أتت لتؤكد بأن الفيلسوف الشهير كان متحمسا لصعود النازية، مبرزة كذلك بعض السمات المميزة لمعاداة السامية. يظهر بإسبانيا حاليا الجزء الأول من هذه السلسلة، مذكرات الفيلسوف التي تضم العديد من الأفكار المتنوعة، والمدوَّنة بين سنوات 1931 و1938.
وبالرغم من أن جزءً مهمّا منها يتعلق بمسائل فلسفية، إلا أن العديد من المقاطع تُلمّح للظرف السياسي الألماني : الانتصار المشهود للاشتراكية الوطنية، الحدث الذي أشاد به كذلك سنة 1933، عندما كان عميدا لجامعة فرايبورغ، ظاهرا بشاربه الهتلري والصليب المعقوف بصدر سترته، الموقف الذي جعله شبيها نوعا ما بالنازيين.
في ظل الضجة الإعلامية لهذه الدفاتر السوداء، يميل الاعتقاد إلى أن تلك الصفحات تشيد بهتلر وتسيء لليهود، إطلاقا، فملاحظات الفيلسوف غير صريحة، وماكرة بدرجة كبيرة. فالكتاب الأول من السلسة لا يكشف سوى عن إلتزام تمهيدي تجاه النازيين، بعدها، إزدراء واضح للوضع "الروحي" الألماني. ولم يدلي بأي كلمة بخصوص اليهود.
بشكل عام، يبدو هايدغر انطلاقا من ملاحظاته كمتحمس ل"الفسلفة"، الرؤية المقابلة للعلم ـ "لا فِكر للعلم"، كتب يقول ـ هايدغر كشخص يفهم التفلسف باعتباره طرحا لأسئلة جذرية وجريئة أكثر من كونه مجرد إجابات : "كل سؤال متعة، كل إجابة انحدار". كان السؤال الجوهري لدى الفيلسوف العظيم الذي طالما أبهر طلابه (كما طالباته، على سبيل الذكر عاشقته الشابة حنة أرندت) هو "ماهية الكينونة؟ لماذا هناك وجود بدلا من لاشيء؟". باختصار، قام "الساحر" بتفكيك المقولات المتداولة ليقول ما انفلت من القول.
في الواقع، نرى أن المفكر الفريد من نوعه، وهو في نفس الوقت إنسان، قد ارتكب خطأ كبيراً بالتزامه مع النازية، معتقدا أن صعود هذه الحركة سيأتي بالتغيير الأفضل لمصير ألمانيا، ثورة جذرية للروح الألمانية لم تحدث كما كان يتوقع. معتقدا أن التوحد الألماني بقيادة هتلر، سيلهم الألمان للسعي نحو الحقيقة والكينونة، فحيّا الصعود النازي ك"مبدأ عظيم"؛ آملاً بأن الفلسفة ستستفيد من جراء ذلك، بهيمنتها الثقافية على الحياة الاجتماعية للألمان، كما حدث ب(مثالية) المجتمع الإغريقي القديم. والفلاسفة، الذين غالبا ما يعيشون منعزلين (هايدغر كان كذلك بدرجة كبيرة)، سيخرجون من عزلتهم، وبصرف النظر عن "أناهم الصغير"، سيمشون مجتمعين مع الرجال الآخرين.
منطق فلسفة العقل الخالص 3/1 ـ هادي معزوز
 إن فلسفة العقل الخالص، أو الفلسفة النقدية والتي يمثلها فيلسوف كونكسبرغ كانط، ليست إلا تلك القراءة المعاكسة لمنطق التفكير الفلسفي خلال عصر الأنوار، والذي كان إما مصنفا تحت تأثير التقليد القاري الذي يعتبر كل من ديكارت، لايبنتز، باسكال، واسبينوزا رواده الأوائل، أو عن طريق هيمنة التقليد الأنغلوساكسوني والذي أرسى دعائمه فلاسفة كبار من قبيل بيكون، هيوم، لوك، والأسقف بيركلي وإن غامرنا في تصنيف هذا الأخير ضمن دائرتهم.
إن فلسفة العقل الخالص، أو الفلسفة النقدية والتي يمثلها فيلسوف كونكسبرغ كانط، ليست إلا تلك القراءة المعاكسة لمنطق التفكير الفلسفي خلال عصر الأنوار، والذي كان إما مصنفا تحت تأثير التقليد القاري الذي يعتبر كل من ديكارت، لايبنتز، باسكال، واسبينوزا رواده الأوائل، أو عن طريق هيمنة التقليد الأنغلوساكسوني والذي أرسى دعائمه فلاسفة كبار من قبيل بيكون، هيوم، لوك، والأسقف بيركلي وإن غامرنا في تصنيف هذا الأخير ضمن دائرتهم.
عندما نعود إلى تاريخ الفلسفة سنجد أن هذا الصراع بين العقل والتجربة الحسية لم يكن وليد لحظة الأزمنة الحديثة، بقدر ما أن جذوره كانت ضاربة مند اليونان خاصة فلسفة كل من أفلاطون المنتصرة للعقل الرياضي، وفلسفة أرسطو المدعومة من طرف العقل الفيزيائي، لهذا ربما لن ننشده عندما نرى أفلاطون قد منع كل من ليس رياضيا من الدخول إلى أكاديميته، عكس أرسطو الذي كان الفيزياء physis من بين الاسئلة الكبرى التي شكلت نسقه الفلسفي إضافة إلى ما بعد الفيزياء، والحال أن العصور الوسطى أو قل فلسفة العصور الوسطى لم تسلم هي الأخرى من صراع خفي بين العقل والتجربة، بين الفكرة والشيء، وبين المثال والواقع، تمثل أساسا في ذلك الحوار الشهير بين مدرستين الأولى اسمية بناها رجل يدعى القديس أوغسطين، والثانية واقعية أسسها القديس طوما الأكويني، الأولى حاولت أن تبيئ معالم المسيحية والفلسفية الأفلاطونية، في حين أن الثانية جعلت من المدرسة الأرسطية منطلقها الأول، وبين هذا وذاك سطع نجم فيلسوف ألماني والذي ليس إلا إيمانويل كانط الذي وإن أبدى اهتماما كبيرا بالفلسفة الديكارتية في بداياته حياته، انعرج عنها بعدئذ خلال تأسيسه لمبادئ العقل الخالص القائم على أسس نقدية تفكر في كيفية التفكير.










