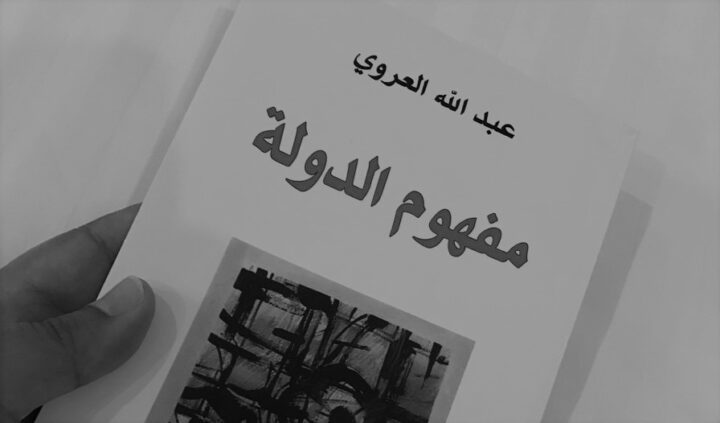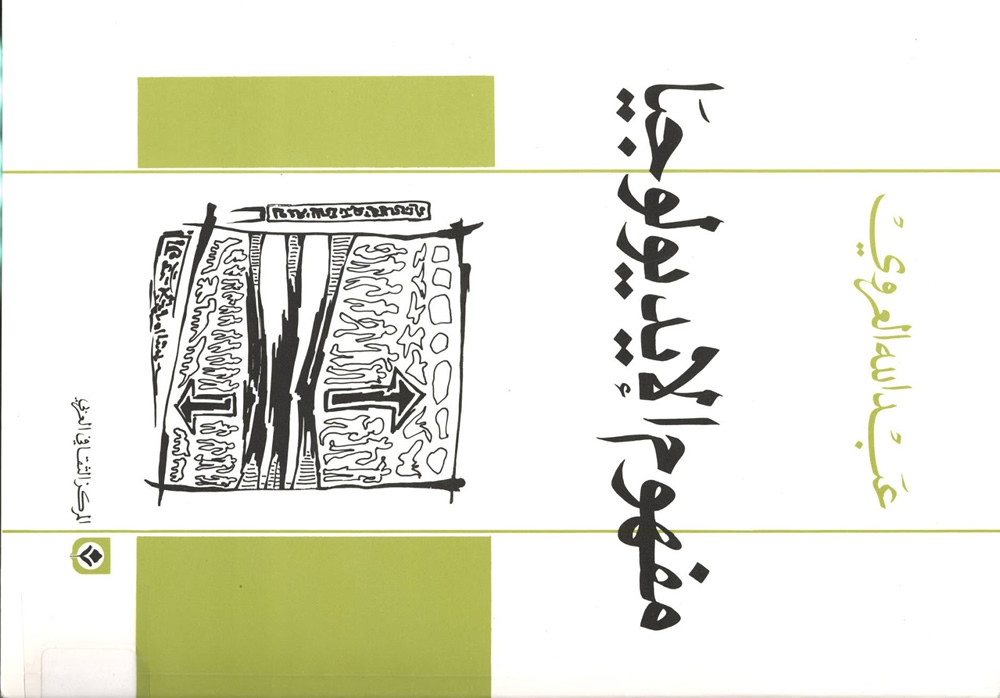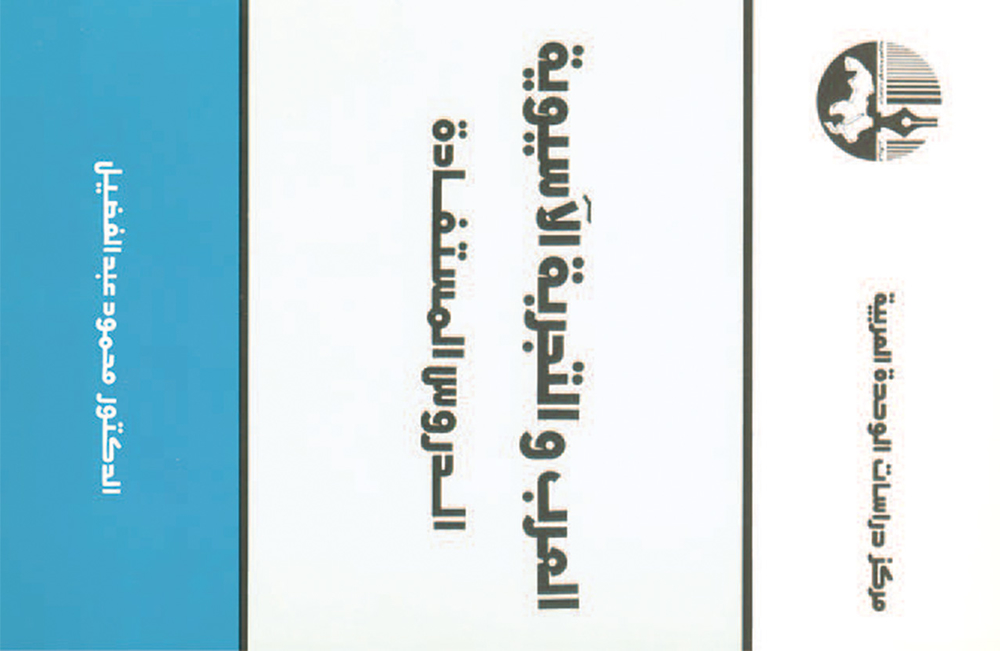البروباغاندا propagande والدعاية من الأسلحة الرئيسية في كل الحروب عبر التاريخ. الهزيمة والفوز رهينان بمدى استعداد كل طرف وفاعلية وسائله واستراتيجياته وموازين القوة .. لإضعاف الخصم وهزيمته.
البروباغاندا في الحروب القديمة كانت تستخدم الوسائل الدعائية الكلاسيكية من نشر الإشاعات، وإطلاق الآقاويل، والأخبار الذي يصعب تكذيبها أو تصديقها، ففي فترة الأزمات تكثر الإشاعات والأكاذيب والتضليل.. ظل مبدأ الدعاية هو نفسه في الحروب الحديثة والمعاصرة، شيطنة الطرف الأخر - العدو، وبث الرعب في قلبه والتقليل من شأنه، وخندقته، وقلب الحقائق.. وهو ما يعرف الآن بالحرب النفسية. ويتم استغلال خلفيات خطابية معينة ذات مرجعيات إديولوجية مختلفة: دينية، تاريخية، سياسية، عرقية.. وكلما كانت وسائل الدعاية مبتكرة وقوية لدى طرف معين، كلما كسب معارك أكثر. ولعل الحرب الباردة بين المعسكرين - الشيوعي والرأسمالي، كانت أساسا حرب البروباغاندا، حيث استطاعت الآلة الدعائية والمخابراتية الأمريكية التفوق في النهاية، مساهمة في انهيار الإتحاد السوفيتي وهو قوة عالمية لا يستهان بها، ورغم تفوقه العسكري الهائل، إلا أن ذلك لم يشفع له لكي يصمد أمام التفوق التكنولوجي النوعي للولايات المتحدة التي نجحت في الترويج للنموذج الأمريكي وقيم النظام العالمي الجديد والعولمة.
قراءة في كتاب "مفهوم الدولة" لعبد الله العروي - صلاح الدين ياسين
كتاب من تأليف المفكر المغربي عبد الله العروي، صدرت طبعته الأولى عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء في مطلع الثمانينيات، يندرج هذا العمل ضمن سلسلة من الكتب التي ألفها العروي حول مفاهيم متعددة (الحرية، العقل، التاريخ)، إذ انصرف فيه إلى تناول مفهوم الدولة على نحو لا يخلو من عمق ورزانة في المضمون الفكري، وتنويع معهود بالنسبة لطرق البحث والمقاربات المنهجية المعتمدة فيه.
أولا: نظرية الدولة في الفكر الغربي الحديث
لقد دشن المؤلف بحثه بالغوص في النظرية الإيجابية بشأن الدولة في التفكير الغربي، ممثلا لها بالفيلسوف الألماني هيغل (1770 – 1831) الذي أبدع تفكيرا متميزا حول الدولة، إذ يشدد على وجوب خضوع الفرد والمجتمع المدني باعتباره فضاء الاقتصاد والحياة المادية للمبدأ العام للدولة وقوانينها، الأمر الذي يناقض المفهوم الليبرالي التقليدي للدولة كما عبر عنه مثلا جون لوك بوصفها مجرد وسيلة لتأمين السوق وحماية حق الملكية الفردية، بحيث وضع هيغل الأخلاق ضمن دائرة الدولة، ولم يحصرها في الضمير الفردي، جاعلا الدولة فوق الفرد والمجتمع المدني.
وبعيدا عن النقد الأخلاقي الليبرالي لهيغل الذي وضع تصورا لدولة مطلقة استبدادية من واجبها استخدام القوة لتضمن الأخلاق وتقمع النوازع الشريرة للأفراد، ذهب البعض إلى أن نظرية هيغل ليست تجريدية وإنما هي واقعية تعبر عن جوهر وحقيقة الدولة المطلقة القائمة – وهو الطرح الذي يتبناه المؤلف - وبالتالي فهو لم يسبح في فلك التفكير الطوباوي حول الدولة.
وصولا إلى النظرية النقدية للدولة عند كارل ماركس (1818 – 1883)، والذي انطلق من نقد واقعي للدولة البرجوازية القائمة لارتباطها بمؤسسة الملكية (بكسر الميم) والصراع الطبقي، واضعا كهدف نهائي لنظريته إلغاء الدولة في المجتمع الشيوعي حيث تنعدم الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. لكنه في الوقت عينه يقر بأن هذا التحول نحو القضاء على الدولة والملكية يستلزم وقتا طويلا، وبذلك استحق أن يُطلق على تفكيره وصف نظرية واقعية رغم ما قد يلحظه البعض من نزوع طوباوي.
هل الراهن العربي مؤهل لدعم فلسطين؟ - د. حسن العاصي
أظهرت حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الكيان الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة ـ من ضمن ما أظهرت ـ أن تحرير فلسطين، هذا الشعار اللغوي الفخم، لم يكن في الحقيقة يوماً على جدول أعمال القادة العرب - باستثناءات قليلة. ولم تكن يوماً فلسطين قضية العرب الأولى، إلا على الورق، في اجتماعات الغرف المغلقة، وفي الخطب النارية فقط.
فغزة التي تُذبح وتستغيث فلا تُغاث، والأقصى الذي يصرخ العون فما من سامع، والقدس التي تتوق للنجدة فلا مُلبي، والفلسطيني الصامد الصابر المعاند الثابت يترك اليوم وحيداً بلا عون ولا مدد من الأشقاء العرب ـ الرسميين ـ الذين بات بعضهم يتبنى الرواية الصهيونية، وبعضهم أصبح يعتبر فلسطين وشعبها وقضيتها عبئاً يجب التخلص منه.
الأخطر أن معظم الدول العربية باتت تتعمد تهميش القضية الفلسطينية، بل والتآمر عليها. وتتجاهل حقيقة أن حالة الصراع الفلسطيني الصهيوني لا يمكن بترها وعزلها عن المحيط العربي والعمق الإقليمي، فكل العواصم العربية هي في قائمة المصالح والاستهداف الصهيوني.
والمثير للشفقة قيام بعض العرب بترتيب أولوياتهم، يقول لك هذا النظام أو ذاك "نحن أولاً" لتبرير عجزهم عن نصرة فلسطين. ثم اهتدوا إلى طريق الخلاص الذي يبعد فلسطين عنهم تماماً، فزجوا بشعوبهم في صراعات داخلية ومعارك جانبية فيما بينهم، أحدثت الفوضى وقسمت المقسوم وعمقت الحالة القطرية. وفلسطين المحتلة على مرمى حجر من الجيوش العربية التي كدّست أسلحتها في المخازن.
انحدار مرعب
أخفقت معظم الأنظمة العربية الاستبدادية في تحقيق شعاراتها المرتبطة بالوحدة والاشتراكية والاستقلال الوطني والحريات، وعجزت عن إحداث أية تنمية وتطوير في البنى الرئيسية، ولم تتمكن من إحراز مهام التقدم الاجتماعي. لكن هذه الأنظمة حققت نجاحاً لافتاً في بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تخصصت وأبدعت في قمع وقهر المواطنين وسحقهم، وحلت كافة مؤسسات المجتمع المدني، وأغلقت أي إمكانية لتطور الوعي السياسي للناس، وقوّضت مفهوم المواطنة، وقضت على الحوار المجتمعي، وشجعت الولاءات العرقية والإثنية والعشائرية والمناطقية، ونشرت الفساد في مفاصل الدولة والمجتمع، وسمحت للمفسدين أن يسمنوا ويتغولوا، وقامت بإعلاء المصلحة الخاصة على حساب قيم المنفعة العامة.
أقدمت هذه الأنظمة وبطانتها على تسخير مؤسسات الدولة وخيرات الوطن لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح الاقرباء والموالين، وفككت الروابط الوطنية والاجتماعية والأخلاقية بين مكونات المجتمع، مما أدى إلى ظهور النزعات العرقية والطائفية والقبلية والمذهبية والعشائرية البغيضة، التي فتتت الأوطان وحولتها إلى إمارات وقبائل وطوائف.
الأخطر قيام هذه الأنظمة بتليين وتطويع معظم المثقفين والمفكرين وتدجينهم، ومن لم تتمكن منهم إما زجت بهم في السجون لسنوات طويلة، وإما أنهم تمكنوا من الهرب خارج أوطانهم إلى بلدان غربية حيث حريتهم، وإما أنهم تركوا الشأن الثقافي وانعزلوا عن الحياة العامة. لم تستثني هذه الأنظمة حتى رجال الدين والمشايخ الذين قام بعضهم بإجراء تعديلات على معتقداته لتتوافق مع خطاب المرحلة.
قراءة في كتاب "مفهوم الإيديولوجيا" لمؤلفه عبد الله العروي - صلاح الدين ياسين
كتاب من تأليف المفكر المغربي عبد الله العروي، صدرت طبعته الثامنة عن المركز الثقافي العربي في العام 2012. يتناول الكاتب بالدرس والتحليل مفهوم الأيديولوجيا، وقد توسل العروي بالمنهج التاريخي في هذه الدراسة، إذ ذهب إلى أن مفهوم الأيديولوجيا نشأ في عصر الحداثة (القرن 19)، وبالتالي لا يسعنا فصله عن الفكر النقدي المتصف بالنسبية. كما تحيل الأيديولوجيا في معناها اللغوي الأصلي (الفرنسي) إلى علم الأفكار، الذي يدرس آلية تكوين الأفكار في الذهن الإنساني، إلا أن الألمان ما لبثوا أن استعاروا المفهوم وضمنوه معنى آخر، لذا يعتبر الكاتب أن الأيديولوجيا هي كلمة دخيلة على مختلف اللغات الحية، الشيء الذي يفسر صعوبة ترجمتها إلى اللسان العربي، ولهذا اقترح تعريبها مستخدما لفظ "أدلوجة".
أولا: تعريف الأيديولوجيا كقناع
يضيء صاحب الكتاب على التحول الذي طرأ على استعمال المفهوم في مراحل نشأته الأولى، عبر الانتقال من التحديد الأصلي (علم الأفكار) إلى نظرة قدحية للأيديولوجيا بحسبانها جملة الأوهام التي تمنع العقل من إدراك الحقيقة. ولعل الفيلسوف الألماني كارل ماركس (1818- 1883) هو النموذج الصارخ لهذا التمثل الفكري، إذ نظر إلى الأيديولوجيا من حيث هي وعي زائف ومضلل، مركزا نقده على الأيديولوجيا الليبرالية باعتبارها محض ستار يُخفي بين طياته مصالح الطبقة المهيمنة (الطبقة البرجوازية).
كما يذهب فريدريك نيتشه (1844 – 1900) إلى أن الأفكار تعبر في جوهرها عن مصالح لا عن حقائق، فالغريزة هي التي تسوس الفكر لا العقل المجرد، وأن الأيديولوجيا بمثابة قناع يخفي وراءه حقد وغل المستضعفين على السادة المتفوقين. وصولا إلى الاجتماعيين الألمان الذين استعاروا طرح ماركس مع توسيع نطاقه ليشمل نقد الماركسية ذاتها، إذ اعتبروا أن جميع الأيديولوجيات تعبر عن مصالح طبقة أو فئة اجتماعية معينة.
الاستيعاب أم الفصل؟ المهاجرون المهمشون - د. حسن العاصي
يتم تعريف التهميش غالباً على أنه عمليات تفاعلية تراكمية تساهم/ ويتم من خلالها دفع الأفراد أو المجموعات إلى هامش المجموعة، أو خارج المجموعة/السياق، نحو الحواف الخارجية للمجتمع بعيداً عن المركز. وقد يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما لا يحصل المهاجرون على وظيفة دائمة، أو عندما يترك الشباب المدارس، أو عندما لا تتمكن الأمهات العازبات من السماح لأطفالهن بالمشاركة في نفس الأنشطة الترفيهية مثل الأطفال الآخرين.
فالأفراد أو الجماعات المهمشة ليسوا موجودين بالكامل خارج المجتمع ولا في داخله بشكل كامل. ويجدون أنفسهم في منطقة رمادية بين الإدماج والاستبعاد، وغالباً ما تتاح لهم فرص أقل للمشاركة في المجتمع مقارنة بغيرهم.
وخلافاً لمفهوم الإقصاء، فإن مفهوم التهميش يعني ضمناً أن الأمر لا يزال يتعلق بمشاركة جزئية، وإن كانت هامشية، في سياق/مجموعة. يمكن فهم الهامشي بالطريقة التي لا يستطيع بها المرء المشاركة بشكل كامل. يشمل التهميش حقيقة أن تأثير الفرد محدود للغاية أو معدوم على الظروف المهمة في حياته.
أشكال التهميش
التهميش ظاهرة ذات أبعاد مختلفة. يشارك المرء الطبيعي في المجتمع من خلال عدة مجالات مختلفة. على سبيل المثال: يذهب إلى المدرسة، ويشارك في الحياة العملية، ويمارس أنشطة ترفيهية واجتماعية مختلفة، ويشارك في المنظمات ومع الأصدقاء.
اُلشِّقَاقُ المَحْتُومُ بَيْنَ اُلْحَاكِمِ واُلْمَحْكُومِ - لطفي خير الله
) مُقَدِّمَةٌ :
إِنَّ اُلنَّاظِرَ فِي عَلاَقَةِ اُلْحَاكِمِ وَ اُلْمَحْكُومِ قَدْ يَتَبَيَّنُ بِأَنَّ اُلْخِلاَفَ بَيْنَهُمَا مُقِيمٌ، والوِفَاقَ نَادِرٌ عَزِيزٌ. وَاُلتَّفْسِيرُ اُلظَّاهِرُ لِذَلِكَ أَنَّ اُلرَّاعِيَ إِذَا مَا اسْتَبَدَّ، أَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِاُلْعَدْلِ، أَوْ اتَّخَذَ بِطَانَةَ سُوءٍ تَسْتَأْثِرُ بِخَيْرَاتِ اُلْبِلاَدِ وَاُلْعِبَادِ، أَوْ وَعَدَ فَلَمْ يَفِ، أَوْ كَانَ كَاذِبًا، فَهَلُمَّ جَرًّا، سَخَطَتْ عَلَيْهِ اُلرَّعِيَّةُ، وقد تُقَابِلُهُ بِاُلْعِصْيَانِ وَاُلْخَلْعِ. إِذًا، فَعِنْدَ هَذَا اُلتَّفْسِيرِ إِنَّمَا اُلْخِلاَفُ بَيْنَ اُلْحَاكِمِ وَاُلْمَحْكُومِ لِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ، لَوْ زَالَتْ، عَادَتِ اُلْصِّلَةُ بَيْنَهُمَا إِلَى الأَصْلِ، أَعْنِي الوِفَاقَ وَاُلرِّضَا. وَإِنْ لَمْ نَرُمْ ظَاهِرَ الأَمْرِ، وابْتَغَيْنَا اُلتَّدْقِيقَ، وَالتَّمْحِيصَ، فَسَنَجِدُ اُلْوَصْفَ عَلَى ضِدٍّ مِنْ ذَلِكَ إِطْلاَقًا: عَلَى مَعْنَى أَنَّ اُلرِّضَا مِنَ اُلرَّعِيَّةِ عَلَى رَاعِيهَا حَالٌ غَرِيبَةٌ، بَلْ إِنَّ حَقِيقَةَ أَمْرِهَا مَعَهُ إِنَّمَا هُوَ السُّخْطُ وَالشِّقَاقُ يَدَ اُلدَّهْرِ. لِأَجْلِ هَذَا فَمَا أَنَا بِذِي غُلُوِّ لَوْ جَزَمْتُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَكُونُ خَصْمٌ لِحَاكِمٍ، أَعْنِي مَحْكُومًا، قَدْ حَلَّ مَحَلَّهُ، أُرِيدُ اُلْحَاكِمَ، إِلاَّ وَخَامَرَ بَاطِنَهُ نَوْعُ نَدَامَةٍ لِمَا كَانَ يَعِيبُهُ عَلَى سَلَفِهِ مِنْ مَعْنًى لَمَّا قَابَلَهُ بِمَعْنَاهُ إِذْ هُوَ مَحْكُومٌ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ جُورٌ وَبَغْيٌ، وَالآنَ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ : بَلْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ حَقِيقَةِ الحُكْمِ وَطَبِيعَتِهِ، وَفِي نَفْسِهِ تَوَجُّسٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَا طَعَنَ بِهِ عَلَى اُلْحَاكِمِ الأَوَّلِ، جَهْلٌ مِنْهُ وَعِنَادٌ وَتَجَنٍّ. كَذَلِكَ يُرَى دَائِمًا اُلْمَحْكُومَ الخَصْمَ، إِذَا مَا ارْتَفَعَ في اُلْحُكْمِ، عَجِلَتِ اُلعَامَّةُ إِلَى جَفَائِهِ وَسُخْطِهَا عَلَيْهِ، بَعْدَ مَا كَانَتْ تَوَدُّهُ كَثِيرًا، وَتُطِيلُ الاِسْتِبْشَارَ بِهِ.
2) عَلاَقَةُ الحَاكِمِ بِاُلْمَحْكُومِ هِيَ عَلاَقَةُ اُلْكُلِّ بِاُلْجُزْءِ
أَمَّا بَيَانُنَا لِمَا قَرَّرْنَا مِنْ أَنَّ أَصْلَ الصِّلَةِ بَيْنَ اُلْحَاكِمِ وَاُلْمَحْكُومِ أَنَّهَا شِقَاقٌ، وَجَفَاءٌ، وَغَيْرُهُمَا عَارِضٌ فَقَطْ، فَبِقَوْلِنَا إِنَّ حَقِيقَةَ اُلْعَلاَقَةِ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هِيَ عَلَى صُورَةِ اُلْعَلاَقَةِ بَيْنَ اُلْكُلِّ وَاُلْجُزْءِ. ونَأْخُذُ مِثَالاً لِذَلِكَ : الأَصْبَاغُ، وَهَذِهِ أَجْزَاءٌ، وَرَسْمٌ مَا، كَشَجَرَةٍ، وَهْيَ كُلٌّ حَاصِلٌ بِتَأْلِيفٍ لِلْأَجْزَاءِ اُلصِّبْغِيَّةِ. فَاُلشَّجَرَةُ اُلْمَرْسُومَةُ إِذْ هِيَ كُلٌّ مِنَ الأَصْبَاغِ عَلَى تَرْتِيبٍ مَا، وَلَيْسَ عَلَى أَيِّ تَرْتِيبٍ، فَلأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ طَبِيعِيٍّ، اِحْتَاجَتْ إِلَى فَاعِلٍ مِنْ خَارِجٍ يُسَمَّى رَسَّامًا، شَأْنُهُ أن يُعَالِجَ الأجزَاءَ الصِّبْغِيَّةَ، ويَنْظُرَ إِلَيْهَا لاَ لِذَاتِهَا، بَلْ مِنْ حَيْثُ هِيَ دَاخِلَةٌ في تَأْلِيفِ الكُلِّ الَّذِي هُوَ اُلشَّجَرَةُ. إِذًا فَاُلْمَوْضُوعُ الأَوَّلُ لِفِعْلِ الرَّسَّامِ إِنَّمَا هُوَ اُلكُلُّ، وَوُجُودُ الأَجْزَاءِ عِنْدَهُ، وَ مُعَامَلَتُهُ إِيَّاهَا إِنَّمَا هِيَ تَابِعَةٌ لِصُورَةِ اُلْمَوْضُوعِ، وَلَيْسَتْ هِيَ، أَعْنِي الأَجْزَاءَ، بِمُقْصُودَةٍ قَصْدًا أَوَّلاً. فَلَوْ تَوَهَّمْنَا أَنَّ اُلأَصْبَاغَ ذَاتُ عَقْلٍ شَاعِرَةٌ بِذَاتِهَا، فَرُبَّمَا قَابَلَتْ إِرَادَةَ الرَسَّامِ بِإِرَادَتِهَا. فَالرَسَّامُ إِنَّمَا عَيْنُهُ عَلَى اُلْكُلِّ، وَالأزْرَقُ الجُزْئِيُّ مَثَلاً، إِنَّمَا تَكُونُ عَيْنُهُ حِينَئِذٍ عَلَى ذَاتِهِ. فَمَا يُدْرِكُهُ الصِّبْغُ اُلْجُزْئِيُّ الأزْرَقُ، غَيْرُ مَا يُدْرِكُهُ أَلْبَتَّةَ، مُدْرِكُ الكُلِّ، الرَّسَّامَ*. وتَحْصِيلُ اُلْكُلِّ، كَصُورَةِ اُلشَّجَرَةِ تَعْلُو زُرْقَةَ السَّمَاءِ، تَقْتَضِي أَنْ يُسَلِّطَ اُلرَّسَّامُ جُزْءً مِنَ اُلأَخْضَرِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الأَزْرَقِ. وَهَاهُنَا فَقَـدْ
تراجع التسامح الديني لدى الأوربيين... الدنمرك وألمانيا نموذجاً - د. حسن العاصي
يتعرض الناس في جميع أنحاء العالم للتمييز والمضايقة والاضطهاد لأنهم يعتنقون ديناً معيناً، أو لأنهم لا دينيون. في أجزاء كبيرة من هذا العالم يعيش بعض السكان في بلدان تتعرض فيها الحرية الدينية لضغوط شديدة ومتواترة. ولم يحدث ذلك أبداً في الماضي حيث الناس أكثر هروباً بسبب إيمانهم مما هم عليه اليوم. هذه التطورات جعلت قضية الحرية الدينية على رأس جدول أعمال السياسيين والتنمويين في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.
الحكومة الدنماركية كانت قد أعلنت عبر مؤسساتها الحكومية أنها ستركز بشكل خاص على تقوية التعاون الدولي لحماية الأقليات المسيحية.
يتعلق الحق في حرية الدين بالحق في اعتناق أو تغيير الدين (أو ألا يكون لديك دين كلياً)، وكذلك للتعبير عن/ أو ممارسة هذا (أو عدمه) بمفردك أو مع الآخرين.
تتعلق الحرية الدينية بكل من حرية الفرد في اختيار الدين وفي حرية الممارسة والعبادة. لا يمكن استخدام الحق في حرية الدين لتقييد حقوق الآخرين، ولا يعطي تفويضاً مطلقاً للتحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف للسيطرة على الآخرين، ومنعهم من التعبير عن معتقداتهم، أو إلى قمع النقد الديني.
تُرتكب انتهاكات للحرية الدينية من قبل الدولة، وكذلك من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل المنظمات الدينية والحركات المتشددة أو من قبل المجتمع المحلي. تتراوح الانتهاكات بين التمييز والتحرش، إلى الاضطهاد الذي قد يصل مرحلة الخطورة عبر الاعتداء الجسدي الذي يهدد حياة وحرية الفرد. والذي قد يحدث في سياق حيث الدولة لا تستطيع ـ أو لا تريد ـ حماية المضطهدين، أو حيث الدولة نفسها تكون نشطة ومشاركة في الاضطهاد.
تتعرض الأقليات الدينية بشكل خاص لانتهاكات حريتهم الدينية. الذي – التي نادرا ما تكون أقلية دينية واحدة فقط. إذا سمح المجتمع بذلك إن اضطهاد أقلية يفتح الطريق أمام اضطهاد الأقليات الأخرى. لكن الجماعات الأخرى تتعرض أيضاً للتمييز الديني والمضايقات والاضطهاد، بما في ذلك الملحدون، والمتحولون، والنساء، والمثليات، والمثليون، ومزدوجو الميل الجنسي، ومغايرو الهوية الجنسانية.
يجب أن تكون الجهود المبذولة لتأمين الحرية الدينية وتعزيزها متاحة للجميع، بغض النظر عن الدين الذي يعتنقونه، وبغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى أقلية دينية أم لا.
ترتبط حرية الدين بالتعددية والتسامح واحترام التنوع، وهو شرط أساسي للديمقراطية واليقين القانوني والسياسي والاستقرار المجتمعي. إذا تم إضعاف الحرية الدينية تضعف إمكانيات الديمقراطية، وتفشل سياسات التنمية، وبالتالي قد تضعف النمو الاقتصادي. لذلك من المنطقي تعزيز الحق في الحرية الدينية كعنصر مركزي في السياسة الخارجية والتنموية.
قراءة في كتاب "العرب والتجربة الآسيوية الدروس المستفادة" - صلاح الدين ياسين
كتاب من تأليف الباحث الاقتصادي المصري محمود عبد الفضيل، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت في العام 2000، إذ انصرف موضوعه إلى تناول جملة من التجارب الآسيوية الناجحة في النهوض الاقتصادي، وتحديدا في دول سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الصين، وذلك بغرض الوقوف على محددات النجاح التي يمكن الاسترشاد بها عربيا، فضلا عن بعض مواطن القصور في تلك التجارب، والتي يجدر بنا تلافيها عند الحديث عن أي أفق نهضوي عربي.
أولا: مقومات نجاح تجربة التنمية الآسيوية
يذهب المؤلف إلى أن تلك التجارب الآسيوية في الإقلاع الاقتصادي استندت إلى مجموعة من المقومات والدعامات في وسعنا تحديدها كما يلي:
* الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في رسم التوجهات التنموية وتحديد الأولويات الاقتصادية، من خلال سياسات التخطيط المركزي الحكومي، بالموازاة مع إعطاء حوافز للقطاع الخاص من أجل الإسهام في العملية التنموية، الأمر الذي يتنافى مع الطرح النيوليبرالي المتوحش الذاهب إلى إلغاء أي دور تدخلي للحكومة والقطاع العام باعتباره عائقا أمام التنمية، بحيث لعب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد دورا أساسيا في إنجاح تلك التجارب الناهضة، وآية ذلك استمرار السياسات التنموية رغم تبدل القيادات والنظم السياسية.
* البعد الثقافي والقيمي من حيث هو محرك للتجارب التنموية في دول شرق آسيا، إذ ليس يخفى إسهام قيم معينة مثل الإخلاص والمثابرة في العمل (قوة عمل منضبطة ومؤهلة)، وشيوع ثقافة الادخار لدى الحكومات والأسر، في النهوض التنموي لتلك التجارب، وهنا تلعب الأخلاق الكونفوشيوسية وظيفة حيوية في هذا المضمار.