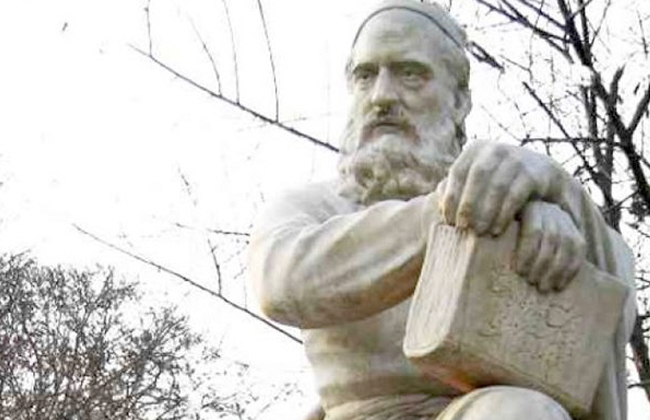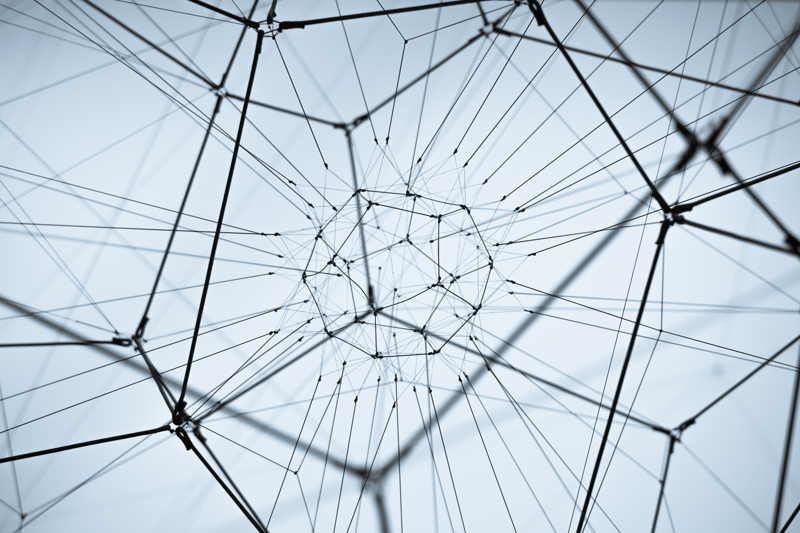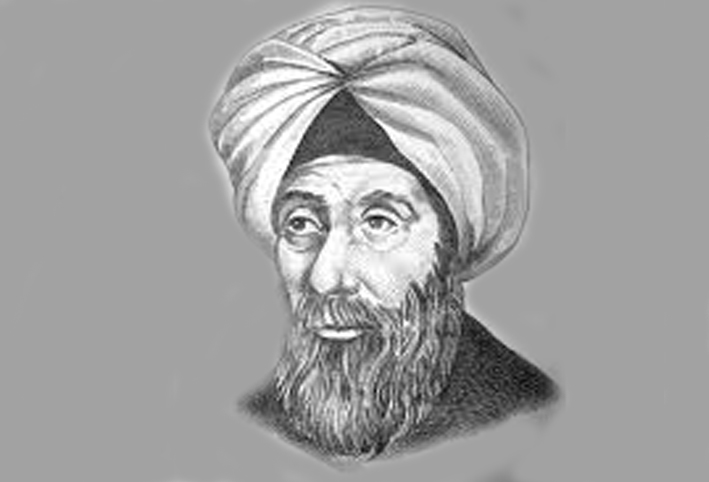"أخشى أن تكون ساحرة الفلاسفة، أي الأخلاق، هي التي تمكر بهم هنا لتجبرهم على أن يكونوا مفترين على الدوام"
فريديريك نيتشه
"في العالم شيء يرغم على التفكير. هذا هو موضوع لقاء أساسي وليس موضوع تحقق"
جيل دولوز
تقديم
يجب التأكيد على صعوبة الإنفلات من الاخلاق والأحكام الأخلاقية، والتي فرضت نفسها على الأفراد والجماعات على طول تاريخ البشر والثقافات والحضارات. إن الحكم الأخلاقي هو الذي وجّه الفلاسفة والمؤرخين وعلماء النفس، وإن الفن والدّين والعلم والتاريخ والتقنية نُظر إليها من جهتها الأخلاقية، وذلك بما ثبت من تفحص هذه المجالات من أنها كانت مشروطة للأخلاق في غايتها ووسائلها ونتائجها. فالقيمة الأخلاقية عدت بهذا القيمة العليا(1). لكن ما يتعب أكثر، هو أن نرى في النوازع الأخلاقية ما يحرك عمل الفيلسوف أو المشتغل بالفلسفة، مع ذلك الإعتزاز بالإنضمام إلى الجماعة والخضوع لقيمها وقوانينها، والإنتشاء بخدمتها وتدعيم سلطتها. إنه الشعور بالواجب، والوعي، والعزاء الوهمي بالإنتماء لإرادة عليا؛ إرادة الجماعة. ضدا على هذا النزوع الإرتكاسي، وجب "تجديد الإنطلاقة" والبحث عن مخارج للتشويه الذي أصاب إرادة "الإنسان الأخير" وقيمه ومعاييره الاخلاقية ومعنى و"جوده مع العالم". إنني أدعو هنا والآن، إلى التشديد على الوسط ومزاولة الصيرورة، وإعادة الإعتبار للجغرافيا على حساب التاريخ، وللفكر كقوة رحالة قادرة على زحزحة المثال وتجديد الإنطلاقة.