 " لا تزال الأمة حية ما دامت تعاودها ذكريات ماضيها ومالنا والمستقبل إذا لم يكن من ماضينا ما يرسم في نفوسنا المثل الأعلى الذي تمتد نحوه آمالنا غير متناهية. وما حاضرنا إلا خطوة نخطوها من ماضينا إلى مستقبلنا، فلماذا نخطوها إذا كنا لا نتذكر ما وراءنا ولا نأمل فيما أمامنا..."
" لا تزال الأمة حية ما دامت تعاودها ذكريات ماضيها ومالنا والمستقبل إذا لم يكن من ماضينا ما يرسم في نفوسنا المثل الأعلى الذي تمتد نحوه آمالنا غير متناهية. وما حاضرنا إلا خطوة نخطوها من ماضينا إلى مستقبلنا، فلماذا نخطوها إذا كنا لا نتذكر ما وراءنا ولا نأمل فيما أمامنا..."استهلال:
الاحتفال بمرور قرن على ولادة الفاضل بن عاشور (1909-1970) اتخذ طابعا فلسفيا عندنا هذه المرة، حيث كان الاتجاه نحو البحث عن الفلسفي فيما كتب الرجل. والمفاجأة حدثت حيث نعثر له على مقالات في الفلسفة الإسلامية من جهة العلوم والاجتهاد والأعلام وأيضا من جهة الحضارة والمدن والجغرافيا والبحوث اللغوية ومراجعة الكتب والمتفرقات والأدب والجامعات. فماهو تصوره لتاريخ الفلسفة عند المسلمين؟ وماهي خصائص الفلسفة التي عثر عليها في القرآن؟ وكيف توصل إليها؟ هل عن طريق الاجتهاد أم من خلال التفسير؟ وكيف نفسر شدة انبهاره بالغزالي؟ وبأي معنى ننسبه إلى الإرث الخلدوني؟ وما السر وراء نظرته إلى الكندي من زاوية علاقته بمدينة بغداد والى بغداد من جهة حضور الكندي فيها؟ هل من ضرورة تقتضي التعريب؟ وماهي المشاكل التي وقعت فيها اللغة العربية؟ وكيف يمكن تجديد النظر فيها؟ ماهي العناصر التي تتكون منها الثقافة الإسلامية؟ وأي دور لفلسفة القرآن في تبويب هذه العناصر؟ ألا يجوز الحديث عن إشارة الشيخ الفاضل إلى مفهوم حضارة اقرأ في مدونته؟ بمن تأثر أكثر؟ هل بالكندي أم بالغزالي؟ وهل كان متكلما أشعريا أم فقيها مالكيا؟ ماهي منزلة الفكر التونسي في هذه الحضارة؟ وضمن أي مجال تتنزل دعوته إلى الوحدة المغاربية؟ هل ضمن فكرة الجامعة الإسلامية أم في اتجاه الوحدة العربية؟ ماهو الدور الذي يلعبه الفقه في توطيد العروة الوثقى للأمة؟ وهل تتوقف قاطرة الإصلاح على استئناف باب الاجتهاد؟ ما سر الحنين الذي يجذبه إلى الدولة الحفصية ومدينة بجاية الجزائرية وصقلية؟ هل يمكن أن نعتبر بن عاشور هو اشراقة من اشراقات العقل المستنير الذي جادت به علينا جامعة الزيتونة المباركة؟
ماهو في ميزان النظر بالنسبة إلينا هو الابتعاد عن هاوية التقليد والإعراض عن الرجوع القهقرى والإقبال على منهج الاقتداء وأسلوب الربط بين الالتزام الاجتماعي النقابي والموقف الأدبي والنظري.
فلسفة القرآن:



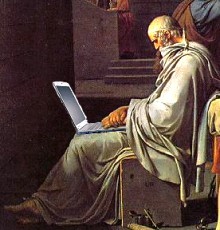 سقراط ،اسم يكاد جميع المتمدريسين يعرفه ،حتى ولو لم يعرف شيئا عن حياته وفلسفته، وهو عند المتخصصين في الفلسفة من انزلها من السماء الى الأرض ،اي من تفكير مجرد متعالي الى فكر داخل الاسواق ووسط العامة وفي الردهات والاروقة ،منه ينطلقون في تأريخهم للفلسفة ومنه يحددون معناها.
سقراط ،اسم يكاد جميع المتمدريسين يعرفه ،حتى ولو لم يعرف شيئا عن حياته وفلسفته، وهو عند المتخصصين في الفلسفة من انزلها من السماء الى الأرض ،اي من تفكير مجرد متعالي الى فكر داخل الاسواق ووسط العامة وفي الردهات والاروقة ،منه ينطلقون في تأريخهم للفلسفة ومنه يحددون معناها. 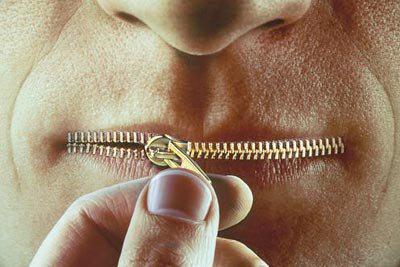 ليس في وارد هذه المقاربة توخي النظر في الجذور التي أفضت إلى غياب الفلسفة وما لابسها نظرياً وتاريخياً , على أهمية هذا وخطورته , وليس القصد من وراءها الوقوف على المآلات التي تناتجت عن هذا الغياب في الفضاء الثقافي العربي العام , من غيابٍ كلّي أو شبه كلّي لسلطة العقل ومرجعيته لصالح مرجعيات ما قبل معرفية مُعتمة , تناسلت ولم تزل بما هو أشد ظلاميةً وقتامةً , لدرجة بتنا نلمس فيها التأثيرات الناتجة عن ذلك ونعاين تجلياته في واقع التخلف السياسي والثقافي والاجتماعي العربي الذي نشهده بين ظهرانينا .
ليس في وارد هذه المقاربة توخي النظر في الجذور التي أفضت إلى غياب الفلسفة وما لابسها نظرياً وتاريخياً , على أهمية هذا وخطورته , وليس القصد من وراءها الوقوف على المآلات التي تناتجت عن هذا الغياب في الفضاء الثقافي العربي العام , من غيابٍ كلّي أو شبه كلّي لسلطة العقل ومرجعيته لصالح مرجعيات ما قبل معرفية مُعتمة , تناسلت ولم تزل بما هو أشد ظلاميةً وقتامةً , لدرجة بتنا نلمس فيها التأثيرات الناتجة عن ذلك ونعاين تجلياته في واقع التخلف السياسي والثقافي والاجتماعي العربي الذي نشهده بين ظهرانينا . " للبيروني نظريات في علم الطبقات والأزمان الجيولوجية... وتقترب نظرياته في هذه العلوم من النظريات الحديثة... ولم تكن هذه النظريات معروفة عند اليونان ولا منتشرة بين معاصريه. ويمكننا أن نعده لذلك من رواد العلوم الجيولوجية، خاصة وأن هذه الأفكار العلمية الصائبة لم تنتشر في أوربا وتأخذ طريقها إلى أبحاث علماء النهضة كليونارد دافنشي وأمثاله إلا بعد وفاة البيروني بعدة قرون."[1]
" للبيروني نظريات في علم الطبقات والأزمان الجيولوجية... وتقترب نظرياته في هذه العلوم من النظريات الحديثة... ولم تكن هذه النظريات معروفة عند اليونان ولا منتشرة بين معاصريه. ويمكننا أن نعده لذلك من رواد العلوم الجيولوجية، خاصة وأن هذه الأفكار العلمية الصائبة لم تنتشر في أوربا وتأخذ طريقها إلى أبحاث علماء النهضة كليونارد دافنشي وأمثاله إلا بعد وفاة البيروني بعدة قرون."[1] يرى المفكر علي حرب في كتابه (( الماهية والعلاقة ، نحو منطق تحويلي )) أنه بصدد إجتراح منطق أسماه المنطق التحويلي بوصفه نقداً للمنطق الصوري .. ويقوم منطقه على أساس القراءة النقدية التحويلية (( على نحو يتيح إبتكارات مفهومية وصيغ عقلانية مختلفة )) .. من أجل إنتاج إمكانيات جديدة للتفكير تعيد تنظيم العلاقة بين الوعي واللاوعي كما ترتب علائق المفهوم بموضوعه أملاً في ولوج المناطق المحرمة التي لم تطأها هواجس المفكرين .. وهو ينشد من كل ذلك الى إبتداع ممارسات جديدة للفكر تنطوي على علائق مبتكرة بالفكر أي علاقة الفكر بالآخر سواء أكان لغة أو ذاتاً أو معرفة أو شيئاً أو حركة أو منهجاً ... الخ ، وهنا نريد أن نسجل بعض الملاحظات كمناقشة لبعض إطروحاته سيما في الصفحات الأولى من الكتاب إذ يقول : (( إن النشاط الفكري ، هو ضرب من ضروب الممارسة . إنه خبرة وجودية بالمعنى الأصيل للكلمة ، أي هو مراس ذاتي وصناعة للحقيقة بقدر ما هو تجربة حية تصاغ بلغة مفهومية )) .. إن النشاط الفكري هو كفاءة أنطولوجية وليس خبرة وجودية فحسب ، هذه الكفاءة / القدرة متآتية من تأصيل عوامل عديدة منها الخبرة وخزين المعلومات والصفاء العقلي ... الخ ، كما لايمكن إعتباره مراساً ذاتياً بعيداً عن البيئة وحتمياتها وسيروراتها .. فضلاً عن إعتباره معني بصناعة الحقيقة فأمر مشكل إذ إن مهمته البحث عن الحقيقة لإعادة تشكيلها ليس بمعنى نمذجتها بقدرما مايتغيا مقاربة المعنى .. وإضاءة المفهوم . ثم يصف منطقه بأنه : (( يتجاوز منطق الهوية والمطابقة )) .. إن تجاوز الهوية ليس بالأمر المتاح وبالسهولة التي يتم طرحها ، نعم التحرر من تابوهات الهوية والإنطلاق مع إنفتاحها وشفراتها ، وإشتباك تلك الشفرات بشفرات ضدية في عملية ترميز تتعاطى مع المعاني الكلية التي صارت حاجة الفكر الإنساني إليها مسيسة في عصر الجدل التكنولوجي الذي راح يغرق الإنسان في (( أتوماتية لاواعية )) قد تحول إنسان التقدم العلمي والتكنولوجي العظيم الى إنسان جملي مشبع بالهمجية بقدر تشبعه بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستحدثة . نعم ذلك الإشتغال على علائق المعنى هو الكفيل بالإنعتاق من قيود المطابقة والتحرر من منطق الهوية القار . أما قوله بأهمية إنفتاح الفكر على (( كثافة التجربة وإشتعالات الحدس وألاعيب الدلالة )) ، فإن الفكر الحديث يكاد يغرق في التجريب منذ بيكون حتى تسيّدت التكنولوجيا على االعلم الذي أصبح تابعاً ووليداً لها .. والإهتمام بألاعيب الدلالة والجدل اللفظي ، قد يرى الى حركة الفكر المطلوبة في البيان بدلاً من البرهان ، وهذا الرأي قديم منذ عصر السفسطة .. وجديد حسبما ماظهر من مناهج جمالية كالبنيوية والتفكيكية التي تقوم على أساس اللعب الحر للغة .. وقد تنتهي الى العدمية اللاغائية . فالمنطق التحويلي في نقده للمنطق الصوري ربما كان محقاً ليس بمعنى أن الأول صحيحٌ والثاني خاطيءٌ .. بل ربما كان الثاني يكتسي الكثير من الصحة ، لكنه أي المنطق الصوري غير منتج لأنه فكر دائري تموت فيه الحركة في نقطة البداية .
يرى المفكر علي حرب في كتابه (( الماهية والعلاقة ، نحو منطق تحويلي )) أنه بصدد إجتراح منطق أسماه المنطق التحويلي بوصفه نقداً للمنطق الصوري .. ويقوم منطقه على أساس القراءة النقدية التحويلية (( على نحو يتيح إبتكارات مفهومية وصيغ عقلانية مختلفة )) .. من أجل إنتاج إمكانيات جديدة للتفكير تعيد تنظيم العلاقة بين الوعي واللاوعي كما ترتب علائق المفهوم بموضوعه أملاً في ولوج المناطق المحرمة التي لم تطأها هواجس المفكرين .. وهو ينشد من كل ذلك الى إبتداع ممارسات جديدة للفكر تنطوي على علائق مبتكرة بالفكر أي علاقة الفكر بالآخر سواء أكان لغة أو ذاتاً أو معرفة أو شيئاً أو حركة أو منهجاً ... الخ ، وهنا نريد أن نسجل بعض الملاحظات كمناقشة لبعض إطروحاته سيما في الصفحات الأولى من الكتاب إذ يقول : (( إن النشاط الفكري ، هو ضرب من ضروب الممارسة . إنه خبرة وجودية بالمعنى الأصيل للكلمة ، أي هو مراس ذاتي وصناعة للحقيقة بقدر ما هو تجربة حية تصاغ بلغة مفهومية )) .. إن النشاط الفكري هو كفاءة أنطولوجية وليس خبرة وجودية فحسب ، هذه الكفاءة / القدرة متآتية من تأصيل عوامل عديدة منها الخبرة وخزين المعلومات والصفاء العقلي ... الخ ، كما لايمكن إعتباره مراساً ذاتياً بعيداً عن البيئة وحتمياتها وسيروراتها .. فضلاً عن إعتباره معني بصناعة الحقيقة فأمر مشكل إذ إن مهمته البحث عن الحقيقة لإعادة تشكيلها ليس بمعنى نمذجتها بقدرما مايتغيا مقاربة المعنى .. وإضاءة المفهوم . ثم يصف منطقه بأنه : (( يتجاوز منطق الهوية والمطابقة )) .. إن تجاوز الهوية ليس بالأمر المتاح وبالسهولة التي يتم طرحها ، نعم التحرر من تابوهات الهوية والإنطلاق مع إنفتاحها وشفراتها ، وإشتباك تلك الشفرات بشفرات ضدية في عملية ترميز تتعاطى مع المعاني الكلية التي صارت حاجة الفكر الإنساني إليها مسيسة في عصر الجدل التكنولوجي الذي راح يغرق الإنسان في (( أتوماتية لاواعية )) قد تحول إنسان التقدم العلمي والتكنولوجي العظيم الى إنسان جملي مشبع بالهمجية بقدر تشبعه بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستحدثة . نعم ذلك الإشتغال على علائق المعنى هو الكفيل بالإنعتاق من قيود المطابقة والتحرر من منطق الهوية القار . أما قوله بأهمية إنفتاح الفكر على (( كثافة التجربة وإشتعالات الحدس وألاعيب الدلالة )) ، فإن الفكر الحديث يكاد يغرق في التجريب منذ بيكون حتى تسيّدت التكنولوجيا على االعلم الذي أصبح تابعاً ووليداً لها .. والإهتمام بألاعيب الدلالة والجدل اللفظي ، قد يرى الى حركة الفكر المطلوبة في البيان بدلاً من البرهان ، وهذا الرأي قديم منذ عصر السفسطة .. وجديد حسبما ماظهر من مناهج جمالية كالبنيوية والتفكيكية التي تقوم على أساس اللعب الحر للغة .. وقد تنتهي الى العدمية اللاغائية . فالمنطق التحويلي في نقده للمنطق الصوري ربما كان محقاً ليس بمعنى أن الأول صحيحٌ والثاني خاطيءٌ .. بل ربما كان الثاني يكتسي الكثير من الصحة ، لكنه أي المنطق الصوري غير منتج لأنه فكر دائري تموت فيه الحركة في نقطة البداية . "إن من يثبت وسط الأخطار ويتصرف حيالها كما يجب لهو أشجع بحق ممن يسلك بثبات في الأوضاع المطمئنة."[1]
"إن من يثبت وسط الأخطار ويتصرف حيالها كما يجب لهو أشجع بحق ممن يسلك بثبات في الأوضاع المطمئنة."[1] "من أول ثقافة العصور القديمة الى آخرها من السهل أن نجد شهادات على الأهمية المعطاة ل"لانهمام بالذات"وربطها بموضوع معرفة الذات." ميشيل فوكو، درس هرمينوطيقا الذات.
"من أول ثقافة العصور القديمة الى آخرها من السهل أن نجد شهادات على الأهمية المعطاة ل"لانهمام بالذات"وربطها بموضوع معرفة الذات." ميشيل فوكو، درس هرمينوطيقا الذات. "يمكن أن يعد سؤال الفلسفة في الإنسان سؤالا استهلاليا وقائما في نفس الآن في أفق كل الأسئلة حتى لكأن تلك الأسئلة تذهل عن ذاتها لو هي ذهلت عن هذا القائم في أفقها جميعا..."[1]
"يمكن أن يعد سؤال الفلسفة في الإنسان سؤالا استهلاليا وقائما في نفس الآن في أفق كل الأسئلة حتى لكأن تلك الأسئلة تذهل عن ذاتها لو هي ذهلت عن هذا القائم في أفقها جميعا..."[1] " الإنسان هو أيضا محل للجهل، هذا الجهل يمكنه أن يتجاوز كينونته الخاصة وأن يستعيد ذاته انطلاقا مما يفوته." ( ميشيل فوكو، الكلمات والأشياء)
" الإنسان هو أيضا محل للجهل، هذا الجهل يمكنه أن يتجاوز كينونته الخاصة وأن يستعيد ذاته انطلاقا مما يفوته." ( ميشيل فوكو، الكلمات والأشياء) الفلسفة والمؤسسة: أية علاقة؟
الفلسفة والمؤسسة: أية علاقة؟






