 " أيها السادة...لن أتوقف البتة عن ممارسة الفلسفة وعن نصحكم وشرح الحقيقة والحق لكل امرئ ".
" أيها السادة...لن أتوقف البتة عن ممارسة الفلسفة وعن نصحكم وشرح الحقيقة والحق لكل امرئ ".
(أفلاطون، دفاعا عن سقراط)
يعتبر سقراط الفيلسوف الأول الذي أعطى اللوغوس الاغريقي جرعة اتيقية كافية ليتحول من نظر في الطبيعة الى عناية بحياة الانسان وتدبير لشؤون المجتمع وانتقل من رغبة في المعرفة النظرية الى تصميم على الوفاء بالحقيقة والتوجه نحو الالتزام العملي والانخراط في التجربة اليومية والممارسة السياسية.
زد على ذلك ان سقراط حالة خاصة وشخص استثنائي في تاريخ الفكر البشري وذلك لأنه أستاذ وأب الفلسفة الاغريقية ولم يسبقه شهرة سوى بارمنيدس وطاليس وهرقليطس وفيثاغورس ولكونه الفيلسوف الوحيد- اذا استثنينا بوذا والنبي عسى ع.س- الذي لم يكتب وكان يعتقد أن فن الكتابة - كما يرى جاك دريدا- ينقص من ثراء المعنى وفيض الدلالة التي تتميز بها اللغة في المحادثة الشفوية والكلام الحي.
هذه المكانة الرفيعة التي احتلها سقراط في قلوب المشتغلين بالفلسفة وما يزال راجعة الى كونه أول من صوب نظر الفكر الفلسفي نحو الانسان وفكر في أحواله ومعاشه ومعاده وبين أن لا شيء في العالم غريبا عن الانسان ولا شيء من عناصر الكون لا يقع تحت طائلة اهتمامه بل الكل من الانسان واليه يعود النظر.
إضفاء المشروعية والحاجة إلى الشرعية - زهير الخويلدي
"  إن البرمجة البديلة التي تشرعن[1] للسيطرة تترك حاجة شرعية حاسمة مفتوحة: كيف يمكن جعل نزع السياسة [2]عن الحشود البشرية مفهوما بالنسبة إلينا؟"[3]
إن البرمجة البديلة التي تشرعن[1] للسيطرة تترك حاجة شرعية حاسمة مفتوحة: كيف يمكن جعل نزع السياسة [2]عن الحشود البشرية مفهوما بالنسبة إلينا؟"[3]
ساهمت عدة عوامل في احتجاب فكرة المشروعية في الجزء الأول من القرن العشرين من ساحة النقاش العمومي وخاصة منذ صعود الأنظمة الشمولية وايديولوجيات الجنات الموعودة وتفجر نمط غير معهود من الحروب الكونية وحدوث أزمات اقتصادية عالمية وفجوة رقمية واكتساح نموذج موحد من علاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع كامل المعمورة وانقسامها هي الأخرى إلى مركز متقدم وأطراف نامية وشمال غني وجنوب فقير.
لكن الآن يبدو أن الأمور قد عادت إلى نصابها وأصبحت قضية المشروعيات تتصدر اهتمامات رجال القانون والفلاسفة والمفكرين بل أنها قد أحرزت في العقود القليلة الماضية مكانة بارزة في الحقل الفلسفي والسياسي والقانوني وطرحت من جديد في علاقة بالشرعنة والشرعية والحكمنة وحقوق المواطنة ومبدأ السيادة.
والحق أن معطيات عديدة جديدة قد حدثت بعد بلوغ البشرية زمن العولمة وانبلاج فجر العصر ما بعد الصناعي والثورة الرقمية وبروز تكنولوجيا النانو والتي أظهرت عدم كفاية المقاربة القانونية الوضعية التي اختزلت المشروعية في قانونية شكلية صرفة وساعدت على تعزيز التفكير في أسس القيم ومقاصد السلطة وقد أفرزت هذه التحولات العميقة حدوث طفرة في الديمقراطية التمثيلية التي حلت مكان الديمقراطية التشاركية، ووصلت فكرة الدولة- الأمة إلى نهايتها وظهرت دولة الرفاه ومجتمع الوفرة، وبلغت نظرية حقوق الإنسان ومبدأ الديمقراطية الجيل الرابع، و دارت المناقشات حول قضية العدالة والمساواة وعدم التمييز والنوع الاجتماعي والحقوق الثقافية وحرية الضمير.
روسو :المطالعة و الطبيعة - خالد كلبوسي
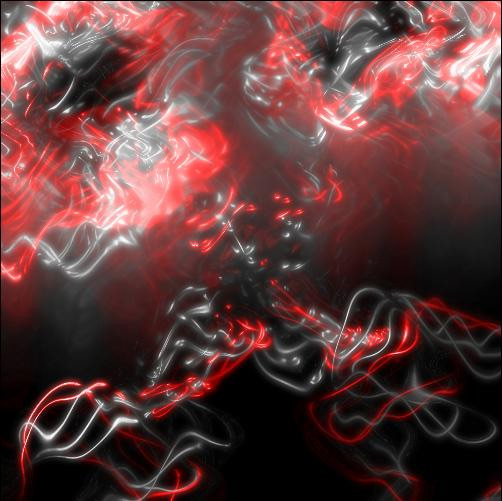 منزلة المطالعة في حياة الفيلسوف ج ج. روسو
منزلة المطالعة في حياة الفيلسوف ج ج. روسو
يقول روسو في كتابه " الاعتراف " وهو عمل في السيرة الذاتية :" بدأت أشعر قبل أن أفكر، وهو قدر الإنسانية العام، وقد جربت ذلك من غيري. فقد كنت أجهل من أنا إلى حدود 5 أو 6 سنوات. ولا أعرف كيف تعلمت القراءة وأتذكر أن من تأثير مطالعاتي الأولى أنني بدأت أعي ذاتي منذ ذلك الوقت. إنّ أمي تركت مجموعة من الروايات وقد بدأنا، أنا وأبي نقرأها بعد الغداء" (ص 36-37 . "الاعترافات" Poket 1996) .
بدأ روسو عن طريق المطالعة يعي ذاته "أحاسيسه ومشاعره"، قبل أن يعي بالعالم الخارجي من حوله.
لقد كان يقرأ أعلام النهضة في إيطاليا خاصة منهم Plutarque الذي ألف حول التاريخ الروماني بالأساس مثل كتابه " مشاهير الرجال Les hommes illustres " ، وقد علمته المطالعة أيضا التحاور مع أبيه. وهكذا بدأت تتكون لديه منذ الطفولة فضيلة الحوار والتعبير عن المشاعر والأفكار. وقد أصبحت هواية بل حبا جارفا إذ أنه قرأ إبان طفولته كل ما تضمه مكتبة La Tribu في مدينته.كما ساعدته المطالعة كذلك على تصور عوالم أخرى خيالية غير العوالم التي توجد في مرمى اليد والحواس بل شكلت شخصيته الميالة إلى العزلة نهائيا كما جاء في : الاعترافات " ص 76 من الطبعة المذكورة سابقا.
هابر ماس من العقل الاداتي إلى العقل التواصلي - نورالدين علوش
 مقدمة : يعد الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ، احد الوجوه الفلسفية البارزة في القرن العشرين، ويعتبر في نظر المؤرخين للفلسفة ممثلا للجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدية وان كانت لديه اختلافات مع ممثلي هذه المدرسة .
مقدمة : يعد الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ، احد الوجوه الفلسفية البارزة في القرن العشرين، ويعتبر في نظر المؤرخين للفلسفة ممثلا للجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدية وان كانت لديه اختلافات مع ممثلي هذه المدرسة .
يمكن اعتبار هذا الفيلسوف موسوعيا فهو تطرق الى الفلسفة والسوسيولوجي والتداوليات والأخلاق والسياسة ؛ في مجموعة من كتابته منها ملامح فلسفية وسياسية والخطاب الفلسفي للحداثة وأخلاقيات المناقشة والحق والديمقراطية....
ومن ابرز نظرياته نظرية الفعل التواصلي التي تجاوز بها العقل الادتي ليطرح مفهوم العقل التواصلي وما أحوجنا اليوم إلى عقل تواصلي يحقق لنا الإجماع والتفاهم والحوار.
* العقل الاداتي : طبيعته وسماته
يميز هابرماس في كتاباته بين العقل الاداتي والعقل التواصلي ،.فما هي طبيعة العقل الاداتي ؟ وما هي سماته؟
الوعي الإنساني في التصور الفنومينولوجي - زهير الخويلدي
" هذه الضرورة بالنسبة إلى الوعي في أن يوجد من حيث هو وعيا بشيء آخر غير ذاته يسميها هوسرل قصدية."[1]
هذه الضرورة بالنسبة إلى الوعي في أن يوجد من حيث هو وعيا بشيء آخر غير ذاته يسميها هوسرل قصدية."[1]
لقد ادخل البحث في مطلب الوعي منذ الوهلة الأولى التساؤل عن ماهية الإنسان إلى صميم التفكير الفلسفي ولقد أيد المعنى الايتيمولوجي هذا الربط بين المعرفة والأخلاق وحازت ملكة الوعي على لقب الضمير.
غير أن الجديد الفلسفي عند ديكارت بالمقارنة مع السابقين هو المعنى البسيكولوجي الذي أعطاه للوعي وذلك بالانتقال من تعريف الإنسان بكونه جوهر ميتافيزيقي وحيوان ناطق يخضع إلى نواميس الكون عند الإغريق والعرب والرومان إلى التعامل معه على أنه ذات عارفة وأنا مفكر وثنائية تتصل فيها النفس بالجسم ولكن النفس تحدد وفق ثلاثة معان:
- النفس هي مبدأ حيوي يغذي ويوجه الجسم.
- النفس موجود روحي متميز عن الجسم وغير فان ويجعل من الإنسان كائنا دينيا وأخلاقيا.
- النفس هي جوهر كل طبيعته أو ماهيته تقوم على الفكر.
العلمانية ونقد العقل العربي الإسلامي عند محمد أركون - مراد زوين
 إن الحديث عن علاقة الدين بالدولة في خطاب محمد أركون لا يمكن فصله عن مشروعه الفكري المتعلق بتفكيك آليات اشتغال العقل العربي الإسلامي. أي الحديث عن هذه العلاقة لايمكن أن يعطي مدلوله الفكري والمنهجي دون تحديد الإطار الذي يتحرك فيه أركون ، الإطار/ الزاوية التي ينظر من خلالها إلى قضايا الفكر العربي الإسلامي بغية تحديد مفاهيمه وتكوين آرائه وصياغة تأويلاته.
إن الحديث عن علاقة الدين بالدولة في خطاب محمد أركون لا يمكن فصله عن مشروعه الفكري المتعلق بتفكيك آليات اشتغال العقل العربي الإسلامي. أي الحديث عن هذه العلاقة لايمكن أن يعطي مدلوله الفكري والمنهجي دون تحديد الإطار الذي يتحرك فيه أركون ، الإطار/ الزاوية التي ينظر من خلالها إلى قضايا الفكر العربي الإسلامي بغية تحديد مفاهيمه وتكوين آرائه وصياغة تأويلاته.
إن كل الإشكاليات والقضايا التي تهم العقل العربي الإسلامي ومن بينها مسألة العلمانية عند أركون "تندرج ضمن إطار بحث واسع متعدد الجوانب" يسمى "بالإسلاميات التطبيقية" .
فبمجرد تناول مسألة" الإسلاميات التطبيقية" عند أركون يطرح أمامنا مقابلها "الإسلاميات الكلاسيكية " فبدون تحديد معنى هذه الأخيرة لايمكن تحديد معنى الأولى. بهذا يرى أركون أنه من اللازم أن نذكر بالاختيارات والحدود والمساهمات التي كانت قد قدمتها الإسلاميات الكلاسيكية.
إن المدلول الذي يعطيه أركون للعلمانية لا ينحصر ضمن حدود جغرافية أو ثقافية أو فكرية - كما هو الشأن بالنسبة للعلمانية عند محمد عابد الجابري - بل يبقى منفتحا ومستوعبا للإرث الثقافي الإنساني دون التقيد بخصوصية ملازمة لهذه الثقافة أو تلك . فالعلمانية عند أركون "موقف للروح وهي تناضل من أجل امتلاك الحقيقة أو التوصل إلي الحقيقة" وبهذا المعنى فهي تواجه مسؤوليتين أو تحديدين اثنين:
الديمقراطية ضد الاستبداد - زهير الخويلدي
"  الديمقراطية بصفتها نظاما يتضمن التحكم بالمواطنين وفصل السلطات وتعددية الآراء وصراع الأفكار هي الدواء الشافي للسلطان المطلق لجهاز الدولة وجنون السلطة الشخصية."[1]
الديمقراطية بصفتها نظاما يتضمن التحكم بالمواطنين وفصل السلطات وتعددية الآراء وصراع الأفكار هي الدواء الشافي للسلطان المطلق لجهاز الدولة وجنون السلطة الشخصية."[1]
ماهو بديهي أن طبيعة الدولة التي تتبني خيار الاستبداد هو تعليق كل ممارسة ديمقراطية وإلغاء التعددية واحتكار ثروات المجتمع من طرف الطبقة الحاكمة وسن القوانين التي تحافظ بها على مصالحها وتعيد إنتاج هيمنتها على المكونات والقوى المتنافسة بشكل دائم. ومن الواضح والمعروف أن إعلان نظام سياسي ما تبني خيار الديمقراطية والشروع في تفعيل آليات معينة لتجسيم هذا الخيار هو كفيل بالتخلص من الاستبداد والحكم الفردي والكف عن تسيير الشأن العام باستخدام القوة واعتماد التشريعات الجيدة واحترام نصوص الدساتير. لكن المفارقة تظهر عندما تتجمل الأنظمة الاستبدادية بالديمقراطية وتستعمل هذه الفكرة الحقوقية النبيلة من أجل توطيد أركان الحكم المطلق وتبقى عليها في الواجهة وتتبجح بالشعارات السياسية الفضفاضة لا غير وتتناقض معها في ميدان الممارسة ومجريات الأحداث اليومية.
ناقد العقل الإسلامي محمد أركون يسجل اسمه في التاريخ ويرحل ـ زهير الخويلدي
 " ما دام العرب وغير العرب من المسلمين لم يخرجوا حتى الآن من إطار المعقولية الدينية القروسطية فلا معنى إطلاقا لنقد العقل العربي قبل نقد العقل الإسلامي."[1]
" ما دام العرب وغير العرب من المسلمين لم يخرجوا حتى الآن من إطار المعقولية الدينية القروسطية فلا معنى إطلاقا لنقد العقل العربي قبل نقد العقل الإسلامي."[1]
إن رحيل العقل اليقظ محمد أركون 1928-2010 يعني أن الساحة الثقافية والإسلامية قد خسرت هذه الأيام ويا للأسف وفي فترة وجيزة العديد من العمالقة والقمم مثل محمد عابد الجابري ونصر حامد أبي زيد والطاهر وطار وغيرهم مما يترك فراغا كبيرا لا يمكن تداركه بسهولة. ويعتبر ابن تيزي وزو من الجزائر الشقيقة وأحد أعضاء معهد العالم العربي باريس رائدا كبيرا من رواد الإنسية العربيةarabe humanisme ومحررا هاما للفكر الإسلامي من السياج العقائدي الدغمائي وقارئا متعدد المناهج للقرآن وعالما فذا من علماء الإسلاميات التطبيقية ومصلحا دينيا حارب الجهل ودعاة اليمين الديني والمتأثرين بالمنهج الاستشراقي على حد السواء.
لقد مثّل أركون حضارة اقرأ في الدوائر الجامعية الغربية على أحسن ما يكون وناظر كبار الفلاسفة والمفكرين الأوربيين وأثبت من المستوى المرموق ومن الندية معهم مما جعله محل احترام وتقدير وتبجيل أينما حل ولكنه لم يلقى في الفضاء العلمي العربي والإسلامي ما يليق به وما يتماشى مع قيمته العلمية وقد مُنع في العديد من المرات من زيارة بعض الدول والجامعات ومن تقديم المحاضرات والاتصال بطلبته ومريديه وحوصرت كتبه وتعرضت أفكاره إلى هجوم سفسطائي ونقاش غير علمي ونقد أصولي بغير حق.
وفاة المفكر الجزائري الفرنسي محمّد أركون
 توفيّ ليل الثلاثاء – الأربعاء 14 ـ 15 شتنبر، في العاصمة الفرنسية باريس المفكر الجزائري/ الفرنسي المثير للجدل محمد أركون. وذكرت تقارير إعلامية إنّ أركون توفيّ بعد معاناة كبيرة مع المرض، وأركون هو مفكر وباحث جزائري من مواليد العام 1928 في بلدة تاوريرت في تيزي وزو بمنطقة القبائل الكبرى الأمازيغية بالجزائر، و انتقل مع عائلته إلى بلدة عين الأربعاء (ولاية عين تموشنت) حيث درس دراسته الابتدائية بها. وأكمل دراسته الثانوية في وهران، وإبتدأ محمد أركون دراسته الجامعية بكلية الفلسفة في الجزائر ثم أتم دراسته في "السوربون" في باريس. وحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب، كما درّس بجامعات عديدة في أوربا وأمريكا والمغرب، واهتم بدراسة وتحليل الفكر الإسلامي.
توفيّ ليل الثلاثاء – الأربعاء 14 ـ 15 شتنبر، في العاصمة الفرنسية باريس المفكر الجزائري/ الفرنسي المثير للجدل محمد أركون. وذكرت تقارير إعلامية إنّ أركون توفيّ بعد معاناة كبيرة مع المرض، وأركون هو مفكر وباحث جزائري من مواليد العام 1928 في بلدة تاوريرت في تيزي وزو بمنطقة القبائل الكبرى الأمازيغية بالجزائر، و انتقل مع عائلته إلى بلدة عين الأربعاء (ولاية عين تموشنت) حيث درس دراسته الابتدائية بها. وأكمل دراسته الثانوية في وهران، وإبتدأ محمد أركون دراسته الجامعية بكلية الفلسفة في الجزائر ثم أتم دراسته في "السوربون" في باريس. وحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب، كما درّس بجامعات عديدة في أوربا وأمريكا والمغرب، واهتم بدراسة وتحليل الفكر الإسلامي.
وأركون عضو اللجنة الوطنية لعلوم الحياة والصحة بفرنسا، وعدة لجان أخرى. من آرائه إعادة قراءة القرآن برؤية عصرية وتجريده من القداسة التي تعيق دراسته وهو ما جعله عرضة لانتقادات التيارات الأصولية المتشدّدة.
أهل الاعتزال قناديل الإسلام الساهرة ـ زهير الخويلدي
" إن الذي لابد له من طلبه في المتكلمين مما يتكامل به علمهم بالله وصفاته وعلمهم بعدله وتوحيده وعلمهم بالنبوة والشرائع وتمسكهم بذلك"
إن الذي لابد له من طلبه في المتكلمين مما يتكامل به علمهم بالله وصفاته وعلمهم بعدله وتوحيده وعلمهم بالنبوة والشرائع وتمسكهم بذلك"
استهلال:
يكاد يتفق معظم الباحثين في الإسلاميات على أن ما سمي بالاعتزال هو حركة عقلية رائدة تعود إلى فئة القراء الذين حفظوا القرآن في صدورهم واتبعوا المنهاج النبوي في أعمالهم وينحدر هذا التوجه من خط التوحيد والعدل وينسبه البعض إلى محمد ابن الحنفية وأبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل وعبد الله ابن مسعود والحسن البصري وغيلان الدمشقي وسعيد ابن جبير. بيد أن واصل ابن عطاء هو أول من جاهر بالاعتزال وحول الكلام في العقائد إلى علم عقلي ينطلق من مقدمات وأصول ويتبع مسالك وأساليب وينتهي إلى نتائج وقوانين وقد تبعه في ذلك من الطبقة الأولى عمرو ابن عبيد وزيد ابن علي وأبو عمرو عثمان بن خالد الطويل وحفص بن سالم وبشر بن سعيد وأبي عثمان الزعفراني.
غير أن الاعتزال لا يتوقف على جملة من الأسماء وعدد من الأشخاص بل هو منزع فلسفي ومغامرة فكرية حمل لواءها الكثير من الأعلام الثائرة والرجال الأحرار والعقول النيرة التي سعت إلى فهم عميق للآيات والآحاديث من أجل الإيضاح والتبليغ والرد على الخصوم بالحجج المنطقية والبينة الدامغة.
فلسفة وحدة الوجود بين ابن عربي واسبينوزا - د. بدران بن الحسن
 إن دراسة فكرة "وحدة الوجود" بشكل متكامل تحتاج إلى جهود متضافرة ومتعددة تخصص لها، كما تحتاج إلى أن تعالج من زوايا مختلفة، بما أنها من إحدى المقولات الصوفية ذات المرتكزين الاجتماعي الأخلاقي، والمعرفي الفلسفي.
إن دراسة فكرة "وحدة الوجود" بشكل متكامل تحتاج إلى جهود متضافرة ومتعددة تخصص لها، كما تحتاج إلى أن تعالج من زوايا مختلفة، بما أنها من إحدى المقولات الصوفية ذات المرتكزين الاجتماعي الأخلاقي، والمعرفي الفلسفي.
كما أن مقارنة ما ورد عن هذه الفكرة في دوائر حضارية مختلفة يجعل من الصعوبة بمكان الخروج بموقف موضوعي بعيد عن التلفيق، أو الإسقاط المتعسف، أو التقول ونسبة المتأخر إلى المتقدم، أو محاولة معالجة الظاهرة بنوع من التجزيء والتعميم الذي يقضي على جوهر المسألة.
ودراسة وحدة الوجود أيضاً، لا تنفك عن دراستها في صلتها بظاهرتي الزهد والتصوف، وبخاصة ظاهرة التصوف التي تعتبر ظاهرة عالمية، لا ترتبط بالدين تماماً بقدر ما ترتبط بالإنسان، أي أنها ليست ظاهرة دينية في جوهرها بقدر ما هي ظاهرة إنسانية، والدليل على ذلك أننا نجد كثيرا من المذاهب الوجودية المعاصرة في الغرب، والحركات الطقوسية، وجماعات العربدة وغيرها لا علاقة لها بالدين السائد في تلك المناطق، بل هي ظاهرة تشبه دائرة الدروشة الصوفية التي انتشرت في عهود انحطاط التصوف الإسلامي.










