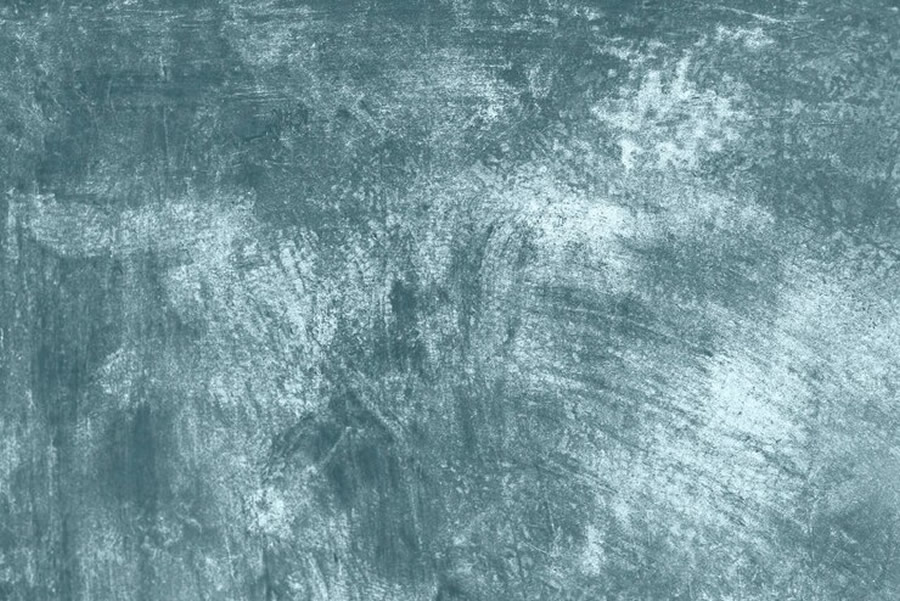أغلقت باب بيتها، وسدت نوافذه بإحكام، ثم تحصنت بالداخل وقد اطمأن قلبها إلى أن الموت لن يصل إليها، ولن يستطيع أن يفاجئها. الكثير من معارفها رحلوا على امتداد السنوات الماضية، أغلبهم اِقْتَنَصَهُ الموت في غفلة منه وهي لا تريد أَنْ تُفاجَأَ مثلهم. لهذا ملأتْ كَرَار بَيتها بكل الموادِّ الغذائية التي تَحتاجها، وقَرَّرت أن لا تغادره البَتَّة. منذ أسْبوع طرق باب بيتها مُوظفون حُكوميون تابعون للبلدية وأخبرُوها بضرورة إخلاء مسكنها لأنه آيل للسقوط، لكنها واجهتم بشراسة:
-لن تنطلي عليّ حِيّلكم أيّها اللُّؤماء أنتم رُسلُ الموت تُحاولون جَرّ رِجْلي لِمغادرة بيتي فيَصطَادني.
-أَغلب السُّكان رَحلوا يا حَاجّة، بُيوتُ هذا الحي ستنهار لأن الشُّقوق تعتري كل الأبْنِيّة.
-تَكذبون! أنتم تريدون بِي شَرّا
-ذَنبك على نفسك، نَحن قمنا بِواجبنا
للموت أعوانٌ، وعيون ترصد الضَّحايا وتُعِدّهم لليَوم المَوْعود، وهِي لن تَنْخدعَ بهذه السُّهُولة وتُصبح لقمة سَائِغة للموت يقتنصُ روحها ويحْرِمها من نعمة الحياة على حين غَرّة. هِي فعلا بَلغتْ من العُمر عتيّاً، وَتُعانِي مِن ضَغط الدّم، واِرتفاع نسبة السُّكري، وآلَام مرضِ النَّقرس، لكن هذا ليس مبررا يَشفعُ للمَوت فَعْلتَهُ.
أفاقت من سَحائِب أفكارها على صُراخ وضَجيج قَوِي بالخارج، تَردّدتْ لحظةً ثمّ اِقتربتْ من الباب الخَشبي المَتِين، ووضعت عَينَها على العَين السِّحرية، رأت شَابّا ملقى على الأَرضِ وهو يَنزِف دَماً.
كانت ملامح وَجْهِه تنِمُّ عن معاناة فَظيعة من الآلام. وكان يَصْدرُ عنه صَوتُ أنينٍ مُمِضّ. عَادت أدراجها وجلستْ على الأريكة الوحيدة التي تملك." لَا شأن لها به، هناك رِجال أمن وإسعاف بالبلد وهم المسؤولون عن حماية أرواح المواطنين ورعاية الجرحى والمُصابين منهم، هِيَ مُجرد سيِّدةٍ عَجوز، مِنَ الأفضَل لها أن تَبتعدَ عن المشاكلِ ".
زادت حِدّةُ الأنين، أصْبحتْ تَطرقُ أسماعَها بقوة وهي جالسة في مكانها، تَقَطّع من الزمن رَدحٌ، وهِي ساكنة تُفكّر، لَكنها في أخر المطاف قامت من مكانها واتجهت مرة أخرى نحو البَاب، نظرتْ عبر العين السحرية، كان الشاب ما يزال مُمدّدا في مكانه وهو يَتَوجّع، لم تتردد هذه المرة، فَتحت البَاب واقتربتْ منه، سالته بصوت أجش :
خيبات – د. الحسين لحفاوي
يداه مغموستان في الطين اللزج تقلبانه برشاقة وخفة ودراية. وقامته المديدة تستوي تارة وتنحني أخرى في لعبة لا يتقنها غيره. شمر قندورته وربط طرفها إلى زناره فانكشفت ساقان رقيقتان معروقتان غطاهما الشعر والطين. تعلوهما ركبتان حادتان مدببتان تحملان فخذين مقوّسين قليلا إلى الخارج محدثين فتحة يتدلى في وسطها طرف القندورة. ذراعاه طويلتان مشعرتان وساعداه مفتولان من عرْك الطين وعجنه. أعلى وجهه الذي يميل إلى طول غير معيب ينبت شعر مجعد وَخَطَه الشيب وتناثر على ما بقي من خصلاته الطين.
يحدق دائما إلى الأمام، كأنما يرسم لنفسه دروبا لا يخط حدودها أحد سواه، ترحل به مرة إلى تخوم ملغومة، وتطوِّح به أخرى في فيافي كثبانها عالية ومسالكها متشعبة لا يتقن السير فيها إلا خرِّيت متمرِّس. وقد تقوده أحايين أخرى إلى حافات مهاوٍ سحيقة لا قرار لها. يخيل لمن يراه أول مرة أنه يراقب الطريق منتظرا قادما لا يأتي.
لا يريد أن يلتفت خلفه. لا يرغب في رؤية تلك الكومة من السنوات الجاثمة وراءه، تلك السنوات التي أفناها من عمره متأبطا محفظة جلدية خضراء جلبها له والده إحدى أوباته من ليبيا. هذا البلد الذي كم قد أغدق على والده وأمثاله من أموال وبضائع، يذهبون إليه بجيوب خاوية ويعودون بها ضاجة بالأوراق النقدية ومحملين بشتى أنواع البضائع والأطايب. يذهبون خِماصا ويعودون بطانا. لم تكن محفظة عادية، كانت بطعم جذوة الأمل التي أوقدها والده في قلبه وأوكل إليه أمانة إضرامها ورعايتها. رافقته تلك المحفظة الأثيلة إلى قلبه سنوات ست في مسيرة تعلم شاقة. رُتقت مرات كثيرة حتى استبدل خيطها الأصلي بخيوط أخرى ذات ألوان متداخلة. في عامه الأخير اتسعت ثقوبها وعِوض حملها على ظهره صار يتأبطها خشية أن تتمزق وتتبعثر أحلامه وآماله وأدواته الهندسية وأقلامه وقطع الطبشور.
العشاء الأخير في حضرة دافنشي – قصة: محمد محضار
عندما عَادَ من مِيلانو كانت ذَاكرتُه لا تزال تَختزن تلك المشاهد التي عَبَرتْ إلى وجدانه مباشرة وأرضتْ ذائقته الفَنِّية ونزعتْ بها نحو رِحاب الجمال وسحر الإبداع الانساني في أروع تجلياته، وحَقَّقتْ له درجة قُصوى من الاسْتِمتاع بِجَماليات يَعزُّ وُجُودَ مَثيلٍ لها في هذا الزَّمن الذي تلوّثَ بالغُبار والإسْمنتِ واعْتَرتْه مَثالب القُبح والسوداوية، لقد وقف مُتهيِّبا أمام لوحة العشاء الأخير الجِدَاريّة لليوناردُو دافنشِي بِدِير سانتا مَاريّا، يتأمل تعبيرات وجوه المسيح وحوارييه الاثني عشر، وجوه كان بعضها كان يحمل ملامح بريئة كَوَجْه يُوحنا، ووجوه البعض الأَخر كانت ترتسمُ عليها علامات الغدرِ كَوجه يهوذَا الإسخريوطي خائن يسوع، الذي باعه لبيلاطس البَنطي الحاكم الروماني، وكان سببا في صلبه(أو من يشبهه) بالقدس، وعندما غادر الدير كانت أصداءُ المَاضي تَحُفُّ خُطاه وروحه تحلّق في رحابه متماهية مع عِبقِه الذي كان يتنسَّمه في الهواء، فتسري في جسده رعشة انتشاء وشعور بالسعادة، ظلت ترافقه حتى وَجدَ نفسه أمام تمثال ليوناردو دافينشي الشامخ مُحاطا بتلاميذه الأربعة يتوسّط ساحة ديلا سكالا ، وجموع الزوار الحاضرين مأخوذين مثله بجمالية المنظر الذي يسافر بهم إلى الثُّلث الأخير من القرن التاسع عشر عندما أزاح ملك إيطاليا فِيتُوريو إيمانويل الثاني سِتار تدشين هذه التحفة الفنية، تكريما لدافينشي عبقريِّ عصر النهضة الذي جاء لِيطوي صفحة العصور الوسطى المُظلمة، ويفسح المجال لإحياء الفكر الكلاسيكيِّ للإغريق والرومان، وترسيخ مفاهيم جديدة مثل الانسانية والإصلاح الديني والواقعية في الفن، كل هذا مرّ بخاطره وهو يجلس على واحد من المقاعد الرُّخامية المنتشرة في محيط الصرح السَّامق الذي يَحتضن التمثال، تساءَل :" هل حقا عُمْرُ هذه التُّحفة قرن ونصف، وكيف تَأتَّى لها أنْ تصمد أمام عوادي الزمن وتقلّبات الطبيعة؟ " تَذكَّر فجأة عملية تدمير تماثيل بوذا بوادي باميان بأفغانستان بمعاول ومتفجرات طالبان، ماذا كان يَحُلُّ بتمثال دافينشي لو كان الحل والعقد بيد المُلّا عمر؟ تَجاوز هذه الفكرة ، وقام من مكانه وأجنحة الأفكار المُتهاطلةِ على دماغه تُحلِّق به بين الأَزمنة المُتَواترة ومواطن الخيال الخلّاقِ، قادته قدماه إلى 1824 MARCHESI PASTICCERIA لتناول وجبةِ إفطار بصالون الشاي بالطابق العلوي، مستمتعا بعبق القرن الثامن عشر الميلادي . ومُتِلذّذا بوجبة تقليدية إيطالية أصيلة، بدا له العالم بشكل مختلف وأحس بأنه يتجاوز ثقل السنين واحباطات الأيام الماضية، اتصل بزوجته وأخبرها بأنه قادم في اليوم الموالي ، وأنه كان يتمنى حضورها معه، وردَّت عليه بأنّ ظروف عملها حَرمتْها من مُتْعة الوُجود صُحبته ولقاء ابْنهما المقيم بمدينة "كومو" صُحبة زوجته، أنهى المكالمة ثم غادر المكانَ.
القطيعة الإبستمولوجية – قصة: محمد محضار
تَوَقّع أن تقع أشياء كثيرة خلال الأيام القادمة تُغيّر مسار حياته ومسار محيطه، بل مسار العالم، لكن " الأيام القادمة " جاءت دون أن يقع أيُّ تغيير، بل ظل كل شيء على حاله، وربما زاد سوءً.
لقد ظل حبيس هذا الإحساس منذ أزمنة بعيدة، دون أن ينتبه إلى أنّ التغيير الوحيد الذي يحدث كان يمس مُورفولوجيا جسده فقط، فوزنه يزداد، وشعره يشتعل شيبا، ووجهه تمسه الغضون والتجاعيد، وحركاته تُصبحُ أقل نشاطا.
حتى زوجته التي كان يَجد عندها السُّلْوَة والمودة الزائدة ودفق المشاعر الذي يُسرّي عنه، أصابها برود رهِيب مُذْ داهمها المرض وصار كل هَمّها أن تَسْتفتيه في موضوع العلاج، وطريقة استعمال الدواء، ومواقيت التحاليل والأشّعة، أما زملاؤه في العمل فأحاديثهم كانت مَلاحم شجنٍ، وبكائيات لا تنتهي وسردا بئيسا لأحداث بعضها مَحلّيُّ، وبعضها يهم ربوع الوطن، أو أرض الله الواسعة، كانت هذه الأحداث تبدو له بَالِغة الفَظَاظِة تَبثُّهُ بالطاقة السلبية، وتُلقي به نَحو دَوّامة الهواجسِ وبواعثِ القلق. وَلَعَلّ هذا ما كان يدفعه في كثير من الأحيان إلى تجنّب تجمعاتهم، وإن قُدّر عليه التواجد بَينهم فإنه يلتزم الصّمتَ ويتسلح بالانطواء. مِمّا جعلهم يلقبونه بالغراب "الأعصم"، لِفرادته في السلوك والمعاملة.
سأل زوجته ذات مرة: " ما بك يا امرأة؟ وماذا أصابك حتى صِرت على هذا الحال من البرود وضيق الخاطر؟"
نظرت إليه مستغربة، وقالت :" لستُ مسؤولة عمَّا تراه أنت تَغيُّراً، وأراه أنا تَطوّرا طبيعيّا ، وجزءً من قواعد اللعبة المفروضة علينا قَسراً ودون رضانا، والتي تنتهي بحتمية لا نستطيع الوُقوف في وجهها"
أحلام الشيوخ – قصة: د.محمد روي
ارتسم في كينونته على حين غرة وهو في طريقه الغائم معنى لطالما وفد عليه فجأة دون استعداد وتقدير، والواقع أن هذا المعنى منه يُعرف صاحبه بشكل دقيق، وهو حكم منطقي يجري على ألسن الناس؛ مفاده: "كل شيء يدخل في نطاق الوجود فهو متغير"، "وحال الإنسان داخلٌ في هذا النطاق"؛ "فحال الإنسان في تغير دائم".
لم أجد مثل هذا الوصف والتحديد الذي قاله صديقي "عبد الله" يصدق عن صديقنا "حميد"، الذي أعرفه شخصيا معرفة تحقيق، وقد كان آخر مرة التقيت به الإثنين الماضي، وبدا لي من خلال تبادل أطراف الحديث أن نفسه قد نزعت إلى تغيير موضعه الذي لبث فيه زمنا ليس بالقليل، وطال مكوته فيه، وسعى فيه سعيا، كما كابد من أجله مكابدة، حتى إن من يراه في وضعه ذاك لن يخطر على باله في يوم ما أن يفكر في الانتقال منه، وقد كان قبل ذلك يحمد الله على تلك النعمة، ويجد فيها نفسه، ويرنو البقاء فيه طويلا طويلا. لا أدري ما الذي حدا به إلى الرغبة العارمة في التحرك من مكانه.. لا أدري، لا أدري. غير أن المحقق عندي أن هناك شيئا ما، وليس بالتأكيد شيئا عاديا مما يمكن أن يقبله المرء دون مواربة، فأنا أعرف الرجل، فليس من عادته أن يقع في هذا المأزق الذي يحرضه على الانصراف عن المقام الذي لطالما حدثني بكل فرح بحبه له وأنه لا يجد راحته إلا فيه، ولم يقع على فؤاده في وقت من الأوقات –وأنا أعي ما أقول- أنه سيأتي تاريخ يسمح فيه عن تلك الجلسة الملائكية أمام بستانه العقلي الحالم.
وصحيح أنه لا يكاد يخلو طريق شخص من أمور تظهر أحيانا على شكل أطياف من التيه والضلال، وبمقدورها في زمن غير محدد أن تتحول إلى أزهار تضفي على الأيام رونقا بهيا ينسي المارّ من الحجيم ما قاسى من ألم وما لحقه من تعب، ولكنها تظل بالقياس إلى غيرها من الأيام كاوية للخواطر التي لا يتوقف سيلان حركات الذهن من إنتاجها؛ ذلك أنه عادة ما يبلغ به الأمر أن يستسلم لتلك الأطياف بالنزوع إلى أي رصيف يتمطاه، دون أن يسأل إلى أين سوف يصل به، ومع ذلك ينازعها ويتولى استشفاف كل ما هو جدير باستمداد ما يمكن أن يجعله مفعما بالذوق المحرك للمياه الراكدة في مخيلته.
صلاة إلى الحوز - قصة: عبد الحفيظ أيت ناصر
بلغت المأساة، بلغ الحزن والأسى المبلغ الذي تسقط معه كل الشعرية. هذه اللية الأولى بعد الفاجعة، استلقي في الفراغ، السماء بعيدة جدا، كم هي بعيدة سماء الجنوب، كم هي مليئة بالنجوم، لكن ما أبعدها. استلقي تحت شجرة زيتون، لا حرية في الأمر أبدا، على مبعدة من منزل لم يعد قابلا لأن يسكن، المسكن الذي كان يوما، قبل اليوم، الحضن والوطن، أصبح بعد الليلة المشؤومة مصدر الخوف واللاطمأنينة. الصغار يغطون في نوم عميق، ليس لهم بعدُ من علم الحياة ما يفسد عليهم نومتهم، لم يربوا بداخلهم بعد فكرة المنزل بالقدر الكافي، صغار يغطون في حضن الأمهات، وصغار يغطون في نومتهم الأخيرة، وقد حضنتهم الأم الرؤوم الأرض، واطفال يغطون في النوم لكن دون أم ما، وأم تنام بغير اطفالها.
في مجرد ليلة واحدة تغير كل شيء، تغير التاريخ، توقفت الحياة هناك وانتهت. الناس، من تمكن من عبور هذه الليلة، عبروها وهم فارغين، فارغين من كل شيء، وانكسرت الذاكرة، واختلطت على الناس كل الاتجاهات.
كان منظر الندى على الأشجار مليئا بالشاعرية، قبل اليوم كنت أخرج من البيت إلى البَحيرة، املأ نفسي ببعض جمالها، واليوم استيقظ وأنا الندي، قد سقتني الطبيعة نداها بنفسها، وقد سقاني غمام الصباح برده، أقسم أن لا شاعرية في المسألة أبدا.
أما مشهد الهروب من السكن الوطن لم يغادرني أبدا، صراخ الأمهات، والاباء، صياحهم في الأبناء، رعب اللاقدرة على رد الهول، معزوفة لا تغادر الأذن. لكن كل شيء بخير، وإن لم يعد أي شيء يشبه أي شيء.
انقسم الفؤاد بين قريتي المنسية في الزمن، وبين البلدة هناك، النائمة عند قدم الأطلس، حيث قضيت أيام فتوتي، ذاكرة مكان آخر خالط وجداني، وهو يكبر معي، المدرسة الإعدادية، المدرسة الثانوية، دار الطالب، وأزقة البلدة المنسية أبدا، البلدة التي لا يعرفها إلا ابناؤها، والأصدقاء.
البلدة التي فيها صَدَرَ لأول مرة الغطاء عن بئر لغتي، البلدة التي ما أكتب نصا إلا محاكاة لنص ما ولدته فيّ، في وجداني، هناك حيث حكاياتي مع أشجار التوت، وأشجار اللوز، حكاياتي مع ليالي نوفمبر الباردة، وربات شعري، وحبيباتي السبع، أقلامي، خطواتي ولعابي على أرصفة هذه البلدة النائمة عند قدم الأطلس.
الهروب الكبير – قصة: محمد محضار
"ارتَدّ إلي طرفي وهو حسير، وقد صدمه قبح ما رأى، واقع أليم، وزمن ساخر يتسلى بأوجاع من طالهم جُورَه وَجُورَ بني جلدَتهم من علية القوم
ونخبة النخبة، ممن يستنكفون إلقاء نظرة على من هم دونهم في الوضع والحال، ويسرفون في ذمهم و تحقيرهم دون أن يرِف لهم جفن، أو تتحرك في قلوبهم رجفة رحمة"
دَاهمهُ هذا الشعور الغريب وهو يلج مقهى " برغواطة" كما كان يحلو له أن يسميه هو لاعتبارات يراها موضوعية وتاريخية، أو "تامسنا" كما سَمّاهُ مالكوه وهم جاهلون –حسب منطقه- أنّ برغواطة وتامسنا صنوان لا يجوز ذكر أحدهما دون الأخر.
جلس في ركن قصي بمواجهة فسيقة المياه المزدانة بفسيفساء من زليج فاس، وضع رجلا على أخرى، وطلب كأس شاي كبيرٍ على الطريقة الشمالية، تلذذ برشف جرعاته، وهو يتنقل عبر الصفحات الفاسبوكية ،
مُستجليا أخبار فيضانات شرق البلاد، وأنباء الهروب الكبير لأهل شمال إفريقيا وجنوبها نحو الثغور المغربية المحتلة من طرف الإسبان، بحثا عن الفردوس المنشود، و الحياة الكريمة.
اقترب منه النادل فجأة ووضع أمامه كوبا من عصير الفواكه المشكلة،
نظر إليه مستغربا وقال : " أنا لم أطلب شيئا يا بُنيّ" ابتسم النادل ورفع يده مشيرا إلى شاب تجاوز الأربعين بشارب أسود وملامح مستبشرة، يرتدي بذلة رسمية لرجال الأمن وقال: " الطلب مُوجّه من الضابط "
كم يلزمنا من الوقت لنكون؟ - نص: عبد الهادي عبد المطلب
خارج الوقت..
"الوقت كالسيف، كالسهم، إن لم تنتبه قطعك"، بمعنى آخر، الوقت سيف مسلّطٌ على أعناقنا، إن لم نستغلّ دقائقه وساعاته، سيُجهز علينا ويجتزُّ رقابنا دون رحمة، فهل نحن، العرب، من قال هذه القولة ومقصودها؟ وهل قلناها في زمن كان للوقت ثمنه، أم قلناها لأُناسٍ غيرنا؟ هل نسينا أن التّاريخ يُسجّل، فأخلفنا وعدنا وموعدنا؟
فاض الوقت بنا، وعنّا، وأصبحنا خلف الرّكْب نتفرّج وقد تاهت بنا السُّبُل والدّروب والمسافات والطُّرق، وأصبحنا فائض الإنسانية، وانتهت صلاحيتنا حين انتهى وقتنا وانقضى، واصح الوقت عندنا فراغا وثالثا ودون قيمة.
قَطَعَنا السّيف أشلاء، وأصابنا السهم في مقتل، حين صنعنا لأنفسنا، نحن الّذين نُحسن الفُرجة والتّصفيق والضّحك لأتفه السباب، وقتاً للفراغ ووقتا ثالثا، كأنّنا أنهينا الوقت الأول بما يفيد الإنسانية ويُطوّرها، ولم يتبقّ لنا منه إلاّ ثالثا نستريح فيه من تعب ما لم نفْعلْ، ووقتاً للفراغ أفرغنا فيه كل ذرة كبرياء إنساني زَرَعَها فينا الأولون الذين كان وقتهم من ذهب، فأقاموا له محاريب للاعتكاف لتُزهر الإنسانية وتسير واقفة شامخة في شتّى المعارف والعلوم.
لنا من الوقت الفائض وما يفيض عن حاجتنا، لدرجة أننا لم نعد نعرف ماذا نفعل فيه أو به، أوقفنا حركته، ووقفنا حيث نحن، لا نزيد خطوة، بل نتقهقر خطوات، حين سار الآخرون مسرعين إلى الأمام، لا وقت لهم للوقوف والنّظر إلى الوراء ولا إلى من تخلّف عن الرّكب، ونحن في وقتنا نغوص حد النُّخاع في مستنقع الانتظار والتواكل والضحك البليد، والتّمايل المجنون مع الأرداف حين تتمايل، ومع البطون حين تهتزُّ، نجمع ما لا يُجمع، ونكتنز ما عافته الإنسانية ومجّتْه، لا نتذكّر أمسنا، ولا نتأمل يومنا وحاضرنا، ولا نتوقّع مستقبلنا، بل ننتظر دائما، نعيد اجترار أيامنا كذلك العُجل المقزّز الذي يمضي يومه كاملا يدفع كرة الرّوث، ولا يُحسن صنعَ شيء غير ذلك، إلى أن "ينتهي بنا الأمر إلى أن نُصبح مخلوقات من نوع آخر كان اسمه "الإنسان"، أو كان يطمح إلى أن يكون إنسانا، ومن دون أن يعي هذا، بالضّرورة، تغيَّر في شكله. إن التّغيّر الأكثر خطورة هو الذي جرى(ويجري) في بنيته الداخلية العقلية والنفسية"[1]
من الوقت ما قتل، وهذا ينطبق علينا، نحن العرب، حين اعتقدنا، بل آمنّا، أن الوقت ليس لنا، بل للآخر يكتشف لنا ويخترع، ونحن في زمننا العربي البئيس، نعيش على هامش الوقت، وهامش الإنسانية نضحك للقمر، ونردّد قولا فهمناه بطريقتنا، "ما فاز إلاّ النّوَّمُ"، فزنا انحطاطا وتخلُّفاً حين انْفَلَتَ من بين أيدينا الوقت الثّمين، وتركناه يسيح غير مأسوف عليه، لأنّ لنا من الوقت ما يسع النّائمين منّا، ويزيد عن حاجتنا، لنفعل كل شيء، إلا التّأثير في العالم، والمساهمة في بناء معارفه، وتغيير ما نحن فيه من ذل وتراجع وعبودية.