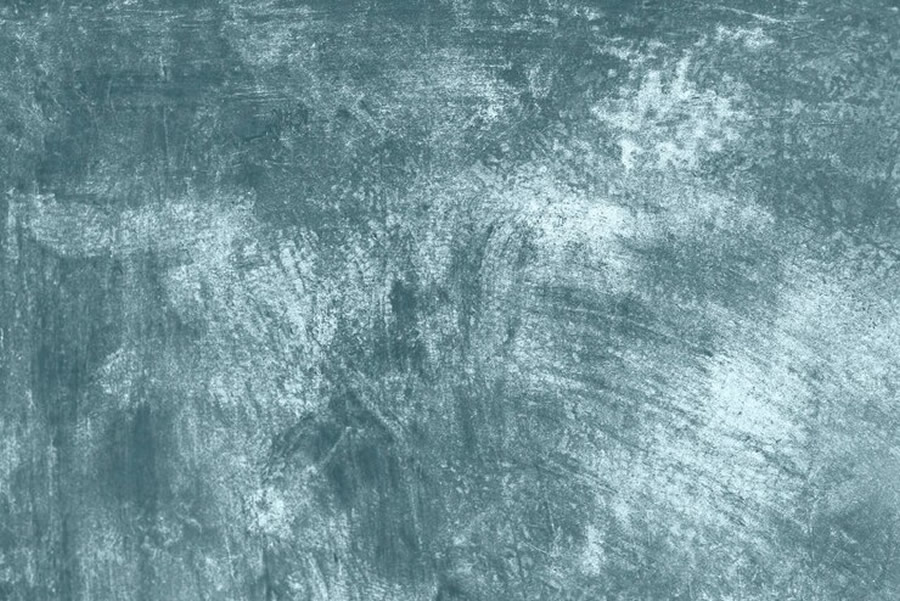بلغت المأساة، بلغ الحزن والأسى المبلغ الذي تسقط معه كل الشعرية. هذه اللية الأولى بعد الفاجعة، استلقي في الفراغ، السماء بعيدة جدا، كم هي بعيدة سماء الجنوب، كم هي مليئة بالنجوم، لكن ما أبعدها. استلقي تحت شجرة زيتون، لا حرية في الأمر أبدا، على مبعدة من منزل لم يعد قابلا لأن يسكن، المسكن الذي كان يوما، قبل اليوم، الحضن والوطن، أصبح بعد الليلة المشؤومة مصدر الخوف واللاطمأنينة. الصغار يغطون في نوم عميق، ليس لهم بعدُ من علم الحياة ما يفسد عليهم نومتهم، لم يربوا بداخلهم بعد فكرة المنزل بالقدر الكافي، صغار يغطون في حضن الأمهات، وصغار يغطون في نومتهم الأخيرة، وقد حضنتهم الأم الرؤوم الأرض، واطفال يغطون في النوم لكن دون أم ما، وأم تنام بغير اطفالها.
في مجرد ليلة واحدة تغير كل شيء، تغير التاريخ، توقفت الحياة هناك وانتهت. الناس، من تمكن من عبور هذه الليلة، عبروها وهم فارغين، فارغين من كل شيء، وانكسرت الذاكرة، واختلطت على الناس كل الاتجاهات.
كان منظر الندى على الأشجار مليئا بالشاعرية، قبل اليوم كنت أخرج من البيت إلى البَحيرة، املأ نفسي ببعض جمالها، واليوم استيقظ وأنا الندي، قد سقتني الطبيعة نداها بنفسها، وقد سقاني غمام الصباح برده، أقسم أن لا شاعرية في المسألة أبدا.
أما مشهد الهروب من السكن الوطن لم يغادرني أبدا، صراخ الأمهات، والاباء، صياحهم في الأبناء، رعب اللاقدرة على رد الهول، معزوفة لا تغادر الأذن. لكن كل شيء بخير، وإن لم يعد أي شيء يشبه أي شيء.
انقسم الفؤاد بين قريتي المنسية في الزمن، وبين البلدة هناك، النائمة عند قدم الأطلس، حيث قضيت أيام فتوتي، ذاكرة مكان آخر خالط وجداني، وهو يكبر معي، المدرسة الإعدادية، المدرسة الثانوية، دار الطالب، وأزقة البلدة المنسية أبدا، البلدة التي لا يعرفها إلا ابناؤها، والأصدقاء.
البلدة التي فيها صَدَرَ لأول مرة الغطاء عن بئر لغتي، البلدة التي ما أكتب نصا إلا محاكاة لنص ما ولدته فيّ، في وجداني، هناك حيث حكاياتي مع أشجار التوت، وأشجار اللوز، حكاياتي مع ليالي نوفمبر الباردة، وربات شعري، وحبيباتي السبع، أقلامي، خطواتي ولعابي على أرصفة هذه البلدة النائمة عند قدم الأطلس.
يا ما نمتِ يا حبيبةُ وسهرت فيك أرقب النجوم، أطالع كتابا، أكتب من اجل وريقات الحناء السبع قصيدة، أكتب رسالة طويلة لن تصل، وإن وصلت لن تُقرأ، إلى عروس شعر لن يُقدر لها أن تركب هودجا من القوافي من بعدي.
هنا كل شيء بخير، وإن كان كل شيء لا يشبه أي شيء، وها أنا قد ركبت الريح، ابتعد شيئاً فشيئا اتجاه البلدة المحبوبة، على مخرج الزمان المتوقف، انفجر نور الحدس بداخلي بصوت مفجع؛ لقد ماتت. فما دريت مما أخاف، لكنه حدس المتفرد بنفسه، صدق ولو بعد حين، سيتأكد، طفقت بما بقي في ركبتي من جهد أدفع عجلات الريح، كم هو ثقيل، على مبعدة من شجرة كاليتوس وقفت، على يميني صف من أشجار السرو الشابة، تقف وكأنها في مأتم، رسالة هاتفية وصلت، افتحها، أجد تأكيد خوفي ونبوءة حدسي، لقد ماتت.
لم أكمل الطريق إلى البلدة، عدت إلى قريتي أجر معي ما ولد فيّ من حدس، ماتت، لا تعليق آخر على الأمر، وإلا فهو سخرية من الأمر في مجمله، إنه الموت، إنه الحدث الأكثر جلالا، الشكل الأقصى من أشكال الحضور، حضور بكل تفاصيله، لكنك لا تقتدر على القبض عليه.
كانت تسكن كتبي، واقتباساتي المفضلة، وعباراتي التي اكتبها في الصفحات الأولى من كل كتاب جديد، حبي لجوامع الكلم، كانت تسكن قصائدي التي لم تُقرأ أبدا، وصار عليّ لزاما التخلي عنها، لم يعد ثمة داع لجمعها في الدفاتر، بعد هذا الحدث، إنها الورقة الثانية التي تسقط من وريقات حنائي اللواتي تعهدتهن بالشعر، واقمتهن بأقلامي.
الليلة الثانية، السماء مازالت بعيدة، وكذلك ستبقى في الثالثة، لا غيمة، وهذا مفرح في هذه الحال، أقضي الليلة مستلقيا تحت شجرة الزيتون، هل هي مباركة، لا شعرية في المسألة، لا رومانسية في الأمر، الناس هناك، أفكر وأنا مستلق تحت الشجرة المباركة، الناس هناك تبيت في الخلاء، في الشعاب، البرد، والخوف والجوع، لا أمن من جوع ولا أمن من خوف، لا أحد يفكر ماذا بعد غد، الكل يفكر، والناس كلها خائفة، الشتاء قادم.
كم هو بارد شتاء الأطلس الكبير، لا يرحم، ومتى كانت السماء تبكي أو تفرح، يا بعدا لاستعارة الشعراء، ولد شتاء الأطلس الكبير ليكون بتلك القساوة، بتلك البرودة، ولد لتكون رياحه عاتية، عاصفة، منذ البدء وهي تمتحن إنسان هذه الجغرافيا، بلدات وقرى منسية، محنط الزمان فيها.
لماذا يموت الإنسان بهذه الطريقة، لماذا يعاني بهذا الكيف، هل ابتكر انسان الحوز جغرافيا أكثر عنفا، أكثر قسوة، كي يمتحن قوته، صبره، جلده، وتحمله لصروف ونوائب الدهر وعواديه، أليس الإنسان من يخترع جغرافياه، لماذا اخترع انسان الحوز هذه الجغرافيا بالذات، يحمل انسان الحوز جغرافيا الأطلس على كاهله، إنه إنسانٌ أطلسٌ، يسقط العالم بسقوط هذا الـ أطلس، في صورة امرأة احدودب ظهرها وهي تحمل حزمة حطب، يشفق الجبل العاتي من حملها، إلا أن انسان الحوز انسان سعيد، لم يشتك يوما من هذا الحمل، وصخرته ليست مجرد صخرة تنفلت في كل مرة يُبلغها القمة، قمة الجبل، إنه يحمل الجبل نفسه.
سقط الجبل يوم تنهد إنسان هذه الجغرافيا، ليست السماء من حرك الجبل، إنه تساؤل إنسانه؛ من يراني.
الليلة الرابعة، أنا استلقي تحت شجرة رمان، شجرة رمان تحاول ما أمكن أن تساعد في حمل دالية عنب، وكذلك لا شاعرية في المسألة ابدا، فارغة من كل طعم، لا أجد تحت شجرة الرمان والثمار دانية، والعنب، أية سعادة من تلك التي تحدث عنها روسو، وإن كانت على غير مبعدة مني ساقية، فيا بعدا لخيال الشعراء، لا رومانسية في الأمر، ولا طعم للرمان والعنب.
قرّى تحولت إلى مقابر جماعية، والجو طافح بالأسى، بالضجر، لا نسيم يهبط من تلك القمم، السماء في كل ليلة تزداد بعدا، تزداد جفاء، النجوم تزداد غورا، فقد العالم، عالمنا، كل ألقه. أما أمزميز الحبيبة فلم تعد كما كانت ولن تعود، وذات أيام الحزن التي خيمت عليها، وقفت هناك، والركام، والزكام، ورائحة النواح، الزفرات تصَّعد من صدور لم تجد إلى الصراخ سبيلا، لا أحد يستطيع أن يبكي، كل الناس تريد أن تبكي، كل الوجوه تسأل، هل وقع حقا الذي وقع، هل مازلنا أحياء، لماذا نحن أحياء.
إنسان الحوز، إنسان هذه الجبال، أسس هذه الجغرافيا، وبروحه خطّ المكان خطّا، ورسمه بإزميل إرادته الصلبة على شاهدة الكون، كم شتاء مر على هذا الإنسان، وهو يؤسس ويخلق هذه الجغرافيا، وفي ليلة واحدة يهرب عنه المكان، وما أقسى هروب المكان، وما أقسى الطريقة التي يهرب بها المكان، هذا المكان. كان سيزيف سيبكي صخرته لو ضاعت، فهو ليس مجرد طفل أمام إرادة هذا الإنسان، إرادة خلقت شموخ جغرافيا بكاملها.
الليلة السابعة، الثامنة، التاسعة، ما زلت تحت شجرة الرمان، والناس في الفجاج، والصبيان والنساء، الخوف والجوع، والبرد، ما اقساه من برد بعد تلك الليلة، إنه برد يصيب الروح، كم من روح بردت، ولن تدفأ ابدا بعدها.
لقد كانت تحمل بين جوانحها أحلاما كثيرة، لم يتسع لها عمرها، لم يسعفها الوقت، لقد عاشت كالكثيرين وماتت مثلهم، عاشوا حياة مرجأة، في هذه الجغرافيا تنعدم أسباب الحياة، هذه الحياة المعلقة، التي تظل مؤجلة إلى أن تنفلت من بين الأصابع كما حفنة رمل خفيف، كانت تريد أن تصبح كاتبة ما، لكنها ارجأت الكتابة، تماما كما ارجأت الحياة.
لم يرجئ هؤلاء الناس الحياة لرغبة فيهم، بل لأن أسبابها كانت منقطعة، منعدمة، في هذه الجغرافيا المنسية في الزمن، لم يستطع إنسان هذه الجغرافيا، رغم كونه مؤسسها أن يجعل العالم يلتفت إليه، لم يستطع أن يجعل التاريخ يلتفت إليه، نسيه التاريخ، وقد كان مبدأه ذات يوم، وحين صرخ الإنسان، و لم يجد جبلا يعيد الصدى، تكلم الجبل نفسه وأحدث ما أحدث، فالتفت التاريخ مجددا إلى هذه الجغرافيا، إلى إنسان هذه الجغرافيا.
الليلة، لم أعد أعرف، لكنني أشعر أن عمرا كاملا قد مر، أما المكان، فما زلت تحت شجرة الرمان، لقد ألفت المكان، أحببته، صنعت معه ألفة من نوع آخر، لكني قد اكلت كل الفاكهة، فالوقت فائض والفراغ قاتل، فبدأت اشغل وقتي بأكل الرمان، ومراقبة الخواء الذي بداخلي يكبر شيئاً فشيئا، ويزداد اتساعا.
لقد التفت الزمان إلى هذه الجغرافيا، لكنه لم يلتفت إلا لينساها من جديد، تناولها التاريخ بعينه لا لشيء إلا ليحرف عنها أكثر مما كان، فتلك جغرافيا ضعف التاريخ، وهو لا يحب ضعفه، كما الإنسان تماما. أما الإنسان الذي صنع هذه الجغرافيا أقسم أن لا يتركها ابدا، لن يتركها إلا ميتا، فكم حملها على ظهره من وقت، الدهر نفسه لن يهزم عزم هذا الإنسان الذي لا يموت. أما عنفوان قمة التوبقال فليست إلا صورة على مثال شموخه وسموق إرادته، قد صقلت هذه الجغرافيا حكمته وصقلها، صانعها، صنيعها، وسيبقى حاملا هذا الـ أطلس على كاهله إلى أن تنتهي الأرض، ولم يبك يوما ولن يفعل.
شاءت قصة الحبيبين أن تنتهي بهذه الطريقة المفجعة، وهذا قدر حب حاول أن يربي زهرته في أرض لا تربي إلا الشوك، فإن كان امرؤ القيس استطاع أن يمر على دار حبيبته، ليبكي هناك، وكل دار حبيب هي كعبة ومبكى العاشق، ويقول قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل، فإن صديقي لم يستطع أن يفعل ذلك، لم يستطع أن يحج إلى بكاء الحبيب وبكاء المنزل الذي أصبح في ليلة وضحاها طللا، انمحت معالمه، لقد غادرت إلى الغياب الأبدي، وها هو لا يستطيع ولو بكاء طللها، حبهما كان سرقة من القبيلة، كان سرقة من الوقت، أحبا بعضهما في غير وقت الحب، فتنكر لهما الزمان، ولم يعشا حبهما إلا مرجأً، إلا معلقا.
ها هو ذا صديقي كالهائم، لم يستطع أن يصرح بحبه، فإن سألته عما فقد لم يستطع إلى الإجابة سبيلا، كيف يصبح فقدانه مشروعا، أي بيت فقد، أي مسكن فقد، أي حضن فقد، آه يا صاح والفقدان الصعب، الفقدان الذي لن يصدقك فيه أحد، لكنه فقد الحضن، فقد الوطن والسكن، وفي المحبوب وحده يصح قول الشاعر عذب بم شئتَ غير البعد عنك تجد.. وحينا، لم أدر ما غربة الاوطان وهو معي، وها هو صديقي يعيش في غربته الواحدة غربتين، في فاجعته فاجعتين، هذا قدر الحب المسروق من العرف، من التقاليد، من القبيلة، من المناجل، من السيوف والبنادق، وقدر وردته التي حاولت أن تكبر بين زمهرير هذا الزمن القاسي، يبدع الزمن في ضروب تعذيب الذاكرة، تتحول الذاكرة إلى صخرة، يحملها الإنسان على كتفيه، يرزح تحت وطأتها، وها هو صاحِ تطأ عليه، تقسو عليه الذاكرة، إن الزمن الشخصي ليس سوى الذاكرة، إنه حد الموجود، بهذا المعنى.
تلك شجرة لوز، لكنها ليست مجرد شجرة، تلك بابونجة تحاول أن تعاكس الشمس، اقحوانة تضاحك الصباح، لكنها ليست هي، إنها العناصر التي خالطت وجودها، يتحسر صاحِ ويعلن، آه والفقد الذي لا نستطيع أن نصرح به، لا تستطيع أن ترمي عنك ثقله إلى بني البشر، ولو على سبيل كذب ما، كم هي صعبة المأساة الشخصية غير المعترف بها، هذا هو الفقدان الصعب.
الليلة، لم اعد أعد الليالي، لكنني هنا تحت شجرة الزيتون، مجددا، الشتاء قادم، هكذا تتوجس الوجوه، لا أعرف إن كان الفلاح هذه السنة سيطلب المطر، لن تكون في المطر أية شعرية، لكن السماء ستمطر، وسيزيد برد الأرض بردا، إنها السّنة التي لا تتبدل. وتحت شجرة زيتون مباركة يقيم براهيم خيمته، هناك فرح من نوع آخر يطغى على المكان، إنه فرح براهيم بصنيعة يده، إنه يصنع لفراخه حضنا أو مسكنا، دافئا في الليل، ويقي شمس النهار القاسية، إنه يبدع في إقامة الخيمة، لكنه رغم هذا الفرح الغريب، يطفو على محياه من حين لآخر توجس غريب، يعرف أن خيمته لن تصمد أمام الرياح، وكم هي عاصفة رياح هذا الجبل العاتي، ولن تقف في وجه السيول، لن تحميه وفراخه من المطر، لكن على الفلاح أن يتجه إلى السماء بالدعاء، ويطلب الماء، يطلب الشتاء.
اليوم، عاد الناس، وخفتت الأصوات، وها هو إنسان هذه الجغرافيا يكابد مأساته لوحده، لقد أشاح التاريخ وجهه مجددا عن هذا الإنسان، ويعود إلى صمته المعتاد، ينظر إلى أطلال ذاكرته، إلى رسوم وجوده في الزمان والمكان، ثم ينظر إلى راحة يده، لم يستطع دفع الهول، وليس يستطيع أن يعيد ترميم الجرح.
من ولد هذا الإنسان، من أب ابن الأطلس هذا، إنسان بلا أم بلا أب، هو الأرض نفسها، ينبت من هذه الأرض، سقته السماء ، عمدته الشمس، وعلمته الحكمةَ الليالي، جاء إلى هنا مع مجيء الأرض، لم يسبق أحدهما الاخر، إنه الأرض والأرض هو، ولكن كم يحسد التاريخ الجغرافيا، لأن الجغرافيا دائما تستطيع ما لا يستطيعه التاريخ.
تستطيع الجغرافيا أن تنسى دون أن تنسى، تستطيع أن تكون حرة دائما، إن الجغرافيا ليست مملوكة إلا لنفسها، عكس التاريخ، ورغم قوته، رغم عظمته، فهو ليس موجودا في ذاته، توجد الجغرافيا أكثر من وجود الأولمب نفسه، فيا لقوة هذا الإنسان، فهو جغرافياه وجغرافياه هو، وكل ما دون الجغرافيا مجرد أطفال رضع، أما إنسان الأطلس الكبير، يمتد جسده امتداد الأرض نفسها.
يحسد التاريخ الجغرافيا، لأنها الصيرورة، إنها ما يصنع الصيرورة، لا يستطيع إذن التاريخ أن يرفض الجغرافيا، لكن ولأنه مجرد طفل في هذا الوجود يخال نفسه يستطيع ذلك، وهو في آخر المطاف مجرد طفل لم يخرج من قماطه، وليس يولد إلا في الجغرافيا.
ليست هذه المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيكوي فيها الدهر جبين إنسان الحوز بقطعة الحديد الحامية، لكنه يسير رغم حروق الجسد، رغم حروق الروح غير آبه
الليلة، لم أعد أعد، في الليالي التي قضيتها تحت اشجار الزيتون، كنت انام، الكلاب والقطط والحلوف والقنافد و أوحاش الليل بجانبي، وقد نمت بيننا ألفة غريبة أما اليوم فإني لا أستطيع النوم، بعد كل هذه المدة الطويلة وأنا افرش الأرض و ألتحف السماء، ها أنا تحت سقف من جديد، لكنني أصبت بالرعب، والأرق، وأصبحت تراودني كوابيس الزلزال لأول مرة منذ الليلة الأولى، بين غمضة وأخرى أحس بالبناء يتهاوى، عرفت أنه لا إنسان بعد الليلة، تلك الليلة، يعود كما كان، لقد رُدم من كل إنسان شيء ما، وكل وما فقد، ويا لبؤس الفقدان الصعب، ولكل انسان فَقدان اثنان، واحد يعلن وآخر لا.
ومات وهو على قيد الحياة، لأنه كان يرجئ الحياة، وذلك لموتها هي وقد كانت ترجئ الحياة، يد الدهر رسمت نهاية قصة عشق ولدت منذ زمن بعيد، اقرأ تأبين صديقي ونعيه حبه، ولكن حتى وهو يكتب لم يستطع أن يصرح، ويقول، ذاك قلبي مدفون هناك، هذا سهم الدهر صوب القلوب، وهذه قصة من قصص الزلزال، قصة إنسان الجغرافيا التي تسكن خارج التاريخ، على هامش الزمن.
يقف هذا الإنسان ينظر إلى رسومه، إلى ذاكرته، وقد سقطت، وقد سقط عنه الزمان وسقط عنه المكان، يقف ناظرا إلى راحة يديه، لم يستطع رد الهول، ولن يستطيع ترميم الجرح.