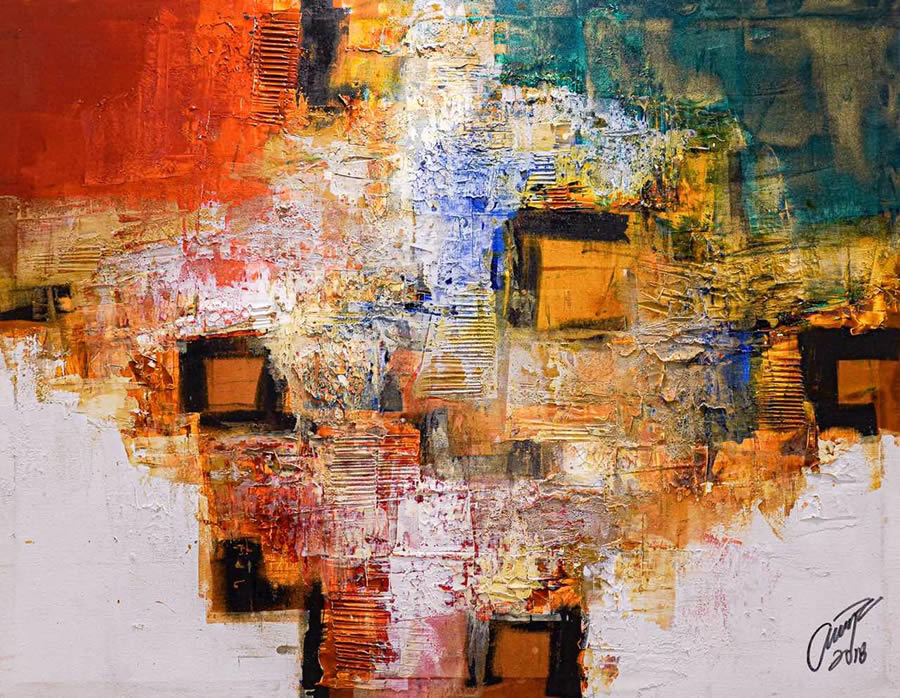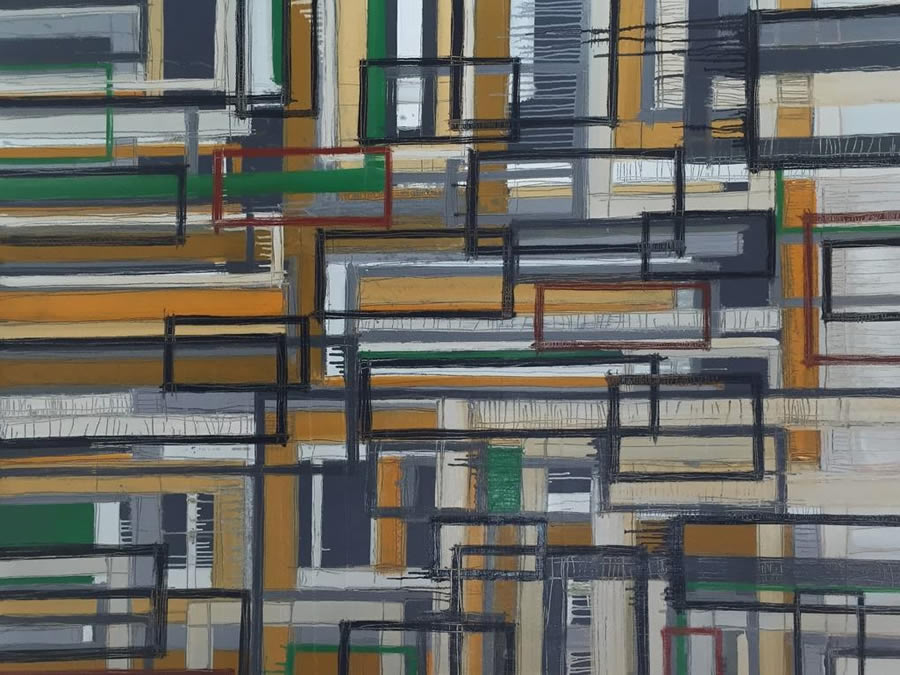خرج في صبيحة يوم خريفي، يجر قدميه متثاقلا بدون هدف، والرأس يضج بمئات الاصوات، وتتصارع فيه الهواجس والتساؤلات، ولكن الاحساس بالضجر والكآبة صار يسكنه بقوة هذه الايام..
لقد أضناه تعب الانتظار..منذ تخرج من المعهد وهو ينتظر..يحلم بالوعود ويتمسك بالاوهام..
في البيت كان غارقا في تأمل أوراقه، حين تناهت الى سمعه طرقات متسارعة على الباب..كأن الطارق في عجلة من أمره..وقف ساعي البريد محملا بكومة من الرسائل، حين بادره قائلا:
- «هذه رسالة لك يا أستاذ..»
تناولها عباس، وأخذ يتأملها مبتسما..
لقد اعتاد أن يتوصل بهذه الرسائل الجوفاء، كما يقول دائما، مثلما اعتاد أن يبعث طلبات العمل - بلا جدوى- الى المؤسسات الادارية بحثا عن وظيفة تلائم مؤهلاته العلمية.
الأجوبة يعرفها.. هي لا تخرج عن نطاق الرفض أو الاعتذار..
وطافت بخياله صور الماضي البعيد..أيام كان طالبا مايزال بالمعهد..«أي جديد هذا الذي تحمله الرسالة ؟ انها مثل الردود السابقة.. وانتظاراتك ستدوم طويلا.. وعليك بالصبر.. الصبر؟ وماذا عساك تفعل غير الصبر؟ انه سلاح الضعفاء..مضى وقت طويل على تخرجك ..وأنت تعلك الانتظار مع الايام..»
وضع الرسالة أمامه على الطاولة، وطفق يتأملها حائرا، ويفكر في محاولاته اليائسة للحصول على وظيفة، وراح يحدق في الفراغ شاردا..
وفكر..«هذه الرسالة قد تكون- بلاشك - جوابا على بعض مراسلاتك، مع احدى المؤسسات الحكومية في قطاع التعليم قبل شهرين..هل نسيت؟ ..أن تكون معلما أفضل لك من أن تبقى متسكعا.. تعلك أوهامك مع الفراغ..»
فقرر أن يقصد المكتب البريدي غدا لاستلام الرسالة..
الدرس الكبير – قصة: شعيب حليفي
سِحر المطر وهو يهطل بانسياب من السماء إلى الأرض تعبير لا يوصف عن السخاء الكبير الذي يعطي للحياة كل المعاني.. وما نُدركه منها يسير.
كل الدروس الكبرى تبدأ صغيرة، وتكتسب مناعتها من قدرتها على التكيف قبل أن تصبح درسا ثم فكرة وربما مثلا أو خاطرة وخيالا رائقا يجوب النفوس الصافية مثل غيمة شردت في بدايات فصل الشتاء، وهطلت في موسم الرعود منتصف فصل الربيع.
هطلت الأمطار فعادت الحياة مثل ثوب طاهر، لكن روائح كثيرة لم يستطع ماء السماء تخليصها منها: الجفاف الذي يواصل خنق الأرض للسنة الرابعة على التوالي، وآثار حرب الوباء في النفوس وبعدها مباشرة حرب فلسطين غير المسبوقة، ثم ضربة الغلاء الذي فاق كل التوقعات وجعل البسطاء والطبقات المتوسطة المُعلقة فوق هاوية بلا قرر، تحيا في ذهول أخرسها لحين، تستمع، وسط هسيس صخب مكتوم، لطقطقات الحبال وهي تتقطع سريعا.
- أليس الأمر مجرد تخيُّل بلا قيد.. لأن الحبال تقطعت منذ زمن سابق، ونحن الآن في سقوط حر تحوّل إلى حلم يتذكر الماضي الذي هو فوقنا ؟
- أقلتَ مجرّد تخيّل !!ومتى يبدأ الواقع عندك ونحن فيه غارقون؟
- نحن فعلا غارقون ولسنا غرقى.. وما نفعله..محاولة أخرى للبقاء فوق الماء.
- هذا كلام منطقي، ولو أننا فيه أشبه بحلم مختوم.
- انظر !!.. تحسس المطر الذي يغسل وجهي(من السخام). حتى ولو كنا داخل الحلم فلن نستسلم.
- ماذا تريد..؟ أحلامك تستغرقك كليّا..ها أنتَ تبحث حينا عن صالح بن طريف ثم تنتقل، حينا آخر إلى أبي يعزى وتجعل منه ثائرا ضاعت ثورته في قمة جبل تاغيا؟
- ماذا لو نؤمن بأن الانتفاض ضد الصمت، هو أشبه بمقابلة مصيرية، الانتصار فيها يليه تتويج تاريخي؟
للزمن مقالبُ – قصة: مالكة عسال
سلّ الوالد غصنها الفتي من حديقة التربية والتدريس، وكبّلها في سن مبكرة إكراها بقيد زواج، تجهل معه تماما معنى مسؤولية العش الزوجي، ولا لها معلومة عن لبناته، أو شروطه؛ قرار مفاجئ اتخذه دون سابق إنذار، خشية أن تأتيَه بكارثة، وتلطخ الشرف حسب ما ترجحه العقول الحجرية البالية، وتلوكه الألسنة المضمخة بالأمية والجهل...
على مضض، عانقت الصغيرة بسواعد من ألم، مصيرها المُرّ المرفوض، وتأقلمت مرغمة مع الوضع الجديد الذي يفوق طاقتها، تُقدم الخدمات لمن في البيت، وتهتم بأشغاله كما في اعتقاد البعض، أن مكان المرأة المطبخ، ومهامها الكنس والتنظيف ولا شيء أخر، تحت لافتة بالبنط العريض ((خادمة باسم الزواج،)) تلبي الطلبات في صمت، على نفس وتيرة أمها وجدتها الممتدة في سلسلة غابرة عابرة؛ لا حق لها في الرفض أو الاحتجاج، حالما تعرضت لإهانة، أو تحقير، أو ظلم، وإن فعلت فهي قليلة الحياء، ومحرومة من رضا الزوج..
اهتزت العائلتان طربا، لما علما بمولود ذكر سيزدان به الفراش ، الابن المنتظر من سيحمل اسم العائلة، الامتداد الأُسُري والسُّري على قاعدة مؤسسة بتمييز حاد، يوشح الأنثى باحتقار لئيم، النظرة الدونية الشرسة، التي مازال البعض يغذّيها بوعي جاحد، رغم أنه لا فرق في المشاعر والإحساس، اللهم الفارق الفزيولوجي...
هذيان – قصة: الحسين لحفاوي
ما زالت كلماتك ونحن نقف أمام مدرج الطائرة تتردد في مسامعي "الواقع هو ما عشناه، والحلم ما لم نبلغه بعد".
وها أنا أذكر تلك الكلمات التي ظلت موشومة في الذاكرة رغم كل هذه السنوات التي مرت على ذلك الواداع البغيض الذي لم يخلف في النفس سوى لوعة مكتومة وعبرة ظلت معلقة في المآقي لا تروم نزولا.
الآن، وبعد أن ذبلت أوراق العمر ولم يبق من هذا العمر أكثر مما مضى منه، يعيدني رنين صوتك إلى تلك السنوات التي حلقنا فيها على أجنحة الأحلام.
الآن، وبعد أن طوحنا معا، وانتقلنا سويا من فرح إلى فرح، تقف كلماتك بين الوهم والحقيقة، تغوص بي عبر بحار عميقة، وتحلق بي عبر فضاءات رحبة، تعانق أشعة الشمس وتراقص دارة القمر.
ها نحن أخيرا نقف وجها لوجه، أمنحك شوق السنين التي خلت، وتهبينني ذكرى ساكنة في القلب وبين ثنايا الروح، حلمان أبحر كل منهما في اتجاه و التقيا أخيرا ومصادفة على شواطئ العمر الزاحف بنا نحو القبر.
يتكرر المشهد أمامي، وتعاد الأحداث، فما أسرع احتفال الذاكرة بالماضي، أراني وأنا أفتح ذراعي لاحتضانك وأنت تطئين أرضي بعد رحلة طويلة قضيتها، عبرت فيها حدود العالم، وقضمت أنا خلالها الحديد بعيدا عنك، تحاصرني ذكراك ويطربني الشوق إليك.
جاءني صوتك هذه المرة متمردا ثائرا، لحنا سيمفونيا هز المشاعر وألهب الأحاسيس وهدهد الروح. اضطربت عندما سمعتك تقولين: "آن الأوان لنخطو أولى خطواتنا نحو حلمنا". وبين ذلك الوداع وهذا الاستقبال مرت سنوات العمر وعبرتُ خلالها من حزن إلى حزن.
ما في القنافذ أملس - قصة: الطاهر كردلاس
( يغلب عليها حرف القاف لقوته وقلقلته بين الحروف )
قال "قاسم" لصديقه "قدور" لقد قضَّني الحَنَق في مرقدي ياصديقي من نقض الحقوق والقوانين وسحقها في أقاليم وأقطار العقوق والمروق..
والمتفاقمة من أقصى الشرق وبقاع سمرقند والعراق – أرض الشقاق- والقوقاز إلى أنفاق قمعستان وقيرغيزستان القريبة من القوقاز . حتى إن الطبقات المسحوقة برحيق الاسترقاق والتي تئن من تضييق الأرزاق ، لا قبل لها بثقلها على الأعناق والأحداق والأشداق..
قال "قدور" : ياصديقي المقرب الى قلبي الحق حق ، فلا يقبر أو يقهر.. ولا يستحق أن يستقر في قرار سحيق .. أو يلقى في قعر عميق..
الحقوق والقوانين قميئة أن تتوافق مع الواقع وإلا انقرضت وانسحقت..
فلا تقلق ياصديقي قاسم.
قال "قاسم" أتفق مع مقولتك أن الحقوق قميئة بتوافقها مع الواقع..
مذكرات زوج مفكر في بلاد الفايكنغ – نص: زكية خيرهم
في مغامرات طفولتي المزهرة، كنت أزرع في قلبي بذور التذمر، مراقبًا كيف تتفجر الشرارات لتقزم لعبي وتمسخ أفكاري، كمن يرسم بالفحم على جدران ذاكرتي. كنت كبرعم غير متفتح بعد، يتساءل في جدية كوميدية: "هل أنا من كوكب آخر؟"، غير قادر على تحديد موطني في هذا الكون المترامي الأطراف. أذكر كيف كانت ضحكاتي تنطلق، لا من الفرح، بل من روح تستهزئ بكل شيء، من الأفق اللا متناهي إلى السماوات الشاسعة، متمردًا على النسيم، محتجًا على الدموع الغادرة التي تسرق الفرح من عيني. كانت أفكاري المشتتة - من الأحكام إلى القيم والمبادئ - تبدو كقيود تثقل كاهلي، تخنق براعم الحرية لدي وتكبل أجنحة الإبداع. كثيرًا ما كنت أتساءل، في لحظات فكاهية ذاتية، لماذا أنا، من بين كل الناس، أرى ما لا يرون وأشعر بما لا يحسون؟ هل لأنني مخلوق فضائي، أم لأن هذا الأنف الكبير الذي كان مصدر تسلية أخي قد منحني هذه القدرة الخارقة؟ وبفضل تفكيري العميق، أهداني القدر صلعًا مبكرًا، تاركًا لي خصلات قليلة يتيمة، تحاول بشجاعة أن تضيء ظلمة الليل كنجوم قليلة وخجولة. في أحضان أسلو، تلك المدينة اللطيفة التي لم تكن قط في قائمة أمنياتي السياحية، وجدت نفسي ضائعًا في كوميديا الأخطاء، حيث الثلوج تتنافس على منح أفضل عرض للجمهور والليالي طويلة كمسلسلات الدراما التركية. بدأت هنا مغامرة لم أسجل لها في دورات التدريب، فصل جديد يضع "المغامر" بدلاً من "النبي المزيف" على بطاقة تعريفي. أهلًا بك في النرويج، حيث الأحلام تتخذ شكل فطائر الوافل والحياة ملونة ككرات الديسكو. في أيامي الأولى، كان كل شيء يبدو كأنني انقلبت من كوكب آخر، من السكان الشقر إلى الطبيعة التي يمكن أن تكون بطاقة بريدية. وأنا أتجول في أسلو، تلك المدينة العريقة بمبانيها التي قد تعتبر معالم تاريخية أو مجرد مراكز تسوق قديمة، كنت أحاول استيعاب هذا الكوكب الجديد. من الأضواء التي تزين المدينة كأنها تحتفل بعيد ميلادها كل ليلة، إلى الناس الذين يحملون قصصًا قد تصلح لمسلسل أو فيلم وثائقي عن "سكان الشمال. وأنا، ذلك الغريب الذي يبدو كشخصية من كتاب طبخ عالمي، تعلمت لغتهم، وغصت في ثلوجهم، وحاولت أن أفهم إذا ما كانوا يضعون الكريمة على كل شيء كما يفعلون مع القهوة. وفي أعماقي، كان هناك هذا النقاش الداخلي الطريف: هل أنا هنا للبقاء أم مجرد زائر يتساءل عن مكان البيتزا الجيد؟ في الليل، بينما أتأمل الأضواء الشمالية التي تبدو كحفلة ليزر فاخرة، كنت أجد نفسي محاطًا بالغربة، تلك الغربة التي تجعلك تتساءل: هل كل هؤلاء الناس يشعرون بالبرودة مثلي أم أن لديهم جينات مضادة للثلج؟ في نهاية المطاف، بينما كنت أقارن بين النرويج وبلادي، بدا لي أن الحياة هنا تمزج بين الحفلات والاحتفالات بالنهار القصير والليالي الطويلة التي تعطي فرصة لمشاهدة المزيد من الأفلام. وأدركت أنني، على الرغم من كل شيء، قد وجدت في هذه الأرض مكانًا يمكن أن أسميه منزلاً، حتى لو كان الجيران لا يفهمون مزاحي دائمًا.
نـاديـــن – قصة: أمينة شرادي
صرخت وسقطت أرضا. غابت عن الوعي، اقتربت منها ابنتها نوال، حاولت اسعافها. ارتبكت، بحثت عن هاتفها، اتصلت بوالدها. هاتفه مقفول كالعادة. عندما يغادر البيت الى العمل أو المقهى، يقفل هاتفه ولا يهتم باحتجاج ابنته أو زوجته التي قالت له يوما في عز غضبها " أكيد سأموت بسببك. كيف سنتصل بك إذا كنا بحاجة اليك؟".
اتصلت نوال، بالإسعاف وهي ترتجف وتنام بين الغضب والخوف والحزن. كان لصراخها وخوفها على والدتها "نادين" الأثر القوي على ذلك الصمت الليلي الذي كان يخيم على المكان. سألتها جارتها: "أين والدك؟" احتارت في الإجابة، ونامت دمعة ثائرة بين مآقيها، وقالت محاولة تلميع صورته:" انه مسافر، لقد اتصلت به وسيحضر بعد قليل."
مكثت طوال الليل الى جانب والدتها نادين، تمسك يدها وتحضنها. وفي نفس الآن، تلقي نظرة على هاتفها ربما يحن والدها لصراخها الذي مزق هدوء ذلك الليل الصيفي. ظلت نادين، غائبة عن الوعي، لكن رفضت ابتسامتها التي لازمتها في أحلك أزماتها معه أن ترحل، كأنها حارسها الأبدي من كل مكروه. فتحت عينيها ببطء شديد، نوال ابنتها على جانب السرير وهاتفها بين يديها. مسحت بيدها على رأسها كأنها تقول لها، "أنا ما زلت معك، لا تخافي انني اقوى من غياب والدك."
كان يوما خاصا، لا يشبه باقي الأيام العادية بالنسبة لنادين. يوم التقت بزوجها أحمد. كانت تركض في الشارع وتصرخ بكل قوتها الى جانب باقي المتظاهرين رافضين التضييق على حرية التعبير. نادين، كانت تخطو ببطء في عالم الصحافة، تهتم كثيرا بكل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وتحلل وتطرح الأسئلة كمن يبحث عن ابرة في قش. كانت ترفض أن يزج بها في الجريدة بخانة الطبخ وتموت كل طموحاتها السياسية والفكرية. الكتابة بالنسبة اليها كالهواء والماء، لا تستطيع أن تتنفس من دونهما. كانت تجري وترفع صوتها، يعلو في الفضاء كسهم محارب يدافع عن أرضه. أثناء المسيرة الاحتجاجية، اقترب منها شاب وسيم ويظهر على ملامحه الجدية والمسئولية. سلم عليها وقال لها" ان حرية التعبير هي عنوان تقدم الشعوب." ابتسمت وتابعت سيرها العنيف الذي يحمل رغبة شديدة في تغيير الوضع المأزوم. كانت تدك الأرض برجليها دكا، كأنها ترغب في اختراقها واخراج ما بباطنها حتى تختلط الأشياء وتولد البلد من جديد. لم تجبه، ظل ماشيا الى جوارها. وقال لها " أنا أيضا كنت من المؤيدين لهذه المسيرة الاحتجاجية."
طل يوم جديد على نادين وهي بالمصحة، نوال ابنتها نائمة الى جانبها على سرير آخر. فتحت عينيها وهي تتأمل أن تجده الى جوارها وتفرح بتلك الابتسامة التي أسرتها يوما. جالت بنظراتها داخل الغرفة، كأنها تبحث عن شيء مفقود منها. رمقت ابنتها، نائمة بشكل غير مريح، من شدة التعب والخوف. فهي لم تفارقها وكانت كالمجنونة تريد أن تفهم ماذا أصابها بتلك السرعة. مسحت الغرفة من جديد بنظراتها المتعبة ثم توقفت عند الباب، ربما سيطل بعد قليل، ويرتمي بين يديها ويقبلها ويطلب منها العفو لأنه كان مشغولا وكان هاتفه مقفلا.
بعد انتهاء المسيرة، كانا قد تبادلا رقمي هاتفيهما، وتواعدا على اللقاء. كثرت لقاءتهما وتعودا على بعض. و لا يمكن أن يمر يوم دون أن يلتقيا. استيقظت نوال مفزوعة على صوت الممرضة التي أتت تبلغ والدتها بأن حالتها قد تحسنت ومرحلة الخطر قد عدت. بكت كثيرا من فرحتها وقبلت أمها التي كانت بالأمس بين الحياة والموت. استسلمت نادين، من جديد الى حنين الأمس وتركت الحرية لنظراتها ترحل وتنتظر قرب باب الغرفة على أمل أن يظهر أحمد. ستغفر له كما عودته على كل هفواته وغياباته. ستغفر له صمته الطويل بالبيت وانزواءه بغرفة الجلوس مع هاتفه. ستغفر له اقفال هاتفه كلما غادر البيت كأنه يرغب في الانسحاب من حياتها والذوبان في عالم آخر. ستغفر له لأنه الحب كله بالنسبة اليها. وكان دائما يقترب منها ويحضنها ويهمس لها بين أنفاسها على انها هي الحب كله. وتبتسم وتبدأ صفحة جديدة كمن يولد لأول مرة ويرى الدنيا بعينين حالمتين باحثتين على الأمل والحياة. سألت نوال بصوت يحمل أثار الألم والحزن: "ألم يتصل والدك؟"
نظرات نوال قلقة لأنها كانت تتمنى أن تسمعها الجواب الذي ترغب فيه. لكنها حاولت ان تختار أحسن الكلام، حتى لا يكون صدمة قوية على روحها كمن سقطت عليه صخرة من أعلى قمة جبلية، وقالت لها "أكيد سيتصل يا ماما، أنت تعلمين أنه يقفل هاتفه كلما خرج من البيت. أكيد أن هاتفه مازال مقفلا."
لكن نادين كانت تدرك في قرارة نفسها بانه بالبيت. وبأنه سعيد هناك لوحده، وبأنه يعد طعامه لوحده، وبأنه يتنقل بين التلفاز وشاشة هاتفه. أو ربما فرح فرحة العمر لما ولج البيت ولم يجد من ستمطره بالأسئلة التي يكرهها ويعتبرها كاستنطاق بوليسي. أو أنه نائم كما تعود دائما، لما يعود في آخر الليل ويدلف داخل غرفته وينام. ظلت حبيسة أسئلتها وتكهناتها طوال اليوم. تحسنت حالتها وأمر لها الطبيب بمغادرة المصحة على أن تهتم بصحتها كثيرا وتبتعد عن كل الضغوطات.
كانت مستلقية على السرير في انتظار ابنتها، سافرت بذاكرتها خارج الغرفة، توالت المسيرات الاحتجاجية السلمية والرغبة في تغيير الحصار المفروض على حرية التعبير التي أصبح كالكمامة على الأفواه. كان هناك الى جانبها، هتافات ولافتات وحماس شعبي ترتعش له الأبدان والعقول. في لحظة جد مفاجئة، حوصروا برجال الأمن وتم القبض عليهما على أساس أنهما يساهمان في الفوضى والشغب. تم الافراج على نادين فيما بعد وظل أحمد محبوسا أسبوعا كاملا. تذكرت كيف كانت تقضي يومها وليلها في انتظار الافراج عنه. شاخت قدميها ودمت أصابعها من كثرة الوقوف والذهاب والإياب. لم تمل ولم تيأس لأنها كانت مؤمنة بقضيتهما وكانت مؤمنة أيضا أنهما يمارسان حقوقهما الدستورية ولم يساهما في أي شغب. بعد أسبوع، كانت هناك، تنتظره، وجدت عددا كبيرا من الناس فيهم الأب والأم والأخت والصديق، كل واحد جاء يحمل بين يديه قلبه في انتظار سماع خبر الافراج الجماعي. تجمهر كبير، حجب عليها الرؤيا، رؤوس تتمايل يمنة ويسرا، تتعالى في الفضاء، أيادي تنادي وأصوات تصرخ. اشتبكت الحناجر والأحاسيس واهتز المكان. كل واحد ينادي على قريب له. حالة من الذعر والفرح والدموع. كانت نادين في آخر الصف، تنتظر وتترقب كمن ينتظر نتيجة الامتحان. طل بقامته الطويلة وشعره المشعث، كانت تحب فيه هذه الفوضى المستوطنة لجسده، كان لا يهتم بتناسق الألوان في لباسه، ولا بتسريحة شعره، كان يعتبر كل هذا ترفا لا فائدة منه. كان يبحث بين الجموع عليها. سرت قشعريرة بين ضلوعها وارتفعت نبضات قلبها وانطلقت كالسهم تخترق الصفوف وتبحث عن منفذ يوصلها اليه. سمع صوتها، التفت، ارتمت بين أحضانه وتمنت ساعتها لو أن الزمن توقف حتى تعيش تلك اللحظة القوية وتختبئ بين ضلوعه. قبلها وقال لها" لم أكن أدرك أنني أحبك كل هذا الحب؟".
دلفت نوال داخل الغرفة، تساعد والدتها على جمع حاجياتها ومغادرة المصحة. سألتها من جديد، وصوتها يحمل كل الأمل " هل اتصل والدك؟" ترددت نوال في الإجابة، حاولت أن تغير دفة النقاش مستغلة وضعها الصحي وما قاله لها الطبيب. لكن صمتها أشعل النار بداخل قلبها المرهف، وأعادت السؤال على نوال. توقفا قليلا خارج باب المصحة، في انتظار سيارة أجرة. حضنت نوال والدتها وقبلتها وقالت لها" أعلم أنك تتألمين لغيابه الدائم وعدم اهتمامه بك أو بنا، لكن يا أمي، والدي حنون جدا وطيب جدا غير أنه له طبائع لا تحتمل. أرجوك، لا تهتمي. أنا معك"
كانت نوال تعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد جعلت منها الأيام الماضية، شاهدة على صراع مستمر بين والديها وخصوصا غياب والدها المتكرر واقفاله لهاتفه كأنه يتحلل من كل مسئولية. لم تفهم سبب سلوكه حتى نبتت برأسها فكرة التجسس عليه. فهي تخاف من الغد الذي لا لون له، فأصعب شيء على النفس هو عدم معرفة المجهول الآتي. فهي تحب والديها وتخاف على أمها من الانهيار. وتكره كما يكره كل مظلوم أن يعاقب ظلما، أن يفترقا يوما وتعيش بين بيتين وعطلتين وحياتين، فبيت الأسرة هو وطنها الذي تعلمت فيه أولى خطوات الحياة، ونطق فمها أولى الحروف ولعبت فيه أولى لعبها. فهي ترفض بتاتا أن يهدم أو يبنى في مكانه بيتا آخر. "الوطن لا يموت "كانت تهمس دائما لروحها لما تكون تقتنص بعض لحظات الراحة والمتعة النفسية بعيدا عن كل ضجيج وصداع الرأس. لكن هذه الفكرة لم ترق لها، هل تحادثه في الموضوع حتى تفهم ما يجول بخاطره. ظلت حبيسة حيرة استوطنت عقلها وسلوكها، حتى وهي في المصحة مع والدتها، كانت الأفكار تطاردها كما يطارد المجرم من العدالة.
غوص - قصة: الحسين لحفاوي
القاعة فسيحة ومضاءة بنور باهر متناسق مع الألوان التي طليت بها الجدران التي تفنن التلاميذ المفتونين بالألوان في تزويقها رفقة أستاذ الرسم الذي جمعهم في ناد يمارسون فيه أنشطتهم الإبداعية. تدافع التلاميذ على الدخول. علا الضجيج وارتفع اللغط كل يبحث عن الرقم الملصق على الركن الأيمن من المقعد. حِيزَت الأماكن وتناثروا فوق المقاعد وأطبق على القاعة صمت، تطلعت العيون إلى الظرف المختوم بين يدي الأستاذ. كان كل التلاميذ في لهفة لمصافحة ورقة الامتحان. بعض العيون اخترقت الظرف وتسللت إلى الكلمات تتهجاها تسترق النظر علها تلتقط بعض الحروف. شردت الأذهان وبحلقت العيون. وفجأة دق الجرس معلنا بدء الحصة، فازداد نبض القلوب وارتفع صوت وجيبها وخيم الصمت على القاعة فلم يعد الأستاذ يسمع غير الأنفاس تعلو وتنخفض. صوت نزع اللاصق من على الظرف بدا كمثل هبة ريح قوية ارتجت له الأجساد وتردد صداه في أرجاء القاعة.
سُحبت الأوراق من داخل الظرف في حركة عمد الأستاذ إلى جعلها تثير مزيدا من التطلع في نفوس أعياها الانتظار. وبدأ توزيع الاختبارات على التلاميذ. ما إن وُضِعَت الورقة الأولى فوق طاولة التلميذ الذي قُدِّر له أن يكون مجاورا لمكتب الأستاذ المراقب، حتى بدأت الوشوشات، وتحول الهمس إلى كلام مسموع. سرت كلمات مشفرة بين الممتحنين. تحركت الشفاه فالتقطت الآذان المرهفة تلك المبهمات وفكت شفرتها: النمذجة، الهوية، الفن.
صمت مطبق يعم القاعة من جديد، لحظات اكتشاف وتجلٍّ وانصبت العيون على الأوراق وانشدت الأذهان للكلمات، وراح التلاميذ يقرؤون الأسئلة، يتأملون ويتألمون. ارتفع صوت من وسط القاعة يشق الصمت الذي كان مخيما "عَوْجُونا"، علت على إثره الهمهمات واختلطت المشاعر بين مستبشر ومتذمر. نقر الأستاذ بأصابعه نقرات خفيفة على المكتب فعاد الهدوء إلى القاعة. بعض الوجوه علاها الوجوم، وطفت الفرحة على أخرى. لكن لا مفر، على الجميع أن يفكر، أن يكتب، أن يحلل، أن ينثر أفكاره ويعرضها، أن يُجري الامتحان.