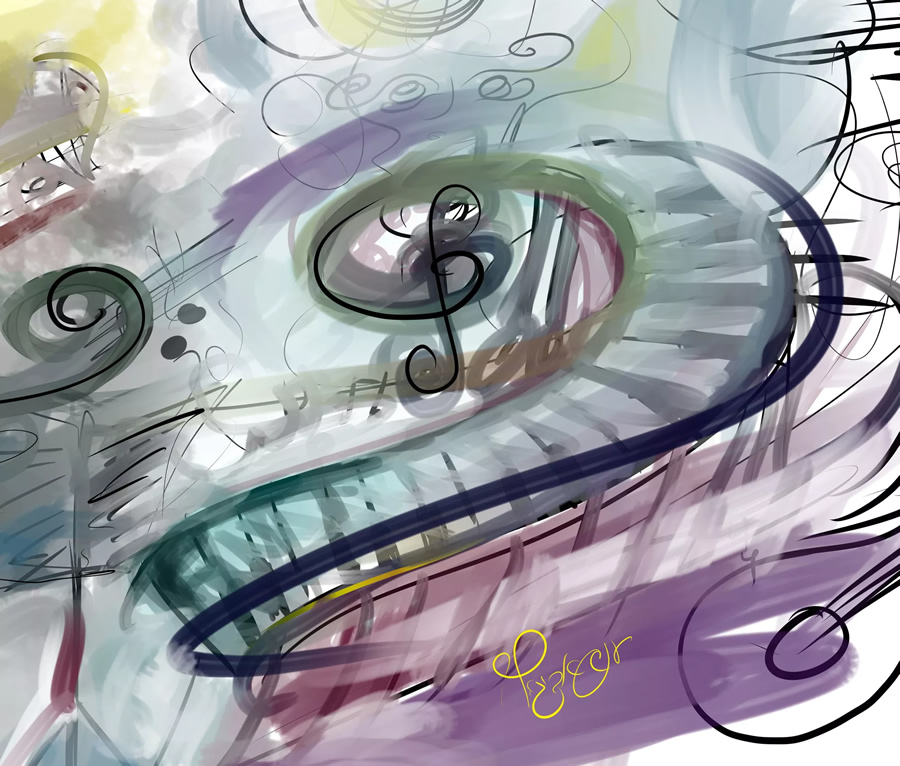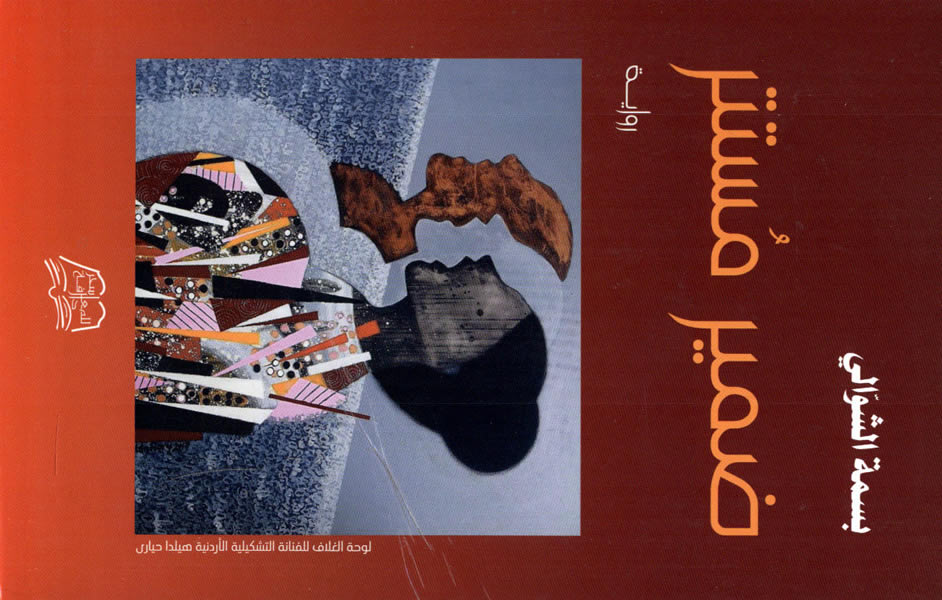- ولا عثرتُ على شيء منها سيّدتي وإن شِلْوًا ينزع، أو ضراعة تتعلّق بتلابيب النّجاة.
صوتي عتيّ الوثوق ترضرض على أحرف الاعتراف الحِداد، وأناخ عاتقي ذلاّ لوِزْر الخيبة الكشيفة فيما تضايق قلبي يظنّ أنّ جهاز استخبارات ما اطّلع على خياناته فتُفعل به فاقرة الآن أو بعد نصر مجيد.. لقد كان اللّعين يرقّ بين مشهد ضريج وآخر فيقترف خطيئة الحنان. وفي غفلة من قادتي الأشدّاء، كان يزورّ بي عن لذاذة الفرح الذي نمّقته الحرب بجثث الأعداء المشتهاة ويتخاذل للبكاء.. وكان صوتها صغيرا جدّا، وجدّا ضعيفا يتناهى من كوّة بين أكوام المباني لم تنتبه له عيون المغيثين، ولا وقعت عليه فرق الإنقاذ إلاّ أذني الخائنة..
أولى له ذا القلب..
لا بدّ أنّه كافر، أو قُذف بروح شرّيرة يَدِين للشّفقة الحرام لمّا الرّبّ يُولم على شرفنا محرقة عظيمة خبزها الأجساد الأشرار وخمرها الدّماء الخبيثة.. لمّا الصّوت يخترق الغليل المبارك بالنّداء..
“ماذا يحدث يا أمّي..؟ أين أنت..؟ نونو عالقة تحت شيء ثقيل.. اِنطفأ المصباح يا أمّي.. لا أراك.. أسمع ريما تبكي بشدّة. تعالي ماما.. أنا خائفة.. ريما كذلك خائفة ونونو عالقة تحت شيء ثقيل.. ماما أين أنت..؟”