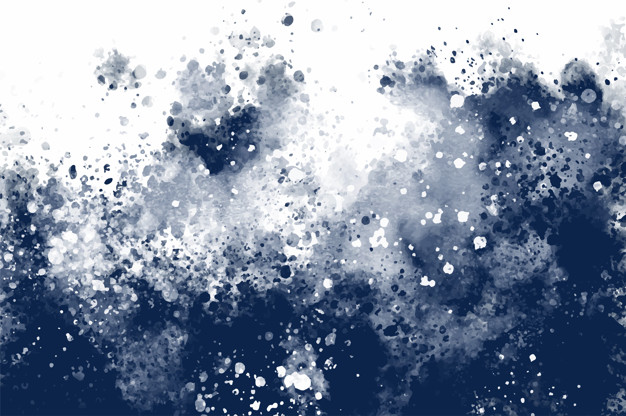( نداءُ الرّيح الأوّل )
النساء بهاءٌ من الحياة القاتل ، إكسيرُ الدُّنيا المعتَّق بالزّهر والمطر والرّياح !!
المرأة ككلّ كائن سحريّ ....لا تنحتُه سوى الذكريات ...لا ترسمه إلا التفاصيلْ ....
تلك التفاصيل الصغيرة التي تنفذ إليك كبداية الموت أو بقايا الحريقْ !
تلك التفاصيل العذبة : رقصةُ الأهداب....ارتعاشُ الأصابع ...حركة امتعاضٍ على الشفتيْن ...التفاتةٌ عجْلى على الرصيف ....يدٌ أتلفها الصقيع فمضت تبحث عن قبلةٍ في ثنايا المعاطفْ .....خاتمٌ شامخٌ يحيط إصبعا من كبرياء .....أناملٌ من عاج تُسوِّي خصلة شعْرٍ تُهرول في خِفّة لتعانق نسائم الصباح ......نظرةٌ مبتلَّة كالشتاء ، مُعلَّقةٌ بشبّاك قِطارٍ ، سيَرْحل ويحْملُ صخَب أحزانه بعيدا ، بعيدا .....كعبٌ صينيٌّ شامخٌ يحْتسي جراح طريقٍ أنهكه انتظارُ العاشقينْ ...!!!!!!!!
ذو العـُثنون ... يَحكي حكايته الأخيرة – قصة: رشيد سكري
ـ 1 ـ
تأخُذنا الرَّجفة من حيث لا ندري ، فترتعد فرائصُنا عندما نسمع اسم " مولانيي " ؛ القائد و الجنرال الفرنسي ، الذي تمَّ تعيينه مباشرة بعد الحماية الفرنسيَّة على المغرب . كانت شرارة الحرب العالميَّة الأولى السببَ المباشرَ في تعيين هذا الجنرال قائدا جهويّا على قبائل زمور. تعلـّم دروسَ الاستبسال من جبالها الوعرة و من قبائلها المتفرقة و المشتتة على طول الخط الناظم و الرفيع الذي يربط مدينة خنيفرة بمدينة الخميسات إلى حدود قبائل آيت يدين ومصَّغرة و آيت عبو . منطقة تدور رحاها على يد القوات الفرنسيَّة .
بداية ونهاية – نص: محسن العافي
البدايات كأنها أزمنة منسابة لا تترك على متنها متسعا من وقت ثالث لنتسلل عبره، وحدها النهايات تعلن بدايات جديدة هنا وهناك ، والكلمات المنبعثة من جوف الحياة باتت معدودة، وبعض الكلام أزلي لا محدود في الزمن، وبعضه الآخر غوغاء تغمر العالم من حولنا، حيث لا فائدة م نه ولا أثر يذكر غير بعض مداد ضائع ، لا يكتب جديدا ، ولا يذكر حياة.
في الماضي دلالة على كيفية قطع الألف ميل مشيا على الاقدام،وباقي المشاكل العالقة لا جدوى من محاولة حلها ، ولن يحاول ذلك أحد أو يجازف
إلا عبر كلمات يدوي صداها عاليا ،و قد يقول سياقها:
حنّاء و أريجُ القبورْ – قصة: خيرالدين جمعة
لا أحد يعرف سرّ شجرة الحنّاء إلا ّ أمّي ...تلك الشجرة الواقفة في بيتنا بخيلاء الفاتنات و صمت الملائكة!
لا أحد في قريتنا له شجرة حنّاء مثل أمّي ..كل الناس كان لديهم الكثير منها و لكن ليس في مثل حجم شجرتها ..لأنهم كانوا يُشذبونها لتنتج ورقًا أكثر فتدرّ عليهم أرباحًا لابأس بها حين يبيعونها في سوق القرية الأسبوعي... لكن المال كان آخر ما تفكر فيه أمّي إذ كان لديها واحدة فقط تتعهّدها بعناية فائقة فتسقيها الماء و تمسح جذعها الصغير و تنظّف أغصانها و تنزع الحشائش من حولها و لكن لا تقصّ أغصانها أبدا و تجد متعة كبيرة حين تقف ويداها ملطّختان بالطين تتأمّلها وهي تكبر و تزداد طولا ... سرّ أمي الغائر كان غافيا في تلك الشجرة.... ترويه أوراقها للرياح مع كل حفيف!... فإذا كانت سعيدة تجلس على سجّاد صغير تحت تلك الشجرة و أمامها أواني الشاي الأحمر و إبريقها الأزرق نائم على جمر الكانون في دعة و اطمئنان ، أمّا إذا كانت حزينة فإنك تراها تقعد على كرسي خشبي قديم و قد غطّتْ وجهها براحتيْها لتكتم نشيجها ثم و ما تلبث حين تراني أن تقوم من مكانها باحثة عن بسمة كاذبة ...
حـكــايات – قصة: مبارك السعداني
(1)
قبع باعروب فوق التلة يتابع ذبابة مسخوطة تسعى للإغارة على عينه اليمنى التي لم يعد يرى بها شيئا.نش عليها مرارا لكنها ملحاحة.تذكر زوجته المريضة التي أنهكته بزيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين.الذبابة النزقة قطعت شريط تفكيره،نش عليها ثانية بعصبية زائدة.تراءت له ابنته الصغيرة في بيت صديقه زوجها تغالب الضنك في بيت كثر أفراده وقلت موارده.تذكر نصيحة صهره :-ابحث لك عن صبية تعيد لك شبابك الضائع...
الرحيل الموجع -قصة: الحسين لحفاوي
لكم أحببنا ذلك العجوز الذي ظهر فجأة في حينا، أفقنا ذات صباح خريفي نديّ فوجدناه بيننا، رأيناه جميعا كما شمس سطعت فوق رؤوسنا، و اختفى فجاة ذات رحيل دون أن يخبر أحدا، و بين ظهوره و أفوله، حكايات يرويها أطفال الحي الذين جمعتهم به علاقة حميمة امتدت جسورها رغم تحذيرات الأمهات بعدم الاقتراب منه، لما يعتقد فيه بعضهن من نحس و شر يخفيهما بين جنبيه و في نظراته، فقد أدعت إحداهن أنها رأته ذات مساء يخرج قاروة خمر، و يعب منها في جوفه، و عيناه تحملقان في محجريهما كأنهما تراقبان الزقاق خوفا من أن يلحظه أحد السكان، بل و أقسمت أنها لم تصدق ذلك في البداية، و لم تشك في أنه عم العيد، لكنه حين دنا من البيت عرفته بملامحه التي لا تخطئها، و ساندها زوجها حين ذكر أنه لمحه يفعل ذلك متجاهلا نظرات الفضوليين و هو يقف داخل الخرابة التي يلجأ إليها أحيانا. أما جارتهما، فقد أكدت أن عم العيد ليس بالرجل العادي، فقد رأته في إحدى الصباحات يجلس القرفصاء أمام الموقد الملتهبة جمراته يتدفأ، و كلما عنّ له أن يلتقط جمرة و يلتهمها، فعل ذلك دون تردد و دون التياع، غير آبه بما يحدث للسانه أو للهاته و غير مكترث باندهاش العابرين. لكن لا أحد صدّق ذلك أو اهتم به و ظل عم العيد ذلك الطود الشامخ العنيد.
قمر ونجمة – قصة: محمد أمزيان
ألف السيد أيور دائما أن يعيش في الهامش، لذلك كان صعبا عليه أن يتأقلم ويتكيف بعد أن تم تعيينه في المدينة، لم يعتد على تلك الحركة الشديدة، ورؤية ذاك الكم الهائل من الناس. كان يتجنب أي احتكاك مع الآخرين، الكل كان ينعته بالانطوائي، فرغم أنه حصل على إجازته الأساسية في مادة العربية بنفس المدينة، إلا أن إقامته بها طيلة ثلاث سنوات لا تكاد تتجاوز عدد حصصه اليومية، كان مغرما بالأدب، يعشق قراءة الروايات خصوصا تلك القديمة كأعمال طه حسين ومصطفى لطفي المنفلوطي ونجيب محفوظ وغيرهم، كما أنه كان مهووسا جدا بالشعر فكان يقرأ للمتنبي وغيره من الشعراء، كان يغترف أسلوبا وتجارب من أولئك الكتاب وشخصياتهم.
فرصة ثانية – قصة: حدريوي مصطفى
ذات خريف، والشمس تفتح بوابة المغيب لجحافل الليل فوق بساط الغاب المديد، حط لقلاق على دوحة يروم بياتا؛ هرما، مهدودا كان إذ ما أن وقع واسْتَأْمن المكان حتى لوى عنقه ونام؛ في اللحظة ذاتها تعالت لقلقة فوقه، واهتزت أغصان حوله، فتنبه من غفوته ولمح بجواره فرخا من جنسه عليه قد وقع. ود أن يصرخ في وجه الزائر ويكيل له اللوم والتقريع بيد أن الدهر الذي عركه أثناه، واستحسن أكثر ردة فعله حين الصغير بصوت وقور ولباقة استعذر إليه وقال:
ـ عفوا سيدي إن أنا استبحت خلوتك، وكسرت بواكر غفوتك.. وسأكون أكثر سعيدا لو سمحت لي أن أشاركك المبيت..