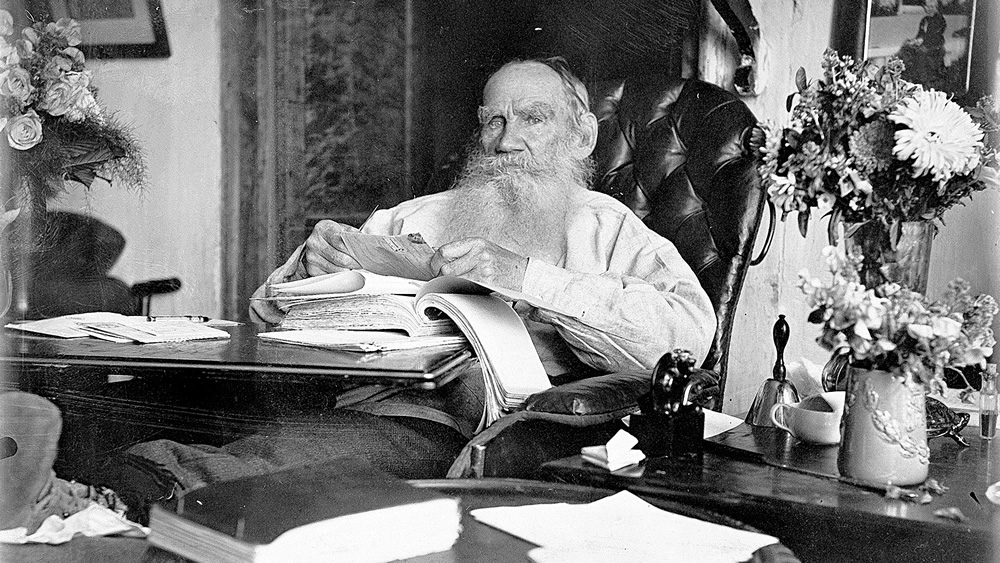الفَصلُ الخَامِسُ: الدَّورُ الجَوهَرِيُّ لِلفَنِّ
ما المقصودُ، إذاً، بالفنّ؟ لو تغاضينا عن مفهوم الجمال الذي لا يُفضي إلا إلى تعقيدِ الــمشكلِ، فإنَّ التعريفات الدقيقة للفنّ، والتي تشهدُ بالمجهودِ الهادفِ إلى تجريدِ مفهوم الجمال، يمكنُ تحديدها كالتالي: حَسَبَ "شيللر" و"داروين" و"سبسير" فإنَّ الفنّ نشاطٌ تنتجهُ الحيوانات أيضاً؛ إنَّهُ نتاجُ الغريزة الجنسيّة وغريزة اللّعب. ويضيفُ "آلان كارنت" أنَّ الفن نشاطٌ يُولِّده فورانٍ عصبيّ لذيذ. أما حسبَ تعريفِ "فيرون"، فإنَّ الفن هو التجليّ الخارجي لانطباعاتٍ جوانيّة تنتجُ عن تموُّجاتٍ وألوانٍ وأصواتٍ وحركاتٍ وكلماتٍ.
ووفق تعريف سيلي، فإنَّ الفنَّ إنتاجٌ لفعلٍ مستمرٍ أو حَتى أفعال عرضيّة بوسعها تزويدُ منتجيها بمتعةٍ حيويّة ومن ثمة خلق شعورٍ مُبهرٍ عند عدد كبيرٍ من المشاهدينَ بصرفِ النظرِ عن أيِّ اعتبارٍ للمنفعةِ (المُمارسة).
والحاصل، فإنَّ هذه التعريفات ناقصةٌ وغير تامّةٍ؛ لأنَّها، بكلّ بساطة، تستمدّ نُسغَهَا من المُعطى الميتافزيقيِّ الذي يُقرنِ الفنّ بالجمالِ.
وبالعودة، مرةً أُخرى، إلى هذه التعريفات، نلفي أن التّعريفَ الأوّل ناقصٌ لأنّه بَدَلَ أنْ يهتم بالنشاطِ الفنيّ في حدِّ ذاته، يبحثُ فِي جُذُورِ وأُصُولِ الفَنِّ. أمّا تعريفُ "آلان كارنت" فينطوي على ابتسار ظاهرٍ، يتبدّى في أنَّ التّحفيزَ العَصَبيَّ، الذي أومأ إليه، يُمْكِنُ أنْ يرافقَ أشكالَ مُتعدّدة للنشاطِ الإنساني عامةً، الأمرُ الذي نتجتْ عنهُ أخطاءٌ في النّظريات الفنيّة الجديدة التي جعلت من تَصْمِيمِ المَلابسِ الجميلةِ والرّوائحِ الزكيّة وكذلك الوجباتِ فنونًا.
أمَّا تعريفُ "فيرون" الذي يؤكد على التّجربة، مُفترضاً أنَّ الفنّ يرتبطُ بالانفعالاتِ، فإنَّهُ تعريفٌ يَنْأَى عن الدّقة؛ لأن بمقدورِ الإنسانِ الكَشْف عن انفعالاتِه من خلالِ الخطوطِ والألواِن والأصواتِ والكلماتِ ولا يؤثر بهذه الانفعالات على الآخرين، وحِينَهَا لَنْ يَكُونَ ما يخطّه فنًّا. وفي النّهاية، فإنّ تعريف "سيلي" نَاقِصٌ أيضًا لأنه لا يَعْدُو أن يكون مجرد ترّهاتٍ وتمارين بهلوانيّة بدل أن يكونَ فنًّا، بينمَا هُنَاكَ إنتاجات بإمكانها أنْ تكونَ فنًّا بِدُونِ أنْ تُحْدِثَ إِحْسَاسًا رَائِعاً مثل مَشَاهِد مُؤلِمَة ومُحزنة في قصيدة شعريّة أو في عملٍ مسرحيٍّ.
إنَّ قُصُورَ هذه التّعاريف ومثيلاتِها من التّعاريف الميتافيزيقيّة ناتجٌ عن كونها تربطُ الفنّ بالمُتعة التي يَخْلقُهَا في نُفوس مُتَلَقِّيهِ ولا تهتم بالدّور المَنُوطِ بالفنِّ في حياة الإنسانِ.