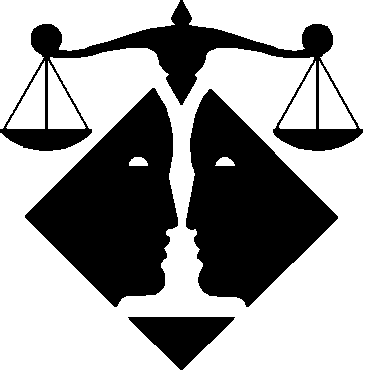 تمهيد :
تمهيد :يعرض نوربار رولان في القسم الثاني من كتابه"الانتروبولوجيا القانونيّة" المعنون ب" مجال القانون" ضمن الفصل الثالث الوارد تحت عنوان "مجالات الانتروبولوجيا القانونيّة" تصوّرات كلا المجتمعين لمفاهيم القانون الحق و العدل. ولعل أهمّ ما يمكن استنتاجه من هذا المقال هو اختلاف كليهما في تصوّر مدى ارتباط القانون بالعدل و الحق ,فإذا كان المجتمع التقليدي يبحث عن العدل و الحق من خلال تقديم تعاليم قيميّة وعبر توفير نموذج من السلوك أكثر من الحرص على تطبيق القانون بصرامة فإنّ المجتمعات الحديثة لا ترى فيهما إلاّ بعض وجوه هذا القانون الذي يرتبط عندهم مباشرة بالعقاب. وفي كلا الحالتيْن يبدو أن الهدف من وجود القانون عندهما هو حفظ النّظام الاجتماعي و تحقيق الانسجام.
ترجمة :سامي الرياحي.
القسم الثاني:
مجـــال القانون:
إنّ محاولة حدّ مجال القانون ليست تحليلا للخطاب و الممارسات فحسب و لكن للتصوّرات التي تقوم عليها أيضا.فمن المفروض أن يسعى القانون في كل مجتمع إلى تحقيق بعض القيم أو القيام بمهام مختلفة. و من الخطأ حسب وجهة نظرنا أن يغفل المختصّون في العلوم الاجتماعيّة ما يمثّله القانون لدى أكثر الناس ممن اختاروا الانصياع له.ومع ذلك فإنّ الارتباط بتصوّرات القانون لا يكفي لتحديده.فالقانون ليس بالضرورة ما نتصوّره.لذا ينبغي الاستعانة من جديد بالعمل الفكري والنّظريّات للتوصّل إلى تعريف أفضل. ووفقا للمنهج الانتروبولوجي فإنّه علينا أن ندرس من ضمن تلك النظريات ما يتأسّس منها على التحليل الثقافي للظواهر القانونيّة .
1 ـ تصوّرات القانون:
أكثرها شيوعا هي البحث عن العدل و الحفاظ على النّظام الاجتماعي و الأمن.
أ ـ البحث عن العدل:



 "بدل أن نكون مُصممي ديكور بلا ذاكرة،
"بدل أن نكون مُصممي ديكور بلا ذاكرة،  من بين الظواهر الاجتماعية البارزة في المجتمع التونسي نلاحظ ظاهرة مهمة تستدعي التأمل العلمي و الاجتماعي، و هي ظاهرة التقرب من أصحاب النفوذ ليس في مستوى الأعمال التجارية و الاقتصادية الكبرى فحسب و إنما من خلال بعض السلوكيات و التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد أو الجماعات في المعيش اليومي، و في هذه المحاولة سنحاول بيان بعض مظاهر هذه الظاهرة الاجتماعية، فماهي هذه المظاهر؟
من بين الظواهر الاجتماعية البارزة في المجتمع التونسي نلاحظ ظاهرة مهمة تستدعي التأمل العلمي و الاجتماعي، و هي ظاهرة التقرب من أصحاب النفوذ ليس في مستوى الأعمال التجارية و الاقتصادية الكبرى فحسب و إنما من خلال بعض السلوكيات و التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد أو الجماعات في المعيش اليومي، و في هذه المحاولة سنحاول بيان بعض مظاهر هذه الظاهرة الاجتماعية، فماهي هذه المظاهر؟  إن الحديث عن المجال، وطريقة تنظيمه،كان محط اهتمام الباحثين والدارسين ـ الأوربيين خصوصا ـ كوبير مونطاني ، وجاك بيرك ،كما أن هناك باحثين مغاربة اعتنوا بهذا الموضوع، وأولوه اهتماما بالغا في كتبهم ، وبحوثهم العلمية والجامعية أمثال الباحث الاجتماعي بول با سكون ، ولقد أكد هولاء جميعا أن المغرب ينقسم في تنطيمه ونظامه السياسي والاجتماعي الى منطقتي نفوذ المخزن والقبائل الاولى تعرف باسم بلاد المخزن والثانية تحت اسم بلاد السيبة أي هناك مجالين متعارضين الاول هو المجال التابع للمخزن والثاني هي البلاد الخارجة عنه.
إن الحديث عن المجال، وطريقة تنظيمه،كان محط اهتمام الباحثين والدارسين ـ الأوربيين خصوصا ـ كوبير مونطاني ، وجاك بيرك ،كما أن هناك باحثين مغاربة اعتنوا بهذا الموضوع، وأولوه اهتماما بالغا في كتبهم ، وبحوثهم العلمية والجامعية أمثال الباحث الاجتماعي بول با سكون ، ولقد أكد هولاء جميعا أن المغرب ينقسم في تنطيمه ونظامه السياسي والاجتماعي الى منطقتي نفوذ المخزن والقبائل الاولى تعرف باسم بلاد المخزن والثانية تحت اسم بلاد السيبة أي هناك مجالين متعارضين الاول هو المجال التابع للمخزن والثاني هي البلاد الخارجة عنه. آفة المخدرات و تعاطيها من المشاكل الأساسية التي تواجه الشباب العربي في العصر الحالي، و وفقا لآخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد المدمنين على المخدرات في الوطن العربي حوالي 10مليون مدمن، و يتوقع زيادة الأعداد نتيجة لانخفاض أسعار المخدرات و زيادة معدلات البطالة
آفة المخدرات و تعاطيها من المشاكل الأساسية التي تواجه الشباب العربي في العصر الحالي، و وفقا لآخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد المدمنين على المخدرات في الوطن العربي حوالي 10مليون مدمن، و يتوقع زيادة الأعداد نتيجة لانخفاض أسعار المخدرات و زيادة معدلات البطالة  المقالة الرابعة :في الإقتصاد
المقالة الرابعة :في الإقتصاد تقديـــــم إشكالــــــي:
تقديـــــم إشكالــــــي: العنف ظاهرة شديدة التعقيد و التشابك و متداخلة العوامل في ظهورها و دوافعها الظاهرة و الكامنة، المباشرة و غير المباشرة، و لكن قبل تحديد مظاهر العنف سنحاول في البداية تقديم تعريف للعنف و نشأته.
العنف ظاهرة شديدة التعقيد و التشابك و متداخلة العوامل في ظهورها و دوافعها الظاهرة و الكامنة، المباشرة و غير المباشرة، و لكن قبل تحديد مظاهر العنف سنحاول في البداية تقديم تعريف للعنف و نشأته. 








