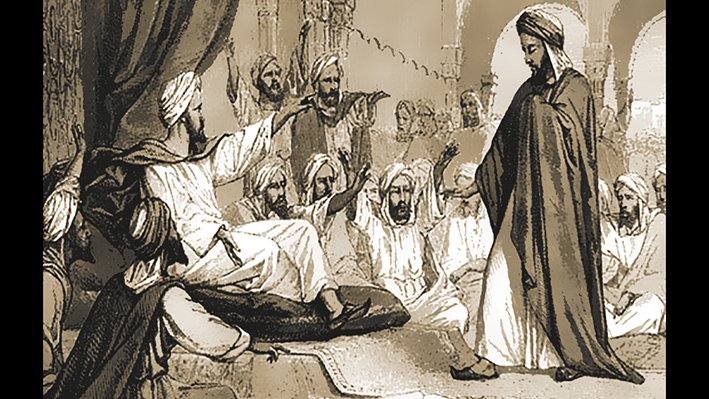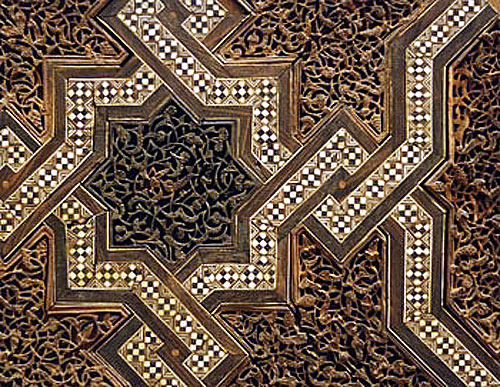قبل الحديث عن ابن رشد(520ه595ه/1126م1198م) وموقفه السياسي من السلطة في زمنه، لا بد من تقديم صورة موجزة لمظاهر المجتمع والثقافة بالأندلس، ففي المراحل الأولى للغزو الإسلامي للأندلس، لم تظهر أي بوادر لازدهار فكري أو إصلاح سياسي، فالداخلون الأوائل معظمهم جنود وفرسان من الأمازيغ والعرب، برعوا في فنون الحرب والقتال وتميزوا بحميتهم الدينية، ولم يكن لهم ميل للفكر والثقافة، وهو ما كان أثره خطيرا على الحياة الفكرية بالأندلس، لكن كيف أصبح الحال بعد ذلك سياسيا وثقافيا؟
1-الفكر بين السلطة الفقهية والسلطة السياسية:
كان الحال بعد استقرار غزو الأندلس، مؤسفا جدا، فقد سادت سلطة الفقهاء وسيطرت ثقافة مبنية على العلوم الدينية واللغوية وبعض فنون الشعر، وغلب على هذه المدارس طابع التقليد والانغلاق، فكان من الصعب الخروج عن سلطة الفقهاء، وأصبحت المشروعية في الإتباع والبدعة في المخالفة والإبداع.