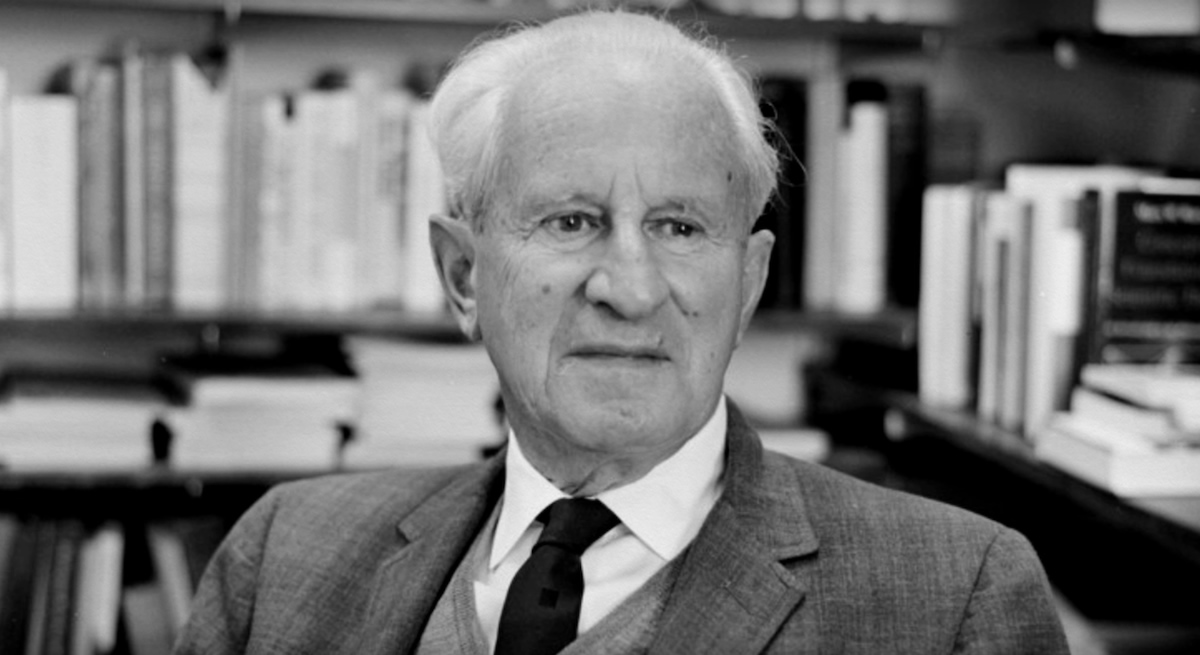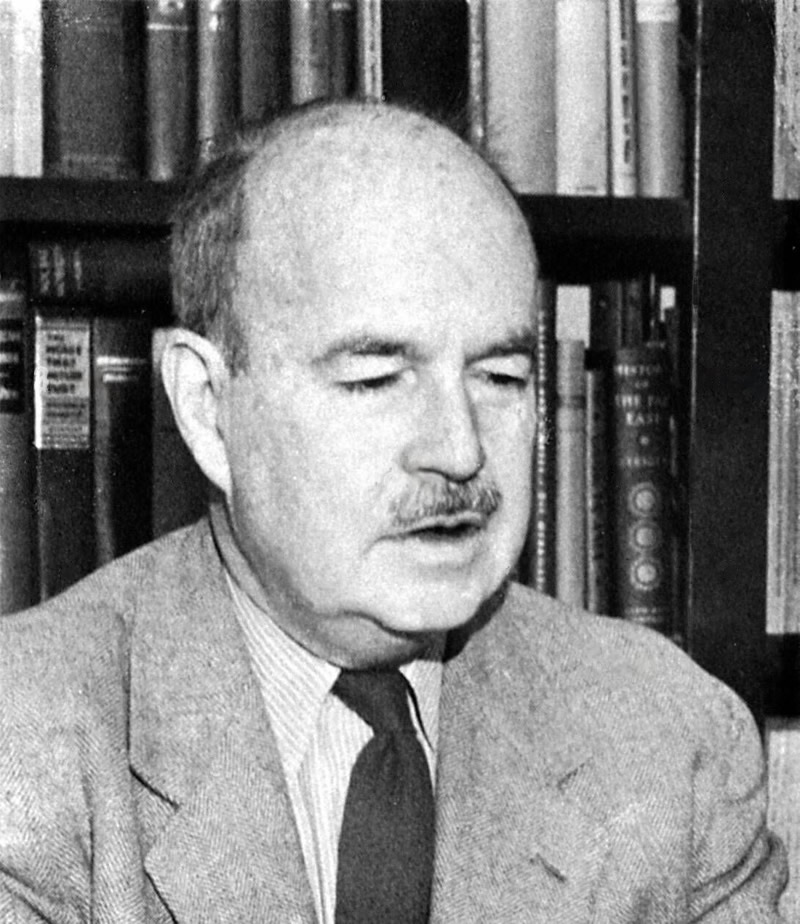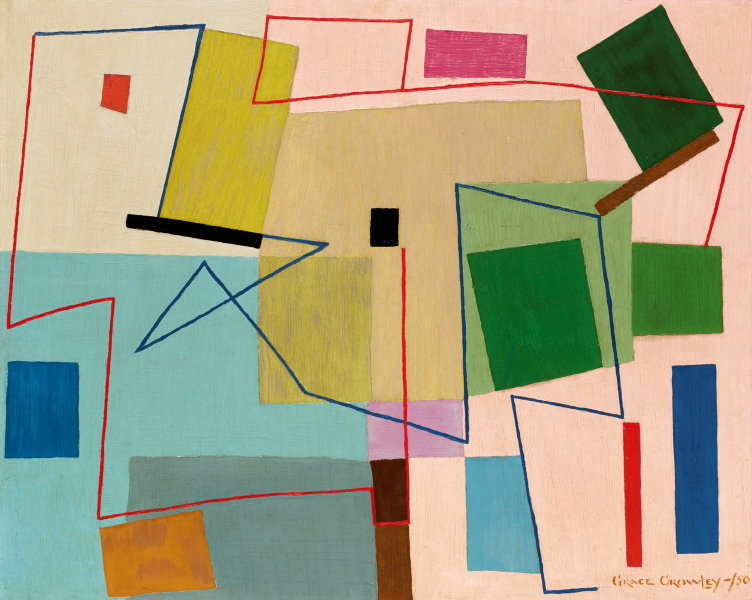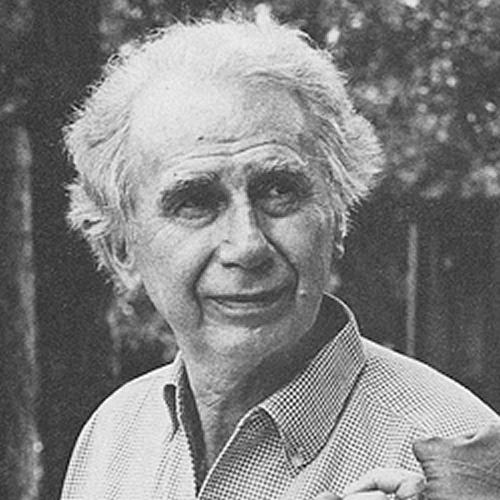” إن مفهوم الإنسان المشتق من النظرية الفرويدية، هو فعل الاتهام الأقصى الذي لا يمكن دحضه ضد الحضارة الغربية، وفي الوقت ذاته هو أفضل دفاع لصالحها لا يمكن رده. فإن تاريخ الإنسان بحسب فرويد هو تاريخ قمعه. ذلك أن الحضارة لا تفرض أشكال القسر على وجوده الاجتماعي فحسب، ولكن على وجوده الحيوي. فهي لا تحد من بعض أجزاء في الوجود الإنساني فقط ولكنها تحد بنيته الغريزية ذاتها ومع ذلك، فإن هذا القسر أو الإرغام هو وحده شرط التقدم الأولي “ (هربرت ماركيوز – الحب والحضارة).
يسعى المقال إلى مناقشة علاقة التقابل والتضاد بين مفهومي اللوغوس والإيروس في الحضارة الغربية المعاصرة بالاستناد إلى نقد ماركيوز لمفهوم الإنسان ذي البُعد الواحد على اعتبار أن لوغوس بوصفه منطق السيطرة وقمع الغرائز، وإيروس بوصفه غريزة الحياة، ومنطق التمرد الساعي إلى اللذة وتحقيق الارتواء، ومن هنا فقد تم النظر إلى مجالي الغرائز والحساسية على أنهما معاديان للعقل، بل ومفسدان له. اعتمد ماركيوز في نقده للمجتمع الصناعي المتقدم على مقولات النظرية الفرويدية عن الإنسان، التي تعتبر من أعنف الاتهامات الموجهة إلى الحضارة الغربية، من حيث إن تاريخ الإنسان عند فرويد هو في الوقت نفسه تاريخ قمعه، فالحضارة عند فرويد لا تمارس قهرها على وجود الإنسان الاجتماعي فحسب، بل على وجوده البيولوجي. والحضارة أيضاً لا تقيد الوجود الإنساني، بل إنها تقيد الوجود الخاص بالبنية الغريزية ذاتها. وفي هذا السياق سنحاول مناقشة هذا التعارض والكيفية التي أثرت رؤية الإنسان الغربي المعاصر لنفسه وللآخرين والواقع المعاش.
يرى ماركيوز أنه رغم وجود الدور النافي (السالب) والثوري للعقل، لكن كما يبدو لماركيوز هناك بعداً آخر للعقل لم يستطيع تجاهله بوصفه مفكراً جدلياً، فالعقل كان له دور أساسي في خلق العالم الذي نحيا فيه... ومع ذلك فقد كان له أيضاً دور أساسي في الإبقاء على الظلم والشقاء والعذاب... وباسم هذا العقل كانت ترتكب أبشع الجرائم في التاريخ، وباسمه أيضاً أنشئت محاكم التفتيش، ومعسكرات التعذيب، وغرف الغاز...إلخ([1]). غير أن العقل والعقل وحده هو الكفيل بتصحيح أخطائه وتطهير نفسه من المظاهر اللاعقلانية أو على حد تعبير هيجل "إن اليد التي تسبب الجرح هي التي بدورها التي تداويه"([2]).
ويعتبر ماركيوز أن تاريخ الفكر الغربي يعكس نوعاً من التقابل أو التضاد بين لوغوس* وإيروس:([3]) لوغوس بوصفه منطق السيطرة وقمع الغرائز، وإيروس بوصفه غريزة الحياة، ومنطق التمرد الساعي إلى اللذة وتحقيق الارتواء، ومن هنا فقد "تم النظر إلى مجالي الغرائز والحساسية** على أنهما معاديا للعقل، بل ومفسدان له"([4]).
ويشير ماركيوز شارحاً إلى أن أصل هذا التعارض يعود إلى المعنى اليوناني القديم لمفهوم العقل والذي استخدم بوصفه ماهية الوجود للدلالة على معاني: العقل المنظم، المصنف، المهيمن، المسيطر، ومن هنا فقد أصبحت فكرة العقل متعارضة بصورة جوهرية مع الدوافع والحاجات التي تقع في المرتبة الأولى من الوجود الإنساني، والتي تكون تقبلية سلبية أكثر من كونها إيجابية ومنتجة، وهي أيضاً تنزع إلى البحث عن الإرضاء والارتواء أكثر من التعالي، لذلك فهي وثيقة الصلة بمبدأ اللذة([5]).