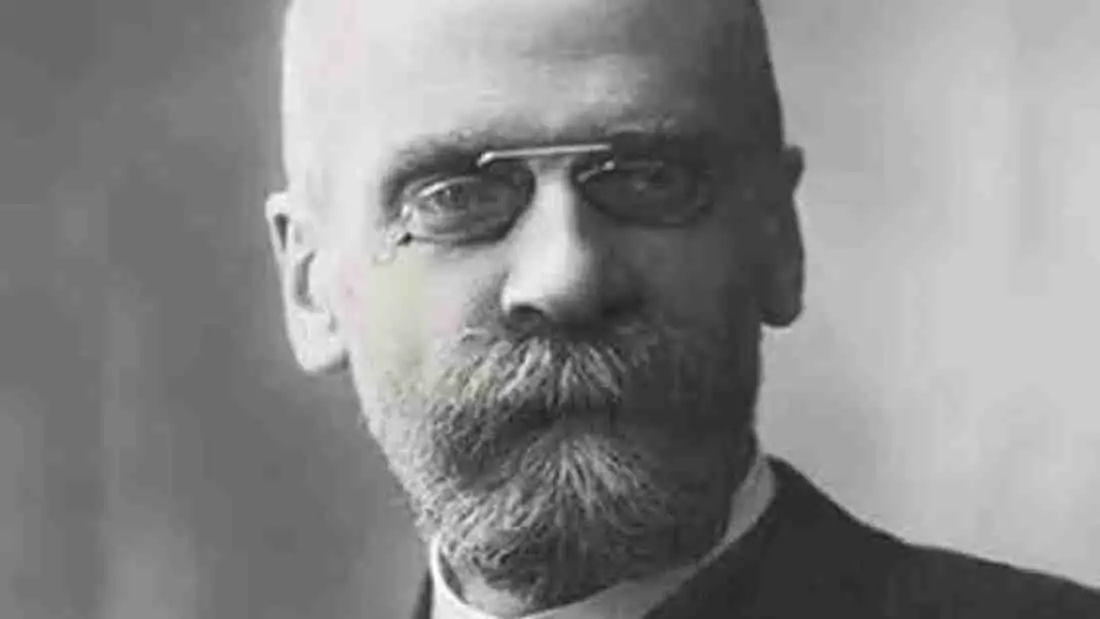يقول بوذا " نحن نتشكل بأفكارنا، نحن نصبح ما نفكر به، عندما يكون العقل نقياً تكون الفرحة ظله الأبدي ". ويقول جيمس هارفي روبنسون :" إن العقل الحديث حديث جزئيا لأن جوانب كثيرة منه ساكنة فينا منذ أيام ماضينا السحيق".
1- مقدمة:
يقول آلفين توفلر، في كتابه المعروف صدمة المستقبل، مشددا على البنية المعقدة لمفهوم العقلية "إن كل شخص يحمل في داخل رأسه نموذجا ذهنيا للعالم، أي تصورا ذاتيا للعالم الخارجي، ويتكون هذا النموذج الذهني من عشرات فوق عشرات من ألوف الصور([1]). إنها نمط ذهني من التصورات الذاتية للعالم تساعد الإنسان على تحقيق تكيفه مع عناصر الوجود وتجعله يمتلك نمطا كليا من التفكير يعتمده في النظرة إلى خصائص الوجود.
ومن أجل أن يستطيع الإنسان أن يواجه التغير السريع والعاصف يجب على الفرد أن يغير من مخزونه من تلك الصور بمعدل يتناسب مع هذا الذي يجري به التغيير في داخل المجتمع " ([2]). " والمعرفة الجديدة إما أن توسع من سابقتها أو تنسخها وفي كلتا الحالتين فإنها تفرض على المعنيين بها أن يعيدوا ترتيب مخزونهم من الصور ([3]). ويصف توفلر آليات تغير الذهنية فيقول: " إن أمواجا تلو أمواج من الصور الجديدة لا تني تهاجم دفاعاتنا وتهزم تصوراتنا الحقيقية في مختلف مجالات الحياة: في التعليم وفي السياسة، وفي الطب وفي العلاقات الدولية ([4]). وكنتيجة لهذا الغزو المتواصل فإن معدل تآكل الصور القديمة يرتفع باضطراد ([5]).
في هذه الصورة البديعة التي يقدمها توفلر لمفهوم العقلية، نجد أنفسنا إزاء مفهوم إنساني متمرد ومغامر، ونعلم منذ البداية بأننا سنواجه صعوبات منهجية في البحث عن تضاريس مفهوم قوام آلاف مركبة من الصور الذهنية. ويجب الاعتراف منذ البداية، أن مفهوم العقلية Mentalité من هذه المفاهيم التي تزداد غموضا كلما اشتد المرء في طلبها، وتزداد صورتها تعقيدا كلما ألحّ الباحث على التأمل في تضاريسها. وهو يشكل واحدا من المفاهيم الإشكالية التي تتداخل بصورة معقدة مع منظومة من المفاهيم المركبة ولاسيما هذه التي تثير الجدل الفكري منذ عهود بعيدة المدى في تاريخ العلوم الإنسانية([6]).
يشير مفهوم العقلية Mentalite إلى تكوينات معقدة واعية وغير واعية، شعورية وغير شعورية، حاكمة للسلوك الإنساني، إنها نظام معقد من المشاعر والأفكار والتصورات والقيم التي تجعلنا نتصرف على نحو ما، وننظر إلى الكون برؤية خاصة، ونقف من أشياء العالم موقفا محددا يفرضه هذا النظام بمؤثراته المختلفة. فالعقلية هي النظام الأكثر غموضا في تكوين الإنسان والأكثر أهمية وخطورة في حياته، وفي هذا الغامض تتحرك أكثر عناصر الوجود الإنساني وتتفاعل لتقدم للإنسان أكثر صيغه الإنسانية تكاملا. وبعبارة أفضل يمكن القول بأن العقلية تشكل الروح الخفية والغامضة التي تشكل الطاقة الأساسية للحركة والوجود الإنساني. وهي في النهاية نظام من السلوك والنظرة إلى العالم يتشكل ويتبلور في الأفران الثقافية للمجتمعات الإنسانية. وهذا يعني أن السلوك عبارة عن ترجمة عملية للتصورات الذهنية المنبثقة عن ثقافة ما فالفرد في أي مجتمع مغمور بتراث ثقافي يتجاوزه وهو التراث الثقافي للحضارة التي ينتمي إليها. "وهو من خلال هذا التراث يدرك العالم ويحكم عليه، غير أن هذا التراث عندما يتجمد ولا يتجدد يسير نحو الضمور فالزوال، ويحول بالتالي بين الفرد وبين كامل إدراكه لذاته وغيره، ومن هنا كانت هناك صلة دائرية بين تجدد المجتمع وتجدد الفرد فكل منهما يجدد الآخر "([7]).