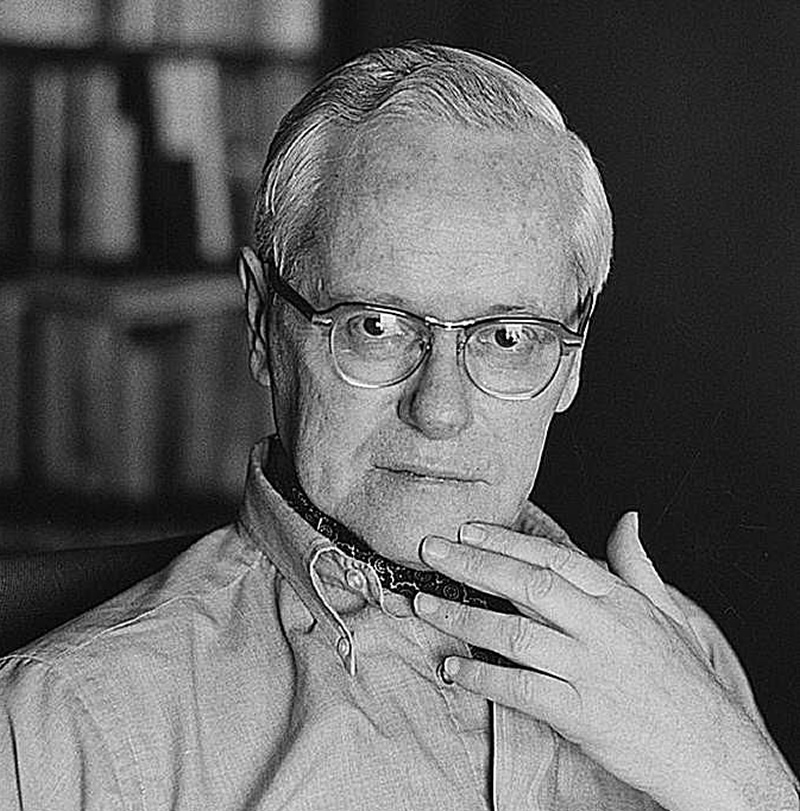1
تَنْبُع أهميةُ فَلسفةِ الظواهر الاجتماعية مِن قُدرتها على تحليلِ طبيعة الأحداث اليومية ، وتفسيرِ ماهيَّة التقاطعات التاريخية معَ الواقع المُعَاش ، وهذه الفلسفةُ غَير مَحصورة في بُنيةِ المُجتمع التَّحتية وبِنَائِه الفَوْقِي ، بَلْ تَتَعَدَّى إلى دَلالات اللغة كإطارٍ مَعرفي ومَرجعيةٍ رمزية ، وهذا يدلُّ على الترابط بين المُجتمعِ واللغةِ ، بِوَصْفِهِمَا كِيَانَيْن مُنْدَمِجَيْن شُعوريًّا وإنسانيًّا ، ويُشكِّلان مَنظورًا وُجوديًّا لتأويلِ تاريخ الأفكار منهجيًّا ومنطقيًّا ، وتوضيحِ كَيفية تفاعله معَ رُؤيةِ الفرد لِذَاتِه ومُحِيطِه ، مِمَّا يُؤَدِّي إلى استخراجِ الأحلام المَقموعة مِن مَسَارَات الزمن المُتشابكة ، واسترجاعِ الوَعْي الإبداعي مِن مَتَاهَات المَكَان العميقة . وهَاتَان العَمَلِيَّتَان تُسَاهِمَان في نَقْل الهُوِيَّة المعرفية مِن كَينونة الفرد الفاعلة إلى الفِعْل الاجتماعي ، وهذا يَضْمَن الانتقالَ السَّلِسَ لتاريخ الأفكار مِن الذِّهْنِ التَّجريدي إلى التطبيقِ العملي ، ومِن الدَّلالةِ اللغوية إلى السُّلوكِ الأخلاقي ، ومِن الجُمُودِ الحَضَاري إلى الحَرَاكِ الحَيَاتي . وإذا تَجَذَّرَ تاريخُ الأفكارِ في فلسفة الظواهر الاجتماعية رُوحًا ونَصًّا ، فَإنَّ الأنساق الثقافية سَيُعَاد تشكيلُها لإنقاذِ الفرد مِن المَأزق الوُجودي ، وإنهاءِ الصِّرَاع بَين مَصادرِ المَعرفة والتجاربِ الواقعية ، الأمر الذي يَدفَع باتِّجَاه تَحويل البناء الاجتماعي إلى جَوهَر إنساني على تماس مُباشر معَ العَقْلِ الجَمْعي ، والوَعْيِ الإبداعي . وإذا كانَ وُجودُ الإنسانية سابقًا على وُجود المُجتمع ، فَإنَّ الهُوِيَّة المَعرفية سابقة على سُلطة الظواهر الاجتماعية . واندماجُ الإنسانيةِ معَ المَعرفةِ يُؤَسِّس للتفاعلات الرمزية بين المُجتمعِ واللغةِ في صَيرورةِ التاريخ ، وتفاصيلِ الحياة اليومية ، وتَحَوُّلاتِ الشُّعورِ والإدراكِ .