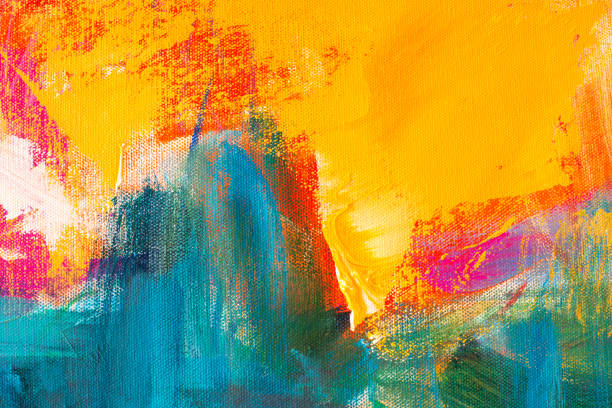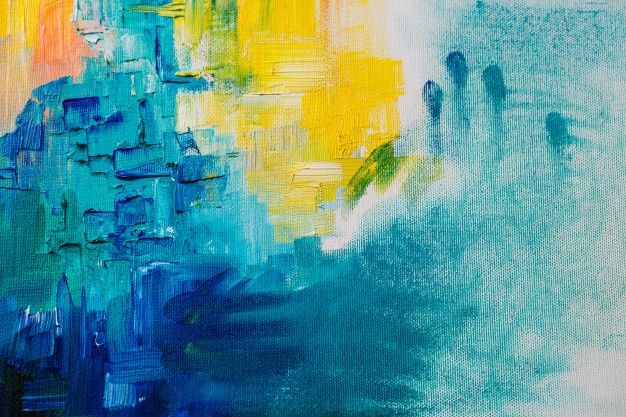ما كنت أظن أنها ستأتي، لكنها جاءت، ضاجة بثمراتها، متفتحة كزهرة ريانة في أوج ربيعها، يفوح شذا عطرها الذي أغرقني وطوّح بي في عوالم من الرهبة والخشوع، تركتني مبعثرا أبحث عن خلاص وألملم فرحا واضطرابا، هزت الروح إلى أكوان خفية لا ترى فيها إلا أطيافا شفافة هلامية تعانق مشاعر وأحاسيس لاأرضية. جاءت أخيرها بتمردها وعنفوانها، بشعرها المتناثر على كتفيها في ثورة عارمة هازئا بتلك النسمات التي تحركه دون أن تجرؤ على لمسه.
هالة من الجمال والأنوثة كانت تتقدم نحوي، تدنو مني، جاءت فاتنتي، وقفتُ إجلالا وأنا أحاول جاهدا تعديل نبضات القلب حتى لا ترتج الدنيا من حولي مثلما حدث لي معها أثناء لقائنا الأول في إحدى المغازات الكبرى وتواعدنا خلاله على هذا اللقاء. هاهي تتقدم فتسحب معها كل ما هو جميل فيتعلق بأهدابها أو ينحني إجلالا أمامها، لوت إليها الأعناق، كدت أصرخ في هذه العيون المبحلقة وتلك الأفواه المشدوهة "إنها لي، لي وحدي، هذا الملاك الذي لا تكاد قدماه تلامسان الأرض لي، غضوا أبصاركم قبل أن تصابوا بالعمى". رغبت في احتضانها واحتواءها لأحجبها عن هؤلاء المتطفلين الذي ظلوا يلوكون الفراغ لكني لم أفعل إمعانا في قهرهم وتعميق حرمانهم، تمنيت أن تظل تمشي إلي وأنا أتأمل حسنها وقوامها وأصغي إلى وقع خطاها العمر كله. كل ما فيها كان منسجما وفاتنا ومربكا إلى أقصى حدود الإرباك. اهتزاز جسدها الضاج بالأنوثة الآسرة غيّب كل من في المقهى. وظلت وحيدة تشق هذا المدى الممتد من الباب إلى حيث كنت أنتظرها، الحسن، كل الحسن الذي تجلى في هذه الأنثى فريد، أفي الكون امرأة بهذا الجمال؟
رسالة حب فلسفية – نص: عبد الحفيظ أيت ناصر
سيدتي يا غزالة الفؤاد، لماذا اكره لك الفلسفة؟ اجيب عن هذا السؤال بأن الفلسفة تفسد الحب، لكني لم اعد اخاف على هذا الحب من الفلسفة، اننا معا ابناء الشعر، ابناء القصيدة الاولى التي كانت سبب حبي لك، لكني لا استطيع التخلص من الفلسفة وانا افكر في الامر، فهي توجسي وشكي الباقي وإني اخاف من ركود التيقن الاعمى.
لو انك يا سيدتي غزالة الفؤاد طلبت مني ان اجعل لهذا الحب حالة ولادة او شهادة ميلاد كي نسجل له حالة مدنية، لقدمت لك زمن الخط الاول، هذا الخط المرسوم بأصابعك الرشيقة كقلم كنت اكتب به على لوحي الخشبي ايام الطفولة الاولى في المسيد.
ماسح الأحذية – قصة: الحسين لحفاوي
الشارع الطويل ممتد في التواءات طفيفة مثل ثعبان يئن وينوس بالحمل الذي يمشي فوقه، يتضور من هذه الأجساد المتلاطمة على غير هدى، أجساد متناثرة هائمة على وجوهها، تضرب في كل الاتجاهات، لا تدري إلى أين تقودها هذه الدروب المجنونة القاتمة.
ها هو سامح يمشي بين هذه الجموع وفي رأسه تتلاطم الأفكار، موج هادر من الذكريات يخضه، يصفعه، يرجه. وجد نفسه في هذا المدى الممتد من الهائمين فهام معهم، سار غير مكترث بهذا الكم الهائل من البشر. ها هو يمشي مترنحا وأمام عينيه صورة حارس السجن وهو يدفعه ليزج به في هذه المتاهة الفسيحة بعد أن قضى أسبوعين ذاق خلالهما ألوانا من العذاب، أسبوعان قضاهما لا هو بالبريء ولا هو بالمجرم، شبهة لم تثبت عليه...آه يا بلدي الجريح، مجرد تشابه في الأسماء يقودني إلى هذا العذاب.
زينة – قصة: أمينة شرادي
كانت زينة تبهج الغرفة بلعبها وحركاتها التي لا تنتهي. ترمي دميتها الى أعلى حتى تكاد تلامس سقف الغرفة وتعود تسقط فوق رأسها وهي في غاية الفرح والسعادة. كان أخوها الصغير يشاركها في اللعب. يرفع بدوره لعبا أخرى ويرميها أيضا الى أعلى ولما تسقط بسرعة يختبئ وراء أخته خوفا منها. فجأة سمع انفجار غير بعيد من البيت، تزعزعت أركان الغرفة الصغيرة ورمى الطفل الصغير بجسمه الطري بين أحضان أخته وهو يصرخ: أنا خائف. أنا خائف.
احتضنته أخته زينة واختبآ تحت السرير، وهمست له:
-لا تخف. ماما تقول لي دائما، لما تسمعي صوت الانفجار، اختبئي تحت السرير ولن يصيبك مكروه.
الأحذية المقلوبة – قصة: حميد اليوسفي
لمح فردة حذاء مقلوبة أمام باب الصالون . منذ كان طفلا ، كلما مر بصندل ، أو بَلْغَة ، أو حذاء مقلوب ، إلا وطلبوا منه تعديله ، وإعادته إلى وضعه الطبيعي . لم يسأل الكبار لماذا يتضايقون من ذلك .
عندما أصبح رجلا بدأ هو الآخر يتضايق من الأحذية المقلوبة ، ويطلب من يمر بجانبها بأن يعيدها إلى وضعها الطبيعي ، دون أن يعلم سبب ذلك .
بعد سنين طويلة ، اكتشف بأن الناس تتذمر من الأحذية المقلوبة ، لأنها تعتقد بأنها تجلب النحس والشؤم والخصومة لأهل البيت ، وتُغضب السماء ، وتمنع البركة من دخول المنازل.
قال لنفسه :
ـ والآن ، بعد أن عرفت السبب ، وزال العجب ، هل ستنهض لتعديل وضع الحذاء ؟
اِطمئن يا قلبي – نص: غزلان ايت جعفر و عبد الحفيظ ايت ناصر
مرت كل هذه السنين وأنا أعتق الحب في قلبي، ظنا منها اني قد سلوت عنها، ولكن هل ينسى القلب من احب، والحقيق به اكثر انه لا ينسى الذين احبوه، قد صُمْتُ عن الحب منتظرا ان يطلع عليَّ هلالها، منتظرا سُقياها كي تبتل عروقي بشراب الحب.
كنا صغيرين والحب يضم قلبينا بخيطه السماوي الصافي كفراشات لطيفة في بستان زاهي، في كل مرة يجمعنا الرصيف أحس بنظراتها تخترقني، آه لو كانت تستطيع ان تقرأ ذلك النقش على اطلال قلبٍ غابت عنه يمامته منذ زمن بعيد، آه لو كانت تستطيع ان تقرأ ذلك الرسم الفرعوني، انه الحب المعتق والعشق المسجى في البردي، النقش الازلي العريق.
سفينة الحياة – نص: أسماء العسري
هل يمكن للإنسان أن يتأقلم مع الفشل، نعم وهذا هو الصواب، فاعتياده يفتح له باب الصبر والمثابرة، والمحاولة ولو كانت مئة مرة، فطالما هناك ليل هناك نهار، والأسود يليه الأبيض، وبدل أن تصبح سلاحا ذا حدين يتناوب حداه على انتزاع انسانيتك، لتصبح إنساناً عديم الضمير، أو مومياء.
حسنا إني أقبل أن أكون مغناطيس الفشل، لكن هل بهذه النتيجة انطوى كتاب الأقدار، لا وألف لا، ففكرة الفشل تُمررك لفشل آخر، لتصبح لاعباً احتياطياً في نزال غير متكافئ، متى مر الفشل أمامك، ورأى سُحنتك الخائفة استضافك على مائدته، ليهمس لك أن تستعد للفشل المقبل.
عوز الاستثناء..... – نص: الخضر بنجدو
استهلال:
هي بعض من رواية، تدور أحداثها في زمن غير الزمن، وفي وطن غير الوطن، وهي تطمح في جمعها أنْ تحرّك في كلّ إنسيّ ما يخْشى من سواكن آلامه وجراحه، تلك التي، قد زعم اندمالها، و هي التي لا تندمل . هي بعض رواية تحاول اقتطاع نسيج، ترديدا لرجْع صدى صوت المرء الخافت، حين يغرق في ظلمة نفسه، عندما تنوء به عزائمه، وتنكسر اشرعته على صخور شرائع واقعه المرّ، مرارة علقم لم يستسغه في كل مرّة حاول فيها، ولكنّه كان يفشل. رواية وليست كذلك، ولكنّها هي ترسم أحداثا لا تقع . وقد تقع حين تنغرس الذّات المنهكة في تربة يأسها وفشلها، حياء الخجل، أو شجاعة الخوف حين ينعدم الأمل في خلاص لا يأتي بقدر ما ننتظره، هي تطمح الى بناء جدار لمداراة وهن يلازمها كثوب تلحّف الجسد حتى صار منه وهو ليس منه، آدمي يطلب إنسيته ولا يدركها وهي منه كالجلد من العظم، نشدانا لممكن يقبل أو لا يأتي، ولكن ربما صوْنا لشرف تليد" لم يرقْ حوله دم"[1]..