 مقدمة :
مقدمة :
اعتبر بعض الدارسين أن مسالك التعليل أدلة على التعليل، ودرسوا هذا المسلك بناء على ذلك؛ قال الطوفي: "إثباتها (أي العلة) بدليل نقلي (…) وإثباتها بالاستنباط.." [1]،وذكر من جملة ذلك كله منهج السبر والتقسيم[2].
غير أن أكثر أهل الأصول اعتبروا مسالك التعليل بشقيها النقلي والعقلي طريقة ومنهجا لاستنباط العلل الشرعية والعقلية، وذهابهم هذا المنحنى ارتبط أكثر بمجالهم الجامع بين الأصول والفقه. غير أن الناظر يرى أن حديثهم عن السبر والتقسيم يضمر حديثين متوازيين، حديث عن طرق استنباط العلة وحديث عن الاستدلال، وهو نفسه قد نجده عند النظار من المتكلمين، وهكذا "يرى بعض المتأخرين أنه كان طريقا قائما بذاته، ويرى آخر أنه طريق لإثبات علة الأصل.."[3].
ولهذا ليس خيرا أن ننظر إلى منهج السبر والتقسيم كطريقة للبحث والاستدلال وطريقة في استنباط العلل. وإن كانت هذه الطريقة في الترتيب لم تصنف في باب الاجتهاد إلا ضمن آخر أبواب وسائل استنباط العلة، فقد يتبع الفقيه المجتهد عند استنباطه للعلة مسلكين:
الأول: نقلي ويعتمد فيه استخراج العلل المذكورة بالنص.
والثاني: استنباطي ويعمد فيه إلى طرق متعددة لاستنباط علة الأصل، وهنا سوف لا أشير إلى كل هذه الطرق وإنما سأقتصر على واحدة تعتبر مهمة في الدراسات النقلية كما هي مهمة في الدراسات العقلية، ولعلي أقصد بذلك منهج السبر والتقسيم.
التراث و«التراث» المضاد أو أسئلة العرب على محك الفكر الكوني ـ محمد مزيان
 «لكن التاريخ، ولحسن الحظ، احتفظ لنا بذكرى أولئك الذين كافحوا ضد التاريخ».
«لكن التاريخ، ولحسن الحظ، احتفظ لنا بذكرى أولئك الذين كافحوا ضد التاريخ».
– Nietsche (Friedrich), considérations inactuelles, p339 ,montaigne,sans date.
مثّل «ابن رشد» قمّة الحضور الكوني للعرب، في حين شكّل «ابن خلدون» آخر عهد لهم بالمشاركة في الفكر الكوني. وتعني المشاركة في الفكر الكوني نمطا من تنظيم الحقيقة على نحو يسترعي أمما ويستدعيها للأخذ به وتبنّيه. هكذا نذكر أن أوروبا في لحظات حرجة من تاريخها حاربت الكنيسة باسم «ابن رشد» (الرشدية اللاتينية). وبهذا المعنى كان فيلسوف قرطبة بمثابة «تراث» مضاد للتراث،شأنه في ذلك شأن «الجاحظ» و»أبي حيان» و»الحلاج»…وهي أسماء تكثّف «الضديّة» على نحو خاص. لكن بعدما كان العرب حجة يأخذ بها غيرهم انتهوا اليوم إلى أن يصبحوا خطرا على قيمة الغيرية،ففي حين انغمس «ابن رشد» في فك ألغاز إحراجات عصره تشهد «داعش» اليوم على منعطف رهيب في مسار حضارة فقدت القدرة على توجيه نفسها.
إن أمارة القصور التي باتت عليها مساهمة العرب تنكشف جلية عند فحص أسرار استفراد الغرب بالريادة الروحية للبشرية وتقدّمه الحاسم في المنافسة المحمومة بين صيغ الكونية. الغرب إخراج غير مسبوق لمعنى الكونية. تفاصيل هذا المعنى يمكن ردّها إلى ركنين أساسيين:المعنى والزمان،وليس هذا غير معنى التّناهي. لذلك ليس صدفة أننا أكدنا في خاتمة واحد من أعمالنا الأخيرة،أكدنا الحقيقة التالية:»حين نتمكن من استضافة التناهي بوصفه عنصرا أساسا للفكر، آنذاك سنتمكن من استقبال الغرب حقا وفعلا بمعزل عن سراب استنساخه، سنستضيفه بطريقة ما ستصبح هي طريقتنا الخاصة ومساهمتنا المتميزة في التاريخ»(1).
قداسة الجسد في التصوف الإسلامي : مداخل وملاحظات ـ هشام العلوي
 لقد اقترن مدلول التصوف بالعزوف عن الحياة، والإضراب "عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة"[1]، رجاء في التقرب من الله تعالى الذي بأمره ترفع حجب الحس، كي تنكشف الحقائق الربانية[2].
لقد اقترن مدلول التصوف بالعزوف عن الحياة، والإضراب "عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة"[1]، رجاء في التقرب من الله تعالى الذي بأمره ترفع حجب الحس، كي تنكشف الحقائق الربانية[2].
إلا إن تاريخ الصوفية وسير بعض رجالاتها، وتأملات أقطابها، تبدو جميعها أكبر من أن تنحصر في ذلك المدلول الرهباني للنسك أو تقف عند الممارسة الشعائرية للدين؛ بما أنها تقدم المتصوف في صورة المريد للنعيم في الدنيا قبل الآخرة، والعائق للحق عبر تجلياته في الخلق. فالمجاهدة ليست سوى مسلك لحظوي مؤقت، يتخلى عنه العارف، ويتعالى عن شروطه فور اعتقاده بلوغ أقصى درجات الولاية. عندئذ تسقط "عنه الشرائع كلها، من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، و[تحلل ] له المحرمات كلها من الزنى والخمر وغير ذلك.."[3]. وكأن "العبادة" في اصطلاح الصوفية كلمة مائعة رجراجة، تتمنع عن الحدود المعجمية، ومفهوم لا يحمل أي معنى سابق عن التجربة الحسية المتفردة والخاصة: "لقد جاء الولي الوهراني سيدي محمد بن عودة الشهير بترويض الأسود إلى بيت الولي عبد الرحمان […] داخل البيت وجد سيدي محمد الولي سيدي عبد الرحمان صحبة فتيات جميلات، فأظهر بعض الدهشة: إن الحضور الإلهي، قال سيدي عبد الرحمان يدرك بين الأقراط والضفائر، أكثر منه على قمم الجبال.."[4].
إذا كان الشهرستاني قد استخلص من استقصائه للمذاهب، والعقائد والديانات التي كانت تعتمل، بتصارعها، بلاد الإسلام، أن البشر لا يستطيعون تصور الغيبيات بالعقل النظري وحده، بل لا بد لهم –بشكل أو بآخر- من قياس يتوسل بالأجسام: تشبيها أو تعطيلا؛ فإن حتمية "التجسيد" عند الصوفية لم تكن إرغاما، بقدر ما كانت نزوعا بديهيا يقدمون عليه انطلاقا من إيمانهم بأن الله "كان وجودا منزها حتى عن الإطلاق. لا يوصف بوصف، ولا يسمى باسم، ولا يعرف بحد ولا برسم. ويطلقون عليه في هذه المرتبة "العماء" […] لا يعرف نفسه، ولا يراها، ولا يدري هو من هو […] ثم اشتاق أن يعرف نفسه وأن يرى ذاته، فتعين في صورة الحقيقة المحمدية، ثم راحت الذات تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، حتى عين الذات هوية وماهية وصفة، أو ما من شيء إلا وهو اسم إلهي تعين في مادة. والحق […] لا يرى مجردا عن المواد أبدا.."[5].
الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية : بين الجمالي والقدسي ـ سليمان القرشي
 بشكل مثير وبادخ، تنكشف الأنثى في حقل الكتابة الصوفية كذات حالمة، وحلم مشخص، ينكشف قمقم التجربة التي لا تؤخذ من الأوراق وإنما هي وجدان وأشواق كما قال ابن عجيبة الحسني[i]، عن فتنة العري، وسحر التستر، يقف الدارس حائرا منشدها أمام الحضور الكرنفالي للمرأة في الديوان الصوفي فلا يملك إلا أن يلبس العري كساء الرمز، ويجرد السحر من لباسه ليعود إلى مجاله حيث جمال المعبد وجلال المعبود.
بشكل مثير وبادخ، تنكشف الأنثى في حقل الكتابة الصوفية كذات حالمة، وحلم مشخص، ينكشف قمقم التجربة التي لا تؤخذ من الأوراق وإنما هي وجدان وأشواق كما قال ابن عجيبة الحسني[i]، عن فتنة العري، وسحر التستر، يقف الدارس حائرا منشدها أمام الحضور الكرنفالي للمرأة في الديوان الصوفي فلا يملك إلا أن يلبس العري كساء الرمز، ويجرد السحر من لباسه ليعود إلى مجاله حيث جمال المعبد وجلال المعبود.
في البد كانت المرأة:
يرى ابن عربي فيما يشبه لذة الاعتراف الصوفي بالارتباط المشيمي بالأنثى أن "المرأة صورة النفس، والرجل صورة الروح، فكما أن النفس جزء من الروح، فإن التعين النفسي أحد التعينات الداخلة تحت التعين الأول الروحي الذي هو آدام الحقيقي، وتنزل من تنزلاته، فالمرأة في الحقيقة جزء من الرجل، وكل جزء دليل على أصله، فالمرأة دليل على الرجل"[2].
إن الشوق والحنين والتعلق والافتتان هي الروابط الرئيسية التي شدت الصوفي إلى المرأة التي ترك غيابها عن ناظره مجالا للحلم وللخيال الخلاق، وهو الخيال الذي شكل المرأة من الحجارة المكومة في تجارب الغزل، خاصة منه العذري، يقول ابن الفارض في إحدى مقاماته العشقية[3]:
المسيطرون باسم الدين ـ اسماعيل فائز
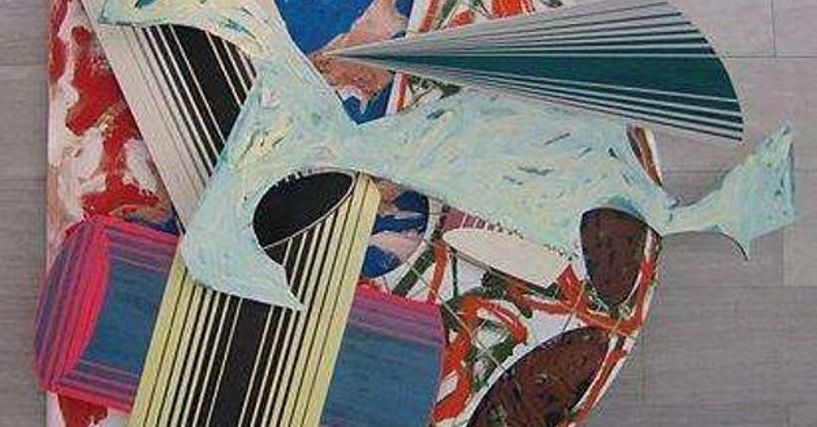 جل المفكرين الأحرار، وجل عشاق ثقافة السؤال لا ثقافة الجواب الجاهز؛ وجل العقول التي تمردت على السجن المعرفي، وسجن الآبائية، وحاولت أن تلقي بحجر في بركة مياه الفكر الراكدة، وأن تسهم في تغيير المجتمع بالفكر والقلم...وجدت نفسها أمام جدار سميك من الجهل، بل "الجهل المقدس" والممأسس أحيانا.
جل المفكرين الأحرار، وجل عشاق ثقافة السؤال لا ثقافة الجواب الجاهز؛ وجل العقول التي تمردت على السجن المعرفي، وسجن الآبائية، وحاولت أن تلقي بحجر في بركة مياه الفكر الراكدة، وأن تسهم في تغيير المجتمع بالفكر والقلم...وجدت نفسها أمام جدار سميك من الجهل، بل "الجهل المقدس" والممأسس أحيانا.
حدث ذلك في المجتمع اليوناني حين اتهم سقراط، وحكم عليه بالإعدام. وحدث أيضا في أروبا العصور الوسطى حين كانت الكنيسة تمسك بزمام السلطة، فبسطت هيمنتها على جل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. فراح علماء وفلاسفة ومصلحون دينيون أروبيون ضحية هذا الاستبداد السياسي المتسربل برداء ديني كنسي.
وإن كانت أروبا قد استطاعت أن تنعتق من تلك الأغلال وتشق الطريق نحو الحرية والتنوير، فإن المجتمعات الإسلامية بخلاف ذلك لازالت ترزح تحت وطأة الوصاية الفكرية ومازالت تعاني من الحجر على العقول من طرف الانظمة السياسية المستبدة؛ ولكن أيضا، وهذا الاخطر(لأنه يضفي على نفسه قداسة دينية) من طرف من نصبوا أنفسهم حراسا للمعبد وكهنة لا يبشرون وينذرون فقط، بل يسيطرون أيضا، وكأنهم وكلاء حصريون منتدبون للدفاع عن الفهم الصحيح والأوحد للدين.
فما هي الآليات التي ينتهجها "التحالف المقدس" بين الاستبداد السياسي والاستبداد باسم الدين في سبيل إحكام السيطرة على العقل والمخيال الاسلامي؟
لقاء ابن رشد - ابن عربي ـ أحمد كازى
 قليلة هي النصوص أو المناسبات التي تحول الباحث الأكاديمي إلى مبدع؛ ومقال الأستاذ محمد المصباحي تحت عنوان "فشل لقاء الشعر والفلسفة بالتصوف"، يدخل في هذا الإطار، فهو يبرز معالجة فلسفية عملت على تحويل المكتوب إلى تناص، يتداخل فيه القديم والحديث والمعاصر؛ مع محاولة لرصد أوجه الوحدة والاختلاف بينهما أو الاتصال والانفصال: بحيث إن مرجعية المعالجة رسمت عمقا فلسفيا، استحضر فيه الكاتب إشكالية كبرى وهي علاقة "الفلسفة بالتصوف": ابن رشد/ابن عربي، متجها نحو بناء أسئلة أعمق تضع للتصوف مكانة في علاقته بالشعر والفلسفة دون التضحية بأحدهما، مع رسم الحدود الممكنة معرفيا، لأن اللقاء في نظره بين هذه المجالات المعرفية باء بالفشل.
قليلة هي النصوص أو المناسبات التي تحول الباحث الأكاديمي إلى مبدع؛ ومقال الأستاذ محمد المصباحي تحت عنوان "فشل لقاء الشعر والفلسفة بالتصوف"، يدخل في هذا الإطار، فهو يبرز معالجة فلسفية عملت على تحويل المكتوب إلى تناص، يتداخل فيه القديم والحديث والمعاصر؛ مع محاولة لرصد أوجه الوحدة والاختلاف بينهما أو الاتصال والانفصال: بحيث إن مرجعية المعالجة رسمت عمقا فلسفيا، استحضر فيه الكاتب إشكالية كبرى وهي علاقة "الفلسفة بالتصوف": ابن رشد/ابن عربي، متجها نحو بناء أسئلة أعمق تضع للتصوف مكانة في علاقته بالشعر والفلسفة دون التضحية بأحدهما، مع رسم الحدود الممكنة معرفيا، لأن اللقاء في نظره بين هذه المجالات المعرفية باء بالفشل.
فلقاء الشعر بالتصوف في زاوية معينة في نظره بقي محدودا بحدود المظاهر الحاجبة للباطن؛ من هذا المنظور يثار السؤال التالي: هل بإمكان القول الشعري النفاذ إلى الأعماق غير المستوية على قرار؟ وألا يمكن اعتبار هذا القول ممارسة أكثر تحررا من الأقاويل الأخرى في الإنتاج والإبداع؟
أما إشكالية لقاء الفلسفة بالتصوف، فتتضاعف أهميتها مع د.محمد المصباحي في اللقاء التاريخي بين الرجلين: ابن رشد-ابن عربي: ونظرا لأهمية هذا الحدث التاريخي، وانطلاقا مما أثاره الباحث في مقالات "فكر ونقد"(1)، من قضايا تستحق التفكير والمعالجة وتساعد على تصحيح نظرتنا لأسلافنا وتراثنا، وتساهم في تحديث رؤيتنا لهذا التاريخ؛ مع نبش هذه الذاكرة التي لا يمكن الاعتماد فيها إلا على مفاصل محدودة، والتي لا تتعدى الفقرتين، وهذا هو المتوفر اليوم في "متن" الشيخ الأكبر: فالقارئ مهما بحث في متن شيخنا لن يجد إلا تلك الإشارات المحدودة حول اللقاء في الفتوحات المكية"(2). وهذا ما يدعو إلى التساؤل التالي: لماذا شكل اللقاء موضوع اهتمام من طرف ابن عربي دون ابن رشد؛ هل هذا راجع إلى غضب "شيخ الفلسفة" على "الشيخ الحاتمي"، بعمل هذا الأخير على إفشال العلاقة بين التصوف والفلسفة، أم أن فيلسوف قرطبة ومراكش، كان يعي جيدا مآل الفلسفة بعد موته؟
المعرّي: نقد الفكر الديني بين الفلسفة والشعر ـ محمد حسام الدين العوادي
 إنه لمن اغرب المفارقات، وأبغضها لكل مثقف عاقل، تلك الإزدواجية في المعايير لدى المفتخرين بماضينا وتراثنا في العالم العربي الإسلامي. فكيف – ليت شعري ـ يقوم المتدينون من المسلمين بالتبرؤ من عظمائهم ثم يقومون بالإفتخار بأن لهم تاريخا وباعا في العلوم والفلسفة والأدب. من أهم الذين تبرأ منهم كثير المسلمين – قديما وحديثا – نذكر: أبو بكر الرازي ، ابن سينا ، ابن المقفع، الفارابي، جابر بن حيان، ونتطرق اليوم لذلك الرجل الذي يدعى بفيلسوف الشعراء أو شاعر الفلاسفة أو بكليهما، ألا وهو أبو العلاء المعرّي. الذي اتهم منذ القِدم بالإلحاد. والهدف من هذا المقال ليس تحديد إن كان الرّجل مسلما أو كافرا فهذا لا يعنينا بل الإشارة إلى أهم أقواله وأشعاره التي اتهم بسببها بالزندقة أو الإلحاد مع التعريف بهذه الشخصيّة الفذّة التي يعرفها كل من يعرف نصيبا من الأدب العربي وإن قلّ هذا النصيب. قد أثارت هذه الشخصية المشهورة جدلا فدافع عنها من دافع نافيا عنها الإلحاد وهاجمها من هاجم متهما إياها بالإلحاد وافتخر بها مسلمون باعتبارها مسلمة، وتبرأ منها مسلمون باعتبارها ملحدة، كما أعجب بها ملاحدة ومؤمنون وكل ذي عقل رشيد وذوق أدبي رفيع.
إنه لمن اغرب المفارقات، وأبغضها لكل مثقف عاقل، تلك الإزدواجية في المعايير لدى المفتخرين بماضينا وتراثنا في العالم العربي الإسلامي. فكيف – ليت شعري ـ يقوم المتدينون من المسلمين بالتبرؤ من عظمائهم ثم يقومون بالإفتخار بأن لهم تاريخا وباعا في العلوم والفلسفة والأدب. من أهم الذين تبرأ منهم كثير المسلمين – قديما وحديثا – نذكر: أبو بكر الرازي ، ابن سينا ، ابن المقفع، الفارابي، جابر بن حيان، ونتطرق اليوم لذلك الرجل الذي يدعى بفيلسوف الشعراء أو شاعر الفلاسفة أو بكليهما، ألا وهو أبو العلاء المعرّي. الذي اتهم منذ القِدم بالإلحاد. والهدف من هذا المقال ليس تحديد إن كان الرّجل مسلما أو كافرا فهذا لا يعنينا بل الإشارة إلى أهم أقواله وأشعاره التي اتهم بسببها بالزندقة أو الإلحاد مع التعريف بهذه الشخصيّة الفذّة التي يعرفها كل من يعرف نصيبا من الأدب العربي وإن قلّ هذا النصيب. قد أثارت هذه الشخصية المشهورة جدلا فدافع عنها من دافع نافيا عنها الإلحاد وهاجمها من هاجم متهما إياها بالإلحاد وافتخر بها مسلمون باعتبارها مسلمة، وتبرأ منها مسلمون باعتبارها ملحدة، كما أعجب بها ملاحدة ومؤمنون وكل ذي عقل رشيد وذوق أدبي رفيع.
الإلحاد لا يعني بالضرورة نفي وجود إله وخالق للكون، فقد اتهم الكثير ممن يؤمنون بالله ويقدسونه بالإلحاد. لذلك يجب أن نرجع مثلا لقاموس لسان العرب ففيه نجد التعريف اللغوي للإلحاد:
معنى الإِلحاد في اللغة المَيْلُ عن القصْد، ولحَدَ إِليه بلسانه: مال. وقال الأَزهري في قول القرآن: لسان الذين يلحدون إِليه أَعجمي وهذا لسان عربي مبين؛ قال الفراء: قرئ يَلْحَدون فمن قرأَ يَلْحَدون أَراد يَمِيلُون إِليه، ويُلْحِدون يَعْتَرِضون. وأَصل الإِلحادِ: المَيْلُ والعُدول عن الشيء.[1[
المصلحة ميزان الشرع ، لكن كيف الوصول إليها ؟ ـ د. مخلص السبتي
 من الممكن تقسيم المصلحة تقسيمات متعددة من حيث اعتبار الشرع لها ، ومن حيث درجة قوتها ، ومن حيث ثباتها أو تحولها...
من الممكن تقسيم المصلحة تقسيمات متعددة من حيث اعتبار الشرع لها ، ومن حيث درجة قوتها ، ومن حيث ثباتها أو تحولها...
1 - اعتبار الشرع
فمن حيث اعتبار الشرع ، فهي إما مصالح معتبرة أو ملغاة ، فالمعتبرة هي ما صرحت باعتماده النصوص الشرعية كأصول الحلال والحرام المفضية إلى مصالح العدل والإحسان ، وصحة العقول والأبدان ، وسلامة الأسر ، واليسر والسماحة ، والقوة والأمانة ، والعدل والبذل ...والملغاة هي ما قد يظهر من مصالح مادية أو معنوية جزئية ملتبسة بمضار أكبر منها وأعم ، مثل المصالح المترتبة عن الاتجار في الخمر أو التعامل بالميسر ، فالنص يسقط اعتبارها : (ويسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ) أو مصالح التعامل بالربا فهي مقرونة بالتشنيع الشديد ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) أو مصالح تقتضيها مجاوزة حدود رد العدوان المفروض بغرض الانتقام و " التأديب وإشفاء الغليل " ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) ، فتلك مصالح ثابتة حظرها الشرع واستنكرها الطبع ، لا لذاتها بل بما لابسها من مضار أفسدتها وأخرجتها عن طبيعتها .










