 "إن التحوّل الحضاري لا يتمّ على يد بطل، أو حاكم، ولكنّه يتمّ على يد الحكمة الجماعيّة، وهي من المصلحين وقادة الفكر"
"إن التحوّل الحضاري لا يتمّ على يد بطل، أو حاكم، ولكنّه يتمّ على يد الحكمة الجماعيّة، وهي من المصلحين وقادة الفكر"
هربرت سبنسر
مهندس وعالم إجتماع إنجليزي
رغم عظمة دور قادة الفكرّ الحرّ الذي تترجمه إسهاماتهم الإيجابيّة الفاعلة في التحوّلات الحضاريّة التي غيّرت وجه العالم نحو الأفضل، فإنّ محنة الكثير منهم، وعلى امتداد التاريخ، تحاكي و لا تختلف في قساوتها عن إحدى أهمّ القصص في الميثولوجيا الإغريقيّة التي تحدّثت عن "بروميثوس"/البعيد النظر (Prométhée) ، وهو أحد الحكماء القادرين على التنبّؤ بالمستقبل والمحبّين للبشر،على خلاف الملك "زيوس"( Zeus) المجنون بالسلطه و العظمه والمحتقر للمعرفة والفكر. ومن فرط حبّه للبشر سرق"بروميثوس" من الآلهة قبسا من النّار- التي هي رمز للفكر الوقّاد- وأهداه للبشر ليتزوّدوا منه بالمعرفة والفكر، بما قد يجعلهم لايدينون للملك زيوس بالولاء اللّامشروط . لأجل ذلك حكم عليه "زيوس" بأن يتمّ ربطه إلى إحدى صخور القوقاز فتآكل النسور كبده في محنة يوميّة متجدّدة، و ذلك بعد أن تتشكّل له كبد أخرى في الليلة الموالية.
القرآن وسؤال نزع القداسة ـ هادي معزوز
 " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول، فدمرناها تدميرا."
" وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول، فدمرناها تدميرا."
ـ القرآن الكريم ـ
"أغزوا تبوك، تنالوا بنات الأصفر."
ـ النبي محمد ـ
لا عجب أن تتوجس الأديان دوما من كل تفكير حر نقدي، لسبب بسيط يكمن في اختلاف الطبيعتين المؤسسة لتربة هذا وذاك، حيث يقوم الدين على التسليم المطلق بالأشياء، بما أنه كلام آت من السماء ـ على حد زعم الأنبياء ـ بينما يتأسس الفكر على التمحيص والفحص قبل إصدار أي حكم، لهذا اعتبر المفكرون في نظر المتزمتين من أهل الدين زنادقة ودهرانيين وملاحدة مشركين، بينما عمل المفكرون غالبا عن النأي بأنفسهم من مثيل هاته الجدالات العقيمة، فكان أن تسلح أهل الدين بالسيف، في حين تسلح أهل العلم بالقلم، وفي ذلك عديد أمثلة يسوقها لنا التاريخ، حيث نذكر من بينها ما حدث للفيلسوفة هيباتيا ومن بعدها ما وقع للحلاج، وابن المقفع، وابن رشد الحفيد، ثم ما عاشه كوبرنيك وغاليلي ومارتن لوثر وديدرو...
لقد انتصر العقل على حساب النص المقدس في عديد البقاع من العالم، فكان لذلك الأمر عظيم وكبير نجاح على حال الناس، خاصة وأن العقل لم يدع يوما إلى التخلص من الدين، وإنما إلى نزع الشبهات منه، والتي تصنف ضمن مصاف الخرافات والخوارق، حيث لن يصدقها إلا العامي الذي لا طاقة له في أمور القراءة النقدية للأمور، لهذا رسم نفس العقل حدودا للدين مثلما اعتبر العقل ديدن كل تفوق إنساني، والبين في ذلك هو تجربة عصر النهضة وما بعدها حيث بدأنا نؤسس للإنسان المسؤول القادر، وليس للإنسان التابع الذي يسلم بالأمور، معتبرا أن كل شيء هو من صنع السماء، مهما كانت طبيعته إن سيئة أو حسنة، لكن وعلى النقيض من ذلك تخبط العالم الإسلامي ومنذ نشأته على نبذ كل اختلاف، مكرسا القراءة الواحدة والوحيدة، معتبرا كل اجتهاد بدعة، ومُجَرِّماً كل محاولة لإعادة التحقيق في عديد الأمور التي لازالت ملتبسة لحد الساعة، لهذا قد لا نتعجب عندما نرى أمتنا تتقاتل فيما بينها لأسباب جد تافهة، وهو ما يجعلنا نفوت فرص التقدم معوضين إياها بجهل مصادق عليه من لدن أصحاب القرار، إذ هل يعقل مثلا أن أثنَكِّلَ بشخص لدرجة تعذيبه حيا وميتا، لسبب أن له قراءة أخرى للعقيدة؟ ولماذا نعتبر خطابنا هو الأصح، بينما كان من الأجدر احترام كل الآراء، امتثالا لنسبية الحقيقة؟ وهل تعتبر مسألة العودة لتاريخ المقدس جريمة، أم أنها محرك إبستيمولوجي يكشف عن ما وراء الراكد فينا؟ للإجابة أو بالأحرى لمعالجة هاته الاسئلة سنعمل في هذا المقام على العودة إلى الأصل، أي إلى الكتاب المقدس للمسلمين، ممحصين إياه بدل تصديقه تصديقا ساذجا، دون المرور مر الكرام على بعض الظروف التاريخية واقفين على الجانب الخفي من أشخاص طالما اعتبروا في نظر العامة مثالا يحتدى به.
نماذج من الفكر العقلاني التنويري والنهضوي العربي ـ فتحي الحبّوبي
 والقول بترجيح النقل على العقل محال لأن العقل أصل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقل ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل فعلمنا أنه لا بد من ترجيح العقل. - فخر الدين الرازي
والقول بترجيح النقل على العقل محال لأن العقل أصل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقل ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل فعلمنا أنه لا بد من ترجيح العقل. - فخر الدين الرازي
لعلّه من نافل القول التأكيد على أنّ إشكاليّة التخلّف المزمن وفشل محاولات النهضة العربيّة التي تعاني من جرّائها المجتمعات العربيّة اليوم، سواء منها تلك التي عاشت ربيعها الثوري أو التي لم تعشه، ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مراكمة مواطن خلل عديدة وأخطاء كثيرة، ليس في المقاربات المفاهيميّة للتنمية ومحدوديّة وقصور مناويلها في مستوى التشغيل والعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات فحسب ، بل وكذلك كإفراز لرؤى فكريّة ومتبنّيات، منها ما يتّصل بالمقدّس بما هو ادّعاء بامتلاك الحقيقة الربّانية المطلقة واعتناق لمعتقدات في غير ما اعتماد للعقلانيّة في شأنها، ومنها ما يتّصل بالزمني بما هو دنيوي مادّي/ مخلوق.
حيث أنّه، كلّما قامت في المجتمع العربي الإسلامي حركة فكريّة نقديّة تنويريّة وإصلاحيّة تؤمن بأّنّ العقل هو المعيار الرئيسي في فهم كل القضايا ذات العلاقة إن بالدين أو بالدنيا وسعت لبثّ الوعي، وتحريض العقل العربي على الإشتغال تجنّبا للتعطّل والجمود والتكلّس، إلاّ وكان –قطعا- مآلها الضُمورَ والنكوص ثمّ التلاشي.
نقّاد الفكر الديني وثالوث التكفير والاضطهاد والقتل ـ فتحي الحبّوبي
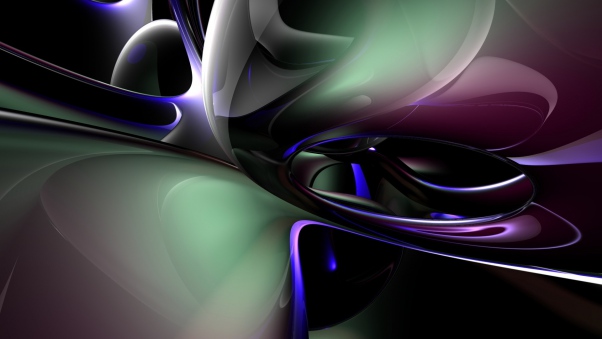 «نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكّر ..
«نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكّر ..
ومتعصّبون إذا لم نرد أن نفكّر..
وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكّر.. »
من مقولات أفلاطون
من اللّافت للانتباه، أنّ سعة الأفق هي من معاني إسم أفلاطون باليونانيّة ، بحيث يصحّ فيه القول أنّه اسم على مسمّى. لا سيّما وأنّ أفلاطون يشجّع في مقولته المذكورة مطلع المقال، على التفكير الذي هو رديف للأفق الواسع. ولا ريب في ذلك فأفلاطون إنّما هو تلميذ لسقراط الذي، من نافلة القول التأكيد على أنّه، يعدّ من أعظم الفلاسفة على مرّ التاريخ، إن لم يكن أعظمهم. ويمكن اعتباره - بتعبير الفكر الشيعي- سيّد شهداء الفكر الحرّ، الذين دفعوا حياتهم قربانا على مذبح حريّة الفكر في سبيل الصدح، بصوت عال وليس همسا، وبقوّة في غير ما إستكانة ولا ضعف، عن آرائهم وأفكارهم المبدعة الحرّة. تلك الأفكار المحرّرة للإنسان من عبوديّته لصنم السلطة السياسية ولأرباب سلطة المؤسّسة الدينيّة الأحاديّة الرؤية والفكر، الممارسة للإرهاب الفكري المنظّم على الفكر المختلف والمتسيّدة ، في الأغلب الأعمّ، للجهل والتجهيل وللجمود والتكلّس الفكري الخانق للإبداع. وهو ما تأباه طبيعة الحياة القائمة على الحركة والتحوّل الذي لا ينقطع بفعل الطوفان المعرفي الذي يقتصر إنتاجه -للأسف- على الدول العلمانيّة دون غيرها.
الحسبة في الحمامات الاسلامية ـ كوجة عبد الغني
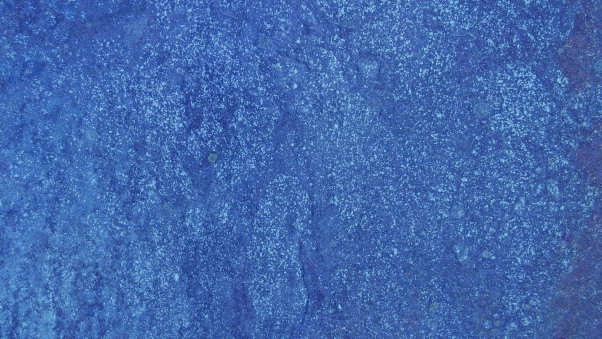 مقدمة
مقدمة
عرفت جميع الأمم المتحضرة الحمامات واعتنت بتشييدها وزخرفتها، كما اعتنت بتسيير مجاري مياهها، وإتقان أحواضها وصهاريجها، وتزيين مجالسها. باعتبارها أماكن للنظافة والاستحمام، وقد رفع الإسلام شأن النظافة، وأعلى قدرها حتى جعل المتطهرين أحباء الله إذ قال جل جلاله :"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"[1] كما أن ظاهرة وجود الحمامات في المجتمعات الاسلامية تعبير صادق عن واقع المجتمع بالتزامه النظافة، كما تعبر أيضا عن مستواهم الحضاري باتخاذ أشكال للبناء تنجم عنها عادات وسلوكيات مرتبطة بها أشد الارتباط.
وقد تجاوزت الحمامات النظرة الضيقة التي تعتبرها مكانا للاستحمام و النظافة فقط، وهو ما يمكن أن نلمسه من خلال الأدبيات التاريخية و كتب الرحلات الجغرافية و رسائل الحسبة. وإذا كانت الدراسات التي أنجزت عن هذه المنشأة المائية قد ركزت على الجانب الفني و المعماري و الخدمات المتنوعة التي كانت تقدم للعامة عند ذهابهم إلى الحمامات، فإننا ومن خلال هذا العمل البسيط سنعطي لمحة عن جانب من الجوانب التي لا تقل أهمية عن سابقتها : وهو الجانب الديني والاجتماعي، لأن الحمامات ليست فقط بناية مكونة من قاعات يرتادها الناس من العامة حتى صارت مرفقا اجتماعيا ؛ بل هي في عمقها مسألة ثقافية، و عادات اجتماعية، و تقليد أخلاقي، ومصدر رزق للعديد من الاشخاص الذين ارتبطوا بهذه المنشأة الدخيلة على الثقافة الاسلامية، ومن خلال ما عرفته هذه الأماكن )الحمامات( عبر التاريخ من عادات و تقاليد منافية للشرع الإسلامي، وكذلك ما عرفته من مثالب و مساوئ تمثلت في كشف العورات ورفع الحياء بين عامة الناس ناهيك عن الملابسات التي تخللت بعض الحمامات كالسرقة والتي استوجبت النظر فيها و الوقوف عندها . كان من الضروري أن توكل للمحتسب أمور الإشراف عن أحوالها ورفع الضرر عن سكانها، من أجل الحفاظ على السلامة العامة وعلى القيم الأخلاقية التي تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
نحن والمستقبل وأثقال التاريخ ـ د. مخلص السبتي
 يستلزم التوجه للمستقبل حسن التخلص من أثقال التاريخ وكفاءة التمكن من التحرر من أغلاله ، لكن السؤال الصعب هو كيف ؟
يستلزم التوجه للمستقبل حسن التخلص من أثقال التاريخ وكفاءة التمكن من التحرر من أغلاله ، لكن السؤال الصعب هو كيف ؟
كانت السلفية وسيلة التحرر باعتبارها " رجوعا إلى ما كان عليه السلف الصالح قبل ظهور الخلاف " وهو هو ما دعا إليه ابن القيم وابن تيمية ثم الافغاني من بعدهم ومحمد عبده وعلال الفاسي وغيرهم ، لكنها ما لبثت أن تحولت بعدهم من مجرد استلهام المبادئ الأولى المؤسسة إلى اجترار مستمر لا ينتهي لإشكالات تاريخ قد مضى ومقتضيات أوضاع قد اختفت منذ عهود وأزمان ، فإذا السلفية اليوم هي التي تشرف على وضع القيود على العقول والهمم ، بعد أن كانت المبادرة إلى التحرير والتنوير .
في تقديري ، يتطلب التخفف من أثقال التاريخ أمرين :
I. الانطلاق من الكليات العامة :
بالرجوع إلى سورة الحشر حيث التنصيص على لفظ " شريعة " نرى الأمر بواجب الإتباع لا بمجرد التطبيق : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) [1] ، فالشريعة هنا منهج حياة يتبع لا مجرد أحكام تطبق ، إنها استرشاد بتعاليم وأحكام كلية واضحة توجه الفكر وتقود الحركة لا مجرد أوامر تنفذ وينتهي الأمر[2]، وتؤكد سورة الشورى هذا المعنى ، فما شرعه الله لنا هو نفس ما شرعه لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) [3] إنها وصايا وتعاليم صالحة لكل زمان ومكان ، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا كانت كلية وعامة ، ومن هنا فإن ما يدرس تحت عنوان " مقاصد الشريعة " ما هو إلا أبحاث في الشريعة عينها ، فهي القبلة والمقصد ، وغيرها لها تبع ، وإليها محتكم ، وما يحتاج فعلا إلى بيان مقاصده هو الأحكام الجزئية المتناثرة في شتى مجالات الحياة ، بدء بالعبادات إلى أحكام الزواج والطلاق والبيوع والمواريث والاقتصاد ....كل حكم يظل محتاجا للشريعة يهتدي بها ، ولا يمكن أبدا فهم الأحكام الشرعية منفصلة عن مقاصدها العليا في ذات الشريعة ، سواء كانت في مجالات الدين أو الدنيا ، فالشريعة قبلة والحكم الشرعي وسيلة ، الشريعة مقصد والحكم الشرعي أداة ، وإنما ينبغي توجيه الجهود في تعميق النظر في مقاصد الأحكام ، كل الأحكام ، وكل حديث عن " مقاصد الشريعة " لا يراعي دقة هذه الضوابط يبعد عن الصواب ولا يقرب منه .
الخطاب الفقهي عند ابن رشد بين التحصيل والتأصيل ـ عبد الله معصر
 1 – مراتب المتلقي في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
1 – مراتب المتلقي في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
لعل أول ما يلفت النظر في كتاب بداية المجتهد هو تقاطب الزوج: "البداية – النهاية" والزوج: "المجتهد – المقتصد". وإذا كانت بداية المجتهد هي نهاية المقتصد فإن هذا يعني أن الخطاب سيتوجه إلى:
ـ المقتصد باعتباره فوق المقلد ودون المجتهد.
ـ والمجتهد باعتباره في أول خطوات الصناعة الفقهية وهذا المنحى سيتخلل كتاب بداية المجتهد. مما يعني أن المقلد سيكون غائبا، إذ المنهج العام للكتاب يقوم على النظر في أدلة المذاهب والمقلد ليس من هذا الشأن.
إن ابن رشد يريد بتوجيه كتابه إلى "المقتصد-والمجتهد" وإقصاء المقلد إعادة الخطاب الفقهي إلى مستوى الإبداع والنظر الصناعي الفقهي بعد أن فشا التقليد[1].
2 – مفهوم الخلاف في كتاب بداية المجتهد:
يتضح للناظر في كتاب بداية المجتهد أن الخلاف يرد على مستويين:
الأول: الاختلاف في مقابل الإجماع.
الثاني: الاختلاف في مقابل الاتفاق مما ليس فيه إجماع، وكلا المستويين قد يردان بمعنيين اثنين:
الأول – مضيق ويقصد به الخلاف بين المذاهب الإسلامية.
الثاني – موسع ويدخل فيه الخلاف بين أصحاب المذهب الواحد.
الصراع بين المعتزلة والأشاعرة 2 ـ ثابت عيد
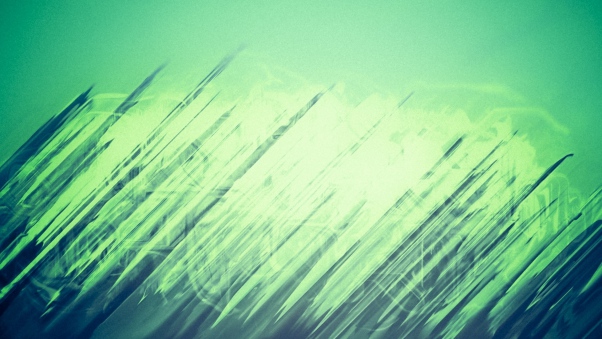 7 ـ تطوير هجوم الأشاعرة على المعتزلة بعد وفاة الأشعري:
7 ـ تطوير هجوم الأشاعرة على المعتزلة بعد وفاة الأشعري:
قد حاولنا تلخيص انفصال الأشعري عن المعتزلة، ثم قيامه بمهاجمة المعتزلة، ولعنهم، ومحاولته التقرب من الحنابلة وأهل الحديث. لم يكن لهذه النزعة الجديدة –أي محاولة التوسط بين العقلانيين ممثلين في المعتزلة، واللاعقليين ممثلين في أصحاب الحديث والحنابلة- أن تستمر، ويكتب لها الدوام، لولا ظهور شخصيات كبيرة في الأجيال التالية للأشعري، وتبنيها الأصول التي وضعها الأشعري، وتوسعها فيها، وتطويرها إياها، ودفاعها عنها. كان من أهم هذه الشخصيات أبو بكر الباقلاني (توفي سنة 403هـ) [1]، عبد القاهر البغدادي (توفي سنة 429هـ)[2]، وأبو المظفر الاسفرايني (توفي سنة 471هـ)[3]، والإمام الغزالي (توفي سنة 505هـ)[4]، والشهرستاني (توفي سنة 548هـ)[5]، وغيرهم.
وما يهمنا في هذا السياق هو ذكر بعض ما كتبه هؤلاء المفكرون الأشاعرة في هجومهم على المعتزلة، وانتصارهم للمذهب الأشعري. وقبل أن نحاول تلخيص ما ذكره هؤلاء الكتاب الخمسة، علينا أن نلاحظ أن أكثر هؤلاء الأشاعرة تطرفا في الهجوم على المعتزلة، ولعنهم، هو عبد القاهر البغدادي الذي ذكر ابن خلكان أنه كان تلميذا لأبي إسحاق الأسفرايني[6]، وكان الصاحب بن عباد (توفي سنة 385هـ/995م) قد وصف أبا إسحاق هذا بأنه "نار تحرق"، وهو وصف يدل على سرعة البديهة، وقوة الجدل، وفصاحة اللسان[7].










