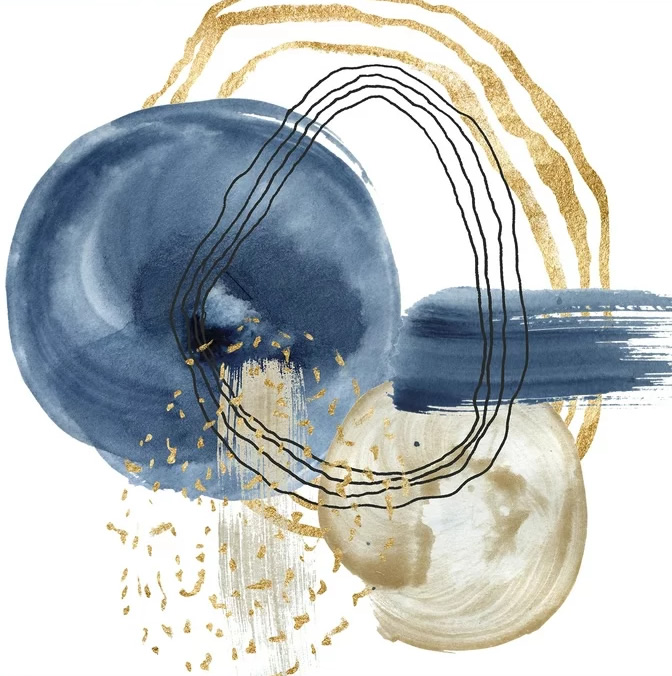حتى لو كان الفكر، كما يقول هيجل، جاحدا، ليس من المحتم أن يظلم المفكرين. حتى لو بدت فلسفة الرياضيات للبعض أنها لا تواجه جميع المشكلات الفلسفية الأصيلة، فلا يمكن لأي من طلابها أن ينسى ما يدينون به لليون برنشفيك، كما لا يمكن لأي شخص يعرفه أن يستحضر، دون مرارة على الشفاه، الموت المأساوي لجان. كافاييس .
"الفهم، كما قال كافاييس عن مناهج الرياضيات، هو التقاط الإيماءة والقدرة على الاستمرار. إن الحديث عن كافاييس هو أولاً، وهذا ما ينبغي أن يكون، التفكير في الطرق الممكنة للاستمرار بعده. بالطبع، يتعلق الأمر في المقام الأول بالتاريخ، ومنذ ذلك الحين تمت كتابة تاريخ الرياضيات وفقا لمعاييره الخاصة، وغالبا ما يكون ذلك في فجوة ملحوظة مع تلك التي يمكن استخلاصها من عمله. لكن الأمر لا يمكن إلا أن يتعلق أيضا بمؤلف لم يعتقد أبدا أنه من الممكن الفصل بين هذين النوعين من الأسئلة، للفلسفة، ولفلسفة الرياضيات. ما الذي يمكننا الاحتفاظ يه من المصطلحات التي فكر بها كافاييس فلسفيا في الرياضيات، وخاصة في علاقتها بالتاريخ؟ تحت أي ظروف، وبأي عواقب على طريقتنا في كتابة تاريخ الرياضيات؟ ولا فائدة من القول بأننا سنكتفي هنا بتقديم بعض الملاحظات، فمن المؤكد أن مثل هذا المشروع يتطلب مساعدة جميع أولئك، من علماء الرياضيات وفلاسفة ومؤرخي الرياضيات أو العلوم، الذين ما زالوا يجدون الاهتمام والتحفيز عند قراءة كتاباته.
الدليل الأول هو أن المسافة التاريخية قائمة بيننا وبين جان كافييس. لها على الأقل نتيجتان واضحتان بشكل مباشر.
أولاً، القرب الحي الذي جلبه وحافظ عليه لفترة طويلة وجود معلمين من حولنا لم يعرفوه ويعملوا معه فحسب، بل شاركوا معه تاريخا، حتى لا نقول مصيرا، وقد اختفى هذا النوع من التواطؤ. ويبدو أننا، في الوقت نفسه، نقف الآن، في مقابله وفي مقابل أعماله، على نفس المسافة التأملية التي تفصلنا عن الأعمال العظيمة للتقليد الفلسفي - حتى مع الأخذ في الاعتبار توقفه الدرامي، ما تسبب في عدم الاكتمال الذي لم يتم إنقاذه دائما في أعمال فلاسفة العصور الأقل بربرية.
كان هناك بعد ذلك التطور الطبيعي والمشروع للنقد، سواء على يد علماء الرياضيات الذين، عندما تحدثوا من داخل الممارسة الرياضية، اعترفوا بأنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب الانفتاح الضعيف نسبيا لتفكير كافاييس على تنوع مجالاته، أو على يد فلاسفة مناطقة، حريصين على أن يتموقعوا إزاء إرث مثالية عقلانية معينة، هو فكر مشترك، وغير منكر، للمعلمين الذين تعرف عليهم. إذا تمكنوا من الحكم على تأكيد القوة العقلانية للرياضيات بأنه مقبول، فقد وجدوا أنه من الصعب قبول نظير عدم الثقة العنيد في ما يتعلق بتطورات المنطق الصوري، الذي يشتبه دائما في تفضيله ولادة الأرسطية السكولائية من جديد.
باختصار، لقد أصبح جان كافييس بالنسبة إلينا فيلسوفا مثل أي فيلسوف آخر. اقتصرنا، على أية حال، على البحث أكثر فأكثر في كتاباته عن عناصر الفحص أو الحكم. ومن بين الاحتمالات التي يتيحها مثل هذا الموقف هو توسيع مساحة تقديرنا النقدي. يمكن أن يحدث هذا التوسع في اتجاهين، من خلال العودة إلى الوراء، نحو المصادر، ومن خلال التوجه إلى الأمام، نحو الأجيال القادمة، التي ما تزال حية إلى حد كبير في فرنسا.
من ناحية، قد يكون من المفيد محاولة العثور على أصل بعض مفاهيمه الأساسية، باختصار، فهم تاريخها. لقد حان الوقت لكتابة تاريخ الفلسفة، أو ما يمكن أن تكون عليه فلسفة كافييس. من ناحية أخرى، من المشروع دائما، ويمكن أن يكون مفيدا، إبراز دراسة الموضوع التاريخي بشكل أكبر، حتى في يومنا هذا، وذلك لتقييم قيمة وأهمية الأسس التي حددها عن طريق المقارنة، صراحة أو ضمنا، للممارسة التاريخية.
إن القول بأن وجود كافييس اليوم يميل إلى الاختزال في وجود عمله المكتوب يعني الاعتراف بأن النظر في هذا الأخير يجب، بشكل أساسي، أن يفرض متطلباته على التعليق. الأول هو الحفاظ في حالة من التوازن على النظر في مصدريها الحيين، الفلسفي والرياضياتي. ولهذا السبب سنسعى أولاً إلى إعادة تشكيل عناصر التقليد الفلسفي التي يبدو لنا أنها كانت الأكثر أهمية بالنسبة إليه، في محاولة لتقييم قيمتها بالنسبة إلى تاريخ الرياضيات. شهادات مختلفة، قصصية إلى حد ما ولكنها متسقة، تشهد على رغبته في الترويج لفلسفة أصيلة للعلوم في فرنسا، بعد الحرب، على أساس متين من التفكير في الرياضيات في ذلك الوقت. "الأصيل"، بالنسبة إليه، يعني في المقام الأول الاستقلال، ولا سيما عن المواقف التي يتخذها ممارسو العلوم الرياضية أنفسهم، والذين هم علاوة على ذلك محاوروه الطبيعيون والمباشرون. هذه الشهادات نفسها، وبعض الكتابات، تبين لنا أنه كان قلقا للغاية بشأن هذه النقطة. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء باستقلال الفلسفة لا يمكن أن يجد الاتساق إلا من خلال الاعتماد على ماضيها المتشكل في التاريخ. لدينا من النصوص ما يكفي لمحاولة تحديد، في غياب ما يمكن أن يشكل المحتوى الدقيق لـ "نظريته في العلم"، على الأقل ما هي مصادرها، وإلهامها، وكل ما يشكل التسجيل في ما نسميه تقليدا. ومن خلال الإشارات المتعددة التي تعطيها لنا النصوص لهيمنة التقليد الكانطي، ليس من الصعب رؤية أصل هذه الهيمنة: تعاليم ليون برنشفيك. لذلك، سنفحص أولاً ما كان أساسا، في ما يتعلق بالمواضيع الرئيسية التي عالجها أو تناولها كافييس، العلوم والرياضيات والفلسفة والتاريخ، درس برنشفيك.
هذا الأخير هو المسؤول عن إدخال عقيدة فلسفية في فرنسا يرتبط فيها التاريخ والفلسفة ارتباطا وثيقا. سنسعى إلى تحديد العناصر التي تبدو لنا الأكثر أهمية مما كانت عليه أول كتابات فلسفية لبرنشفيك، وهي أطروحته الرئيسية، "Modalité du jugement" ، والتي تعود طبعتها الأولى إلى عام 1897، وهو العمل الذي يحتوي في الأصل على كل المواضيع تقريبا التي سيتم تطويرها لاحقا.
منذ بداية الفصل الثاني ، يشرح المؤلف الأهمية التاريخية للمشكلة المعالجة. وشدد على ضرورة التفكير في التاريخ، موضحا أنه لا يمكن اختزاله في الفضول الباطل. إن المشكلة الفلسفية لا تُعطى أبدا من الخارج، ولا تُفرض من الخارج بواسطة الأشياء. وبما أنها موجودة في العقل فقط، فلا نستطيع أن نجد معياراً موضوعياً للتأكد من أنها ليست خيالاً أو خدعة، بل أن لها أساساً حقيقياً في طبيعة التأمل الفلسفي. لا يمكن توفير مثل هذا المعيار إلا من خلال فحص المذاهب المختلفة التي نشأت في التاريخ: "فقط بهذا يخرج تأملنا الفردي إلى حد ما من عزلته الحتمية وتواصله مع فكر الإنسانية". وبهذا المعنى، فإن التاريخ هو بالفعل الدعم الدائم للتأمل الفلسفي. وسنرى لاحقا أن الأمر لا يزال أكثر من ذلك بكثير.
ما هي الفلسفة بالنسبة إلى ليون برنشفيك؟ «إن النشاط الفكري الذي يصبح واعيا بذاته، […] هذا هو الفلسفة». الفلسفة تأتي بالكامل من هذه العودة إلى التفكير – ومن هنا جاءت الإشارة إلى التفكير النقدي – حول الفكر كنشاط عفوي أو طبيعي. إنه موقف محايثة. وسوف نجدها ما يطلب صراحة عند كافاييس، صاحب الأطروحات على أية حال. كيف يتم تصميم هذا النشاط؟ وبالعودة إلى الفعل الذي يقوم به العقل في المفهوم. وهذا الفعل هو الحكم الذي يضع الرابطة، فيعيد الازدواجية إلى الوحدة، ويبقى على حاله من خلال تنوع تعبيراته المنطقية. ومن حكم العقل هذا، فإن المفهوم هو التعبير المكثف، والمنطق هو التعبير المتطور. لكن الحكم في حد ذاته هو الفعل الكامل والفريد للنشاط الفكري، وهو بداية العقل ونهايته.
المشكلة الفلسفية تتمثل في البحث عن سبب هذا الحكم. لقد بحث عنه أفلاطون وديكارت، كل على طريقته، في مبدأ متعال، وكان لكانط الفضل في البحث عنه في تحليل الفكر الإنساني، أي في النقد . أعطى هذا الاكتشاف للفلسفة شكلها النهائي، وبالتالي، فهي نقطة الانطلاق الإلزامية للتفكير الفلسفي: فمن كانط يجب على المرء أن يبدأ بالتفلسف. لكننا لا نستطيع أن نأخذ الكانطية حرفيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختزالها إلى موضوع دراسة لمؤرخي الفلسفة. إذا استطاع أن يضطلع بدور صعب في تنشيط الفكر الفلسفي منذ بداياته، فشريطة أن
يجد في النصوص وفي ما وراء التأويلات، الكانطية الحقيقية، الأصيلة، التي هي منهج وليست نسقا.
من الضروري العثور على الطريقة التي اضطر كانط إلى اعتمادها في "نقد ملكة الحكم"، حيث كان عليه، للتعامل مع الحكم الجمالي والغائي، أن يوافق على عدم اختزال الحكم في المفهوم. ثم يجد التفكير النقدي مجالا متميزا في معالجة مشكلة الجهة (modalité). إن الجهة لا تنتمي، في الواقع، إلى الحكم المعتبر في تعبيره التلقائي، بل تضاف إليه بواسطة العقل: فهي ترجع بالكامل إلى التفكير النقدي. إنه حكم على الحكم. من خلال تدمير أساس الفلسفة الديكارتية، يؤدي دحض الحجة الوجودية إلى تقدم حاسم: لم تعد مشكلة الجهة مشكلة لاهوتية لتصبح مشكلة إنسانية. وفي الوقت نفسه، أصبح التفكير في المعرفة الإنسانية ممكنًا، والتي لا يمكن تحديد خصائصها في الفكر الحديث إلا عن طريق العلم.
من الضروري العثور على المنهج الذي اضطر كانط إلى اعتماده في "نقد ملكة الحكم،" حيث كان عليه، للتعامل مع الحكم الجمالي والغائي، أن يوافق على عدم اختزال الحكم في المفهوم. ثم يجد التفكير النقدي مجالا متميزا في معالجة مشكلة الجهة. إن الأخيرة لا تنتمي، في الواقع، إلى الحكم المعتبر في تعبيره التلقائي، بل تضاف إليه عن طريق العقل: فهي ترجع بالكامل إلى التفكير النقدي. إنها حكم على الحكم. من خلال تدمير أساس الفلسفة الديكارتية، يؤدي دحض الحجة الوجودية إلى تقدم حاسم: لم تعد مشكلة الجهة مشكلة لاهوتية لتصبح مشكلة إنسانية. وفي الوقت نفسه، أصبح التفكير في المعرفة الإنسانية ممكنا، ولا يمكن تحديد خصائصها في الفكر الحديث إلا عن طريق العلم.
يميز ليون برنشفيك بين ثلاثة أشكال للحكم، ثلاثة "أفعال حكم مطلقة": حكم الباطن، وحكم الخارج، والحكم المختلط. يطور الشكل الأول علاقات محايثة للأفكار، ووحدتها تكمن في باطنها المتبادل. ""هو"" يعني هذه الوحدة الأولية، المصدر الأصلي للحقيقة. وفي الثانية، يفترض الحكم الوجود، ليس كعلاقة جوهرية بين الأفكار، بل على العكس من ذلك باعتباره استبعادا لكل ما هو داخلي، باعتباره خارجيا خالصا. إن علاقة الذات التي تحكم بالموضوع الذي يحكم عليه هي علاقة تباين مطلق: يتم تفسيرها بصدمة المعطى، مما يدل على عدم قابلية العقل للاختزال إلى شيء آخر غير نفسه. وبالتالي فإن التحليل المجرد يؤدي إلى ثنائية، إلى معنى مزدوج للرابطة "هو"، هذه الأخيرة تدل إما على الفكر أو الكينونة، وكلاهما متعارضان تماما كتأكيد ونفي. إن ثنائية الوجود والفكر بدائية وغير قابلة للاختزال، ولا يستطيع العقل أن يتصور وحدتهما. وهنا نجد المساهمة الأساسية للفلسفة المتعالية. الداخلية هي تأكيد للعقل: الحكم يؤسس العلاقات المحايثة للأفكار. والخارجية هي نفيها المطلق: فالحكم يفترض وجودا خارجيا غير متجانس وغير قابل للاختزال. لكن النفي ليس غياب الإثبات، بل هو فعل حكم. وعلى هذا النحو، فإنه ينطوي على أساس إيجابي. إن سبب النفي ليس غياب سبب الوجود، بل وجود معارضة حقيقية. إن اتحاد الإثبات والنفي في نفس فعل العقل، الذي تفرضه حقيقة المعرفة، هو في حد ذاته غير مفهوم، ولا يمكن أن يكون في الحكم إلا شكلا مختلطا، ملتبسا، قادرا على المشاركة في نظامين مختلفين جذريا من المبادئ. فإذا كانت المعرفة، مصدر الحقيقة، شفافة تماما للعقل، فلن يكون هناك أي شك في حقيقتها. أي شخص مخطئ لا يمكن أن يعتقد أبدا أنه يمتلك الحقيقة. ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال: فالمعرفة التلقائية معرضة بنفس القدر للحقيقة والخطأ. المعرفة المهددة دائما بكونها كاذبة وغير مستقرة وهشة بطبيعتها، هي فقط المعرفة الممكنة. الشكل المختلط هو جهة المعرفة الممكنة. إنه في الأساس شكل العلم، الذي يتضمن تقدمه المستمر تساؤلا دائما عن المبادئ التي تعتبر مكتسبات، واستكشافا مستمرا يسبقه الشك. ومن هنا ما سيكون من الآن فصاعدا الإطار لتطور فلسفة برنشفيك: فلسفة الفئة المختلطة، الإمكان.
يبدو لنا أنه يمكننا أن نجعل من مسألة وضع جهة الحكم التاريخي، مع اختيار الجهات والتسلسل الهرمي المخصص لها، محك الاختلاف في التوجه بين فلسفتي المعلم والتلميذ، حتى لو كانت إحداهما ما تزال في طور التكوين، وستظل كذلك إلى الأبد. سنحاول أن نبين كيف أنه، في فجوة يبدو لنا أنها مفترضة بالنسبة إلى معلمه، لم يتمكن كافاييس من إبراز دور الضرورة في الصيرورة الرياضية، ولا يقتصر على ذلك المعترف به على أنه احتمالية، فقط عن طريق تقليل كل ذلك من الإمكان. وحتى لو تم إثبات هذه النقطة، فإن مهمة فهم الأسباب الكامنة ستظل قائمة.
إن اختيار الإمكان كجهة مطلقة لتاريخ العلم هو ما سمح لبرنشفيك بتصور هذا النظام وفقا لمعايير الفكر التأملي، وبالتالي له معنى مختلف تماما عن معنى البحث التجريبي البسيط، الذي تم تطويره لتلبية احتياجات السبب، في المناسبات التذكارية العشوائية أو البحث عن العناوين ذات الأولوية. والتاريخ بهذا المعنى هو مظهر من مظاهر العقلانية الفلسفية. ستسعى أعمال برنشفيك العظيمة، ولا سيما "مراحل فلسفة الرياضيات" (1912)، و"التجربة الإنسانية والسببية الفيزيائية" (1922)، إلى إعادة اكتشاف المبادئ الأساسية للنشاط الفكري، من خلال متابعة تاريخ العلم.
إن مراحل التقدم العلمي هي مراحل كثيرة جدا في تقدم المعرفة، أي في الجهد الذي يبذله العقل البشري بلا كلل من أجل إخضاع الخارج إلى باطن الفكر العقلاني بشكل أحسن فأحسن، وذلك من خلال سلسلة من المحاولات والتوازنات المؤقتة والثورات.
وسوف نضيف أنه في هذا التطور للعقل العلمي، يتم حجز مكان خاص للرياضيات. إنها "النزعة الرياضياتية" التي سنجدها، مأخوذة إلى درجة أعلى من التوهج، عند جان كافييس.
لدى برنشفيك قناعة، ربما جاءت من كورنو، بأن تاريخ الرياضيات يوفر مفتاح الفلسفة وتاريخها. كما يعتقد أن تطور الرياضيات شرط لتطور العلوم. "النظر في الرياضيات، كما كتب في مراحل فلسفة الرياضيات ، هو أساس معرفة العقل كما هو أساس العلوم الطبيعية، وللسبب نفسه: يعود العمل الفكري الحر والخصب إلى الوقت الذي جاءت فيه الرياضيات لتجلب للإنسان المعيار الحقيقي للحقيقة".
إن مذهبه حول جهة الحكم هو الذي سمح لبرنشفيك بتجاوز الموقف البسيط المذكور أعلاه، للتاريخ كدعم للتأمل الفلسفي من أجل مفهوم أكثر دينامية للفلسفة التأملية التي تجد مادتها الطبيعية في تاريخ الفكر الإنساني. إن الفلسفة، بعد أن أدركت النشاط الفكري باعتباره جهدا دائما لاستيعاب حكم الخارج تدريجيا وبالتالي تحقيق الوحدة في المعرفة، تكتشف دينامية العقل. ولا يمكن معرفة هذه الدينامية العقلانية بشكل مباشر، ولكن فقط من خلال منتجاتها، أعمالها. ولا يمكن فهمها إلا من خلال التفكير في المفاهيم العلمية المختلفة، المرتبطة بتفسيراتها الفلسفية، كما تجلت عبر التاريخ. التاريخ هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للفيلسوف لإنجاز مهمته: “فهم العقل”، بحسب ليون برنشفيك، و”بناء نظرية العقل” بحسب جان كافاييس.
هذا هو المكان الذي يفصل فيه ليون برنشفيك نفسه عن الفلسفة الألمانية، وعن ممثليها الذين يمكن أن نسميهم ما بعد كانطيين. ولم يعرف الأخيرون كيف، حسب رأيه، أن تزدهر المثالية الجديدة التي أخفى النقد بذورها. سوف تعارض المثالية البرنشفيكية المثالية الألمانية من خلال ما أسماه السيد جيرو "الوضعية الروحية". وتعطي هذه الأخيرة لنفسها المهمة الحصرية المتمثلة في معرفة الروح الحية، واتباع الإنسان في الغزو البطيء لروحه، وهو الأمر الذي يعده العلم ويحدد مراحله.
من خلال العلم نكتشف أعمال العقل، ومن خلال الانطلاق من الأعمال العلمية يمكننا اكتشاف الأساليب العقلانية التي ولّدتها، كل هذا التطور الذي يسميه برنشفيك "تقدم الوعي". لكن، بدلا من دراسة أعمال العقل البشري لتمييز القوانين الأساسية لنشاطه والعلاقات الأساسية التي يكشف عنها تقدم العلم تدريجيا، انشغل الما بعد كانطيين بمشكلة الأصل، وإقامة علاقات البنوة بين هذه القوانين. لكنها مشكلة غير قابلة للحل، تماما كما المشكلة "الوجودية".
وفي ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، سنلاحظ، دون الخوض في المزيد، أن كافييس لم ينكر أبدا تمسكه بهذا الموقف. إن تصور العقل كنشاط أساسي يعطيه وحده صلاحية القضاء على الأنطولوجيا أو الميتافيزيقا. إن النصوص التي يرفض فيها كافاييس، باعتباره تنازلا عن الفكر، أي إسقاط له في نظام وجودي مطلق (ما يسميه بسهولة الشيء “في ذاته”) عديدة ولا لبس فيها، ويقبل مؤلفها تماما العواقب التي استخلصها معلمه منها. إذا كان عليه أن يحرم نفسه من الملجإ الأنطولوجي، فكل ما يبقى للفكر، ليشكل نفسه كرياضيات وكعلم، هو التاريخ.
أما اشتراط الأصل فهو في نظر ليون برنشفيك انحراف حقيقي عن الفكر المثالي. وهكذا نرى مفكرين مثل فيخته شيلينغ، هيغل لم يعودوا يكتفون باستنباط العالم من المعرفة، بل أخذوا على عاتقهم أيضا استنباط الطبيعة والتاريخ، إلخ..، بحيث يظهر تسلسل الأحداث كعلامة، بل تصديق، للضرورة المنطقية. ثم ننتقل من النقد إلى الميتانقد، ونميل نحو العقلانية المطلقة التي من شأنها أن تقلب المعنى الحقيقي للمذهب الكانطي. وهنا مرة أخرى، يمكننا أن نعتبر أن كافاييس، برفضه إدخال مشكلة اشتقاق الرياضيات من شيء آخر غير نفسها، إلى مجال مهام فلسفة الرياضيات، إلى درجة التجاهل المتعمد لاعتبارات التكوين النفسي أو السوسيولوجي، لم تجد نفسها متفقة مع الامتناع البرنشفيكي عن التصويت، لكنها أعطته شكلاً أكثر راديكالية.
اللحظة الأكثر تمثيلاً للنزعة الرياضياتية، في نظر برنشفيك، هي اللحظة الديكارتية. يتم تقديمها على أنها غزو لاستقلالية العقل، وتحويل المكاني والخيالي إلى علاقات عقلانية، واختزال الخارجية إلى داخلية، وإظهار القوة البناءة لـ "التحليل" - وهذا الأخير يؤخذ بالمعنى الجبري الجديد، الذي سمح لبرنشفيك بالحديث عن "روحانية الجبر". أحد أكثر مفاهيم ديكارت أصالة، والتي تم اقتراحها بالفعل في كتابه "قواعد لتوجيه الفكر"، هو مفهوم الحدس كفعل عقلي، وذكاء علائقي مباشر، مثل الوضع في معادلة. والنتيجة النهائية هي محو أي اختلاف في الطبيعة بين الحدس والاستنباط. "الحدس"، كما يقول برنشفيك في كتابه "مراحل فلسفة الرياضيات"، ليس شكلا أعلى من التمثيل الذي من خلاله يتواصل العقل مع شيء في ذاته، ويؤكد الحقيقة المتعالية للموضوع: إنه تعقل خالص يجمع في فعل اتصاب غير قابل للتجزئة مجموعة متنوعة من الأفكار المتميزة ويؤكد وحدتها كحقيقة واضحة بذاتها». لا يتعلق الأمر هنا بـ «ملكة ميتافيزيقية»، بل بـ «مبدأ العلم الذي وصل إلى أعلى درجات الوضوح والمعقولية»، مما يسمح لتعقلية الفكر الحديث بأن تتكشف بحرية وخصوبة لا حدود لها.
هذا التصور الديكارتي هو على وجه الخصوص ما سمح لسبينوزا بمعارضة الحدس الحسي باعتباره ملكة إدراك محتواها الصور، بالفكرة كفعل عقلي. عند سبينوزا، «العلم الحدسي مكتف بذاته، إنه ليس سوى تطور الدينامية الداخلية التي تحدد طبيعة الفكر، تميز التلقائية العقلية». كل فكرة تؤكد نفسها، وتنتج من تلقاء ذاتها نتائجها الخاصة، والتحقق من صحة المعرفة ليس سوى وعي بالقوة التركيبية للأفكار.
نحن نعرف، وكثيرا ما شرحنا، إحالات كافاييس إلى سبينوزا. باعتبارها كذلك، فهي بالأحرى ضمنية، مرتبطة باختيار بعض التعبيرات المميزة، مثل "الجواهر المفردة"، وبدلاً من إرادة الاسترجاع المحضة والبسيطة، سيكون من الأفضل بلا شك الحديث عن انخراط عام، من حيث المبدأ، في السبينوزية. يخفي عنده هذا الانخراط، من بين أمور أخرى، قناعة، تم تأكيدها مرات عديدة، بهيمنة الضرورة في التاريخ، وقبل كل شيء بالطبع في تاريخ الرياضيات. لقد طوَّر كافايليس تصورا أصيلا، مستوحى من المآل المعاصر لنظرية المجموعات، للضرورة الرياضياتية التي تُفهم على أنها محايثة للتاريخ. سوف يتعين علينل العودة إلى ذلك، لكن من المناسب هنا التأكيد على أن وضع الضرورة في المقدمة هو إحدى النقاط التي يبتعد بها كافاييس بدقة عن تصورات برنشفيك الذي يربط، كما رأينا، فكرة تاريخ العلم بجهة المعرفة الممكنة. يقول: «إن الحل الذي سيقدمه سبينوزا - ضمنيًا بلا شك، ومع ذلك بكل وضوح - لمشكلة الجهة سيكون اختزال جميع أشكال الجهة في نوع واحد، هو الضرورة»، أو مرة أخرى: "تتمثل مشكلة جهة الحكم عند سبينوزا في البديل التالي: “ليس هناك حل وسط بين الممكن والضروري؛ الممكن يؤول إلى العدم، الوجود هو الوجود الضروري”. إذا نظرنا إليه في علاقة بتنظير برنشفيك، الذي سنناقش أدناه نسخته العقلية المختلفة تماما عند جورج كانغيلام، يمكننا القول إن تصور كافاييس، مثل تصور سبينوزا، يذهب إلى أقصى الحدود على طريق الضرورة، أو بشكل أكثر دقة ربما، ينزع، بين قطبي الضرورة والإمكان، إلى إلغاء قطب الممكن البسيط. قد يكون هذا هو المعنى الأساسي لإحالة كافيليس إلى سبينوزا.
يبدو أن كاتبنا (كافاييس) وجد عند ديديكيند التطبيق المثالي لما كان يقصده بالضرورة. في كتابه "المنهج الأكسيوماتيكي والنزعة الصورية"، يستشهد ب"خطاب التمكين" (لديدكيند) ويأخذ مثال الأسي غير الكامل: "إن التوسعات في التعريفات لا تترك مجالا للاعتباطي ولكنها تتبع بضرورة مطلقة تعريفات بدائية إذا طبقنا مبدأ أن القوانين التي تنشأ منها هي سمة من سمات المفاهيم التي تقدمها وذات صلاحية كونية. هناك "توليد ضروري لمفاهيم جديدة"، ووفقا لضرورة مزدوجة، يوضح كافايييس، وهو يعترف بأنه لا يمكن تحديد الكلمة بأي طريقة أخرى سوى بالاعتراف بمتطلبات معينة، متطلبات داخلية للمشاكل والأفاهيم. تتطلب العملية المطلوبة توسيع مجال الموضوعات؛ وفي هذا المجال الجديد، تتطلب العلاقات تعريفا جديدا. يتعلق الأمر في الأساس باستقلالية إجرائية، أي استقلالية أفعال عالم الرياضيات الذي يمارس العمليات. في عرض ديديكيند للتقدم الرياضياتي كتقديم ضروري، لأنه ضروري، لمفاهيم جديدة، يقرأ كافاييس "الدينامية الداخلية للرياضيات المستقلة": استقلال الرياضيات ومستقبلها، ضد أي محاولة للاختزال.
هذا العداء لأي شكل من أشكال الاختزال (بالأخص الحسابي هنا) وجد تعبيره عند ديديكيند في معجم "الخلق"، وهو مصطلح استخدمه كافايليس نفسه في أطروحته الصغيرة حول النظرية الكانتورية، دون أن يكون هناك تناقض واضح. يتعارض مع ضرورة المسار: كيف يمكننا أن نفهم الأخيرة؟
في الواقع، لا يسعى كافاييس إلى استيعاب النمو برمته في خطاطة الاستقلال الذاتي-الضرورة، ويعرف تماما كيف يفسح المجال، على هامش مثل هذا الخطاطة إذا جاز التعبير، للاحتمال. وإذا رجعننا، في "ملاحظات على تشكيل النظرية المجردة للمجموعات، إلى وصف ظهور هذه الأخيرة، نرى أن الضرورة بالنسبة له، في تاريخ أصيل، ليست مطلقة. إن التأملات التمهيدية موجهة بالتأكيد ضد ممارسة التاريخ التي من شأنها أن تبالغ بشكل غير لائق في دور الاحتمال، وهي لا تنفيه. لا يقول كافاييس إن تاريخ الرياضيات ليس مرتبطا بما يحمله - فهذا الارتباط ذو شقين، مع المشكلات والأساليب، وهو مجرد موقف جزئي - ولكنه، من بين جميع القصص، هو الأقل. لا ينكر أي قيمة تفسيرية تاريخية لعوامل مثل الاعتباطي، الفردي أو أسلوب البيئة، فهو يدعي أنها ليست كافية للتفسير. بل إنه يدرك صعوبة التمييز بين الترابطات النفسية أو الاجتماعية والضرورة الرياضياتية، أو صعوبة الإجابة على السؤال: هل هناك ظهور ضروري، أو بنية مستقلة، أو خيال تاريخي، أو تعددية مدمجة في نسق محتمل؟ ما يتعلق به الأمر هو الحفاظ على وجود نواة غير قابلة للاختزال من الموضوعية في المعرفة، من الضرورة في التطور التاريخي للرياضيات.
كما ذكرنا سابقا، لم يكتف كافاييس بالمهمة المتمثلة في إعادة صياغة التصور الذي استطعنا تكوينه عن المعرفة الرياضياتية وتاريخ الرياضيات بربط الاتصال بأحدث التطورات في المنطق والتحليل الرياضياتي. كان لديه مشروع للمساهمة في تشكيل، بناء على هذه الأسس، نظرية للمعرفة، سُميت في البداية ب"نظرية العقل"، ثم ب"فلسفة المفهوم" في ما بعد. ويبدو لنا، هنا مرة أخرى، أننا سوف نفهم القصد منها ورهاناتها بشكل أفضل، إذا وافقنا على العودة إلى تفسير برنشفيك لكانط.
بالنسبة إلى ليون برنشفيك، نتجت النظرية الكانطية حول المعرفة ككل من الجهد المبذول لأخذ الرياضيات في الاعتبار كمعرفة. بدأ كانط من المعارضة الهيومية الواضحة بين حقائق العقل وحقائق الواقع، ومن تفككهما الجذري: من ناحية الاستخدام المنطقي للعقل التحليلي، ومن ناحية أخرى، التجربة التي لا يمكن اختزالها إليه. لكن اكتشاف المعرفة الرياضياتية باعتبارها عقلانية وتركيبية يبني جسرا بين الفهم والواقع، جاعلا علما يقينيا قابلا للتصور. وهذا لا يمكن أن يكون دون عواقب على الفهم وضرورته، التي يجب تعديل مفهومها ذاته. هناك حاجة إلى نوع جديد من الحكم الضروري، الذي يعارض الضرورة الرياضياتية مع الضرورة التحليلية، التي أراد لايبنتز إلحاقها بها. بالنسبة إلى هذا النوع الجديد من الضرورة، هناك حاجة إلى حالة مدنية جديدة: سنكون هنا أمام حكم تركيبي قبلي. لكن، في الوقت نفسه، يتصور كانط هذا الحكم الرياضياتي بطريقة أكثر تقليدية من ديكارت ولايبنيز. بينما، عند هذين الأخيرين، يتم تنفيذ تسلسل الحقائق الرياضياتية بطريقة غالبا ما تكون غير قابلة للاختزال إلى القياس المنطقي، يستمر كانط في تصور هذا التسلسل وفقا للقوانين البسيطة للمنطق الصوري ويبني طبيعتها اليقينية على مبدإ التناقض. ويتمثل حلها في السماح للضرورة التحليلية بأن تتمدد قبليا إلى المجال الواقعي، بحيث يمكن أن يعطى لها قبليا محتوى واقعي، وذلك بفضل الحدوس الخالصة. وهكذا نحصل على المبادئ والقضايا التي لا يمكننا التخلص منها، لكن العلاقة بينها تظل منطقية بشكل حصري. مثل هذا الحل لا يمر دون أن يثير الكثير من الصعوبات، التي لا يمكن ل"نظرية العقل"، في "المنهج الأكسيوماتيكي والنزعة الصورية"، أو "فلسفة المفهوم"، في الكتابات المنشورة بعد وفاته، إلا أن تأخذها بعين الاعتبار.
هذه التحليلات الكانطية، إذا أخذناها مع انتقادات برنشفيك، توفر الأصل والإطار، ليس فقط للمناقشة المحكمة التي أخضع لها كافييس المذهب الكانطي في عدة مناسبات، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، لما ستكونه تصورات كافييس المتعلقة بالرياضيات، وبالعلاقة بين الرياضيات والمنطق. وعلى أية حال، فهي تساعد على توضيحها. وسنبين ذلك عبر ثلاث نقاط.
النقطة الأولى تتعلق بالأهمية التي يوليها كافييس لمذهب هيلبيرت في الرياضيات.
في التطورات التي خصصها لهيلبرت، لم يتأخر كافاييس عن تذكر الاستشهادات التي اقتبسها هيلبرت من كانط. وهكذا، في "المنهج الأكسيوماتيكي والنزعة الصورية"، الفصل الثالث، نجد استشهادات من Neubegründung der Mathematik (إعادة تأسيس الرياضيات) لعام 1922: “لقد أظهر كانط بالفعل أن الرياضيات لها موضوع مؤكد، بشكل مستقل عن كل منطق، وبالتالي، لا يمكن تأسيسها أبدا على المنطق وحده، ومن هنا فشل فريجه وديديكند. على العكس من ذلك، فإن شرط تطبيق الاستدلالات المنطقية هو وجود معطى في التمثل، بعض الأشياء الملموسة غير المنطقية والتي تكون موجودة بشكل حدسي كتجربة مباشرة تسبق كل فكر". يؤول كافاييس الإحالة إلى كانط على أنها بحث عن سلطة فلسفية تدعم فكرة استقلالية الرياضيات مقارنة بالمنطق: "الرياضيات أكثر من مجرد منطق، بقدر ما هي فكر فعال، وأن كل فكر فعال يفترض مسبقا تطبيق الفكر المجرد على الحدس." من ناحية، الرياضيات هي طريقة أصيلة للمعرفة، والتي اعترف بها كانط فلسفيا من خلال تخصيصها لمجال الأحكام التركيبية القبلية؛ ومن ناحية أخرى، فهي شيء آخر غير المنطق، ومجالها الصحيح هو التسلسل أو الارتباط بين القضايا، باستثناء تحديد القضايا نفسها، والذي من الضروري أن ينطوي على حدس خالص قبلي. وهذا ما يعترف به التحليل الهلبيرتي، بينما هو يتميز عن الاستنتاجات الكانطية ويعطيها نطاقا آخر. "من الذي لا يستخدم، يقول هيلبرت في كتابه Mathematische Probleme (مشكلة الرياضيات) لعام 1900، الذي استشهد به كافاييس، رسم القطع المضمنة لإثبات صارم لنظرية معقدة حول استمرارية الدوال، أو وجود نقاط التراكم؟ من يمكنه الاستغناء عن شكل المثلث، والدائرة مع مركزها، وتقاطع المحاور الإحداثية؟... العلامات الحسابية هي أشكال مكتوبة، والأشكال الهندسية أشكال مرسومة، وسيكون من المستحيل أيضا على عالم الرياضيات أن يستغني أو يتجاهل الأقواس عند الكتابة". إن جوهر الرياضيات، كما يعلق كافاييس، هو «لعب منظم بالرموز». إن العملية الملموسة للتوفيق تحدد، وهذا عن حق، "منطقة غير قابلة للاختزال من الاستدلال الحدسي"، والتي بدونها لن تكون الرياضيات موجودة. في العمل الرياضياتي الحقيقي، يكمن المهم في التسلسلات الحدسية. إنها أولا، كما فطن كانط، الخصوبة في المعرفة هي التي تضمن اللجوء إلى الحدس. لكن التقدم في المعرفة لا يحدث بشكل سلبي، نتيجة توحيد المتنوع المعطى حدسيا للفكر المجرد. فالإشارة، العلامة الرياضية، لا تكون شيئا بدون قواعد الاستخدام، التي هي ذهنية، والتي يؤدي تطبيقها إلى حركة في المحسوس، المادة الحقيقية للخلق. "إنما في الحدس يظهر الفعل الحر"، والحدس ما يزال نشاطا. لدينا هنا أحد المصادر لما سيكون موضوعا ثابتا لـكافييس.
والنقطة الثانية لا تقل أهمية. في فقرة رئيسية من منشور له بعد وفاته، سعى كاتبنا، من خلال تحليل عميق بشكل خاص لعملية البرهنة، إلى إعادة مسك "الخصائص التأسيسية للفكر" التي يسميها "النموذج" و"الموضوعي". من خلال ربط التسلسل العقلاني بالتركيب الكانطي، رغب في تحديد أن "التركيب الذي كشف عنه كانط في الفكر لا يتطلب أي تنوع مقدم أو مختلف بل يتطلب نفسه، تعدد بلحظاته وتقدمه..." المقطع موح بشكل مباشر انطلاقا من الطريقة التي، كما أكدنا أعلاه عند تذكيرنا باعتراضات ليون برنشفيك على استنباط المقولات، يصف بها كانط القوة التركيبية للمقولة عندما يسعى إلى إعادة القبض عليها بشكل مطلق، بصرف النظر عن كل تجربة. إن توحيد المصطلحات يجد نفسه فيها، لا من خلال حذف أو إهمال ما قد يجد فيها من مختلف، بفضل هوية خاصية مشتركة، ولكن كوحدة المختلف كما هو كذلك. هذا التعميم للتركيب المقولاتي المطلق لكانط نفسه ينطلق، كما نلاحظ، من المفهوم الأنطولوجي للعلاقة التي سيسعى كافييس إلى الحصول على دعم لها في محاورة "بارمينيدس" لأفلاطون : "كينونة [العلاقة] هي ما تضيفه إلى أصلها، وبالتالي فهي غير الضرورة التي تجعلها واحدة، لذلك يؤكد رغم هذه الضرورة استقلالا يترجم إلى لامبالاة نسبية، مصدر للتعددية". ويربط كافاييس على الفور، في حركة برنشفيكية بالكامل، التوحيد المقولاتي المفهوم على هذا النحو بالتاريخ أو بما سيسميه في النهاية "التقدم"، ما دام أنه يحدد كموضوع حقيقي لهذا التوحيد، ليس المتعدد الحدسي للتمثيل، المتروك ل"الخيال المكاني"، ولكن "حدوث الأفعال بحيث أن كل واحد منها، وهو ينسى ويتحقق في نفس الوقت في المعنى، لا يمكن إلا أن يطرح كينونته الخاصة كعنصر من مجموعة معترف بها كتعددية كاملة، وعلى الفور كقاعدة انطلاق لأفعال جديدة"، تجعل التركيب "متوازي الامتداد مع توليد المركب". سيتم استئناف التحليل في الصفحة الأخيرة.
النقطة الأخيرة تتعلق بعقيدة المفهوم بمعناها الحصري.
إن صعوبة حل كانط للمشكلة التي تطرحها المعرفة الرياضية، ألا وهي تمديد الضرورة التحليلية إلى الواقعي الحدسي، ترتبط بعدم كفاية نظريته حول المفهوم. حجة كانط العظيمة ضد لايبنتز في ما يتعلق بالرياضيات، والتي نجدها في عدة فقرات من "نقد العقل الخالص"، هي ما يلي: من المستحيل استخلاص مفهوم بسيط من قضايا تتجاوزه، كما يحدث رغم ذلك باستمرار في الهندسة. سلسلة المبرهنات الهندسية تمثل زيادة في معرفتنا، وليس فقط زيادة في وضوح المعرفة المفترض وجودها قبلا بداخلنا، كما أرادها لايبنتز. ولتفسير هذه الزيادة الحقيقية، نحتاج إلى تركيب، وهو شيء يضاف إلى المفهوم، ولا يمكن استخلاصه منه، وبالتالي يجب البحث عنه في مكان آخر، وإلا فإن تقدمنا في المعرفة سيفتقر إلى الواقع. وبالتالي فإن الفرق بين كانط ولايبنيز يتعلق في النهاية بالفكرة التي لديهما حول طبيعة المفهوم. بالنسبة إلى كانط، فإن المفهوم، منظورا إليه في حد ذاته، ليس سوى إطار فارغ، قابل لتعريف اسمي بحت. بالنسبة إلى لايبنتز، عالم الرياضيات الحقيقي، فإن المفهوم هو جوهر إيجابي، واقع معقول بحت،٠ لا يتضمن تعريفا اسميا فحسب، بل تعريفا حقيقيا، يمكننا من خلاله تطوير الخصائص إلى ما لا نهاية.
من وجهة النظر تلك، لا يمكن للعقيدة الكانطية حول المفهوم، المفتقر للمعقولية، أن تقنع كافاييس، الذي ينتمي هنا بالكامل إلى تقليد العقلانية الكلاسيكية القادمة من ديكارت: تقليد الفهم باعتباره قوة تفكير، وقوة إيجابية لتوليد المفاهيم الكاملة، المشبعة بالمعقولية، المناسبة لمعرفة الأشياء. سحب جوهر "الطبيعة البسيطة" الديكارتية من نمطه الجبري التجريدي طابع الكونية المفردة، الذي جعلها قمينة بتأسيس علم الفهم الخالص. وهذا ينطبق أكثر، إن أمكن، على سبينوزا، الذي رأينا أنه طبع بطريقة معينة، بالنسبة إلى ليون برنشفيك الذي لم يخف أبدا ارتباطاته السبينوزية، طريقة لتحقيق اللحظة الديكارتية. نحن ندرك أن الأخير لمس في ذاته القدرة على أن يظن نفسه مخولا هنا للاستسلام للحظة للمفارقة التاريخية مقترحا أن نرى في حكم العلاقة الديكارتي تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للحكم التركيبي القبلي، المتحرر من الحكم المسبق الأرسطي لصالح المفاهيم والمقولات.
عند ديكارت، يسمح التفرد الذي يدركه الفهم بأن ندرك، في بساطة صيغة وحيدة وفريدة، قانون العديد من الأسباب الأخرى، المتفردة نفسها، في مجال أكثر تقييدا. معنى التفرد، بما هو غياب الامتداد بحسب تعريف المناطقة، حاضر هنا ليميز استبعاد التصور التجريدي باعتباره عمومية تجريبية لا تأتي حقيقتها إلا من المحسوسات التي تتحدر منها. إن "الجوهر المفرد" السبينوزي لا يتناسب مع المفهوم النوعي.
في التطور البرنامجي الذي يتم الاستشهاد به كثيرا والذي اختتم منشوره بعد وفاته، يؤكد كافاييس أن نظرية في العلم لا يمكن أن تأتي إلا من "فلسفة المفهوم" وحدها القادرة على السماح لنا بالتفكير في "الضرورة المولدة"، وهي ضرورة "جدلية". أن التقدم، كما يوضح، يتم "بين جواهر مفردة"، وأن "ما بعد أكثر مما قبل، لا لأنه يحتويه أو حتى يمتد إليه، بل لأنه يخرج منه بالضرورة، ويحمل في مضمونه العلامة، المفردة في كل مرة، على تفوقه". ولذلك نجد مجددا، في ما يمكن أن نعتبره فكره التاريخي النهائي، سيطرة الضرورة. يتم التعبير عنها بلغة فلسفية تستعير في آن واحد من سبينوزا ("الضرورة"، "الجوهر المفرد")، وتحيل في زمن متأخر إلى هيجل ("الجدل"، "لحظات الوعي") - دون أن نكون متأكدين من قدرتنا على جعل محتوى الفكر يتطابق مع هذه الأفاهيم بما يتوافق تماما مع المذاهب التي تستحضرها. ومن الطبيعي أن يؤكد مفسرو هذه المقاطع الغامضة بعص الشيء إما على أحدها أو بالأحرى على آخر، حسب حساسيتهم الفلسفية. من المستحيل بالطبع، ومن غير المجدي بلا شك، الاختيار بين الاثنين، على افتراض أن الإحالات غير متوافقة، وهو ما لم يكن بالتأكيد في ذهن كافاييس على أي حال.
في عمل سابق اعتقدت أنه من الممكن تسليط الضوء على هذا التطور للجواهر المفردة من خلال مرحلة بارزة بشكل خاص في تاريخ الرياضيات، والتي لم يتجاهلها كاتبنا أبدا، لأنها تتعلق بمفاهيم القياس والتكامل. لنفكر في مفاهيم تكامل كوشي، وتكامل ريمان، وقياس بوريل، وقياس ونكامل ليبيسغ، وقياس وتكامل ستيلتجيس، ثم ستيلتجيس-ليبيسغ
، وقياس رادون، والقياس والتكامل بمعنى دانييل. سوف نعثر من جديد على جوهرها المعقول الرياضياتي في تعريفها وعلاقتها بالنظرية، وعلى وضعها باعتبارها "جواهر مفردة" في واقعة أن خصائصها المميزة تكشف، في كل مظهر من مظاهرها التاريخية، عن تفوق يمكن التعبير عنه بمصطلحات إجرائية خاصة. سواء تعلق الأمر، في المجال الدالي، بالخصائص المطلوبة للدالة المراد تكاملها (استمراريتها، رتابتها، إلخ..)، أو، في حقل التعريف، بطبيعة المجال الذي ندمجها فيه (نهائي أو لا نهائي، واقعي أو معقد، يتضمن أو لا يتضمن نقاط انقطاع، إلخ..)، يترجم كل غزو للعمومية إلى زيادة في الإمكانات العاملية، بالنسبة إلى كل خصائص في كل مرة محددة. وهكذا، فإن تكامل ريمان سمح بتفادي إكراه الاستمرارية (الكلي) على الدوال التي حدد لها كوشي نهجه التكاملي، وبألا يتطلب منها بالتالي سوى التكامل بمعنى ريمان، وهو شرط أكثر عمومية من الاستمرارية. وهكذا، بالنسبة إلى قياس جوردان، المقتصر على المحدود، فإن قياس بوريل يصل إلى التناهي القابل للعد، وهي علامة فريدة من التقدم التي ستجعل تعريف ليبيسغ لتكامله ممكنا.
وهكذا، بالمقارنة مع تكامل ريمان، يؤذن تكامل ليبيسغ، من بين المزايا العاملية الأخرى، بالمرور إلى الحد على التسلسلات المتزايدة للدوال، الذي يسمح بالوصول إلى الإكمال في مساحات الدوال التي يمكننا تحديدها انطلاقا منه. أما في ما يخص"قياس ستيلتجيس" فتتمثل خصوصيته في تعميم أفاهيم ذات أصل فيزيائي مرتبطة بقياس الأحجام، مثل أفهوم القياس الفوري، المعرف بطريقة مباشرة، المستقلة عن أي تعريف مسبق للكميات، ثم أفهوم المجموع المرجح. يمكننا اعتبار تكامل ستيلتجيس، على سبيل المثال، دالة محددة على قطعة حقيقية مقسمة إلى فواصل، مثل المجموع المرجح لهذه الدالة لأجل قياس محدد على أنه يأخذ كقيمة، في كل فاصل زمني، فرق القيم المأخوذة بالدالة عند حدود الفواصل. ستظهر الميزة العاملية لهذا المفهوم لاحقا، مع مبرهنات التمثيل التي تجعلها ممكنة، خاصة بعد أن أظهر فريجيس ريسز أن أي دالة خطية تدع نفسها تعبر من خلال تكامل ستيلتجيس عن دالة مقيدة بخاصية معينة محددة جيدا (كونها "مع تغير محدود"). يصبح التكامل "معاملا"، أي وسيلة للحصول على دالة من دوال أخرى، ووجهة نظر أساسية للتحليل الدالي. إن الجمع بين تكامل ستيلتجيس وتكامل ليبيسغ، وصياغته من حيث الشكل الخطي، اللذين يفتحان مجالات جديدة للعمل، يؤديان إلى تعريفات حديثة.
يبقى تحديد الاختلافات التي تفصل تصورات تاريخ الرياضيات التي كانت، في رأينا، تلك الخاصة بكافييس، عن تصورات برنشفيك، الأكثر عمومية، المتعلقة بتاريخ المعرفة العلمية. ربما تحتفظ بكل معانيها، إذا كنا على استعداد لقبول الموقف الذي نتمسك فيه بالسؤال الرئيسي الذي تغطيه، وهو جهة الحكم التاريخي.
بالنسبة إلى كافييس، يتطلب الإخلاص لما في محتوى فكري من رياضيات طرح موضوعية وضرورة صيرورته. بالنسبة إلى الأولى: "هناك موضوعية، مؤسسة رياضياتيا، للصيرورة الرياضية"؛ "وحتى لو تصورنا الرياضيات كنظام في حد ذاته، فإن لفات عملية الكشف ستكون مرتبطة ببنية الأجزاء المكشوفة". وبالنسبة إلى الثانية: "عالم الرياضيات هو كاشف الضروريات"؛ "يجب ألا تكون صورة الإيماءة خادعة: فمهما ظهر اختراع منهج ما بلا مبرر، فإن تطور الرياضيات يحدث وفقا لإيقاع ضروري"؛ "الاستقلالية إذن ضرورة".
المشكلة تأتي من واقعة أن الموضوعية والضرورة هما في حد ذاتهما نافيتان للتاريخ. وبالتالي، فإن تاريخ الرياضيات لا يمكن أن يكون إلا تاريخا خاصا جدا، يجب أن يُؤخذ بمعنى لا يتوافق مع المعنى العادي لكلمة تاريخ. كما حدث لكافييس أن قال عن هذا التاريخ "إنه ليس تاريخا"، أو حتى أنه "لا شيء أقل تاريخية - بمعنى أن يصبح مبهما، لا يمكن فهمه إلا عن طريق الحدس الفني - من تاريخ الرياضيات". وهكذا فإن التاريخ، عندما يدرس موضوعا رياضياتيا، فهو، إذا جاز التعبير، مجبر بطبيعته على فصل نفسه عن "ما هو حامل له"، أي مادته المحتملة. وهذا الانفكاك عن الاحتمالي، الذي يصل إلى حد الكشف عن الضرورة، يؤدي إلى إلغاء الجزء من التاريخ بالمعنى التجريبي. بمجرد اكتمال التاريخ، ندرك أن الصدفة، في جانبها الاعتباطي، كانت في الأساس مجرد مظهر. لقد كانت الضرورة حاضرة، ظهرت عند التحليل، فجأة، في التسلسل المكشوف للمفاهيم: كان هناك إكراه على المشكلات والمناهج، تكييف متبادل للأفاهيم والنظريات، اعتماد متبادل للأجزاء في ما بينهما ومع الكل.
كحد لعمل التوضيح وإعادة البناء، الذي هو على وجه التحديد عمل المؤرخ الحقيقي، لا تكون الضرورة إلا بعدية. ومن هنا رفض أي غائية عقلانية، الجزء الذي يظل من المشروع الاعتراف به لما لا يمكن التنبؤ به، للمغامرة في مشروع العلم. لقد رأينا كافييس يؤكد على هذا في ما يتعلق بالنظرية المجردة عن المجموعات. المستقبل لا يتبع خطة، ولا يتم رسمه مسبقا. يمكننا أن نقول عنه إنه يفترض، كما قيل في الكتاب المنشور بعد وفاته، أن "الحركة باعتبارها غير قابلة للاختزال، إذن المجازفة بالابتعاد عن الذات، بالمغامرة نحو الآخر، يوجد هناك قبلا ولا يوجد هناك قبلا في نفس الوقت"، ما يمكن أن يخيب أملنا رغم أننا نتوقعه، ما يسير على وتيرته.
عندها سنجد، خلف كل الفروق الدقيقة لفكر دقيق بشكل لا يحاكى، الدرس المستفاد من جهة الحكم. يمكننا أن نسأل أنفسنا اليوم، حتى لو اقتصرنا على وجهة نظر ممارسة التاريخ، عما إذا كان بوسعنا أن نذهب إلى هذا الحد في اتجاه الضرورة - سنقول بسعادة: إذا كان من المعقول أن نذهب إلى هذا الحد في اتجاه الضرورة. لا يمكن فصل تاريخ الرياضيات عن تاريخ العلوم الأخرى، تلك التي نسميها أحيانا بعلوم الواقع، والتي يبدو أن تاريخها لا يخضع لمثل هذا الشكل الحصري من الجهة. نجد هناك، وفقا لتحليل ليون برنشفيك، الحضور الأصلي للإمكان، الذي لا يمكن إزالته بالضرورة. وكما أوضح جورج كانغيلام بجلاء، وقد كان أيضا تلميذ برنشفيك، فإنما في السير الفعلي للعلم بشكل عام، تنطبق قاعدة برجسون حول رجعية الحقيقي: الحكم على قضية بأنها صادقة هو منح رجعية للصلاحية تفضي على وجه التحديد إلى انتشاله من التاريخ. يبدو التحقق، بمجرد إنجازه، وكأنه تأثير شبه ميكانيكي لضرورة غير شخصية تظهر نفسها بشكل لا يقاوم. لكن ترسيخها في الزمن يعيدنا إلى فكرة أن الحقيقة العلمية لم تكن موجودة في البداية إلا كاحتمال.
إن موضوع المعرفة يقدم نفسه أولاً كاحتمال، ثم التحقق من صحته كضرورة هو الذي ينتجه كحقيقي. ولكن في هذا الإنتاج التاريخي للمعرفة الحقيقية، فإن نشأة الممكن لا تقل أهمية عن التحقق من الضروري، وهشاشة أو عرضية اللحظة الأولى، فإن الممكن - المطروح افتراضا وبحرية - لا تنزع عنها قيمة من شأنها أن تضفي على الثاني، الضروري، صلابته المؤقتة، أو استقراره. فهل يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك في تاريخ الرياضيات؟ وينبغي الاعتراف لهذه الأخيرة بحالة استثنائية يصعب تبريرها، ومن الأفضل الاعتراف بأنه في تاريخ الرياضيات، كما هو الحال في تاريخ أي علم آخر، لا يوجد "حكم علمي نهائي". "وراء عبارة نحن نعلم ، يقول جورج كانغيلام، هناك كلمات لم نكن نعرف دائما ". ما نبحث عنه، لا نعرف كيف سنجده، وإلا لكان موجودا بالفعل، أو في الأفق المنظور. ولهذا السبب لا يمكن كتابة التاريخ كغائية، وكأنه يتجه منذ بداياته نحو غايته، نحو موضوعية النتيجة النهائية، بل كمغامرة، وهو كذلك في الأصل. من الضروري أن ندرك أن فكر كافييس، بينما يقبل الواقعة ويدمجها في تحليله، كما رأينا، لم يعتقد أنه من الضروري أن يتنازل أكثر عن حرية الاختيار الأولية، وأن يقحم في حركة التاريخ البسط الأولي لإمكاناته.
لنأخذ على سبيل المثال نظرية المُثُل، وهي نظرية أساسية لإدراك تصورات هيلبرت وديديكند، التي هي بذاتها بشكل مباشر أصل آراء كافييس حول التعميم والتقدم الرياضياتي. نحن نعلم اليوم، من خلال أعمال م. إيشلر، وه. م. إدواردز، وبشكل بارز، أ. ويل، أن مقاربة كرونيكر لمفهوم المثال لم تكن، من وجهة نظر رياضياتية، أقل شأنا من مقاربة ديديكند. وقد أبدى أ. ويل نفسه تفضيله لنظرية كرونيكر، والتي طور منها، في كتابه عن النظرية الجبرية حول الأعداد، نسخة حديثة. نحن نعلم أن نظرية كرونيكر عن القواسم لم تفعل بالضبط ما فعلته نظرية ديديكند عن المثل: تعميم نظرية كومر عن التعميل المثالي، من مجال الأعداد السيكلوتومية إلى مجال الأعداد الجبرية، ولكنها سمحت لنا بتجنب عيبين رئيسيين في نظرية ديديكيند، وهما: عدم وجود طابع جوهري، وغياب البناء الصريح للقواسم. لذلك يبدو من الصعب جدا التأكيد على أن هناك ضرورة، كما قد تقودنا بعض صيغ ديديكند إلى الاعتقاد، لإشراك المُثُل العليا بمعنى المجموعات.
من الواضح أن الحكم التاريخي قد تم حجبه من خلال الاختزال التعسفي للمسألة إلى مقارنة التصورات المذهبية، التي غالبا ما يتم تقديمها بشكل كاريكاتوري، لكرونيكر، مع تصورات ديديكند، أو خصمه القديم، كانتور. "وبينما يقول أ. ويل، كان كل سطر من الملحق الحادي عشر لديديكند في صيغه الثلاثة المتعاقبة "الخالصة" دوما أكثر، مفحوصا ومحللا، مبدها ومعمما، تنوسيت تقريبا Grundzüge…كرونيكر (أساسيات النظرية الحسابية للأعداد الجبرية)، أو لم ينظر إليها سوى كتقديم لمنهج أدنى وأقل صفاء بحيث لا يصل إلى نفس النتائج [...]" وأوضح أ. ويل كيف كان هدف كرونيكر أوسع بكثير من معالجة المشاكل الأساسية لنظرية المُثُل، التي شكلت الموضوع الرئيسي لديديكند. كان الأمر بالنسبة إليه يتعلق بوصف وافتتاح فرع جديد من الرياضيات، والذي كان سيحتضن في نفس الوقت، كفرعين محددين، نظرية الأعداد والهندسة الجبرية: تصور عظيم حقا، وهو لم يفعله، لم يمتلك، بمفرده، الوسائل اللازمة لتنفيذه، ولكن التطورات التي شهدتها هذه الفروع في الفترة الأخيرة سمحت لنا بالحصول على وجهة نظر هي بلا شك أكثر عدلاً من الإدانات الموجزة لتصورات كرونيكر "الحسابية". إن النجاح النهائي والكامل للنظرية الكانتورية عن المجموعات اللانهائية، ونتيجتها الأساسية، وهي الاعتراف بالمجموع اللانهائي الكامل كموضوع شرعي أساسي للرياضيات، والذي تم تأسيسه كعقيدة أدانها كرونيكر، قد استفادا من مشروعه. ما اعتبره كرونيكر أعظم فضيلة لعمله: بناء تعريفاته، وتقديم أدلة على الوجود بمصطلحات جبرية ومحدودة، وبكل صراحة، بمصطلحات خوارزمية، تم التستر عليه لفترة طويلة.
لفترة طويلة، ولكن ليس بشكل نهائي. هيأ التاريخ كرونيكر لينتقم، من خلال ظهور الآلات الحاسبة، ونجاح مدرسة جديدة، وهو ما يمكننا أن نطلق عليه باختصار التفكير الخوارزمي. إن إمكانية اختبار الفرضيات، وحساب البيانات بسرعة وسهولة لم يسبق لهما مثيل في الماضي، لم تغير طريقة التعامل مع المشكلات فحسب، بل أيضا طريقة التفكير فيها. ومنه يمكننا أن نكتشف أن هناك احتمالات أخرى للتطور غير مسار التنظير المجموعاتي المجرد الذي كان جميع علماء الرياضيات تقريبا سينخرطون فيها، على حدو كانتور وديديكند. كان من الممكن، وهذا بالضبط ما يشهد عليه عمل كرونيكر، التفكير في الرياضيات بمصطلحات مختلفة عن مصطلحات كانتور وديديكند، أي، حتى بمتطلبات مختلفة عن تلك الموجودة اليوم، بمصطلحات خوارزمية.
بإعادة قراءة كرونيكر اليوم، يبدو أنه لا يوجد امتياز رياضي محدد مسبقا لتعبير مجموعاتي عن المفاهيم، بما فيها تلك المعترف بها على أنها أساسية. في الواقع، لا ديريشليت ولا جوس، الذي يستحق أسلوبه أيضا أن يُوصف بالمفاهيمي، والذي كان لديه أيضا تصور راسخ للتعميم، لم يكن ليتعهدا بلا شك بصياغة مفاهيم رياضية أساسية بلغة المجموعات، ليس أكثر مما كانا سيقبلان بشرعية استخدام اللانهائي ككيان مكتمل. وهكذا، فإن ما تسميه Transfini et continu "المذهب الحسابي الدقيق" لكرونيكر، والذي يقارنه، دون أي فارق بسيط، مع المحاولات المماثلة التي قام بها ويلستراس (arithmétisation du calcul infinitésim)، وهيلبيرت (finitisme)، وديديكند نفسه (الذي يستشهد بشعاره: "الإنسان يقوم بالحساب دائما")، فهو بلا شك لم يحظ، من كافاييس، بالاهتمام الذي يستحقه. قد نميل إلى القول إن هذا في حد ذاته يشهد على حقيقة أنه لا تزال هناك حرية غير قابلة للاختزال في الحكم التاريخي، حتى عندما يتعلق الأمر بالرياضيات، لأنه لا يوجد إنجاز ضروري في التاريخ الحقيقي الذي كان في المقام الأول بسطا للاحتمالات.
بالنسبة لكافييس، فإن العمل التأملي، الذي تصوره برنشفيك كخاصية للفلسفة، يهم أولاً الرياضيات نفسها. إن ما ينبغي أن يقودنا إليه "العمل العميق لمدرسة بوريل-ليبيغ"، كما يشرح في بداية كتاب "المنهج الأكسيوماتيكي والنزعة الصورية"، هو "تأمل نقدي حول ماهية العمل الرياضياتي، "مراجعة نسقية" و"نكوص يقود إلى الحفر في ما وراء الرياضيات بمعناها الحصري، في الأرضية المشتركة للأنشطة العقلية".
اعتبار الرياضيات عملاً شبه تجريبي يشتغل على مضامين مفردة، ثم كمعالج ل «مادة» نؤكد أن فيها يتمثل موضوع التاريخ، وليس الذات الفردية أو الوعي، وضع "نظرية العقل" في منظورها الصحيح انطلاقا من ثمة، كان يعني حقا أخذ مسافة تجاه المثالية البرنشفيكية، وحتى، بطريقة معينة، من خلال عكس اتجاهها. ومع ذلك، لم يتوقف كافاييس أبدا عن التفكير في أن هذا الفهم لجوهر العمل الرياضياتي لا يمكن تحقيقه دون استخدام، أو حتى تجديد، مفاهيم أو مقولات الفلسفة. وفي هذا، لم يكن مخلصا لدرس برنشفيك، ويظل صحيحًا أن هذا الاستخدام لا يمكن فهمه حقا، في عمله، دون وساطة التأويلات التي أعطاها المعلم لكانط أو ديكارت أو سبينوزا.
حساسا للاحتمال التاريخي، ومستعيرا علنًا من ديديكيند تعبيرا عن ثقته في القدرة على الخلق الرياضياتي الحر، وحرصا على الحفاظ على أقرب مسافة من فعل أو أفعال عالم الرياضيات، أراد كافاييس أن يفكر في الرياضيات وتاريخها، في ظل جهة الضرورة. لقد فعل ذلك بنفس الثبات، ونفس الرغبة في رؤية العواقب، وبنفس التألق، باختصار، مثل ذلك الذي أضاء عمله كمقاوم. ولكن من واقع التجربة أنه بعد حدوث التدخل الفلسفي، مهما كان قويا، في التاريخ، كشف مسار الأخير، تدريجيا، ولكن حتما، عن الفجوات. دون الإفلات من القاعدة، يمكن لعمل كافاييس أن يقدم لنا خدمة أخيرة، وهي مساعدتنا على رؤية حدود تصور التاريخ الذي يمكن أن يتناسب مع إطار فلسفة الضرورة بشكل أفضل. إن حقل التاريخ التأملي، كما مارسه في مبحثي المنطق والرياضيات، بطابعه البرنشفيكي، وفي الوقت الذي تركته فيه الأحداث المأساوية، يمكن الحكم عليه اليوم بأنه ضيق بعض الشيء. قد نرغب في استئناف تأويله للضرورة التاريخية، والعودة إلى استبعاده للأنطولوجيا، عندما تتأسس على النظرية المنطقية، لتوسيع إطار التفكير نفسه، إلى درجة إفساح المجال لأحداث التاريخ التجريبي، لاقتراحات الفيزياء. إن علامة عظمة جان كافييس هي أن هذه الانعطافات، التي ربما تكون مرغوبة اليوم، في ممارسة التاريخ، لا تأخذ معنى حقيقيا بالنسبة إلينا إلا بشرط المطالبة بانعطافنا، وبالتالي قبول درسه.
المصدر:
https://www.cairn.info/revue-de- metaphysique-et-de-morale-2020-1-page-9.htm