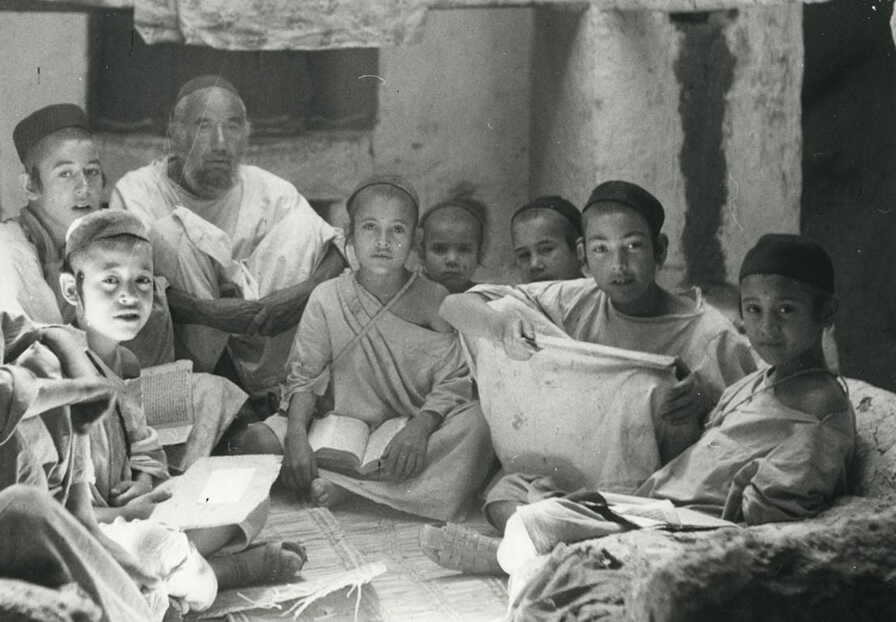أصبحت الكثير من الدراسات في السنوات الأخيرة تحلل موضوع "الهويات الأوروبية"، أو تستخدم مفهوم "الهويات" في دراسة الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر لا يمكن قوله عن المراحل السابقة في دراسات الاتحاد الأوروبي. حتى وإن تناوله بعض الرواد المؤسسين لدراسات الاتحاد الأوروبي في أعمالهم. على سبيل المثال، عرّف عالم السياسة الأمريكي المتخصص بالعلاقات الدولية "إرنست هاس" Ernst Haas التكامل الأوروبي بأنه عملية تنطوي على "تحول الولاءات" من قِبَل "الجهات الفاعلة السياسية في العديد من البيئات الوطنية المتميزة" إلى "مركز سياسي جديد.
في حين أدرج آخرين "الشعور بالمجتمع" في مفهوم للتكامل. إن الاهتمام الأكاديمي المتزايد بدراسة الهويات في أوروبا يستجيب لما تسميه بعض الباحثين "الدوافع الخارجية" و"الداخلية". إن الاهتمام الأكاديمي بالموضوع هو استجابة للتغيرات "على الأرض"، أو المحركات الخارجية. لقد كان سياق ما بعد الحرب الباردة، وما بعد ماستريخت، وحتى ما بعد "الحرب على الإرهاب" سياقاً حيث أصبح التكامل الأوروبي وأنواع معينة من الجدل حول الهوية أكثر إثارة للجدال. وقد أثار هذا تساؤلات حول العلاقة بين الهوية، من ناحية، وشرعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وآفاق الديمقراطية ذات المغزى خارج الدولة ومستقبل الاتحاد الأوروبي ذاته من ناحية أخرى. وعلاوة على ذلك، أدى التوسع الكبير والمستمر للاتحاد الأوروبي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، واحتمال عضوية تركيا، والصراع المتزايد حول التعايش بين التقاليد المسيحية والإسلامية والعلمانية في المجتمعات الأوروبية، إلى زيادة التنوع الثقافي في الاتحاد الأوروبي وأهمية المناقشات حول الهوية. ومع ذلك، فإن الاهتمام الأكاديمي بالهويات الأوروبية يعكس أيضاً تطور المناقشات النظرية حول الاتحاد الأوروبي، أو المحركات الداخلية. ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن الاهتمام المتزايد بقضايا الهوية مع بداية ما تم وصفه بالمرحلة الثانية "تحليل الحكم" والمرحلة الثالثة "بناء الاتحاد الأوروبي" من بناء النظرية، والتي تركز المزيد من الاهتمام على قضايا السياسة والسياق الاجتماعي للتكامل الأوروبي.