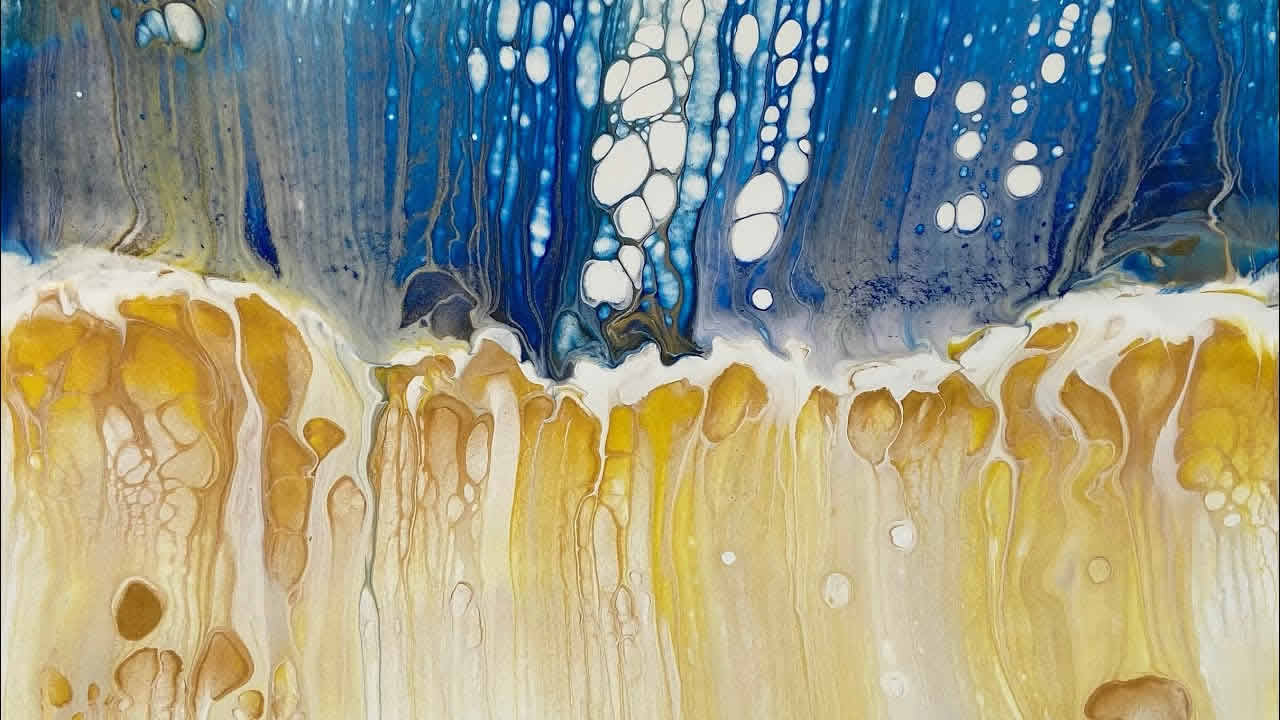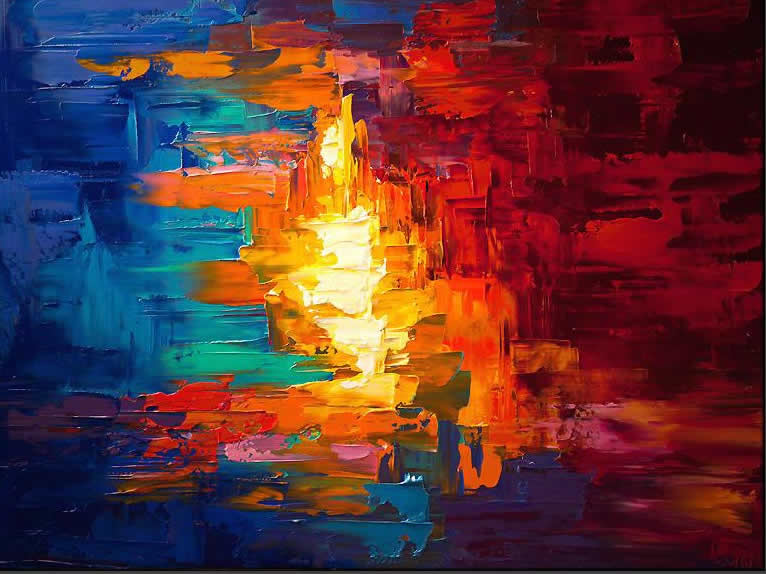" .. لكني ما لبثت أن اضعت صوت الولية فيحاء في زحمة الصيحات من حولي واشتداد وقع الخطى والأحذية المصفحة .. " (ص:361)
هل أضاع " زين شامة " صوت الولية فقط ؟
1 ـ نهاية لبدايات متعددة ..
تلك نهاية الرواية " زين شامة .. المعطل بينكم " للروائي بنسالم حميش، نهاية جمعت الرواية وفتحت لها ـ من جديد ـ بدايات تطل على الآتي.. الآتي الذي يتتبع الخطى.. خطى الذين صنعوا وانصهروا مع أحداث الرواية، وبنوا فضاءاتها وأحداثها، مداخلها ومخارجها وأسرارها، آلامها وآمالها.. أو الآتي البكر الذي لا يزال في رحم التكوين التخييلي في ذهن القارئ الذي أنهى الرواية، ليعيد إنتاجها ببناء خاص، يكون امتدادا لنهاية فتحت للآتي هوامش الإبداع والمغامرة والانطلاق..وبما أن القراءة وجه آخر للكتابة، وخوض لغمار لعبة السرد، كتابة أو تخييلا أو تماهيا..فإن القارئ الذي تعول عليه الرواية / القراءة لم «يعد مجرّد مستهلك للنص بل أصبح مشاركاً فيه بصوره أو بأخرى»(1)
خبايا عبور - حسن إدحم
"عبور" عنوان للمجموعة القصصية الأولى لآمال الحرفي، مجموعة صادرة عن الراصد الوطني للنشر والقراءة سنة 2021، وتضم عشرة نصوص، تسافر بالقارئ إلى مختلف دروب الحياة، عبر أمكنة متنوعة، تعيد الذاكرة بناءها باتساق وانسجام مع الزمن الذي تجري فيه الأحداث. إن الأماكن ليس لها وجود محايد ومستقل، بل تبنى وتستكشف باللغة، بالرمز والاستعارة...، غير أنه قبل التوقف عند هذه النصوص، يجدر بنا أن نواجه عنوانا لا يمكن تجاوزه بيسر، عنوان يسائل مخيلة القارئ، عنوان يخفي، يحجب ويضمر أكثر مما يصرح، ويبوح. " عبور"، عنوان يضعنا منذ البداية في قلب الحيرة و التساؤل:
بأي معنى "عبور"؟ هل هذا ال"عبور" تم وانتهى أم هو سيرورة مستمرة لا تنتهي؟ كيف يتم، من أين وإلى أين؟ هل هو " عبور" فيزيائي أم نفسي أم هما معا؟
لاشك أن القصة، تعد من الأجناس الأدبية الأكثر اقترابا من الواقع ولتفاصيله المنسية، تنصت لشخوص، وأمكنة الهامش والمركز، لا، إن القصة لا تصنت فقط، إنها لا تكتفي بالحقائق الظاهرة فحسب، إنها توغل في التنقيب والتساؤل، بل والاستنطاق أحيانا. إن الحقيقة ليست متروكة على السطح، تنتظر من يضفر بها، إن قولا كهذا سيكون ساذجا. تعيد القصة تركيب اللحظات الهاربة، اللحظات التي تنفلت جراء رتابة اليومي وتكراره، التكرار الذي يجعلنا نعتقد أن كل لحظات المعيش تلك، لحظات بديهية لا تستحق التوقف والتأمل، ولكن القصة، القصة الحقيقية، تدهشنا عندما تعيد تركيب كل هذه التفاصيل بصورة نراها، وكأننا نشاهدها للمرة الأولى، إن القصة، والأدب الحقيقي عامة، يدفعنا للتعرف على أنفسنا عن طريق المزج بين الواقعي والخيالي، مزج يعيد تركيب الحقيقة الهاربة.
الذاكرة
صلاح بوسريف وإشراقة الإقامة في الوجود بالشعر - مليكة فهيم
إذا كانت اللغة أساس إقامة الانسان، حسب صاحب " الكينونة والزمان"، وإذا كان هولدرلين يعتقد بأن الشعر أسمى تجليات الفعل الجمالي، فإن شاعرنا، ينحت حضوره الشعري على نفس الإيقاع، إذ يعتقد بأن الشعر أصل كل فن وإبداع، وبأنه تجربة مفتوحة على المجهول واللانهائي؛ ألم يقل هولدرلين: " أيها الشعراء، كونوا أحرارا كالسنونو"؟
يعتبر الشاعر "صلاح بوسريف" صوتا شعريا، قدم إلينا من عقد الثمانينات من القرن الماضي، السلسلة الثالثة من المشهد الشعري المغربي المعاصر، مخترقا أفقا مختلفا عن شعر الستينات والسبعينات المثخن بالشعارات السياسية. كان اسمه ولا يزال انعطافة مختلفة في مسار الشعر المغربي والعربي المعاصر، كما قال عنه الناقد " نجيب العوفي". بكثير من وله الشعر يرتل قلقه الوجودي، يصطاد المعنى على أشجار عدة مرجعيات: فكرية، وفلسفية، وصوفية؛ ليخلق كينونته الشعرية المتفردة، التي لا تنأى عن سؤال الحداثة الشعرية ومزالقها وغواياتها. يقول مع لوركا: " أكثر الأفراح حزنا، أن تكون شاعرا. كل الأحزان الأخرى لا قيمة لها حتى الموت ". لا يكتمل الهلاك إلا به وعبره. في شكه وتساؤلاته، شيء من حق الشاعر في النص المختلف، لخلق الشغف والدهشة نافذتا الشعر الحالمتين.
شاعر مَشَّاء؛ خَبِرَ رعشات الكتابة الشعرية، ذلك النص المكتنز، الكثيف والشفاف، فكان ديوانه الأول: فاكهة الليل سنة 1994. لم يدركه موسم الهجرة إلى أي جنس أدبي آخر، لم يعتبر الشاعر صلاح بوسريف الشعر تمرينا: شعر فقصة ثم رواية؛ فكان مكوثه المشتهى في محراب الشعر عنوانه الذي يراهن عليه، والذي حاكه بإبدالات أنعشت تجربته الشعرية المتجددة باستمرار.
السينما الشعبية في مواجهة السينما التجارية - هاني بشر
لا تهدَأ الحركة حول مبنى تاريخي قديم وسط العاصمة الأسكتلندية أدنبره منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل. رجال ونساء وأطفال من مختلف الأعمار يتوافدون على "بيت الفيلم" لمشاهدة عروض سينمائية، أو المشاركة في إحدى ورشات العمل والندوات، أو استخدام مقهى المبنى لتناول إحدى الوجبات وعقد اللقاءات بين الأصدقاء. ثلاث قاعات صغيرة للعروض السينمائية، ومقهى صنع حالة ثقافية على مدار العام في المدينة، ويستضيف أقدم مهرجان سينمائي مستمر حتى الآن منذ عام 1947، وهو مهرجان أدنبره السينمائي الدولي. إذ يمثل "بيت الفيلم" -كمؤسسة خيرية- حالة للدور الذي تقوم به السينما الشعبية في مواجهة السينما التجارية.
تعرض المؤسسة أيضا أفلاما قديمة وحديثة، وتستضيف مهرجانات سينمائية محلية على مدار العام، مثل مهرجان السينما الإيرانية ومهرجان السينما الإسبانية، كما تقوم بدور في توزيع الأفلام على دور العرض الأخرى في بريطانيا. وعلى بعد أمتار في شارع لوثيان ذاته بأدنبره، تقع دار سينما حديثة تعرض الأفلام التجارية الموسمية، ليجد الجمهور نفسه أمام مشارب متنوعة للثقافة البصرية عبر عدة أماكن تلبى احتياجات كافة الأذواق. وكان مشهد دخول وخروج الممثل الهوليودي الراحل شون كونري ابن مدينة أدنبره إلى مقر "بيت الفيلم" خلال مهرجان أدنبره السينمائي الدولي، أحد الأحداث المميزة المتكررة التي تبين الصلة والجسور بين السينما التجارية التقليدية والسينما الشعبية.
رواية "زهرة اللارنج" للكاتبة حسناء شهابي: عن الحسناء القاهرة بالحاءات الثلاث - عبدالحق ميفراني
صدر حديثا عن منشورات دار التوحيدي، وفي أول إطلالة على المشهد الثقافي، رواية "زهرة اللأرنج" للكاتبة والفاعلة في مجال البيئة المغربية حسناء شهابي. الإصدار، رواية بصيغة المؤنث، والكاتبة امرأة والعنوان "زهرة". يبدو التأمت نون النسوة في تشكيل نص قامت بإخراجه الكاتبة حسناء شهابي، عن محكيات وأسرار لا تقف عند حدود.. فقط محفل الجسد، يجعل الجميع يدور في حلقة دائرية تبدو أشبه ب"شظايا" قصص.
التقيت بالرواية، وساردتها، صداقة النص، سابقة عن صداقة الكاتبة، وفي هذا سر للحاء الرابعة... ألم تطلب الساردة منا جميعا، قراء على اختلاف مرجعياتنا الجنسية، أن لا نسألها ما المقصود بالحاءات الثلاث (ص180)، هناك وعد من الساردة أن يكون الرد عند نهاية الرواية، ومادمت القارئ هنا، فإني أحتفظ بما فهمته جوابا وإيضاحا لنفسي، لكني سأخبركم، عكسها بالحاء الرابعة.
قراءة في رواية "نقطة الانحدار" للكاتبة فاتحة مرشيد: جُرحٌ إنساني بين الانحدار والصعود - عبد المطلب عبد الهادي
" الكتابةُ انْفتاحُ جُرْحٍ ما " (فرانز كافكا)
مفتتح ..
"كيف يُعقل أن يكون البلد الذي ينتج أكبر عدد من العلماء والباحثين والحاصلين على جوائز نوبل والمستقطب لأذكياء العالم، هو نفسه الذي ينتج أكبر عدد من المشردين" (نقطة الانحدار ـ ص 51)
جُرحٌ غائرٌ فينا انفتح، نداريه، نستر عيوبه وأخطاره بمساحيق مختلفة الألوان والأشكال والأسماء، جُرحٌ انفتح على مرأى ومسمع من عالمٍ يغضّ الطرف عنه، يتناساه، يحجِبُه بغربال اللامبالاة وعدم الانتباه والاكثرات، جُرحٌ يتقاسمه العالم، مُتقدِّماً كان، أو في مرتبةٍ ثالثة أو أقل، إلا أن الرواية "نقطة الانحدار"(1)، فتحت الجُرح وتلمَّست أسبابه ودوافعه في بلاد الأحلام الوردية والمال والقوة، وأعملتْ فيه مؤلّفتها، الشاعرة والكاتبة فاتحة مرشيد، مِبضع جرّاحٍ عليم بدواخل النفس البشرية وأسرارها وتقلباتها بين الضعف والقوة والكرامة والهوان وهي تعري حقيقتها، " أمريكا لا تقبل المهزومين.. وحدهم الفائزون لهم مكان في هذه القارة. والقروض لا ترحم إنها تلقيك بضربة على مؤخّرتك خارج بيتك أو ما كان بيتك.." (ص 33).
"نقطة الانحدار"، عنوانٌ لرواية أنيقة توصّلتُ بها شاكرا هذه الالتفاتة الطيبة من الأديبة والشاعرة والطبيبة الأستاذة فاتحة مرشيد بتوقيع لطيف..
داروسيا الحلوة : رواية أوكرانية تخترق الكهوف السرية للنفس البشرية - جودت هوشيار
ماريا ماتيوس كاتبة أوكرانية معاصرة حائزة أرفع الجوائز الأدبية في بلادها، وعلى العديد من الجوائز الدولية. وهي معروفة على نطاق واسع بأسلوبها الأصيل المتفرد، وتقيم حاليا في العاصمة كييف.
ولدت ماريا ماتيوس في 19 ديسمبر/كانون الأول 1959 في إحدى قرى منطقة بوكوفينا، التي تعرضت للغزو والاحتلال من قبل غزاة كثر، تعاقبوا على اضطهاد وإذلال سكانها على مدى عدة قرون، وتقع عبر المنحدرات الفاتنة لجبال كاربات الشرقية – وهي منطقة جميلة متجذرة بعمق في التقاليد والدين والفولكلور، وتشكل حاليا جزءاً من أوكرانيا المستقلة.
تعد رواية « داروسيا الحلوة « التي صدرت في مدينة لفوف عام 2004 واحدة من أفضل الروايات في الأدب الأوكراني الحديث، منذ استقلال أوكرانيا في عام 1991 إثر تفكك الامبراطورية السوفييتية، وتدور أحداثها في قريتين في منطقة بوكوفينا بالقرب من الحدود مع رومانيا، في الفترة الممتدة من الثلاثينيات إلى السبعينيات من القرن العشرين. وتتناول الرواية أحداثاً مروعة، لكنها مكتوبة بلغة شعرية جميلة، ومفعمة بعواطف إنسانية جياشة وقوية، خاصة في الأوقات العصيبة. نص بديع وعميق على عدة مستويات: الفرد، والأسرة والمجتمع والوطن. هذه ملحمة عائلية حقيقية بحبكة مبتكرة وتعرض العديد من القصص، التي تتقاطع وتحكي من خلال الشخصيات والأحداث.
صورة ومتخيل - ذ.رشيد سكري
بات من الواضح جدا أن الفلسفة عين العقل على الكون والوجود . وفي هذا ذهب أفلاطون إلى إبعاد الشعراء ، ونفيهم في النسيان والتيه ، فتجاوز بذلك أزمة حادة كادت أن تعصف بمدينته الفاضلة . أ يمكن اعتبار هذا الكائن ، ذي الوجود المتعدد ، يتراوح بين الوجود ونفي الوجود ؟ هل المتخيل يناقض العقل أم يكمل دورته الوجودية ؟ بعبارة أخرى هل الوجود الاعتباري للإنسان قادر على أن يتجاوز الحلم والصورة والأسطورة وكل الرموز والإشارات ؟ هل بالعقل وحده يعيش الإنسان ؟
إن إبعاد المتخيل الرمزي ، الذي شوش على الفكر والعقل معا ، كما يقول ديكارت ، خلق من إبداع الصور والرموز والإشارات عالما من الغموض والإبهام ؛ ليظل الهوس قائما على مستوى استكمال الإنسان إنسانيته و آدميته . في هذا المنحى ، الشائك ، تنطلق المخيلة المجنحة إلى عوالم الحس والصور والتخييل ، حيث انفلتت ـ أي المخيلة ـ من عقال العقل ؛ لتجد نفسها تتمرغ في التصوير البلاغي . بالموازاة مع ذلك ، ومنذ الخليقة الأولى ، تحتل الصورة المتخيل الإنساني ، فهي تسير في تواز مع العقل والفكر ، فعندما أراد إبليس أن يغوي آدم ، ويطرده الله من الجنة ، صوره على شكل ملك ، وبه اتسعت دائرة الرؤية والتخييل والحلم .