 إذا تحدثنا عن الدولة المغربية، فإن هناك فئة اجتماعية لربما لا تعتبر نفسها مغربية بقدر ما هي فرنسية أو كتوضيح أدق، فرنسيون بنكهة مغربية. طبعا سنفهم أكثر إذا عدنا لهيغل واستدعينا معه فوكوياما حينما يقوم هذا الأخير بناءً على مشروع الأول بتعريف التاريخ الإنساني انطلاقا من سعي الناس لفرض الاحترام الذاتي، من ضمن ذلك يرى فوكوياما أن من شروط هذا الاحترام عند البعض هو "اللامساواة"، حتى يظلوا أفضل من غيرهم. هنا تحقق اللغة الفرنسية للفئة ـ التي نطوقها بالحديث هنا ـ ذلك عن طريق جعلهم شبيهين بالفرنسيين، طالما أن هناك بأعماق العقل المغربي، صدمة كامنة عن تفوق الفرنسي ـ والثقافة الفرنسية إجمالا ـ منذ ما قبل الاستقلال، ومحاولة التأقلم الصدموي (المرضي) مع ذلك بمرحلة ما بعد الاستعمار.
إذا تحدثنا عن الدولة المغربية، فإن هناك فئة اجتماعية لربما لا تعتبر نفسها مغربية بقدر ما هي فرنسية أو كتوضيح أدق، فرنسيون بنكهة مغربية. طبعا سنفهم أكثر إذا عدنا لهيغل واستدعينا معه فوكوياما حينما يقوم هذا الأخير بناءً على مشروع الأول بتعريف التاريخ الإنساني انطلاقا من سعي الناس لفرض الاحترام الذاتي، من ضمن ذلك يرى فوكوياما أن من شروط هذا الاحترام عند البعض هو "اللامساواة"، حتى يظلوا أفضل من غيرهم. هنا تحقق اللغة الفرنسية للفئة ـ التي نطوقها بالحديث هنا ـ ذلك عن طريق جعلهم شبيهين بالفرنسيين، طالما أن هناك بأعماق العقل المغربي، صدمة كامنة عن تفوق الفرنسي ـ والثقافة الفرنسية إجمالا ـ منذ ما قبل الاستقلال، ومحاولة التأقلم الصدموي (المرضي) مع ذلك بمرحلة ما بعد الاستعمار.
لا أود الخوض في الحديث الممل، عن الأفق الذي يفتحه إتقان اللغة الفرنسية بالمغرب ـ خاصة بالنسبة لفئة الشباب ـ والعنصرية المموَّهة تجاه من لا يجيدون التحدث بالفرنسية ببعض المؤسسات والمراكز بالدولة، إضافة للاحترام الروحاني لكل ما يمت لثقافة جون جاك الروسو السوداوي بصلة !
حضور التحليل النفسي في المتن البارثي ـ نموذج "لذة النص" ـ أزروال ابراهيم
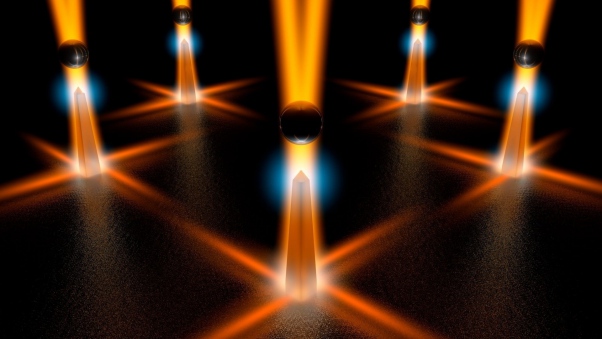 يميز إمبرطو ايكو في "تمكن بارث"، بين صنفين من المعلمين، دون تقصد صياغة مراتبية Hiérarchie اختزالية. فثمة صنف يبتدع النماذج النظرية أو التجريبية لتشغيلها بالاسترشاد بقواعد الملاءمة Pertinence، وإخضاع الجهاز النظري لاختبار قابلية التطبيق Applicabilité ولقابلية الكمال Perfectibilité. ويقدم كغرار لهذا الصنف: شومسكي وغريماص. أما بالنسبة للصنف الآخر، فإنه "يعمل ليعطي حياته ونشاطه كنموذج"(1)، بدون أي هوس بتقنين النظرية وتنميط المقاربة؛ مما يضع المتأمل في مسار هذا الصنف، في موقف هرطوقي Hérétique بالضرورة(2).
يميز إمبرطو ايكو في "تمكن بارث"، بين صنفين من المعلمين، دون تقصد صياغة مراتبية Hiérarchie اختزالية. فثمة صنف يبتدع النماذج النظرية أو التجريبية لتشغيلها بالاسترشاد بقواعد الملاءمة Pertinence، وإخضاع الجهاز النظري لاختبار قابلية التطبيق Applicabilité ولقابلية الكمال Perfectibilité. ويقدم كغرار لهذا الصنف: شومسكي وغريماص. أما بالنسبة للصنف الآخر، فإنه "يعمل ليعطي حياته ونشاطه كنموذج"(1)، بدون أي هوس بتقنين النظرية وتنميط المقاربة؛ مما يضع المتأمل في مسار هذا الصنف، في موقف هرطوقي Hérétique بالضرورة(2).
وينتمي بارث بالتأكيد إلى هذا الصنف، لأنه حسب إيكو، شدد على نجاعة الممارسة الكتابية كمدخل خصب لولوج المعرفة، بعيدا عن كل رسم تخطيطي مجرد Diagramme abstrait، وعن إقصاء النبوغ الشخصي ونبذ المنحى الاقتدائي. وبمعنى آخر، إنه يحتفل بالذاتية ولا يغيبها لصالح غيرية تسمى موضوعية! الشيء الذي تولد عنه مروره على نحو كلبي cynique أمام واجهات المذهبيات والمرجعيات النظرية والترسانات المعرفية. والواقع أن زئبقية بارث ولغزيته ومعاندته للتصنيف على حد تعبير اديث كيروزيل ترجع إلى ذلك المسلك الوجودي والأنطلوجي بالذات. وليس من المستبعد أن يفسر هذا المسلك تأويل تودوروف للمتن البارثي كمتن يتاخم الرومانسية ويتماس معها نقدا ونظرية.
علم نفس التحليل العصبي : عودة فرويد ـ كات ماكغوان ـ ت : حمودة إسماعيلي
 العودة الثانية لسيغموند فرويد : كما لو أن المحلل القديم على وشك أن يلقى بمزبلة التاريخ، ليقوم علماء الأعصاب بإعادة إحياء أبرز معطياته..
العودة الثانية لسيغموند فرويد : كما لو أن المحلل القديم على وشك أن يلقى بمزبلة التاريخ، ليقوم علماء الأعصاب بإعادة إحياء أبرز معطياته..
الحفلة بالطابق السفلي الخاص في مطعم فاخر بالهارلم، الذي يضم حدثا علميا، باهرا، حيث النساء متأنقات بفساتين السهرة، والرجال يضعون ربطات عنق باهظة. بالقرب من طاولة البار يقف بلحية ذقنه المشذبة، جو لودو، المعروف بأبحاثه الرائدة عن الخوف، كذلك الأمر بالنسبة لباقي فرقة الروك أند الرول من أصدقائه العلماء. رئيس الطهاة المشهور والذي بدوره يمتلك المطعم يلقي التحية على المدعويين بنفسه.
هذا التجمع الغير معتاد كانت له أسبابه الخاصة، حيث تم تنظيمه من طرف مؤسسة التحليل النفسي العصبي، بهدف ترويج فكرة أن مفاهيم التحليل النفسي كـالدوافع المكبوتة وبواعث اللاوعي، لا تزال ذات إفادة و صلة بعصرنا بالنسبة لدراسات الطب العصبي عن الدماغ. وإذا كان الأمر يبدو مفاجئا، إذن سنقول بأن : سيغموند فرويد، مؤسس طريقة التحليل النفسي، كان في الواقع قد انطلق ببداية مسيرته كطبيب أعصاب، حيث كان يقوم بتشريح الجهاز العصبي لجراد البحر. غير أن آواخر القرن التاسع عشر، لم تكن تعرف الأمر الكثير حول الدماغ، حتى أن أي فهم لسلوك الخلايا العصبية لايزال لغزا. فرويد سيتخلى عن مادته العلمية، لأجل تطوير منهج موضوعي يمكّنه من فهم العقل، حيث يقوم زبناؤه الأشقياء بالبوح عما يجول بدواخلهم.
التحليل النفسي، تأسس كأسلوب بحث، كتقنية تقوم بالتخفيف عن الناس المكروبين. الأمر الذي سيجعلها نظرية بمطلع القرن العشرين بل واحدة من أكثر النظريات تأثيرا عن العقل البشري.
علم نفس الأنا : كيف تصبح أنت هو أنت ؟ ـ حمودة إسماعيلي
 كما تتلقفك الموّلدة لدى ولادتك، كذلك تتلقفك من جهة أخرى منظومة معرفية، تشمل اسمك، ديانتك، محيطك الثقافي الذي سيشكل ميولك واتجاهاتك الفكرية والنفسية. داخل كل أسرة هناك تحيّز معرفي، ذو أساس سيكولوجي : تعتقد كل أسرة، والأمر يرتبط بصيرورات أنثروبولوجية حول بقاء الجماعة الجينية، أنها أسرة تتميز عن باقي كل أسر العالم، من هنا يستقي أفراد الأسرة، خاصة منهم الأبناء، بنية نرجسية تشكل هويتهم الأسرية. بالتالي، ولا عيب في ذلك، ترى الأسرة في تمظهرها تميزا وجوديا. هنا، أين يقع الإشكال ؟
كما تتلقفك الموّلدة لدى ولادتك، كذلك تتلقفك من جهة أخرى منظومة معرفية، تشمل اسمك، ديانتك، محيطك الثقافي الذي سيشكل ميولك واتجاهاتك الفكرية والنفسية. داخل كل أسرة هناك تحيّز معرفي، ذو أساس سيكولوجي : تعتقد كل أسرة، والأمر يرتبط بصيرورات أنثروبولوجية حول بقاء الجماعة الجينية، أنها أسرة تتميز عن باقي كل أسر العالم، من هنا يستقي أفراد الأسرة، خاصة منهم الأبناء، بنية نرجسية تشكل هويتهم الأسرية. بالتالي، ولا عيب في ذلك، ترى الأسرة في تمظهرها تميزا وجوديا. هنا، أين يقع الإشكال ؟
يقع الإشكال، في التغذية المستمرة لهذه المنظومة الضيقة المتحيزة، حيث تركب عقول الأبناء، فكرة الاستعلاء الوجودي، وتمثيل الخير، ما يعني استحقاقات مبررة (مكافآت إلهية وما سواه)، والذنب المُسقط على الآخر (الأسوء دائما مني، مهما بدى العكس ـ أو أن الصورة ستنقلب إذا تأكد ذلك/أن الآخر أفضل) . وكشمولية فكرية لهذه البنية المتفرقة ـ بين الأسر ـ والمنتشرة دوليا، تنتشر اعتقادات مزيفة عند كل فرد ضمن المنظومة :
دفاعا عن التحليل النفسي ـ يوسف عدنان
 " انتظرونا أن ندرس اللاشعور قبل أن يقفل :
" انتظرونا أن ندرس اللاشعور قبل أن يقفل :
سيغموند فرويد
لم يخب تنبؤ سيغموند فرويد الأب المؤسس 'pére fondateur' للتحليل النفسي حول مصير هذا العلم اليهودي الجذور وذي المنشأ البرجوازي كما آخذ عنه كل من المحلل النفسي الماركسي وليام رايش وفرتز بيرل مبدع العلاج الجشطلتي. صحيح أن التحليل النفسي ولد في فيينا وتطور في ألمانيا و بريطانيا العظمى ليلقى أوج ازدهاره في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات 1950، عندما تحررت طرديا الطبقات الوسطى من قهر النفاق الجنسي 'l’hypocrisie sexuelle'. ولكن يجب أن نقف هنا على التذكير أن التحليل النفسي الأمريكي، قد أصبح أكثر فأكثر ميالا إلى هيكلة أسسه القاعدية في قالب منمذج يدعى علم نفس الذات (أو الأنا) psychology’ ‘l’Ego- و ينحو فيه العلاج إلى الانتظام وفق رؤيا تكيفية ذات صبغة ايديولوجية كرستها أبحاث كل من هينز هارتمان وغيرهم. وهذا الإنعطاف المفجع ما اعتبره جاك لاكان خليفة فرويد خيانة للتراث الفرويدي وكبوة لا تغتفر في حقه، الشيء الذي أدى إلى تفشي دوائر سوء الفهم، مقابل امتعاض السلف عن إعطاء تبريرات تصويغية لمدى صلاحية (أصالة) منظوراتهم الملغزة كما لو أنهم محل استنطاق في قاعة المحكمة، داعين الجروح تتعفن بدل بيع العلاج المزيف واللامتمايز، ومكتفين ذات الحين بموقف عرابهم الذي يدافع عن نفسه قائلا: أن التحليل النفسي لا يجيد استخدام سلاح الجدل، بقدر ما أداته اللاشعور غير مستعدة على تحييد النقاش.
الذكاء الانفعالي: لماذا قد يكون أكثر أهمية من الذكاء؟ ـ المختار شعالي
 سادت في المجتمع ظواهر مقلقة من قبيل العنف المتفشي في المجتمع وداخل الأسرة وفي المدرسة، وساد الإحساس بالانزعاج وباللا أمن وانحراف في الأخلاق. كل ذلك هي أعراض انحراف واضطراب عاطفي عام ترتب عن فقدام مراقبة انفعالاتنا. يفرض هذا الوضع أن ينكب البحث خاصة في المجال السيكولوجي على تسليط الضوء على مكانة المشاعر والانفعالات في حياتنا وعلاقتها بالحياة المعرفية التي ظلت لسنوات طويلة خارج اهتمام السيكولوجية، مما جعل من الانفعالات، في جزء كبير منها على الأقل، غير خاضعة للدراسة العلمية وبالتالي غير مكتشفة.
سادت في المجتمع ظواهر مقلقة من قبيل العنف المتفشي في المجتمع وداخل الأسرة وفي المدرسة، وساد الإحساس بالانزعاج وباللا أمن وانحراف في الأخلاق. كل ذلك هي أعراض انحراف واضطراب عاطفي عام ترتب عن فقدام مراقبة انفعالاتنا. يفرض هذا الوضع أن ينكب البحث خاصة في المجال السيكولوجي على تسليط الضوء على مكانة المشاعر والانفعالات في حياتنا وعلاقتها بالحياة المعرفية التي ظلت لسنوات طويلة خارج اهتمام السيكولوجية، مما جعل من الانفعالات، في جزء كبير منها على الأقل، غير خاضعة للدراسة العلمية وبالتالي غير مكتشفة.
في الخمسينات من القرن العشرين هيمن التيار السلوكي على السيكولوجية، حيث اعتبر السلوكيون أن مجال البحث العلمي ينحصر في السلوك القابل للملاحظة. وبذلك أبعدوا الحياة الداخلية والانفعالات ( المشاعر والأحاسيس والدوافع النفسية..) من مجال الاهتمام والبحث العلمي. كما اهتم رواد السيكولوجية المعرفية، في الستينات من القرن الماضي، بما يقع داخل العقل ردا على التيار السلوكي الذي أهمل هذا الجانب. غير أنهم بدورهم اهتموا أكثر بالميكانيزم الذي يعالج به العقل المعلومة ويضعها في الذاكرة، وميكانيزم الإدراك والفهم والتذكر. غير أن نماذج معالجة المعلومة التي أخذ بها رواد هذا التيار لا تأخذ في الاعتبار أيضا المشاعر والانفعالات التي قد تؤثر بل تهيمن أحيانا على العقل مثل ما يقع لكثير من العقلاء حيث يمكن أن يصدر عنهم سلوك مشين ولا عقلاني في حالة الانفعال.
تأرجح الكائن بين اللاّوعي والوعي عند سغموند فرويد ـ د.زهير الخويلدي
 "يمكننا الاعتماد على فرضية اللاوعي وأن نؤسس ممارسة متوجة بالنجاح والتي من خلالها سنؤثر على مجرى سيرورات الوعي"1[1]
"يمكننا الاعتماد على فرضية اللاوعي وأن نؤسس ممارسة متوجة بالنجاح والتي من خلالها سنؤثر على مجرى سيرورات الوعي"1[1]
تجمع المناهج المعتمدة في مدارس علم النفس عند دراسة الوضع النفسي للكائن البشري بين الوصف والتفسير والتنبؤ والضبط وذلك في سياق عملية واحدة تكون مهمتها تقديم تقرير عن الظواهر النفسية القابلة للملاحظة وتتبع تجليات الظواهر الخفية وبيان علاقاتها البعضية والاهتمام بالحوادث الماضية والمنبهات الخارجية والدوافع الذاتية وتأثيرها في أنماط السلوك البشري وطرق التفكير والتعلم والتذكر.
بماذا تتصف الحالة النفسية للكائن البشري؟ هل هي حالة سوية أم حالة مرضية؟ وماذا يمكن أن يفعل؟ ومتى يأتي الإنسان إلى الوجود؟ وهل عن طريق فعل الولادة البيولوجية أم حينما تتوفر جملة من الشروط والنفسية والثقافية وسيرورته شخصا عن طريق الإدراك الذاتي للعالم ؟ وأين نحن الآن؟ وهل نحن في مفترق طرق ؟ والى أين نتجه؟ وماذا يعني أن يصبح المرء إنسانا؟ وكيف يصبح الإنسان ماهو عليه؟ هل هناك أخطر من أن يتواجه الإنسان مع نفسه وأن تتجمع غريزته لكي تقاوم كل شيء يغزوها من هذا العالم الخارجي ؟ أليس التكثر هو الشيء الوحيد الذي يجعل المرء يعاني من التنوع اللاّمتناهي لنفسه ويتحمل الضرورة بأي ثمن وينضج قدرات يمارس بها نفسه؟ هل الكائن البشري يخضع لحتمية بسيكولوجية أم يمكن أن يستعيد حريته؟ كيف يتعامل المحلل النفسي مع تأرجح الكائن البشري بين اللاّوعي والوعي؟
علم نفس الإلحاد : نحو مقاربة تاريخية للإلحاد من زواية سيكولوجية ـ حمودة إسماعيلي
 في الطبيعة ليس هناك من عقاب و لا ثواب، بل هناك نتائج
في الطبيعة ليس هناك من عقاب و لا ثواب، بل هناك نتائج
روبرت جي إنغرسول
إن مقولة "لا كرامة لنبي بين قومه" لم تأت من فراغ، فكل نبي يعتبر خارجا عن أعراف قومه، متمردا على عاداته الاجتماعية والدينية، ولا كرامة لخارج عن الأعراف، لا قيمة لم يقلب نظام القوم الروحي أو السياسي ـ وهما بتاريخهما متداخلين، قبل فصل الكنيسة عن الدولة. كل نبي يعتبر ملحدا بنظر قومه، طالما أنه يلحد/ينفي أسس الديانة بادعاءه لمبادئ أخرى، توحي بتنزيل ديانة أخرى من إله ـ هو غير مقبول بالغالب من السلطة القائمة. وهذا طبعا ينطبق على كل تفكير يخرج عن مألوف الحاضر الاجتماعي الروحي/السياسي، ذلك ما دفع إرنست همنغواي ليقول بأن كل المفكرين ملحدين، بمعنى أن التفكير هو عملية إلحاد بالموضوع الذي لم يعد بعد قابلا للتصديق من جهة المفكر ـ ونظرا لخطورة الموقف في بعض الحالات، بما يترتب عنه من تحريض ضد السلطة أو قلب النظام، تتم معاقبة المعني دركا للفوضى (كتبرير)، أو وسمه بالجنون كتبعيد مقصود له عن الناس، وعدم أخده بجدية. وهذا ينطبق كذلك على الشعراء العرب، كما في تأكيد أدونيس : "في تاريخ المسلمين لم يوجد شاعر واحد عظيم ومؤمن. أبداً"(عن El País). طالما أن الشعر تفكير خارج المألوف والسلطة، والدين/السلطة يحمي "المألوف" ضد كل تجاوز/تحرر فكري ينبثق من التساؤل، خاصة حول جوهرية الدين/السلطة.












