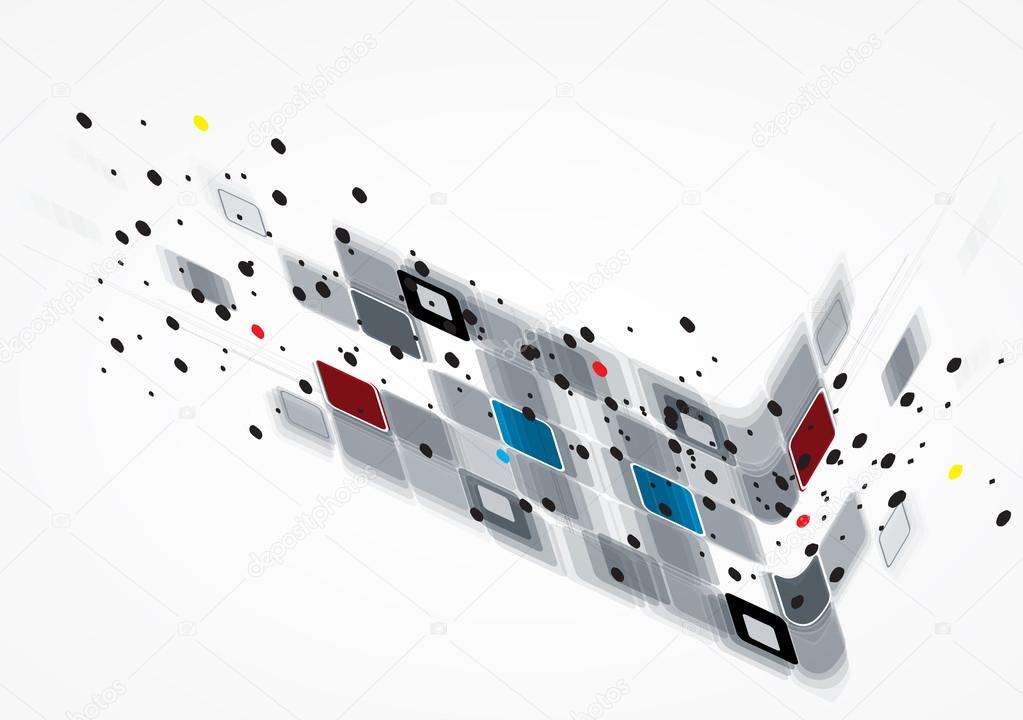إذا كانت التكنولوجيا الحيوية إحدى المظاهر الحاسمة للتقدم التقني الذي يشهده عصرنا، فإن ثمة سؤالا ينفتح على أفق فلسفي لا يقل أهمية وقيمة عن السؤال الأخلاقي، وهو ذلك المتعلق بنمط العقلانية الموازية للتقدم التقني الذي تفتتحه الثورة البيوتقنية في أفق الألفية الثالثة؟ هذا السؤال يرتبط في وجه منه –لنقل الأساسي- بصيرورة الكائن المعاصر من حيث هي صيرورة ترتسم في عالم يعيش تحت التأثير المباشر والعميق لقوة جبارة تدعى التقنية.
شهدت العلوم المعاصرة تطورات مذهلة في المنتصف الأخير للقرن العشرين 20. وقد تسارعت وتيرتها أكثر مع اقتراب نهاية القرن المذكور، مستفيدة في ذلك من السباق المحموم بين اقتصاديات الدول المتقدمة التي راهنت في تقدمها وطموحها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي على التحكم بأنظمة البحث العلمي بدرجات عاليا وربطها بمتطلبات الإنتاج الاقتصادي، بل وإخضاعها في النهاية لمنطق السوق الخالص كما تشهد على ذلك اتجاهات البحث في نطاق ما أصبح يعرف بالبيو-تكنولوجيات.
وإذا كان من الطبيعي أن تطرح مثل هذه التطورات مشاكلها الفلسفية والنظرية على صعيد الموقف الأنطولوجي للكائن، كما هو الشأن في كل المنعطفات الإبستمولوجية التي عرفها تاريخ العلم منذ الثورة الكوبيرنيكية، فإن الثورة التي أطلقتها علوم الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية Biologie moléculaire على إثر الاكتشافات العظيمة في مجال الاستنساخ clonage والتي يظهر أنها تكرست كإنجاز حاسم وعلى نحو لا يقبل التراجع فيما يخص أهدافه البعيدة مع الإعلان عن إنجاز الخريطة الشاملة للجينات البشرية (الجينوم) تطرح بالإضافة لذلك، مشاكل أخلاقية على قدر كبير من الحساسية والخطورة، بالنظر إلى طبيعة مجال تطبيقاتها وما يثيره من شكوك حول مدى قدرة العلماء على التحكم بنتائجها وأغراضها الإنسانية المعلنة، فيما كثير من الأصوات تدق ناقوس الخطر بشأن تدخل أطراف مستفيدة من هذه الثورة لتحريف إنجازاتها واستغلالها لأغراض لا إنسانية أو على الأقل ستنطوي على تهديد لحميمية الكائن البشري وكرامته وخصوصيته.
ثلاث ثورات علمية ستطبع القرن الحالي ببصمات قوية: الأولى ثورة الكم التي كانت قد أطلقت في القرن العشرين موجة من الاكتشاف العلمي ارتكز على وصف المادة في تعددها الظاهري اللامتناهي قلبت المفاهيم القديمة الموروثة من العصر اليوناني رأسا على عقب. ومن المرجح أن تساهم هذه الثورة المتواصلة بشكل حاسم في فتح آفاق جديدة أمام العلماء والبشرية ستمكن من التحكم في المادة وتصميم أشكال جديدة للحياة. ثانيها الثورة الإلكترونية التي مكنت من فهم أنظمة الذكاء ودراسة أنواعه المتعددة والموزعة في كل أنحاء المحيط الكوني. ويفترض أن تقود هذه الثورة في القرن الواحد والعشرين إلى التحكم بأنواع متقدمة من الذكاء. ثالثها الثورة البيوجزئية التي تعد المستفيد الأكبر من الثورتين السالفتين، مما سيسمح لها بتفسير الحياة بالاعتماد على مؤشرات عالية الدقة مثل الشفرة الوراثية للحياة، التي أصبحت ممكنة بفضل تكنولوجيا البيولوجيا الجزئية. وهكذا فإن حل شفرة الجينوم البشري سيمكن العلماء من "دليل تشغيل" للكائن البشري، وبالتالي القدرة على التحكم في الحياة بشكل يستجيب لرغبة البشر؟!
لقد خلخلت هذه الثورات الكثير من اليقينيات وأفسحت في المجال لظهور تنبؤات جديدة أثارت حماسا كبيرا وسط العلماء، وفي الوقت نفسه مخاوف مشروعة فيما يعود لانعكاسات تطبيقاتها التقنية ذات الصلة بالإنسان والطبيعة. ويجدر التذكير هنا أن هذه المخاوف لم تعد مقتصرة على الرأي العام، بل نجدها أيضا لدى العلماء أنفسهم، خصوصا الذين يعملون في مجالات الحي le vivant كالبيولوجيا والطب. ولعل استحضار مصطلح البيوإيتيقا bioéthique الذي كان قد أطلقه عالم بيولوجي أمريكي قبل أكثر من ربع قرن، كاف للتدليل على تنبه العلماء للمشكلات الأخلاقية التي يطرحها التقدم العلمي، خاصة تلك المرتبطة بالعالم الحي. إن عمر هذا المصطلح يفصح عن حقيقة أن السؤال الإيتيقي الذي يلازم إنجازات العلوم وتطبيقاتها ويقلق العلماء والفلاسفة لا يخص فقط علوم الهندسة الوراثية وإنجازاتها في نطاق الاستنساخ وقدراتها على فك الشيفرة الكيميائية التي ستمكن من "خلق الإنسان"، وتحليل الخريطة الوراثية للكائن الحين (يقدم مشروع الجينوم البشري مثالا لتلاقح الثورات الثلاثة التي تمهد لقرن علمي جديد فاصل في تاريخ البشرية)، وإنما هو يتجاوزها ليشمل جل العلوم الأخرى التي تتعدى أبحاثها نطاق المختبرات والصياغات الرياضية، مثل الفيزياء الجديدة والكيمياء وغيرها. ويكفي الإشارة في هذا السياق أن المشكل الأخلاقي كان قد بلغ ذروته مع إقدام مجموعة من الفيزيائيين العاملين في مشروع "منهاتن" على إنتاج القنبلة الذرية وتفجيرها لأول مرة بالمدينتين اليابانيتين (هيروشيما وناكازاكي)، حيث خلق هذا الفعل الشنيع أزمة ضمير ألقت بظلالها على جيل كامل من العلماء على حد تعبير ميشال سير. وقد سارع بعض العلماء على إثر ذلك إلى التخلي عن تخصصهم العلمي ليتجهوا نحو مجالات بحث أخرى كان يعتقد حينها أن تطبيقاتها سيكون لها نفع كبير للإنسانية مثل البيوكيمياء وتطبيقاتها في الميدان الطبي. غير أنه سرعان ما تبين لهؤلاء أن هذه العلوم بدورها تطرح مشكلاتها الأخلاقية التي لا تقل حساسية وخطورة عن ما طرحته التطبيقات الفيزيائية. وهكذا يظهر اليوم أن كل العلوم تطرح أسئلتها الأخلاقية الخاصة بها: الكيمياء ومشاكل البيئة والبيوكيمياء وتحويل الجينات، بل وحتى الثورات الإلكترونية، التي يبدو مجالها محايدا، تطرح مخاطرها المتمثلة في تهديد الحريات المدنية والخصوصية من خلال التنصت والرقابة، وتعميق الفوارق بين الناس (الذين يملكون المعلومات والذين لا يملكونها)، "وإحالة عشرات الملايين من الناس إلى طوابير الخبز، مما يؤدي إلى زيادة الفوارق على هذه الأرض". وتعميق الفوارق بين الأمم، بين تلك التي تستثمر استراتيجيا في العلم والتكنولوجيا، وبين أمم لا تملك من العلم والتكنولوجيا شيئا وتكتفي باستهلاك ما تملك من ثروات ومواد طبيعية قابلة للنفاذ .
1 – قرن البيو-تقنيات أو القدر الميتافيزيقي للعلم:
لقد كان القرن المنصرم بحق قرن الفيزياء النووية والمعلوميات. وإذا كان القرن الحالي يواصل تطوير مكتسبات سلفه العشرين بشكل مدهش ربما لم يكن ليخطر على بال أولئك الذين وضعوا أسس الثورة الفيزيائية والمعلوماتية، فإنه في اتجاهه الأساس يكرس نفسه كقرن للهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية أو بالأحرى قرن البيو-تقنيات كما يسميه جيرمي ريفكين. فقد اعتبر هذا الأخير التكنولوجيات الحيوية بمثابة الثورة الصناعية الثانية التي يشهدها التاريخ الإنساني، حيث تتقاطع في مركب واحد قوى ثلاث ميادين أساسية: علمية، تكنولوجية واقتصادية. وهو المركب الناتج عن التقاء الثورة الجينية والثورة الإلكترونية الذي يهيئ البشر لولوج عصر البيو-تقنيات، إنه الالتقاء الذي يجسد ذلك الزواج الذي تحدث عنه هيدغر بين العلم والتقنية باعتباره القدر الميتافيزيقي للعلم. فالعلوم البيولوجية التي عرفت تطورا حاسما مع سطوع نجم الهندسة الوراثية وتقدم التقنيات المخبرية لم تعد مجرد علوم نظرية محضة بعد أن ولجت التطبيقات التقنية والصناعية مثل الطب والصناعة الصيدلية والفلاحة الاصطناعية وغيرها من المجالات التي استفادت من تقنيات التحكم في البنية الوراثية، والتي أصبحت قابلة للتعميم داخل الزراعات النباتية والبكتيرية بعد النجاح الباهر الذي حققته في الزراعة الحيوانية خاصة مع التجربة الشهيرة لنعجة "دولي".
لقد سمح التعاون الجاري بين مختلف العلوم البيولوجية والتكنولوجية الحيوية بتغيير علوم الحياة بشكل عميق إلى حد يسود فيه الاعتقاد بين العلماء أن ذلك سيؤدي حتما إلى تغيير الحياة نفسها، علاوة إلى ما سيترتب عن ذلك من ثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات أبعاد كونية يصعب تصور شكلها أو التنبؤ بعواقبها على المدى البعيد.
لا شك أن هذه الثورة العلمية الجديدة قد تأتي بفوائد عظيمة على مستوى تطوير وسائل وطرق علاج الأمراض المزمنة، وتوفير تنوع غذائي يسد حاجيات البشر، بل وحتى الكشف عن أسرار الوجود. لكن مع ذلك ثمة شكوك تحوم حول هذه الثورة ومنها ما يساور العلماء أنفسهم حول المخاطر التي قد تنجم عن استغلال نتائجها لتهديد البيئة، وهو ما يتحسسه اليوم كل الناس. على أن الأخطر من هذا التهديد هو تحكم رجال الصناعة في مستقبل الإنسانية من خلال تحويل المخزون الوراثي للبشر إلى مجرد ملكية صناعية على خلفية قوانين السوق. وقد عبر مؤلف كتاب (قرن البيو-تقنيات) عن هذا التخوف بقوله أن الإنسان يوجد اليوم على مرمى "تكوين جديد" يتميز بميلاد طبقة اصطناعية موضوعة لأجل تعويض الآليات الأصلية للتطور. فتقنيات التحويل الوراثي تمكن الإنسان اليوم من إعادة قولبة الحياة فوق الأرض، وهي نفسها التي تسمح بتحويل المساحات المزروعة إلى مساحات مغطاة بالنباتات المعدلة وراثيا. هذا علاوة إلى أن هذه التقنيات ستصبح قابلة للاستخدام في الأغراض العسكرية. ولعل ذلك يعيد إلى الأذهان المآسي التي تسبب فيها استخدام العلوم لأغراض مناقضة للأخلاق الإنسانية. فبعد القنبلة الذرية، ستمكن هذه التقنيات من التحكم أكثر في الطبيعة والسيطرة على قوتها. ولما كانت أخطار القنبلة الذرية واضحة فمن لا يصدق أن التقنيات الجديدة لا تحمل ذات المخاطر كما يقول ريفكين؟
توجد العلوم البيولوجية اليوم في موقف إبستمولوجي جدير بالاهتمام، فيما الحاجة إلى الفلسفة تزداد أكثر من أجل التدخل لفك رموز هذا الموقف بكل ما يلزم من الفعالية ليس فقط لصياغة موقف إيتيقي نظري أصبح ضروريا في ظل الوضعية الملتبسة التي تحيط بتقدم العلوم واتجاهات تطورها الراهنة، بل وكذلك لدعم موقف سياسي مضاد يعبئ الإنسانية في مواجهة المخاطر المفترضة من جراء الاستغلال الإيديولوجي والاقتصادي للاكتشافات العلمية الجديدة. وتبرز أيضا ضرورة تدخل الفلسفة في الكشف عن الرهانات التي تحيط بمجمل التطورات التي تشهدها العلوم البيولوجية وقد صارت رهينة للصناعات البيوتقنية. إن ملحاحية انخراط الفلسفة في هذا السياق تتمثل في كون العلوم البيولوجية وقد صارت رهينة للصناعات البيوتقنية. إن ملحاحية انخراط الفلسفة في هذا السياق تتمثل في كون العلوم البيولوجية على وجه الخصوص لم تعد مجرد علوم بحث برهانات المعرفة، وإنما صارت قوة تقنية تهيئ لصناعات مستقبلية ذات أهداف اقتصادية صرفة، خاصة بعد أن امتدت الأبحاث البيولوجية خارج المختبرات لتعانق تقنيات تحويلية ذات يد طولى على الأسواق مستفيدة في ذلك من دعم مالي قوي للشركات المتعددة الجنسية التي تسعى إلى اكتساح أسواق جديدة وترويج منتوجات تجارية جديدة تتعدى حدود الصناعات الصيدلية والطبية لتشمل منتوجات الفلاحة والصناعة الغذائية والحربية وغيرها، مما يثير مخاوف مشروعة حول ما قد ينجم عن ذلك من انحرافات أخلاقية وسياسية وإيكولوجية يرى الكثير من المتتبعين أنها واردة بنسبة كبيرة الاحتمال إذا كان الأمر يتعلق هنا بالذات بمغامرة السوق؟
إن الموقف الفلسفي الذي تبلوره الإيتيقا في هذا المضمار إذ يضع العلوم البيولوجية أمام سؤال الأخلاق دون مواربة، فإنه لا يغفل عن تقاطع هذا السؤال مع السياق التاريخي الذي تجري فيه الثورة العلمية المعاصرة في مختلف الميادين، والمتميز عموما بالتحكم الاقتصادي والسياسي في الأبحاث العلمية، وهو ما يظهر جليا في حقل البيو-تقنيات.
2 – منطق العلم ومنطق السوق:
في سنة 1907 كان Hugo Devries وهو بيولوجي شهير وأحد الذين أعاد اكتشاف ما يعرف بقوانين مانديل Mendel، قد أدرك أنه بالنسبة لعلم تطبيقي كالهندسة الوراثية الزراعية يهيمن الاقتصادي على ما هو علمي Le scientifique بل ويحدد ما هو "صحيح علميا". ولعل ما نشهده اليوم من هيمنة مطلقة على حقل الهندسة الوراثية والعلوم البيولوجية من قبل المركب الجينو-صناعي Le complexe genetico-industriel وتوجيهه للبحث في هذين المجالين بمنطق الربح والسوق على حساب المعايير الأخلاقية والإنسانية، لغير خير دليل على ما ذهب إليه De vries. H . فالمركب المذكور بسيطرته على التقدم التقني يسعى إلى الرفع من قيمة أرباح الشركات المستثمرة على حسبا المصالح الحيوية للمجتمعات الإنسانية، كما أنه يعمل على تحويل القضايا السياسية إلى قضايا تقنو-علمية بالشكل الذي يمكنه من التحكم فيها أكثر.
إن إحدى المجالات الهامة التي يجري فيها إعمال سيطرة المركب المشار إليه أعلاه تتمثل اليوم فيما أصبح يعرف بالفلاحة الاصطناعية التي غدت حقل اختبار حقيقي للتقنيات التي تمكن من الحصول على أنواع من العضويات الحية يتم تعديلها أو تغيير شفرتها الوراثية بحيث تصبح ذات إنتاجية عالية وقدرات فائقة على المقاومة والتكيف مع ظروف إنتاجها. وقد أثار استعمال هذه التقنيات مواقف متناقضة بين أنصار يتشكلون من منتجي المواد والمنتجات الفلاحية، وهم يزعمون أن أشكال التحكم الوراثي التي يجري تطويرها في أحضان البيو-تكنولوجيات ستمتع بعض العضويات بخصائص وراثية جديدة من شأنها أن تسهم في محاربة المجاعة في العالم، ومناهضين يرون أن ذلك لا يخلو من مخاطر عدة، أهمها اختفاء التنوع البيولوجي الناجم عن نمط الفلاحة الصناعية التي تمنح الأسبقية لعدد محدد من الأنواع العضوية ذات مردودية عالية. والحال أن الشركات المهيمنة لا يهمها توفير الأمن الغذائي للعالم بقدر مصالحها الخاصة، وهي لذلك لا تتوانى في ممارسة كل أشكال الضغط على التحركات التي تستهدف وضع قواني حماية الأمن البيولوجي مثل تقنين "بعثرة" المنتوجات المعدلة وراثيا OGM في المحيط الإيكولوجي وقوانين حماية المستهلك والبيئة من المخاطر المترتبة عن تسويق هذه المنتوجات.
إن السباق المحموم بين الشركات المتخصصة في "الصناعة الفلاحية" يكشف حقيقة أن الأمر لا يتعلق لديها بتوفير الأمن الغذائي للبشرية بقدر ما أن ذلك يخدم بالدرجة الأولى سعيها إلى تنحية الفلاحة الأحادية وتقوية موقعها على مستوى الأسواق العالمية من خلال السيطرة والتحكم بالأبحاث التكنولوجية والاختراعات. ويكفي استحضار مثلا شركة "مونساطز" في هذا البابا لتنفيذ خرافة الأمن الغذائي. فقد قامت هذه الأخيرة باختراع "سوجا" معدلة وراثيا تتمتع في الآن نفسه بمقاومة مبيد الحشائش تصنعه نفس الشركة، مما يعني أن زراعة هذه السوجا يستوجب استعمال ذات المبيد الذي تصنعه الشركة المسوقة لها. وهو ما يفيد عمليا إحكام القبضة على رقاب الفلاحين وتحويلهم إلى عبيد جدد للأسواق. وفي السياق نفسه يكشف التنافس الشرس حول امتلاك براءات الاختراع الوضع الاحتكاري للشركات المتعددة الجنسية، فيما يبقى الفلاحون مرغمين على استعمال البذور التي يتوقف إنتاجها على براءة الاختراع (ومن هنا يصبح مفهوما سعى الولايات المتحدة لجعل حقوق الملكية الفكرية إحدى النقاط الأساسية في مفاوضات التجارة العالمية المتعددة الأطراف التي كسبت في النهاية رهانها غداة مداولات الأروغواي). فالحقوق الفكرية تطال اليوم العضويات الموجودة في المحيط الطبيعي، مما يعني حرمان الفلاحين ودول العالم الأخرى من استغلال ما يعتبر ملكا مشاعا بين الإنسانية جمعاء. على أن الخطر الأكبر يظل هو محاولات تملك التنوع البيولوجي والعبث بالإرث المشترك للبشر.
إن منطق السوق الذي يتحكم في معالجة مسألة الأمن الغذائي للإنسانية يوهم أن مشكلة المجاعة ذات طابع تقني يمكن حلها بواسطة الهندسة الوراثية. والحقيقية أنها قضية ترتبط في النهاية بما يسميه إدغار بيزاني بـ"السيادة الغذائية المرتبطة بدورها بتقوية السياسة الاقتصادية المستقلة للدول السائرة في طريق النمو وحماية حقوقها إزاء الغزو الاقتصادي والتخريب الإيكولجي والاجتماعي الذي تمارسه الدول الغنية.
3 – المسؤولية الأخلاقية للعلماء: البيوإتيقا
إذا كانت المخاطر التي يطرحها تحكم الشركات المتعددة الجنسية فيما أضحى يعرف بالذهب الأخضر للقرن الواحد والعشرين (الجينات) تتجاوز إرادة العلماء، فإن ما تنبه له البيوإتيقا في هذا الإطار يتعلق بالدرجة الأولى بالمسؤولية الأخلاقية للعلماء تجاه أبحاثهم واكتشافاتهم في الوقت الذي صارت فيه تحت وصاية المؤسسات الصناعية. بل إن هذا التحذير يذهب أحيانا إلى رفض أشكال التحكم الجيني التي يطورها العلماء بمختبراتهم والمنطوية على مخاطر محتملة مثل نشر الأمراض بواسطة فيروسات معدية، وتهديد الإنسان في غيريته واختلافه، كإنتاج أعضاء بشرية موجهة لأغراض تجارية. وعن هذه الأخيرة تؤكد هيلين كاردين أن الطلب في هذا المضمار قوي بلا شك، وأن التقنية على ما يظهر لا تجد بدا من الاستجابة له إلى أبعد الحدود.
مما يبعث على قلق حقيقي اتجاه تسويق المنتوج العلمي واستخدامه لأغراض تتناقض والمبادئ المؤسسة لخصوصية الكائن الإنساني.
ما هي طبيعة المشاكل الأخلاقية التي يواجهها العلماء أثناء نشاطهم؟
تقول كلودين جوينين أنها تتمثل في مستويين: 1) مستوى البحث العلمي، 2) مستوى تطبيق الاكتشافات العلمية المترتبة عن البحث. وتعتقد أن هذه المشاكل ربما تحتد وتتعقد أكثر على المستوى الثاني، سيما وأنه مجال منفتح على المستقبل وغير متوقعة آفاقه البعيدة فكثير من المشاكل تنحدر من تطبيق قوانين Huriet والبيوإتيقا على أبحاث الهندسة الوراثية. على أنه في بعض الحالات يدعو العلماء إلى توخي نوع من الحذر الفكري تجاه تضخم وتعملق المشكل الأخلاقي، إذ أن "كثيرا من الأخلاق تقتل الأخلاق" كما تقول كلودين، زيادة إلى أن بعض القوانين الشرعية المنظمة للبيوإتيقا تستنزف الكثير من الوقت على صعيد البحث. وإذا كانت قوانين Huriet ضرورية في زمنها لتأطير البروتوكولات العلاجية فإن تمديدها لتشمل الأبحاث في نطاق الهندسة الوراثية تطرح الكثير من التعقيدات، خصوصا في الاختبارات الوراثية على المرضى لدى الشركات وشركات مشكلا سياسيا خطيرا للغاية. ويعتقد أنه بالنظر للإيقاع الذي تسير به الأمور فإن الاختبارات ستنتهي لأن تصبح في متناول غايات جماعية طالما أن الطلب واقعي تماما. فالأفراد أنفسهم سيطالبون بمعرفة مستقبلهم الجيني. ويضيف هذا الباحث أن السؤال المطروح حول مستقبل الاختبارات يتمفصل مع العلاقة الأبدية للعرض والطلب. فلما يتعلق الأمر بحالة عائلة مثلا مهددة باحتمال كبير للإصابة بسرطان الثدي، فإن الخوف يكون واردا لدى الأفراد عموما.والحالة هاته فإن واجب الطبيب أن يعمل في اتجاه الملاحظة الجينية لأنه في جميع الأحوال المعرفة أفضل من الخوف.
وعلى خلاف كلودين .ج يرى جون بيير شنجو "أن القوانين الأخلاقية في الميدان الطبي لا تعرقل تطور البحث، بل التأطير القانوني للبحث أمر لا بد منه، خاصة بالمجالات التي تهم البحث في الوقت الراهن، حيث تطرح مسألة كرامة الفرد. ومن ثم فإن دور اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاق بفرنسا مثلا، يتمثل بالأساس في معالجة كثير من النقط المتصلة بحماية كرامة الأفراد ومنع الانحراف الذي يتهدد البحوث الطبية في ميدان التجارب على السكان واختبار فعالية الأدوية. ويشير الباحث في هذا السياق إلى أن محكمة نورنبيرغ 1946 بإدراكها لجرائم الأطباء النازيين، شكلت المحطة التأسيسية للتفكير البيوإتيقي. وعليه فإن من واجب اللجنة المذكورة أن تتصدى للقضايا الأخلاقية المترتبة عن تطور الأبحاث سواء تعلق الأمر بالفرد أو الإنسانية جمعاء.
إن البيوإتيقا أضحت اليوم مرجعية عمومية لمواجهة التحديات التي تطرحها الثورات العلمية الجديدة في عدد من المجالات، وخصوصا ما يتصل بقدرات بعضها على تغيير أنماط الحياة في الكون وتعديل الكائنات الحية وتهديد التنوع البيولوجي مثل الهندسة الوراثية التي تزعم القدرة على تغيير الجينوم البشري وبالتالي الجنس البشري نفسه. والحال أن هذه التحديات تتجاوز العلماء أنفسهم في كثير من الأحيان، وهو ما يدعو إلى خلق تحالفات واسعة تضم قوى متعددة ومتضامنة للتصدي لها على المسرح العمومي. ولعل مبادرة جيرمي ريفكن في هذا الصدد لجديرة بالانتباه. فقد قاد هذا الأخير تحالفا احتجاجيا دوليا ضد تسجيل براءة الاختراع تسيطر عليه شركات لا رادع أخلاقي لها مثل شركة (ميرماد جبيتيك) التي سجلت براءة اختراع "جين" يكبح ورم سرطان الثدي BRCA وقامت بتسويق اختبارات جينية مسموحة تجاريا، وهو ما رأى فيه هذا التحالف تهديد واضح لخصوصية النساء، سيما إذا وصلت المعلومات إلى شركات التأمين، هذا فضلا عن كون ذلك يعد احتكارا وتجاوزا لمنطق التنافس العلمي مما يمكن القطاع الخاص من جني أرباح طائلة من بحث ممول من قبل الدولة.
على أن المشكلة تظل قائمة ضمن مسؤولية العلماء في معالجة الآثار الأخلاقية المترتبة عن أبحاثهم في مجال الهندسة الوراثية على وجه الخصوص.
يذكر م.كاكو أن علماء البيولوجيا الجزيئية استفادوا من أخطاء علماء الطاقة النووية الذين أغفلوا التجاوزات بسماحهم القيام بتجارب إشعاعية سرية على مواطنين أبرياء 20 ألف دون علمهم منذ الأربعينات، وذلك بأن طالبوا بتخصيص 3% من ميزانية مشروع الجينوم لمعالجة التأثيرات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية، والتي تظل على كل حال نسبة ضئيلة للغاية. على أن مسؤولية هؤلاء تبقى قائمة لمواجهة التجاوزات المحتملة للثورة الجينية، مما يحتم ضرورة المساهمة في خلق نقاش "واعي بين مواطنين مثقفين لاتخاذ قرارات ناضجة بشأن تكنولوجيا من القوة بما يسوغ أن نحلم بأنها ستتحكم في الحياة نفسها". وطالما أنه من المستحيل احتواء التكنولوجيا الحيوية، فليس بالإمكان، يقول "كاكز"، سوى مناقشة واختيار التكنولوجيا المختلفة إما عبر قانون حكومي أو عن طريق الضغط الاجتماعي والسياسي". ويعتقد هذا العالم أيضا أن أفضل وسيلة للتصدي للمشاكل الأخلاقية والقانونية والاجتماعية الناجمة عن علم الجينات تتمثل في "ذكر مخاطر وإمكانيات البحث الجيني علنا أمام الجمهور وإصدار قوانين تحدد بشكل ديمقراطي اتجاه التكنولوجيا نحو تخفيف المرض والألم". بل إن عالمنا لا يرى مانعا من التحريم النهائي لبعض نواحي البحث الجيني التي لا يمكن التحكم فيها واحتواء مخاطرها.
وإجمالا يقترح "كاكو" أن ترتكز مسؤولية العلماء على المساهمة الجدية في ترسيخ مبادئ بيوإتيقية تضمن ما يلي: 1) العدالة للجميع، 2) عدم التمييز الجيني، 3) حق الخصوصية بمنع إذاعة الأسرار، 4) الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للجميع، 5) الحاجة إلى التعليم ورفع وعي الجماهير.
إن هذه المبادئ هي عموما ما يسمح بالتعاطي مع الأخلاق كمسألة تقع في صلب جدلية العلاقة بين العلم واستعمال المعرفة من قبل المجتمعات الإنسانية بما يضمن حقوق الأفراد وكرامتهم وخصوصياتهم.
4 – عقلانية القرن 21 أو نحو إنسانوية جديدة:
إذا كانت التكنولوجيا الحيوية إحدى المظاهر الحاسمة للتقدم التقني الذي يشهده عصرنا، فإن ثمة سؤالا ينفتح على أفق فلسفي لا يقل أهمية وقيمة عن السؤال الأخلاقي، وهو ذلك المتعلق بنمط العقلانية الموازية للتقدم التقني الذي تفتتحه الثورة البيوتقنية في أفق الألفية الثالثة؟ هذا السؤال يرتبط في وجه منه –لنقل الأساسي- بصيرورة الكائن المعاصر من حيث هي صيرورة ترتسم في عالم يعيش تحت التأثير المباشر والعميق لقوة جبارة تدعى التقنية. لقد أطلقت الثورات العلمية في مجالات الحي جدلا واسعا بشأن المسألة الإنسانوية Humanisme استقطبت، علاوة إلى انشغالات العلماء والفلاسفة، قطاعات واسعة من الرأي العام بالنظر إلى خطورة ما تنبئ به من تحولات ستمس لا محالة مواطن حساسة من كينونة الإنسان. وقد تمحور هذا الجدل حول سؤال كبير من طبيعة أنتروبولوجية جذرية يلحق بالسؤال الإيكولوجي للقرن العشرين حول مصير الكوكب وهو: ماذا سنفعل بنوعنا الإنساني؟
من الأطروحات التي برزت في أحضان هذا الجدل مثيرة نقاشا صاخبا بين أعداء النزعة الإنسانية وأنصارها نجد أطروحة ما بعد الإنسانية Post-humanité. وحسب ما ذكر أحد الكتاب فإن شخصيتين حظيتا باهتمام خاص في سياق هذا الجدل بالنظر إلى حساسية موقعهما الإيديولوجي. الأول محسوب على اليمين المحافظ، كان قد ذاع صيته عقب نشر مقاله حول نهاية التاريخ سنة 1989 وهو فرنسيس فوكوياما، والذي أصبح اليوم غنيا عن التعريف. أما الآخر فهو ينتمي لليسار الراديكالي الألماني برز على إثر خوضه لسجال عنيف مع هابرماس ومدرسة فرانكفوت ونشره لمحاضرة ألقاها في ملتقى دراسي حول مارتن هيدغر وليفيناس بعد توسيعها بالفرنسية تحت عنوان مستفز Règles pour le parc humain ويتعلق الأمر بـ Peter stoterdijk.
بالنسبة للأول، فقد وضع أطروحة جديدة يزعم فيها أن الوقائع التي شهدها التاريخ بعد 1989 أثبتت صحة أطروحته الأولى حول نهاية التاريخ. ذلك أن الثورة البيوتكنولوجية هي في طريقها إلى خلق شروط تاريخ ما بعد-إنساني، ويستند فوكوياما في زعمه إلى التأثير القوي للثورتين التوأم: ثورة تكنولوجيا الإعلام وثورة البيوتكنولوجيا على تطور العالم. ويعتقد أنه إذا كانت الثورة الأولى ملحوظة فإن الثانية هي المرشحة لإحداث انقلابات حقيقية في سيرورة العالم، ذلك أنه بعد جيلين من الآن ستمنحنا البيوتقنية أدوات ستمكننا من إنجاز ما لم ينجح في تحقيقه أخصائي الهندسة الاجتماعية، وهو ما يعني أنه في تلك اللحظة سنحسم نهائيا مع التاريخ الإنساني ومن ثم نلج تاريخا جديدا ما وراء الإنساني. وللبرهنة على أطروحته يسوق فوكوياما بعض الأمثلة من المعالجة الكيميائية للانفعالات للدفاع عن عالم جديد سيكون فيه أشباه إنسان في خدمة الإنسان الأعلى. ويعلق فيفيري على هذه الأطروحة قائلا: إن النزعة المضادة للإنسانوية النظرية والعملية التي تنطوي عليها ليبرالية فوكوياما نخفي في الواقع نزعة مضادة لليبرالية الثقافية والسياسية التي تبرر الليبرالية الاقتصادية التي تعمل الآن على إغراق العالم والبشر في فوضى وضع لا-إنساني.
أما فيلسوفنا اليساري الراديكالي فقد وضع أطروحة أثارت صخبا كبيرا بسبب ما تعمده من شحن لفظي جارح قريب من القاموس اليميني المتطرف الذائع الصيت في ألمانيا مثل منتزه إنساني، التدجين، الترويض وغيرها. ولتجنب ردود الفعل المحتملة لا يتردد Stoterdijk في العودة إلى أفلاطون ليجد في تراث هذا الأخير ما يعين على تأسيس خطاب "الجماعة الحيوانية" بشرعية فلسفية سيكون من الصعب بمكان انتزاعها من داخل المتن المعاصر يقول: "منذ البوليتكوس وبوليتيا، وجدت خطابات تتحدث عن الجماعة كما لو كان الأمر يتعلق بمنتزه حيواني parezoologique(…). ومن ثم يمكن لمقابلة الناس في المنتزهات –وفي المدن- أن تبدو كمهمة زو-سياسية une tâche zoopolitique. ليضيف قائلا "أن الحديقة الأفلاطونية يهمها أن تتعلم ما إذا كان الاختلاف بين السكان والقيادة هو فقط في الدرجة أم في النوع" وهذا الكلام لا يخفي انزلاقا صاحبه إلى قاموس يميني عنصري منحط.
ويرى باتريك .ف "أن الرد على هذا الخطاب ينبغي أن يعزز بالكشف عن مواطن الهشاشة في الإنسانوية الحديثة، والمتمثلة أساسا في: الهشاشة الإيكولوجية التي ترتبت عن الإنسان الديكارتي سيدا ومالكا للطبيعة دون أن نحدد مسؤوليته إزاء محيطه الطبيعي، ثم الهشاشة الأنتربولوجية التي تمثلت في إعادة تأسيس الرابطة الاجتماعية على نزعة فردانية عقلانية كرست المقارنة الرأسمالية للشرط الإنساني. ومن ثم يرى الباحث أنه في مواجهة التحدي الإيكولوجي والتنمية المستديمة والتحدي الأنتربولوجي ينبغي أن نفكر في تأسيس إنسانوية جديدة قادرة على حل المعادلات الصعبة والتوترات الدينامية التي تشغل حيز العلاقات بين الفرد والجماعة، العقل النقدي والبحث عن المعنى، تحويل الطبيعة واحترام الفضاء الحيوي، التقدم التقني العلمي وتجنب آثاره التدميرية المحتملة. ولأجل مقاومة إغراءات النزعة ما بعد-الإنسانية يلزم أخذ التحول المعلوماتي والثورة في مجال الحي بعين الاعتبار، طالما أن طريقة إقامتها داخل أجسادنا الخاصة يتهددها التحول وأن ما هو حميمي فينا أصبح موضوع رهان في صناعة الكائن الإنساني الحي.. إنه بالأحرى ينبغي الذهاب أبعد من ذلك في تأمل هذه الجدلية التي تعمل في بنية الرأسمالية المتجددة التي كتب عنها "شارو" يقول: "التكنولوجيا والإيديولوجيا أسس رأسمالية القرن الحادي والعشرين. تجعل التكنولوجيا المعرفة والمهارات المصادر الوحيدة للتفوق الاستراتيجي المستدام، وتتحرك الإيديولوجيا مدفوعة بالوسائط الإلكترونية نحو شكل جذري من تعظيم الاستهلاك الفردي على المدى القصير تماما، في الوقت الذي سيعتمد فيه النجاح الاقتصادي على الاستعداد والمقدرة على تقديم استثمارات اجتماعية –على المدى البعيد- في المهارات والتعليم والمعرفة والبنية التحتية. وعندما تفترق التكنولوجيا عن الإيديولوجيا فإن السؤال الوحيد سيكون هو: متى ستحدث (الواقعة الكبيرة)، أي الهزة الأرضية التي ستطيح بالنظام؟