 برحيل الفنان الكبير محمد رويشة، الثلاثاء 17 يناير الجاري بمدينة خنيفرة، بعد صراع ومعاناة مع المرض عن سن 62 عاما، يكون المشهد الفني الوطني عامة، والأغنية الأمازيغية على وجه الخصوص، فقدا تجربة غنائية متفردة استنفرت مكنون الذات في أشواقها الوجدانية والروحية.
برحيل الفنان الكبير محمد رويشة، الثلاثاء 17 يناير الجاري بمدينة خنيفرة، بعد صراع ومعاناة مع المرض عن سن 62 عاما، يكون المشهد الفني الوطني عامة، والأغنية الأمازيغية على وجه الخصوص، فقدا تجربة غنائية متفردة استنفرت مكنون الذات في أشواقها الوجدانية والروحية.
فقد اختطفت يد المنون محمد رويشة بينما كان يتم الاستعداد لتنظيم سهرة تكريمية له، إلى جانب موحا الحسين أشيبان الملقب ب`"المايسترو"، يوم 24 يناير الجاري بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.
وكان الراحل رويشة غادر سرير المرض مؤخرا بمستشفى الشيخ زايد بالرباط عائدا إلى مسقط رأسه خنيفرة، حيث تحسنت حالته الصحية، إلا أنه أحسّ بمتاعب صحّية صباح اليوم قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، لكنه أسلم الروح إلى باريها قبل الوصول إليه.
التنوير و الحداثة في فلسفة أبي يعرب ـ خالد كلبوسي
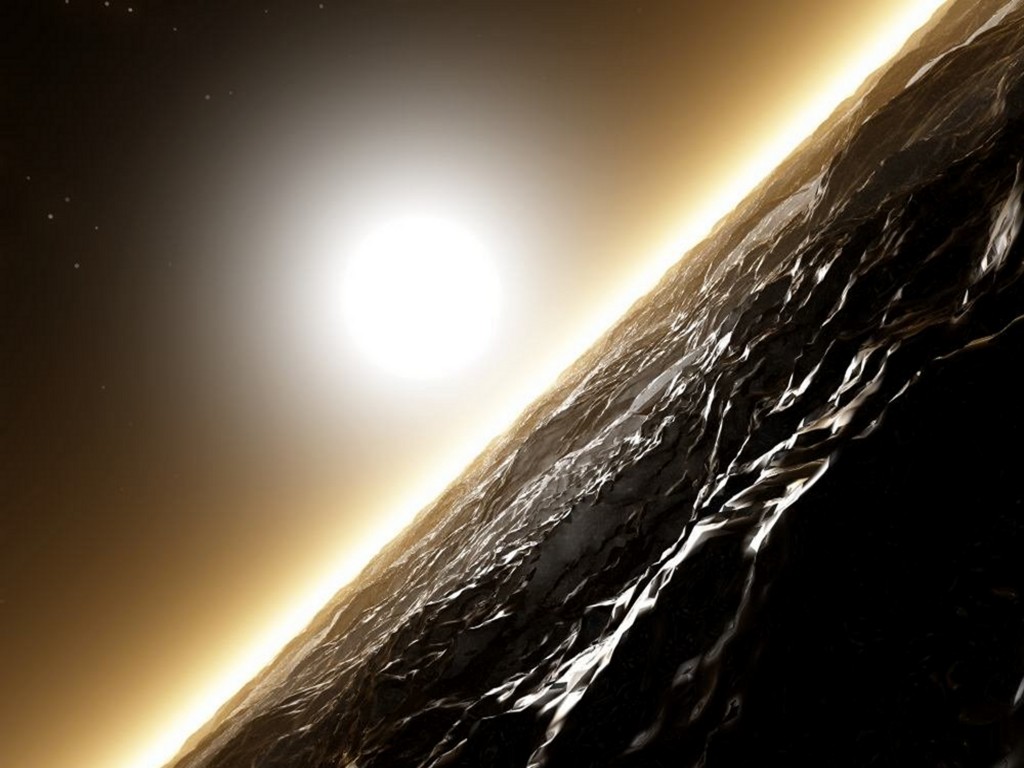 يفرض الباحث و الفيلسوف التونسي المعاصر أبو يعرب المرزوقي, صاحب أول دكتوراه في الفلسفة تقدم بالعربية في الجامعة التونسية سنة1991 ,نفسه على المشهد الفلسفي و السياسي في تونس .فهو صاحب إنتاج فكري غزير ذو قيمة معرفية عالية,إضافة إلى كونه شغوف بالمجادلات و المناظرات ذات الأهمية في المجالين الفكري و السياسي.وهو الآن أحد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 الذي وقع انتخابه على إثر ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة حيث قدم ترشحة ضمن قائمة تونس العاصمة عن حزب حركة النهضة الإسلامي.
يفرض الباحث و الفيلسوف التونسي المعاصر أبو يعرب المرزوقي, صاحب أول دكتوراه في الفلسفة تقدم بالعربية في الجامعة التونسية سنة1991 ,نفسه على المشهد الفلسفي و السياسي في تونس .فهو صاحب إنتاج فكري غزير ذو قيمة معرفية عالية,إضافة إلى كونه شغوف بالمجادلات و المناظرات ذات الأهمية في المجالين الفكري و السياسي.وهو الآن أحد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 الذي وقع انتخابه على إثر ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة حيث قدم ترشحة ضمن قائمة تونس العاصمة عن حزب حركة النهضة الإسلامي.
إن اهتمامنا بفكر المرزوقي يعود إلى الأسباب التي ذكرنا ولكن كذلك لأن البعض يعتبره رجعيا و ربما سلفيا أولا حداثيا على الصعيدين الفكري و السياسي,مستندين في ذلك إلى أنه ينتقد بحدة يندر أن نجدها لدى غيره أولئك الذين ينتسبون إلى الحداثة و العلمانية الفرنسيتين مدعين أنهما قيمتين كونيتين ,إضافة إلى كونه يعتبر أن النهضة العربية المأمولة لا يمكن أن تتم إلا بالعودة إلى ابن خلدون مؤسس علم العمران و ابن تيمية الذي يسود الاعتقاد لدى أغلب الدارسين أنه سلفي , في حين أن أبا يعرب يعتبره أحد أقطاب التنوير في الفكر الإسلامي.
"الآخر " في فكر الأمير عبد القادر من خلال المراسلات. ـ أ.د. حبيب مونسي
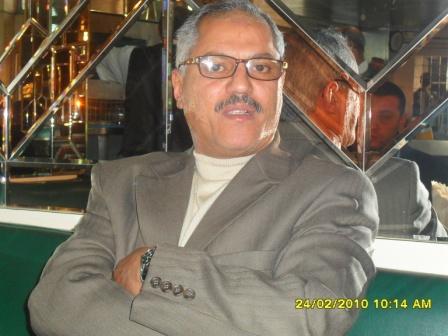 نص الرسالة:
نص الرسالة:
« ولما رأى الأمير أن بعض القبائل في الساحل القريبة بلادهم من المدن التابعة للعدو مالوا إلى طاعته والدخول تحت ظله وحمايته، أرسل إليهم من العلماء والأشراف من يعظهم ويحذرهم من مقت الله تعالى وغضبه،فلم يجد ذلك نفعا فيهم. ثم هددهم وأوعدهم وأمرهم بالخروج من مواطنهم، واللحوق بإخوانهم المسلمين في الداخلية، فلم يقبلوا، وتمادوا على ما هم عليه. فاعتزم حينئذ على غزوهم، والفتك بهم، ثم توقف في شأنهم واستشار الفقهاء في أمرهم، وبعث إلى قاضي فاس في ذلك، لينظر ما عنده فيه، وزاد أسئلة أخرى عن أشياء متفرقة عرضت له. ونص ما كتبه إليه:
« الحمد لله حق حمده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من خادم المجاهدين والعلماء عبد القادر بن محي الدين إلى الشيخ الإمام علم الأعلام السيد عبد الهادي العلوي الحسني قاضي القضاة بفاس المحمية،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. فما حكم الله في الذين دخلوا في طاعة العدو الكافر باختيارهم، وتولوه ونصروه، يقاتلون المسلمين معه، ويأخذون مرتبه كأفراد جنوده، ومن ظهرت شجاعته في قتالهم للمسلمين، يجعلون له علامة في صدره، عليها صورة ملكهم. هل هم مرتدون أم لا؟ وإن قلتم بردتهم، فهل يستتابون أم لا؟ وما حكم نسائهم، هل هن كرجالهم أم لا؟ وإن قلتم أنهن مثلهم فهل يحكم باستتابتهن أو يقتلن أو يسترققن، كما نقل عن ابن الماجشون أم لا؟ وما حكم ذراريهم؟ هل لنا سبيهم أم لا؟ وهل ما حكاه ابن بطال من الإجماع على أن المرتد لا تسبى ذريته،منقوض بما نقل عن ابن وهب وعن جمهور الشافعية أن المرتد كالكافر الأصلي أم لا؟ وهل يسوغ لنا العمل بما ينقل عن أصحاب مالك t عنه من الأقدمين كابن وهب وأمثاله في طبقته في هذه النوازل وأمثالها مما لم يشهره المتأخرون أم لا؟ ...
تناقضات الحداثة العربية ـ د. كريم الوائلي
المقدمة
تبدو كلمة الحداثة لكثرة استعمالها بين المثقفين وغيرهم لا معنى لها ، فهي تعني كل شيء أحيانا ولا شيء أحيانا أخرى ، إذ يستسهل بعض الناس استخدامها وتداولها ـ بحكم بريقها ـ ويتم بها توصيف مفكرين وسياسيين ومبدعين ، ويزداد الأمر غموضا إذا رافقتها كلمات مصاحبة دالة كالحداثوية والحداثانية ، الأمر الذي يجعل دراستها علميا أمرا ملحا .
والحداثة ليست كتلة مصمتة أو كيانا معلقا في فراغ ، ولكنها ـ دون شك ـ لبنة في منظومة اشمل ، وظاهرة بالغة التعقيد ، لا تعرف الاستقرار والثبات ، بمعنى أنها ليست مطلقة بحسب مفاهيم فكرية وافدة ، وإنما هي نبت تاريخي متغير تتحدد في ضوء السياقات التاريخية والاجتماعية ، فهي لا تولد فجأة ، دون إرهاصات سابقة تمهد لها ،وتساعد على نشأتها وتطورها ، الأمر الذي يدفع إلى دراسة التصورات والمفاهيم التي سبقت الحداثة ومهدت لها ، وان كانت على نحو خلافي .
ويعنى هذا البحث بدراسة :
1 ـ محاكاة الخارج .
2 ـ معاناة الداخل .
3 ـ تأسيس الحداثة .
ويكشف المحوران الأول والثاني عن أبرز وأهم التصورات الإحيائية والرومانسية التي أسهمت بشكل أو بآخر في التمهيد لتأصيل الحداثة ، أما المبحث الثالث فتتركز العناية فيه بتأصيل مفهوم الحداثة في ضوء التصورات والتجليات المختلفة التي تعرض له الحداثيون العرب .
ا. د . كريم عبيد هليل الوائلي
الـمــــــــاء وكونية قاعدة الدوران الأصولية ـ الدكتور المصطفى الوضيفي
 عند بحثي لهذا الموضوع، فكرت في الرجوع إلى أربعة أقانيم تعتبر أساسية لفقهه، وهكذا رجعت :
عند بحثي لهذا الموضوع، فكرت في الرجوع إلى أربعة أقانيم تعتبر أساسية لفقهه، وهكذا رجعت :
أولا : إلى القرآن وأنا أعرف مبدئيا أن الرجوع إليه في مسألة فقهية سوف يفتح أمامي خيالات متعددة لانفتاحه وللفراغات التي تركها للسنة النبوية من جهة، والعقل من جهة أخرى، هذا ناهيك عن إرادة المشرع في عدم دخوله في التفاصيل الدقيقة حفاظا على مقصوده المتجلي في التعبد والذكر وحفاظا كذلك على نسقه وجماليته الأخاذة … ولذلك فليس من مصلحة القرآن أن يدخل في هذه التفاصيل .
ثانيا : رجعنا إلى السنة النبوية، فاكتشفنا وللأسف تعارضا كبيرا بين النصوص فسح لنا المجال الواسع للمعاني والتفاسير والمواقف… حجبت عنا التطورات التاريخية التي تطورت فيها هذه اللفظة أو تلك من الألفاظ، ولعل حصول ذلك يقتضي منا إعادة ترتيب هذه النصوص ترتيبا تاريخيا نتمكن بواسطته من التأريخ للأفكار على الأقل إبان الفترة المكية والمدنية من تاريخ المسلمين.
ثالثا : رجعت إلى المعاجم وكنت آمل من هذه المظان أن تعكس لنا تصورات تاريخية للمعاني التي تطور فيها هذا اللفظ أو ذاك، غير أنه وللأسف لم نظفر بذلك، ولعل هذا راجع إلى تخصص هذه المعاجم في تقريب تصورات المعاني واشتقاقها وصرفها وجمعها وغير ذلك.
القربان الإبراهيمي ـ محمد البوعيادي
 في ظل الحدث الاحتفالي الذي تعرفه الدول الإسلامية في هذا الشهر "الحرام" يعود إلى الواجهة طقس ديني ضارب بجذوره في أعماق التاريخ البشري ، إنه طقس الذبح أو النحر بما هو سلوك يُبرز إلى الواجهة تجدُّر العلاقة الجدلية بين الأسطوري- الديني و الديني- الإنساني من جهة أخرى، هذه العلاقة تتجسد من خلال ممارسة تطبيقية ترمز إلى استمرار الميثاق الديني المبني على الطاعة و الوفاء للآلهة \الإله و هو طقس تقديم القرابين، ومن جهة نظر أنتربولوجية يمكننا النفاذ إلى عُمق الممارسة لمقاربتها كما هي في الإسلام دونما الخوض في نقد القيمة الرمزية لهذا الفعل أو دونما تعكير صفو الممارسة بما هي جزء من إطار ثقافي شامل يخص الإنسان و المجتمع الإسلامي ، لكن و من جهة أخرى لن نكون مُلزمين بالتخندق ضمن أنظمة الفهم اللاهوتي القاصر و التي تفقه الفعل الديني في مستواه السطحي و تُحيل دوما إلى شرعيته الثابتة دونما الخوض في مُساءلته من خلال الكشف عن رمزيته و توافقاته الضرورية مع الراهن أو اللحظة التي ندّعي فيها عيش الحداثة ، ببساطة لأن الأنظمة اللاهوتية (الفقهية فيما يخص الإسلام) " تستمر في إهمال المقولات الأنتربولوجية و الجانب التاريخي الظرفي من السياقات الاجتماعية و الثقافية و السياسية التي كانت قد رُسّخت فيها الحقائق الإلهية المعصومة و المُقدّسة و العقائدية " {1}، و نحن هنا لا نهدف إلى الكشف عن الجانب التشريعي للقربان في الإسلام من أجل الكشف في حد ذاته كغاية نهائية، بل إن فهم السلوك القُرباني سيكون الهدف من ورائه مساءلة شرعيته أيضا و بالتالي الخوض مُكرهين فيما لا مهرب منه، أي الخوض في الشرعية القُرآنية و فهم الميكانزم الكامن وراء التشريع للذبيحة التي تصير بفعل ظروف سوسيو- نفسية شبه إلزامية إذا ما وضعناها في سياقها الواقعي المُعاش حيث يتضافر العامل النفسي و الاجتماعي (صورة الشخص أمام الجار أو المجتمع بصفة عامة).
في ظل الحدث الاحتفالي الذي تعرفه الدول الإسلامية في هذا الشهر "الحرام" يعود إلى الواجهة طقس ديني ضارب بجذوره في أعماق التاريخ البشري ، إنه طقس الذبح أو النحر بما هو سلوك يُبرز إلى الواجهة تجدُّر العلاقة الجدلية بين الأسطوري- الديني و الديني- الإنساني من جهة أخرى، هذه العلاقة تتجسد من خلال ممارسة تطبيقية ترمز إلى استمرار الميثاق الديني المبني على الطاعة و الوفاء للآلهة \الإله و هو طقس تقديم القرابين، ومن جهة نظر أنتربولوجية يمكننا النفاذ إلى عُمق الممارسة لمقاربتها كما هي في الإسلام دونما الخوض في نقد القيمة الرمزية لهذا الفعل أو دونما تعكير صفو الممارسة بما هي جزء من إطار ثقافي شامل يخص الإنسان و المجتمع الإسلامي ، لكن و من جهة أخرى لن نكون مُلزمين بالتخندق ضمن أنظمة الفهم اللاهوتي القاصر و التي تفقه الفعل الديني في مستواه السطحي و تُحيل دوما إلى شرعيته الثابتة دونما الخوض في مُساءلته من خلال الكشف عن رمزيته و توافقاته الضرورية مع الراهن أو اللحظة التي ندّعي فيها عيش الحداثة ، ببساطة لأن الأنظمة اللاهوتية (الفقهية فيما يخص الإسلام) " تستمر في إهمال المقولات الأنتربولوجية و الجانب التاريخي الظرفي من السياقات الاجتماعية و الثقافية و السياسية التي كانت قد رُسّخت فيها الحقائق الإلهية المعصومة و المُقدّسة و العقائدية " {1}، و نحن هنا لا نهدف إلى الكشف عن الجانب التشريعي للقربان في الإسلام من أجل الكشف في حد ذاته كغاية نهائية، بل إن فهم السلوك القُرباني سيكون الهدف من ورائه مساءلة شرعيته أيضا و بالتالي الخوض مُكرهين فيما لا مهرب منه، أي الخوض في الشرعية القُرآنية و فهم الميكانزم الكامن وراء التشريع للذبيحة التي تصير بفعل ظروف سوسيو- نفسية شبه إلزامية إذا ما وضعناها في سياقها الواقعي المُعاش حيث يتضافر العامل النفسي و الاجتماعي (صورة الشخص أمام الجار أو المجتمع بصفة عامة).
جاحظ الأندلس ابن حزم الأندلسي ـ سعيد موزون
 حياته وشخصيته:
حياته وشخصيته:
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان(أو صفيان) بن يزيد الفارسي، وتعيد المصادر نسبه إلى أصول مشرقية، فتذكر أن يزيد هذا ى كان من موالي يزيد بن أبي سفيان، وأن جده "خلف" كان ممن نزحوا إلى الأندلس، ولعل هذا ما يفسر النزعة الأموية الواضحة في شخصية ابن حزم وفكره وأدبه.
ولد ابن حزم سنة 384هـ/ 994م، في قرطبة، إذ كان آباؤه قد انتقلوا إليها وحققوا فيها مكانة مرموقة، فقد كان أبوه أحمد بن حزم من وزراء الدولة العامرية في عهدي المنصور محمد بن أبي عامر وابنه المظفر، ثم ولي ابن حزم نفسه الوزارة عن أبيه في عهد عبد الرحمن بن هشام، ولكن القلاقل والاضطرابات التي شهدها عصره قادته إلى نبذ الوزارة والمناصب، والتفرغ لقراءة العلوم المختلفة: الفلسفة والمنطق والفقه والآثار والحديث والآداب واللغات والملل والنحل والأنساب ..
عرف ابن حزم بآرائه الفقهية الخاصة ومناقشاته أصحاب الملل والنحل الإسلامية وغيرها، وعرف كذلك باهتمامه الكبير بالمنطق والأخلاق والشعر والأدب والسياسة والخطابة والنحو والبلاغة، وكانت شهرته قد بزغت في مجال الأصول والحديث، وكان واحدا من رموز المذهب الظاهري في الفقه وهو عصره وبيئته فأوغر عليه صدور الأعداء والخصوم الذين ألبوا ضده العامة.فمُزّقت كتبه وأحرقت وهو يتحسر على ذلك ويقول مدافعا:
تجليات التعارض في قصيدة المدح عند البحتري ـ د. كريم الوائلي
 تُمثل بنية القصيدة واحدةً من القضايا التي شغلت التفكير النقدي ، وتتفاوت الدراسات في كيفية تحليلها وتفسير معضلاتها ومشكلاتها ، ويمكن تأمل بنية القصيدة من خلال منظورين ،يتأمل أحدهما البنية من جهة المتلقي ، ويتأملها الآخر من ناحية المبدع ، وأبرز من يمثل المنظور الأول ابن قتيبة الذي حاول إرجاع بنية القصيدة إلى مكونات تقع خارج النص الأدبي ، فلقد قام باستقراء ناقص للقصيدة العربية ثم عمد إلى تفسير ذلك على وفق تصور تحكمه مقولات عقلية ترد الكثرة والتنوع والتعدد إلى وحدة ذات طابع شبه منطقي، فهو يؤسس بنية القصيدة انطلاقاً من المكان، ويتطور بها على وفق مسببات منطقية تقود إلى نتائج تتوقف في النهاية عند المديح الذي يقود هو الآخر إلى الجائزة والمكافأة التي يحصل عليها الشاعر .
تُمثل بنية القصيدة واحدةً من القضايا التي شغلت التفكير النقدي ، وتتفاوت الدراسات في كيفية تحليلها وتفسير معضلاتها ومشكلاتها ، ويمكن تأمل بنية القصيدة من خلال منظورين ،يتأمل أحدهما البنية من جهة المتلقي ، ويتأملها الآخر من ناحية المبدع ، وأبرز من يمثل المنظور الأول ابن قتيبة الذي حاول إرجاع بنية القصيدة إلى مكونات تقع خارج النص الأدبي ، فلقد قام باستقراء ناقص للقصيدة العربية ثم عمد إلى تفسير ذلك على وفق تصور تحكمه مقولات عقلية ترد الكثرة والتنوع والتعدد إلى وحدة ذات طابع شبه منطقي، فهو يؤسس بنية القصيدة انطلاقاً من المكان، ويتطور بها على وفق مسببات منطقية تقود إلى نتائج تتوقف في النهاية عند المديح الذي يقود هو الآخر إلى الجائزة والمكافأة التي يحصل عليها الشاعر .
إنَّ المكان يمثل مثيراً يدفع الشاعر ـ في تصور ابن قتيبة ـ إلى ذكر آهليه، ومن ثم الانتقال إلى التحدث عن حبيبته وذكرياته معها، فهو انتقال من العام إلى الخاص، أي الانتقال من المكان إلى عموم قاطنيه، ثم الانتقال إلى أخصهم وهي حبيبة الشاعر، يقول ابن قتيبة : « إنَّ مقصّد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها، .... ثم وصل ذلك بالتشبيب فشكا شدة الوحدة وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق » [1].










