![]() يتضح تصور روبير مونتاني R . Montagneللقبيلة في كتابه البربر والمخزن، ومن خلال هذه الدراسة اتخذ قبائل منطقة سوس بالجنوب المغربي كنموذج لدراسة القبائل البربرية. وتعد نتائج هذه الدراسة من الركائز الأساسية التي اعتمد عليها المستعمر الفرنسي لاحتلاله للمغرب، باعتباره مجتمعا قبليا لما له من خصوصيات تقليدية، يصعب على المستعمر اختراقه وغزو بنياته القبلية الرافضة للتدخل الأجنبي إلى مجال عيشها، مما دفع المستعمر – تفاديا للتجربة الدموية بالجزائر - إلى بلورة إستراتجية الاختراق من خلال استخدام فرضية التعارض بين البربر والعرب.
يتضح تصور روبير مونتاني R . Montagneللقبيلة في كتابه البربر والمخزن، ومن خلال هذه الدراسة اتخذ قبائل منطقة سوس بالجنوب المغربي كنموذج لدراسة القبائل البربرية. وتعد نتائج هذه الدراسة من الركائز الأساسية التي اعتمد عليها المستعمر الفرنسي لاحتلاله للمغرب، باعتباره مجتمعا قبليا لما له من خصوصيات تقليدية، يصعب على المستعمر اختراقه وغزو بنياته القبلية الرافضة للتدخل الأجنبي إلى مجال عيشها، مما دفع المستعمر – تفاديا للتجربة الدموية بالجزائر - إلى بلورة إستراتجية الاختراق من خلال استخدام فرضية التعارض بين البربر والعرب.
إن ما يهمنا اليوم، نحن كباحثين في ميدان العلوم الاجتماعية ليس الغاية السياسية للمستعمر من دراسة روبير مونتاني، بل تلك الحقيقة الموضوعية لواقع القبيلة البربرية وخصوصياتها الثقافية و الاجتماعية التي تتضمنها هذه الدراسة. لهذا، يجب أن نكون في غاية الحياد و تجنب العاطفة، و استقراء ما هو مفيد علميا في قراءتنا لمثل هذه الدراسة التي كانت خلفية سياسية للاحتلال الفرنسي، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأهمية المنهجية التي تتسم بها هذه الدراسة، حيث شارك و لحظ عادات و تقاليد القبائل و نمط عيشها، يمكن اعتبار ذلك بمثابة العمل الانثروبولوجي و الاثنوغرافي.[i]
حلقات حول النوع الاجتماعي ( الجندر ) : تقديم حول ماهية النوع الاجتماعي ( الجندر ) ـ ذ . رشيد اوبجا
 برز مفهوم الجندر le genre أو النوع الاجتماعي بصورة واضحة في بداية السبعينيات من القرن الماضي. وهو مخاض فلسفي و فكري للحركات النسوية و نتاج نضالاتها . وأول من حدد مفهوم النوع من وجهة نظر نسوانية ، هي" ان أوكلي" سنة 1972، فقد ميزت بين الجنس و النوع ،" فكلمة الجنس تحيل على الفروق البيولوجية بين الذكور والإناث ، و إلى الفرق الظاهر بين الأعضاء الجنسية ، وكذا إلى الفروق في ارتباطها بوظيفة الانجاب. أما النوع، فهو معطى ثقافي يحيل على التصنيف الاجتماعي ( مذكر/ مؤنث) " (1)
برز مفهوم الجندر le genre أو النوع الاجتماعي بصورة واضحة في بداية السبعينيات من القرن الماضي. وهو مخاض فلسفي و فكري للحركات النسوية و نتاج نضالاتها . وأول من حدد مفهوم النوع من وجهة نظر نسوانية ، هي" ان أوكلي" سنة 1972، فقد ميزت بين الجنس و النوع ،" فكلمة الجنس تحيل على الفروق البيولوجية بين الذكور والإناث ، و إلى الفرق الظاهر بين الأعضاء الجنسية ، وكذا إلى الفروق في ارتباطها بوظيفة الانجاب. أما النوع، فهو معطى ثقافي يحيل على التصنيف الاجتماعي ( مذكر/ مؤنث) " (1)
وتخلص (أوكلي) إلى القول بأن النوع الاجتماعي هو بمثابة "الجنس الاجتماعي" انطلاقًا من قدرته على التغير بحسب الزمان والمكان.
إن النوع الاجتماعي يشير إلى المكانة التي يحددها المجتمع للرجل والمرأة في جميع مراحل حياتهما بصفتهما ذكرًا أو أنثى. وهو بذلك يختلف عن الجنس الذي يحيل على الخصائص والصفات البيولوجية والفيزيولوجية التي يتحدد الذكور والإناث على أساسها.
وتعتبر كل من الباحثتين الأمريكيتين " جوديث بتلر " و " تيريزا دو لورتيس " في أبرز أعمالهما Gender trouble : Feminism and the subversion of identity(1990) و Technologies of Gender (1987) أن النوع الاجتماعي هو ، قبل أي شيء ، شكل من الأداء performance ، وهو بالتالي أساسي في فهم تشكّل الهويات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء والرجال.
انطلاقًا من هذا المصطلح يمكننا فهم بعض السلوكيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء أو الرجال في مجتمع محدّد في سياق عملية تأكيد للهويات المتوقعة (الحاجة أو اللجوء من قبل بعض النساء إلى التبرّج أو انتقاء ملابس معيّنة أو المغالاة في أدوار الأمومة وربة المنزل لتأكيد أنوثتهن ، أو من قبل بعض الرجال إلى تبني سلوك حازم أو في بعض الأحيان عنيف مع الشريك أو أمام الأطفال لتأكيد ذكوريته).
المثقّف العربي في الغرب ـ عزالدين عناية
 ثمة كوكبة مهمّة من مثقفي البلاد العربية تتوزع على جملة من البلدان الغربية، باتت تلعب دورا معتبرا في الحراك الثقافي الحاصل بين الثقافتين. يطبع اهتماماتها انشغال بقضايا المثاقفة بكافة أبعادها وآثارها، ناهيك عمّا لها من انعكاسات على الجانبين. ونقصد بالأساس فئة المثقفين الذين اختاروا المكوث الطوعي في الغرب وليس المثقفين العابرين، الذين اقتضت ظروف عملهم، أو دراستهم، أو ما شابه ذلك الإقامة المؤقتة فيه. من هذا الباب سنسلّط الضوء على شريحة مَن صاروا مواطنين غربيين، أو من نشأوا في أحضان تلك المواطنة مع استبطانهم لمكوَّن حضاري عربي. فأية هوية حضارية تميز هؤلاء وأي دور وظيفي لهم في ظلّ تقلص فرص التواصل مع بلدان المأتى التي هجروا التفاعل المباشر معها وتنامي نشاطهم في بلدان المهجر التي باتوا يعيشون بين أحضانها؟ فأن يكون المرء عربيا ثم يغدو غربيا، أو أن ينشأ بالمولد غربيا ويستبطن رأسمالا ثقافيا عربيا (في حال مواليد المهجر) ليس أمرا متناقضا، بوصف الغرب هو جملة تراكمات ثقافية تتداخل فيها انتماءات حضارية متنوعة وليس مكوَّنا مغلَقا يجبّ ما دونه. فالغرب أتون تنصهر في جوفه جملة من التقاليد الثقافية، ما عاد بمقدور الرؤى المنغلقة ادعاء نقاوته الوهمية، أو الحديث فيه عن نموذج مفارق ينبغي ملاحقته والمقايسة عليه، بل هناك صيرورة ثقافية متحركة هي ما يشكّل هوية غرب ما بعد الحداثة. إضافة أن المثقف الكوسموبوليتي، المتحرر من تصلب الهوية، والمرشَّح للتطور وأخْذ دور في ظلّ تحولات العالم الجارية، هو كائن عابر للثقافات وغير خاضع للتصنيف المعتاد المحصور بمحددات جغرافية تقليدية.
ثمة كوكبة مهمّة من مثقفي البلاد العربية تتوزع على جملة من البلدان الغربية، باتت تلعب دورا معتبرا في الحراك الثقافي الحاصل بين الثقافتين. يطبع اهتماماتها انشغال بقضايا المثاقفة بكافة أبعادها وآثارها، ناهيك عمّا لها من انعكاسات على الجانبين. ونقصد بالأساس فئة المثقفين الذين اختاروا المكوث الطوعي في الغرب وليس المثقفين العابرين، الذين اقتضت ظروف عملهم، أو دراستهم، أو ما شابه ذلك الإقامة المؤقتة فيه. من هذا الباب سنسلّط الضوء على شريحة مَن صاروا مواطنين غربيين، أو من نشأوا في أحضان تلك المواطنة مع استبطانهم لمكوَّن حضاري عربي. فأية هوية حضارية تميز هؤلاء وأي دور وظيفي لهم في ظلّ تقلص فرص التواصل مع بلدان المأتى التي هجروا التفاعل المباشر معها وتنامي نشاطهم في بلدان المهجر التي باتوا يعيشون بين أحضانها؟ فأن يكون المرء عربيا ثم يغدو غربيا، أو أن ينشأ بالمولد غربيا ويستبطن رأسمالا ثقافيا عربيا (في حال مواليد المهجر) ليس أمرا متناقضا، بوصف الغرب هو جملة تراكمات ثقافية تتداخل فيها انتماءات حضارية متنوعة وليس مكوَّنا مغلَقا يجبّ ما دونه. فالغرب أتون تنصهر في جوفه جملة من التقاليد الثقافية، ما عاد بمقدور الرؤى المنغلقة ادعاء نقاوته الوهمية، أو الحديث فيه عن نموذج مفارق ينبغي ملاحقته والمقايسة عليه، بل هناك صيرورة ثقافية متحركة هي ما يشكّل هوية غرب ما بعد الحداثة. إضافة أن المثقف الكوسموبوليتي، المتحرر من تصلب الهوية، والمرشَّح للتطور وأخْذ دور في ظلّ تحولات العالم الجارية، هو كائن عابر للثقافات وغير خاضع للتصنيف المعتاد المحصور بمحددات جغرافية تقليدية.
قراءة في مؤلف بيير بورديو: الهيمنة الذكورية ـ هشام أبولعيد
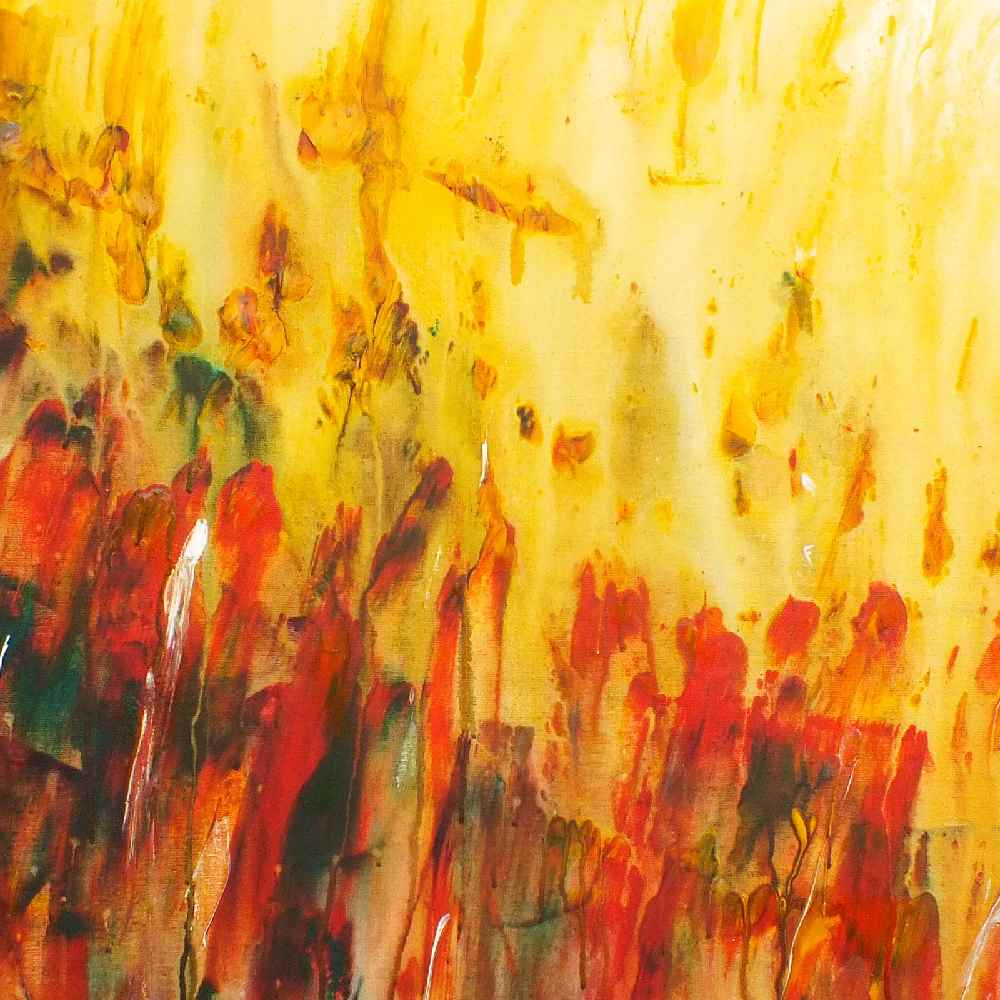 ".. المجتمع مثل كائن للتآمر، يبتلع الأخ الذي يملك الكثير منّا مبررات احترامه في الحياة الخاصة، ويفرض مكانه ذكراً متوحشاً ذا صوت يزمجر وقبضة قاسية (...) يستمر في طقوسه الصوفية، وقد تحلى بالذهب والأرجوان وتزين بالريش المتوحش، متمتعاً بالملذات المشبوهة للسلطة والهيمنة، فيما نحن نساؤ(ه) يُغلق علينا في منزل العائلة، من دون أن يُسمح لنا بالمشاركة ". V. Wolf
".. المجتمع مثل كائن للتآمر، يبتلع الأخ الذي يملك الكثير منّا مبررات احترامه في الحياة الخاصة، ويفرض مكانه ذكراً متوحشاً ذا صوت يزمجر وقبضة قاسية (...) يستمر في طقوسه الصوفية، وقد تحلى بالذهب والأرجوان وتزين بالريش المتوحش، متمتعاً بالملذات المشبوهة للسلطة والهيمنة، فيما نحن نساؤ(ه) يُغلق علينا في منزل العائلة، من دون أن يُسمح لنا بالمشاركة ". V. Wolf
تقديم
تمثل الهيمنة موضوعاً أساسياً انكبّ عليه بيير بورديو (Pierre Bourdieu) درساً وتحليلاً[1]، قبل مؤلفه الذي يحمل اسم "الهيمنة الذكورية"[2]بسنوات عديدة، وذلك في سياق تشريحه للعلاقات القائمة بين الأفراد في مختلف حقول العالم الاجتماعي/ المجتمع، وليس فقط في الحقل السياسي أو السلطة السياسية كاختزال سافر لمعاني الهيمنة؛ لأنّ أكثر الحقول التي لا تعلن عن نفسها كحقول هيمنة واستعباد إنّما تستثمر كلّ أدوات التخفي والاحتجاب لتمارس التقنع والمخاتلة والمراوغة والخداع.
نحن إذن أمام عنوان دال ممتد وعميق، فـ "الهيمنة الذكورية" مفهوم يختصر واقعاً قائماً لا يساهم فيه الذكور وحدهم وإنما الإناث أيضاً وبشكل لا واع، إنّه اشتراك الضحية والجلاد في تبنّي التصورات والمقولات التصنيفية ذاتها، ممّا يسمح بالحديث عن إعادة إنتاج الهيمنة والمحافظة عليها بل وتأبيدها.
بالتوقف عند مقدمة الكتاب، نجد صاحبه يقرّ بصعوبة الموضوع البحثي، ويعتبره مغامرة منه سبقها تردد كبير، لأنّه كان مدركاً ليس فقط للصعوبات التي تخترقه وإنّما للأحكام والتصورات التي تلفّه، الواعية منها واللاواعية حتى لدى كبار الباحثين. وفوق كلّ ذلك فهو مجال ظلّ محتكراً من قبل النساء في سياق امتزج فيه ما هو ذاتي بما هو موضوعي، لدى جلّ الكتابات النسائية التي أقحمت الدفاع السياسي داخل الحقل العلمي[3[ .
العلوم الإنسانية والمواطنة في زمانية متحولة ـ مولاي عبد الحكيم الزاوي
 أي موقع بات لعلوم الإنسان ضمن زمنية مطبوعة بالتحول في تفسير "عالم ما فوق الواقع" بتوصيف من الفيلسوف الفرنسي جون بوديار؟ هل أضحينا أمام خطاب مُتجاوز في تقديم مداخل علمية لفهم تشعبات الواقع الإنساني المتعدد، في سياق سطوة خطاب التكنوقراطية الماتح من عولمة اقتصاد السوق؟ كيف يُمكن للتاريخ والفلسفة وباقي المباحث الإنسانية المجاورة أن يُحصنا الذات البشرية من تطرف الواقع وغلوه؟ وهل بات مختبر العوم الإنسانية على المحك كما يقول بذلك جوزيف ستيكليتز؟
أي موقع بات لعلوم الإنسان ضمن زمنية مطبوعة بالتحول في تفسير "عالم ما فوق الواقع" بتوصيف من الفيلسوف الفرنسي جون بوديار؟ هل أضحينا أمام خطاب مُتجاوز في تقديم مداخل علمية لفهم تشعبات الواقع الإنساني المتعدد، في سياق سطوة خطاب التكنوقراطية الماتح من عولمة اقتصاد السوق؟ كيف يُمكن للتاريخ والفلسفة وباقي المباحث الإنسانية المجاورة أن يُحصنا الذات البشرية من تطرف الواقع وغلوه؟ وهل بات مختبر العوم الإنسانية على المحك كما يقول بذلك جوزيف ستيكليتز؟
أسئلة عديدة ترتسم داخل مغرب اليوم، في تفسير تموقع العلوم الإنسانية ضمن خارطة الفهم، تُبرز معها نتوءات التباعد وأنوية المغايرة، بين دولة تتمخزن، وفرد يتحرر، طارحة بسؤال ساخن، من يريد حَرْق الوضع؟
زمن جديد، بمرجعيات جديدة، يقتحم الحديقة السرية لمختبر العلوم الإنسانية، بأسئلة جديدة، يعيد رسكلة الخطاب والممارسة، بتصور مانوي، يقيم شرخا، بين قديم يترنح، وجديد لم يولد.
في التحوَل الثقافي : من ثقافة الحركة الوطنية الى ثقافة الحركة المواطنة ـ محمد مومر
 ...لا يستقيم الفعل الثقافي الجاد، بما هو بناء مستمر ضمن سلسلة متلاحقة لا تعرف التوقف،إلا باستحضار دائم للشرط الموضوعي دون أن يظل حبيسا له ، ولن يتحقق هﺬا الوعي الثقافي المبني على الواقعية وتجاوزها في الآن نفسه إلا بتجاوز كل الوثوقيات وإخضاعها المستمر للمساءلة .
...لا يستقيم الفعل الثقافي الجاد، بما هو بناء مستمر ضمن سلسلة متلاحقة لا تعرف التوقف،إلا باستحضار دائم للشرط الموضوعي دون أن يظل حبيسا له ، ولن يتحقق هﺬا الوعي الثقافي المبني على الواقعية وتجاوزها في الآن نفسه إلا بتجاوز كل الوثوقيات وإخضاعها المستمر للمساءلة .
إن اللحظة التاريخية في تجاﺬبها بين المحلية والكونية ، بين الذات والآخر، والتي أصبحت تستدعي بإلحاح ضرورة الاختلاف المولد للتنوع المثمر، تطالبنا بتنسيب الحقائق وتجاوز أوهام اليقين ، تلك التي لم يترتب عنها إلا تفريخ النسخ المتشابهة وممارسة الحجر على العقل الشعبي المبدع ، ولعب دور الوصي على الأجيال اللاحقة .
فاللحظة التاريخية لم تعد تطيق كل أشكال التصنيم وتفويض الأمر الى الكهنوت الثقافي ، ﺬاك الذي استلذ مقامه وصاغ مقاله وفق قواعد عفا عليها الزمن، تراهن على المحرّم وتؤطره دون حتى التفكير في المسموح به والمباح ، مما جعل من ثقافتنا ثقافة الممنوع التي بفعل عامل وجوب التطور والتغير، اتّسع معها مجال المسكوت عنه ، وظل يحفر أخاديد سفلية توهم بالاستقرار وتنذر في الآن نفسه بالانفجار في كل لحظة .
إن ثقافة الموت التي طفح كيلها في الآونة الأخيرة وأصبحت ظاهرة عقائدية لم تولد من فراغ ، ولم تكن وليدة تحول بالطفرة ، بل كانت نتيجة حتمية لهيمنة ثقافة المحرّم السابقة الذكر، النتيجة الطبيعية المشتقة من علّتها الثقافية . فليس للكائن المحاصر بين الاكراهات اليومية والفكر المستورد إلا سبيل التطرف شرقيا أو غربيا لتظل نفس آلية العدمية، وإوالية الإقصاء، وبناء الحقائق المطلقة في الاشتغال بوثيرة مرتفعة تفتح الغد على المجهول، مما ستصبح معه الثوابت موضع شك وتساؤل في متاهة فقدان الهوية الوطنية وتراجع الإحساس بالانتماء.
ليس الفعل الثقافي ممارسة مناسباتية ينقضي فعله بانقضاء أهازيجه ومراسم احتفاله . إنه بناء مستمر حتى ليغدو عرفا اجتماعيا يسكن اللاشعور الجمعي بقيّم عنوانها العريض الضارب في عمق المحلية المؤهلة للكونية " تمغربيت " ، تلك التي تتماهى بالوطنية فتصبح عمودا فقريا للشخصية المغربية، والتي لا تقبل المساومة أو المزايدة ، شرطها الاعتدال وأفقها التشبث بما يميزنا عن باقي الأقطار، ويرسم لنا صورة خاصة بكل قدرتها على التمسك بتاريخها وقابليتها للتكيف مع ما يمليه المستجد التاريخي .
لنا موقع جغرافي بين شمال يشرئب على الأفق الأوروبي، وجنوب له امتداد في العمق الإفريقي. لنا حمولة ثقافية شعبية خرجت من معطف الحركة الوطنية ، وأسست لثقافة المقاومة ومناهضة كل أشكال الاستبداد.
فاطمة المرنيسي: تفكّك البطريركيّة الغربيّة ـ ممدوح فرّاج النّابي
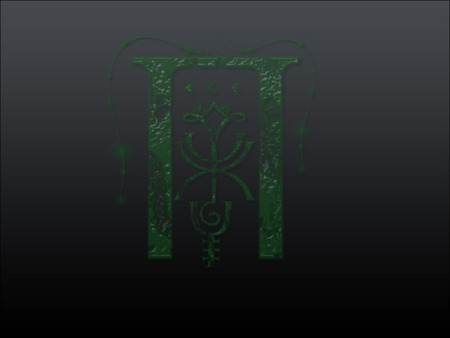 لم تعدم الكاتبة الرّاحلة أستاذة علم الاجتماع الدكتورة فاطمة المرنيسي (فاس 1940، نوفمبر 2015 برلين) الوسيلة أو الحيلة لهدم كافة التصورات التي رسمتها وَسعت إلى إبرازها وتكريسها المخيلة الغربية(1) لنساء الشرق، حتى إنّها وصلت إلى حد اعتبارها نسقًا مهيمنًا سيطر على كافة الأعمال الأدبيّة والفنيّة على اختلافها؛ كالرسم والباليه والسينما، فسعت الدكتورة المرنيسي من خلال مؤلفاتها المتعدّدة على هدم وتفكيك هذا النّسق، بل لم تكتفِ بهذا بل قامت بتقديم النسق البديل الذي كان مفارقًا للنّسق الأوّل ومناقضًا له، كنوع من التصحيح لسوء الفهم الذي كَشَفَ عن نزعةٍ استعماريّة كامنة داخلهم.(2) وهذا الدفاع عن صورة المرأة ليس غريبًا عليها، فقد شغلت قضية المرأة معظم مؤلفاتها، وتناولت كافة القضايا المُحيطة بها في كافة عصورها القديمة والحديثة.
لم تعدم الكاتبة الرّاحلة أستاذة علم الاجتماع الدكتورة فاطمة المرنيسي (فاس 1940، نوفمبر 2015 برلين) الوسيلة أو الحيلة لهدم كافة التصورات التي رسمتها وَسعت إلى إبرازها وتكريسها المخيلة الغربية(1) لنساء الشرق، حتى إنّها وصلت إلى حد اعتبارها نسقًا مهيمنًا سيطر على كافة الأعمال الأدبيّة والفنيّة على اختلافها؛ كالرسم والباليه والسينما، فسعت الدكتورة المرنيسي من خلال مؤلفاتها المتعدّدة على هدم وتفكيك هذا النّسق، بل لم تكتفِ بهذا بل قامت بتقديم النسق البديل الذي كان مفارقًا للنّسق الأوّل ومناقضًا له، كنوع من التصحيح لسوء الفهم الذي كَشَفَ عن نزعةٍ استعماريّة كامنة داخلهم.(2) وهذا الدفاع عن صورة المرأة ليس غريبًا عليها، فقد شغلت قضية المرأة معظم مؤلفاتها، وتناولت كافة القضايا المُحيطة بها في كافة عصورها القديمة والحديثة.
لكن الملاحظ من هذه الكتابات أن مصطلح الحريم أو الأحاريم شَابه تَباين كبير على مختلف العصور، ففي زمن المرنيسي وَمَن ارتبطتْ بهن من نساء داخل محيط الأسرة كان المعنى السَّلبي لهذه الكلمة هو الحاضر والمهيمن بما يحمله من معانٍ تشير للقيد والحَجْر، والتي تصل في بعضها إلى إقرانها بالسّجن والحصار، ومن ثمّ سعت النِّساء إلى التحرُّر منه على نحو ما كانت تفعل الجدِّة الياسيمن، فبقدر المعاناة التي عانتها في إطار الحريم وما أثقلها من قهر وكبت وهي تصارع الانفلات من رَبَقِ دائرته، جاء تحفيزها لحفيدتها بالتحرُّر من هذا النّسق، ومحاولة تجاوزه عبر حكايات قدمتها لها عن بطلات ألف ليلة وكيف واجهن بذكائهن وعقولهن وليس بأجسادهن أحاريمهم التي وضعن بها سواء من قبل الزوج الإنسان أو حتى الجن، وهو الدرس السياسي الذي قدمته شهرزاد لكن مع الأسف رسائلها لم تجد مَن يَسْتَقْبِلُها، وبحكايات عن نساء مِن المشرق استطعن أيضًا في العصر الحديث التمرّد على هذه الأنساق مثل الأميرة اللبنانيّة أسمهان،(3) التي شبّت عن الطوق والتقاليد والأنساق الحاكمة، بارتداء الملابس القصيرة وذات التقويرات التي تكشف الصدر، وأيضًا بإعلان العشق والغرام عبر أغنياتها التي كانت النساء على السطوح يتخذنها مَعبرًا لتحلّق أحلامهن المُجهَضة متجاوزة حدود الأحاريم.
تأثير ابن خلدون في العلماء الغربيين ـ أ . د . عبد الجليل غزالة
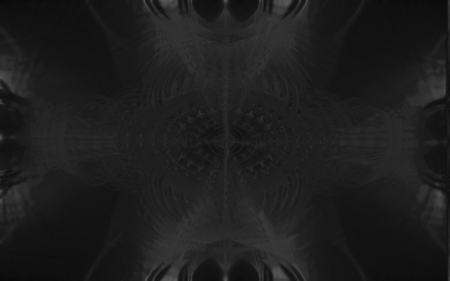 عتبات الموضوع
عتبات الموضوع
يُجَسِّدُ كتاب ( مقدمة ابن خلدون ) إنجازا علميا متميزا بالنسبة للعلماء الغربيين ، لأنه خلق بين ظُهْرَانَيْهِمْ ثورة منهجية وجعلهم يركزون على الجانب العقلاني المنطقي الذي كان مهملا عند أسلافهم ، كما أنه يمثل البداية الفعلية لعلم الاجتماع والعمران ، إذ إن صاحبه قد وظف فيه مفاهيم متفردة ما زالت لحد الآن محطَّ الاهتمام والبحث في شتى بقاع المعمورة .
لَقَدْ كان العلاَّمة عبد الرحمان ابن خلدون مُوَلِّدًا في إبداعاته ، حيث عالج قضايا مهمة طبعت عصره ، مع العلم أنه عاش في فترة تاريخية شهدت تدهور وانقسام العالم الإسلامي ، الأمر الذي دفعه إلى الاهتمام بالجانب الإصلاحي ، وتغيير منظومة الفكر التربوي ، والسياسي ، والاقتصادي ، وروح المواطنة...
اِسْتَفَادَ عدد كبير من المفكرين ، والمستشرقين ، والمؤرخين الغربيين من أعماله ، وتأثروا بفكره وانبهروا به ، لكنهم انقسموا الى طائفتين متنازعتين حول هذه الأعمال المتفردة :
أ _ طائفة معارضة : جرَّدت الرجل من هويته العربية وعقيدته الإسلامية ، زاعمة أن العالم العربي والإسلامي لا يستطيع إنجاب عالم من طينة ابن خلدون رغم كثرة النماذج المشرقة كابن النفيس ، وابن الهيثم ، والبيروني ، والرازي ، والكندي ، وابن سينا ، والفارابي ...
ب _ طائفة مؤيدة : اعترفتْ بعلمه ، ومجدت أعماله واستشهدت بها في أكبر المحافل ، والمجالات ، والدوريات ، والمصنفات العلمية والثقافية .












