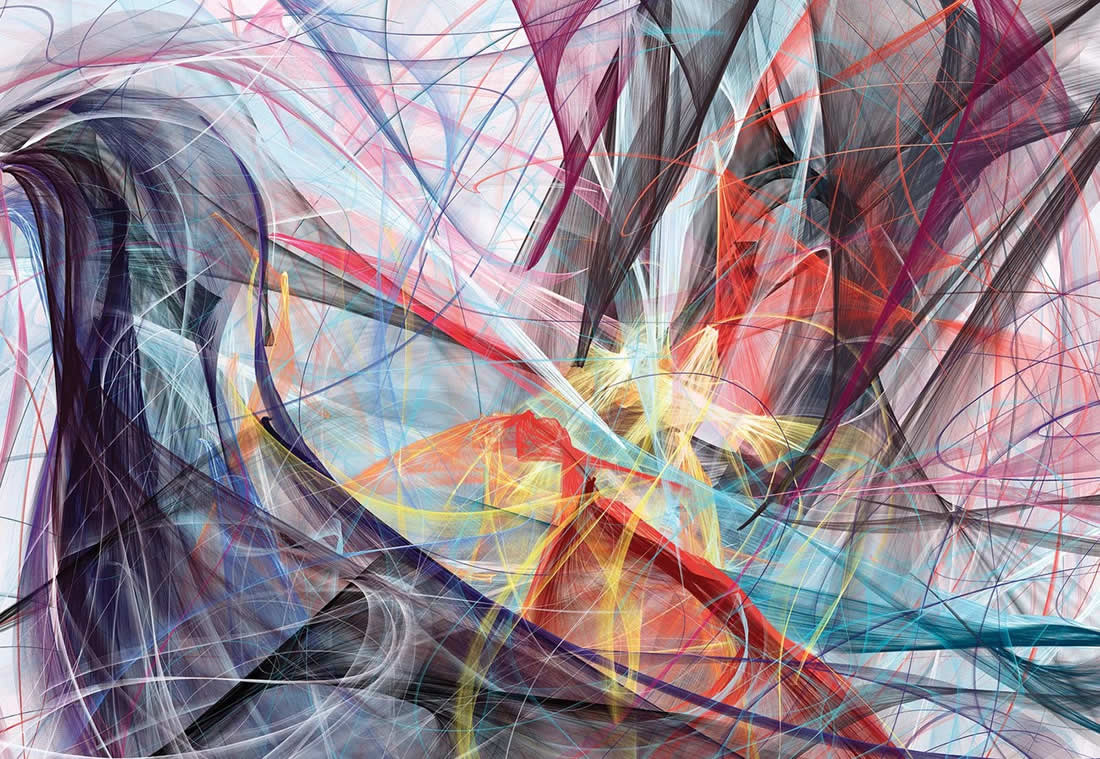إن أيّة قراءة للمجموعة القصصية " جنازة امرأة"، للقاص جواد السراوي، لا يمكن أن ثُلِمَّ بجموع التفاصيل، والأحداث الكثيرة والمتنوعة في المجموعة. وراهنية البعض منها، بل لحظيتها. فالمجموعة تعتبر ناطقة بلسان حالِنا، ومعبرة عن أبعاد وجودنا الإنساني، في كينونته وتجلياته. إن قراءتنا لهذا المجموعة، تتخذ من الحضور الفلسفي مدخلا لها، إذ أن الكاتب عَمِل في مجموعة من المناسبات وفي مختلف لحظات بنائه القصصي على النبش في التساؤلات الفلسفية التي تحرك الفكر البشري، وهذا ما بدا واضحا، بدءا من العنوان " جنازة امرأة"، فالجنازة كدلالة على الموت، تقتحم حياة الناس، على حين غفلة منهم، وهي تشكل ذلك المنعطف الذي يُفصل الإنسان عن العالم المادي الملموس، ويُقْحمه في عالم آخر مجرد وغير مرئي، ناهيك عَمّا تخلفه من أثار نفسية واجتماعية على ذوي الفقيد(ة).
في الجنازة لا معنى فوق معنى الموت، ولا حديث إلا عنه، يجعلنا نتناسى الحياة وما تَعُج به، ونتناسى تقلبات الدهر وما يمكنه أن يفعل بالإنسان، ونتذكر في ذات الوقت الغاية الأسمى التي لأجلها خُلِقْنا، نعيد ترتيب أولوياتنا في الحياة ونفكر فيما نحن مُقصرون فيه، وبذلك، فالموت يقدم للمرء درسا في الحياة قبل أن تنْسَلَّ منه. هكذا، فالموت تجربة وجودية، وما حديث الكاتب عن الفيروس كوفيد 19 وما تمخض عنه، من نقاشات وسجالات على مستوى القنوات الفضائية، ومن داخل البيوت، وما توّلد عنه من مآسي وأحزان، وما رافق ذلك من دراسات وأبحاث علمية، للحد من خطورته إلا دليلا قاطعا على حب الإنسان للحياة وتمسكه بها،وغير بعيد عن ذلك، يُطلعنا القاص، عن تجربة وجودية جديدة، تتجلى في التمرد باعتباره إعلانا عن العصيان وعدم التصرف تحث الإكراه والإجبار والإلزام، فقد عالج الاستاذ جواد هذه التيمة بأسلوب أدبي ماتع، مصورا بذلك نظرة الأكاديمي إلى مسألة الانفتاح اللغوي والثقافي ومساوئ التقوقع حول اللغة، وهنا نستحضر القيم الإنسانية الكونية الرامية إلى ضرورة احترام الآخر، والنظر إليه باعتباره ذاتا واعية مفكرة، لها الحق في الوجود، بعيدا عن التعصب ونبذ الآخر المخالف ثقافيا ولغويا، معتبرا اللغة والثقافة وجهان لعملة واحدة[1]. لاسيما ونحن على علم بأن اللغة والثقافة خاصيتان إنسانيتين، الواحد منهما يتضمن الآخر، إذا لا يمكن فهم الثقافة بدون لغة، ولا يمكن انتاج اللغة في غياب الثقافة. ففي ظل ما تحدثنا عنه حتى الآن، نجد أن ثنائية الأنا في مقابل الآخر، حاضرة بقوة في متن ما كتبه القاص، إلا أن ذلك يظهر بشكل صريح في خضم حديثه عن النادلة وتصويره لمجموعة من المشاهد الإنسانية داخل مسرح المقهى، هذا الفضاء العام الذي يتسع لمناقشة كل القضايا وفي مختلف المجالات سواء على المستوى الاجتماعي، حيث سيادة التراتبية، إذ نجد الهشاشة والفقر والحرمان، في مقابل الثراء والغنى والرفاهية، العلم والمعرفة في مقابل الجهل والأمية، الهدوء والسكون في مقابل الفوضى والضجيج، قهوة سوداء في مقابل براد شاي بالنعاع ... فهناك تفاصيل كثيرة منها تسخير الجسد الأنثوي، لا باعتباره حاملا لذات إنسانية مفكرة، وإنما كبعد بيولوجي للاشتهاء الغريزي " تجئ النادلة وتمشي، لم يحدث أن سحبت ابتسامتها، والمارة كانوا يغتصبونها بمحاجرهم، كانوا يتفنون في الغمز واللمز والهمز[2]"، إلا أن هذه المشاهد سرعان ما تنمحي بمجرد مجيء النادل النحيف. لينتقل بنا الكاتب إلى الكلام عن طلقة تائهة وهي القصة التي تجسد ذلك الصرع الحاصل في الفكر الإنساني بين لحظة يقظته ولحظة نومه، أو بالأحرى في حلمه، فهنا، تحدث السارد عن تلك العلاقة غير المتكافئة بين الزوجين، حيث المرأة تعكر صفو مزاج الزوج، ولا تترك له مجالا للاستمتاع والراحة، الأمر الذي دفع الزوج للتفكير في الانتقام وارتكاب جريمة القتل في حق زوجته، عن طريق مسدسه أو عن طريق الوسادة، بيد أن صراخ الطفل أيقظ الزوجة من حلم لا تعرف كم دام. فالحلم كأحد موضوعات علم النفس تحدث عنه فرويد وتلميذه كارل يونغ وإيريك فروم، ويقول هذا الأخير أن هناك ترابط بين النشاط الذي نقوم به وبين عملية التفكير اللازمة لهذا النشاط أي أن الفرق بين الوظائف الحيوية أثناء اليقظة وأثناء النوم هو الفرق الذي يميز، في الواقع، صيغتين من صيغ الوجود، فإن مهمة الإنسان المستيقظ تتلخص في الحفاظ على بقائه. ولذا فهو يخضع للقوانين التي تحكم الواقع، في حين أن الإنسان النائم لا يهتم أدنى اهتمام بإخضاع العالم الخارجي لغاياته ومآربه. إنه يصبح عاجزا، ولذا سُميّ النوم بحق شقيق الموت". وفي ذات المضمار، تمت مناقشة قضايا وجودية تكرس ما ينبض به الشارع المغربي، وما ينخر بنيته المتهالكة من فقر وقلق وبطالة وألم ومعاناة راسما بذلك تلك الخيوط العنكبوتية المتشابكة التي تستعصي على الحل في غياب إرادة حقيقة صادقة وثابتة، ليخرج الإنسان من هذه الانكسارات التي لم تأب أن تنتهي، سواء تعلق الأمر بتلك بالفتاة العشرينية التي بكت بحرقة جراء فقدان الكلبة " تيرا"، لدرجة أن الدموع التي تهاطلت من عينها غيرت من تضاريس ووجها، أو ذاك الأستاذ الجامعي الذي فشل في كتابة القصيدة، رغم ما أوتي من بلاغة، واخياره للبحر والروي والموضوع ...ففي ظل كل هذه التيمات الموضوعاتية، يجرنا المؤلف لإشكال فلسفي مُغل في القِدم ألا وهو الحقيقة في مقابل الوهم، التي أخبرنا نيتشه عنها يوما قائلا:" إن الحقيقة أوهام نسيان أنها كذلك" ما ينِمُ على أن الحقيقة ما هي إلا مجموعة من الاستعارات والمجازات التي صارت بعد طول استعمال وكأنها حقيقة، ولو أن الكاتب ها هنا، يُحدثنا عن تلك الهوة أو الفجوة الموجودة بين الفكر والواقع، أي أن الشيء الحقيقي لا يعكس ما هو منقوش في الفكر كخاصية وفعالية بشرية، إذ أنه أي – الفكر- يبقى شاردا كلما أدرك أن نظرة ذات أخرى تحملق فيه، حيث يُشيئ ويُفرغ من مقوماته الأساسية المتجسدة في الحرية والإرادة والفعل ... فالنظرة يمكنها أن تجعل المرء يتصبب عرقا إما خوفا أو خجلا وهذا ما تدل عليه العبارات التالية ( جلسا في الطاولة نفسها؛ ادعى القراءة؛ أخذته قشعريرة؛)[3] . فهاته الصور ركبت في قالب فني ذكي، يجعل الخيال الإنساني منشرحا، أخذا من العالم ما فوق المحسوس مادة غنية له، غير مبالٍ بما يروج على مستوى الواقع، وهو ما يجعلنا نتساءل هل الفن التشكيلي قادر على خلق التماهي التام والتطابق بين الناسخ والمنسوخ عنه؟ وهل الفن يحاكي الواقع أم يبقى إبداعا لا صلة بينه وبين الواقع؟ وهل الريشة فعلا تطاوع الرسام فيما يتغيا رسمه ؟ كل أسئلة ذات عمق فلسفي نترك الإجابة عنها لعبد الله. لقد عمل الكاتب على سبر غور الواقع الاجتماعي، مبرزا معضلاته اللامتناهية، منتقلا بين موضوعات التحرش ونظرة الذكور للجنس الآخر عادة، أو نظرة الإناث أنفسهن لذواتهن، موضحا تلك النظرة التقليدية الرامية إلى كون مكان الفتاة في المطبخ، بخلاف الذكور، مستعرضا قصة ريم الفتاة الطموحة التي ترغب في استكمال دراستها، ورؤية الأب سي المدني للأمر، حيث يجد نفسه محصورا بين رؤيته هو للأمر ونظرة المجتمع له لاسيما في المجال القروي، غير أنه انتصر في الأخير إلى رغبة ابنته، وعلى نفس الخطى لو أن الأمر هذه المرة يتعلق بنون النسوة، قامت مي صفية أن تقف إلى جانب ابنتها مؤمنة بقدرتها على تحقيق ما تصبو إليه، وسخرت إمكاناتها البسيطة لأحلام، حتى يتسنى لنا، بلوغ مسعاها، وهو ما تأتى لها فعلا، إذ تفوقت في دراستها وباتت محاضرة في كبريات الجامعات[4]، ليسترسل الكاتب في قصصه، مبينا اللعنة التي طالت العاشقين المبعدين من القرية، وهنا يثبت السارد بشكل مضمر، نظرة بعض أهالي القرية لمسألة الحب والتعبير عن المشاعر، ليس لعدم اعترافهم به، وإنما لكونه يُقمح ضمن الموضوعات المسكوت عنها، والتي لا يحق الكلام عنها خارج مؤسسة الزواج، هكذا فاللعنة تصيب الأجساد التي لا تمتلك أدنى شروط النظر والتأمل، أي إعمال العقل لفهم وتحليل بل وتفسير بعض القضايا التي تصادفنا، أضف إلى ذلك أن الحالمون وحدهم يعيشون في الخيبات والخسارات[5] وعلى حافة العشق استحضر المؤلف للعلاقة اللا متكافئة " قلبه كان مخلصا لها منذ مدة، هي لم تراع ذلك، أو تناسته لا يهم"[6]، العشق، إنه الأخ الصغر للحب. وابن الهيام والتوأم الأكبر للإعجاب، بمثل هكذا كلام، يستبطن الكاتب لتلك القضايا الباطنية، لأنها تعبر عن الجانب الجواني في الشخص، ما يجعله يبحث عن أجمل الألفاظ والعبارات، وأكثرها استمالة للمستمع، الأمر الذي يفقد تلك الأحاسيس قيمتها وبريقها ورونقها، لأنها ليست من موضوعات العقل المحض بتعبير إيمانويل كانط.
يظل العمل الذي قدمناه في هذه القراءة متواضعا جدا، لا يلامس إلا نزرا يسيرا من القضايا التي يثيرها الأستاذ جواد السراوي، وفي عمله هذا، والإلمام بعمل أدبي أصيل مثل هذا، يحتاج إلى نفس الطويل والارتواء حد التخمة من قواعد اللغة وفنون البلاغة، ومواكبة أهم الأعمال التي جادت بها القريحة الأدبية سواء في مجال القصة أو الرواية أو في كل الأجناس الأدبية الأخرى. وهذه القراءة لا تغطي إلا جانبا من جوانب هذه الباقة المعرفية الأصيلة، التي تجر هموم الشعب وقضاياه المتشابكة والمعقدة.
[1] " جنازة امرأة" للكاتب القاص جواد السراوي ، الطبعة الأولى 2020، ص 10
[2] جنازة امرأة، ص 14
[3] ص 29/30
[4] نفس المرجع ، ص 51.
[5] نفس المرجع ص 58.
[6] نفس المرجع ص 62.