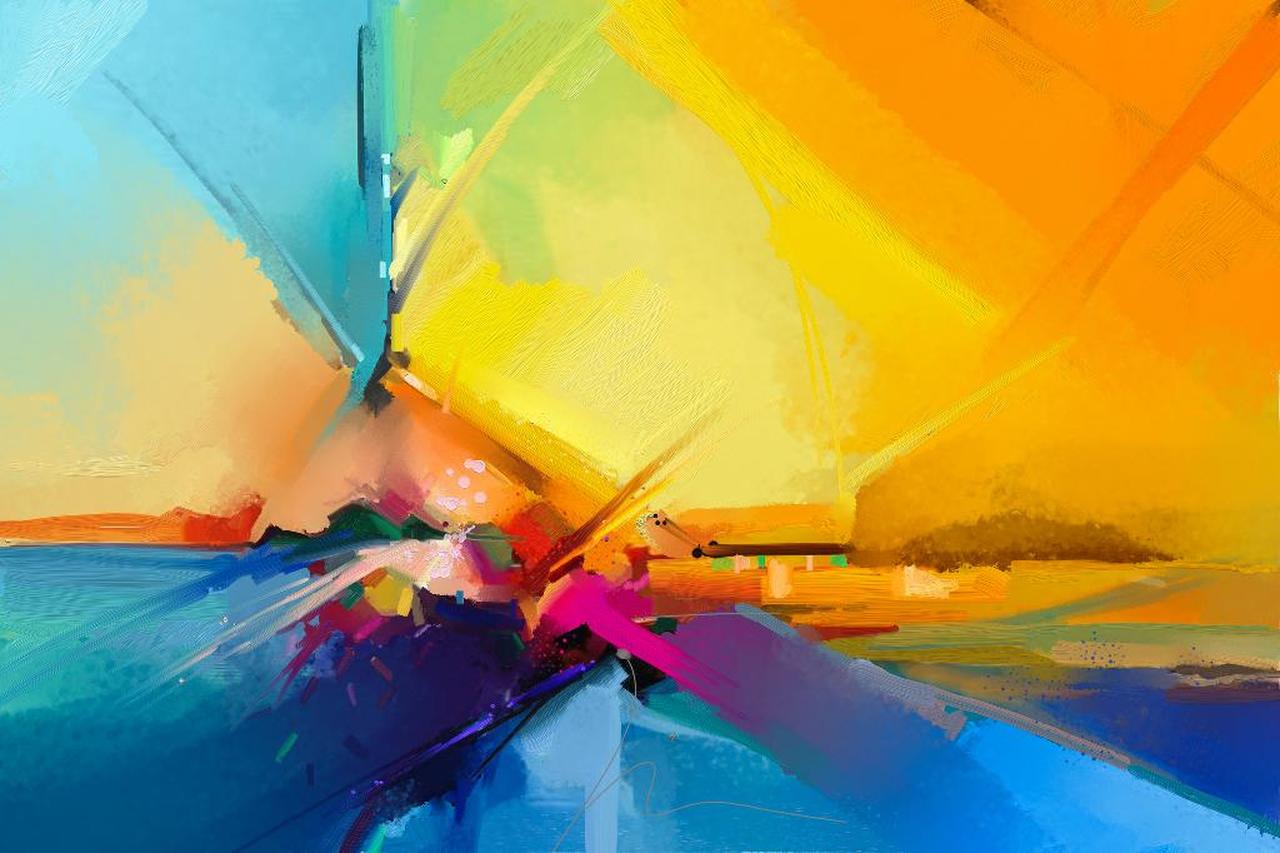من حافّة الدّنيا إلى نهايتها أطلّت رشيدة الشارني على عُمق الوجود و عذابات الحياة و انتهت الإطلالة بلحظة خشوع و تراتيل أشبه بالصّدى و الصرخة المتبقيّة ألماً و احتفاءً بمن مضى إلى الأبد . بين أسرار البدايات في "الحياة على حافة الدّنيا" و رعب النهايات في رواية "تراتيل لآلامها "مسافة في الزمان و المكان و التّجربة ، دورة في تبدّل الأحوال تشبه دورة العمر و الوجود . تتطلّع العين إلى جبال الكاف العالية و ترنو إلى مجاوزة التخوم و اكتشاف الأسرار ثمّ ينزل طفلٌ إلى الدّنيا بقدرة قادر ، من هذه الحكاية البسيطة ننتهي إلى قبرٍ مهجورٍ بين نخلة و سنديانةٍ في مكان قصيٍّ من مقبرة الجلاّز . و بين شوق البدايات و رُعب النهايات تخطّت السّاردة الحافّة و تشكّلت الدّنيا و لكن هذه المرّة في شخصيّة "دنيا" فتاة في عنفوان العمر مثقفة تحبّ الرقص و الغناء و الكتابة و معها تشكّلت رواية رشيدة الشّارني .
رواية مستطيلة الحجم تشبه المطويّات و كتب الجيب القديمة و أسفار التّوراة و كأنّها قُدّت لتُحفظ في القلوب قبل حفظها في الرفوف و المكتبات و غلافها مطويّ يُخفي ثلثه سيرة الكاتبة و صورتها أمّا صورة الكتاب فنرى هيكلاً آدميّا يقف بقفاه في وجه القارئ و لا يبدو من ملامحه شيء إلاّ يدٌ تمتدّ و كأنّها لفتاة في ربيع العمر ترتدي عباءة حمراء أقرب إلى رداء الرّهبان . اليد الأنثويّة النّحيلة تمسك فانوساً يُنير عتمةَ سهوبٍ خضراء تبدو كالأمواج ثمّ تمتزج خضرتها بالسّواد ، فتكوّن خلفيّة ذات خضرة داكنة . في الأعلى ينتصب العنوان ليكسر بعضاً من العتمة الخضراء و فوقه اسم الكاتبة بالأحمر فيرتدّ بنا فجأة إلى لون الرّداء . هذا التّشكيل الوظيفيّ للصّورة و العنوان يمثّل عتبة نصيّة أوليّة تبعث بشفرات و ألغاز تستثير أفق انتظار القارئ وهو يقتحم عالم الرواية و بمجرّد الانخراط في استراتيجيّة التقبّل الأولى من الصورة و العنوان تواجهنا الأسئلة تباعاً : "تراتيل لآلامها " ، من تُراه يكون ضمير الغيبة المؤنث المفرد في المضاف إليه ؟ و إلى من يُشار به يا تُرى ؟ هل إلى صاحبة الرّداء في الصورة أم إلى شخصيّة مستكنّة في أفق عالم الرواية أم إلى الكاتبة باعتبارها امرأة هي الأخرى ؟ و هل يُحيل ضمير الغيبة على امرأة بعينها أم أخرى مجرّدة كقيمة رمزيّة مثلا ؟ و بنفس الهاجس يُخامرنا سؤال التّراتيل فمن المُنشد يا تُرى ؟ و إن كانت كلّ القرائن تحملنا إلى تلك الفتاة ذات الرداء الأحمر و الشبيهة برجال الدين المسيحيين و الرّاهبات يُفاجئنا سؤال الدلالة : هل نخصّ الآلام بالتّراتيل ؟ و إلى أيّ مرجعيّة تحملنا هذه التّراتيل و التّرانيم ؟ هل هي تراتيل طقوس العبادة و الموت و الصلوات المسيحيّة أم تلك السوّر القرآنيّة التي تُقرأ على الميّت مغفرة و رحمة ؟ فالسّؤال يحملنا إلى تحسّس ملامح السّياق المُلغز في الصورة و العنوان : هل نحن في حضرة قُدّاس مسيحي أم طقس شبيه بصلاة الغائب في الموروث العربي الإسلامي ؟ فالسياق الحاضن للصّورة و العُنوان لا يمنح نفسه للتمثّل بسهولة و تظلّ مفاتيحه بيد السّاردة كما للكاتبة رشيدة الشارني وحدها الأعلم بسرّ هذا التّداخل و التّعالق المرجعيّ الغريب فلا ندري إن كانت ترانيم الإنجيل أم تراتيل القرآن ؟ و بين هذا و ذاك يظلّ الصّوت بلا ملامح و لا يُشير إلى عقيدة بعينها و كأنّه صرخة الكون و الحياة وهي تُطلّ على حقيقة الدّنيا .
الرواية ذات بنية انفجاريّة مُتشعّبة[1] شبيه بالقُنبلة العنقوديّة أو بضربة البيغ بانغ أو الانفجار العظيم الأوّل . تبدأ بموتٍ و صوت فتاة تبحث عن مكان شاغرٍ لقبر امرأة مجهولة التّاريخ في مقبرة الجلاّز . لا نعرف شيئا عن الفتاة و لا عن المرأة الّتي مضت و لا عن أسباب الموت . يبقى كلّ شيء مؤجّل إلى حين. كلّ ما سنلتقطه شبيه باللغز أو بالشفرة الّتي ستهدينا إلى الحلّ : هو أنّ المرأة المتوفّية سترقد في الجلاّز بمكان قصيّ "بين سنديانة و نخلة " . تحاول السّاردة في الفصل الأوّل أن ترمي شفراتها و ألغازها بشيء من الترميز الغريب و كأنّها تعمل بقاعدة تشيكوف الذهبيّة المأثورة : "إذا دقّ الكاتب مسماراً على الحائط فاعلم أنّ البطل سيشنق على ذلك المسمار" . و كما الأفلام البوليسيّة و قصص الألغاز الّتي تبدأ من نهايتها تبدأ الحكايات في التّناسل و الانفجار لينشأ الكون الرّوائي من حكايات كالجزر المتناثرة و ما على القارئ إلاّ أن يلُمّ شتاتها و يعقد نظامها . في سياق حوار في الفصل الأوّل حول مشاقّ البحث عن مكان لقبر شاغر للمرأة المتوفاة يقول زوجها سعد الحاج مخاطبا العامل في المقبرة "من فضلك يا ولدي ، جرب البحث هناك قرب السّور ، و إلاّ سأضطرّ على دفنها في كدية السّلطان" . فاسم العلم " كدية السلطان" موتيف[2] سردي قادح لانفتاح عوالم مخفيّة كامنة في الذّاكرة و الصّدور . فهو وحدة سرديّة بسيطة و أوليّة تفتح أفق الاسترجاع و الارتداد[3] و تذهب بنا إلى أغوار الماضي فنسافر إلى جبال و غابات بني مطير في أقصى الشّمال الغربي بحثاً عن قبر مهجور للجدّ الأوّل والد سعد الحاج و منها تتوالد حكايات أخرى عن الحرب العالمية الأولى و زمن الاستعمار و معارك يوغرطة و الكاهنة التي يشهد بها المكان . فداخل تقنية الاسترجاع تنهضُ علميّة التّضمين[4] في السرد الشبيهة بالدّمى الروسيّة ثمّ سرعان ما تنغلق حتّى لا يسيح القصّ و تنفرط حبات العقد إذ ستظلّ المرأة الراقدة بين شجرتين هي مركز الاهتمام و الاستقطاب في البرنامج السردي . كما سترمي الساردة بموتيف ثانٍ أشبه بشفرة اللغز عندما يسأل حفّار القبر سعد الحاج عن سبب اصطحاب ابنته إلى المقبرة و التّعويل عليها فيقول له : "ألم تُنجب المرحومة ذكوراً ؟ " فيُجيب "بلى ، لقد أنجبت المرحومة ثلاثة ذكور ، أصغرهم مسجون ، و أوسطهم مفقود و أكبرهم مقهور " و يسكت سعد الحاج و تسكت معه الساردة و يبقى السرّ مُعلّقا في غيب الأحداث المستكنّة في عالم الرواية . و نحن نتلمّس الطريق إلى فكّ خيوط لغز "المقهور" و "المفقود" و "المسجون" تظلّ الساردة تلعبُ معنا لعبة الألغاز كما لعبت "دنيا" الأحاجي مع والدتها خضراء في الماضي السّحيق .
بداية من الفصل الثّاني تبدأ السّاردة حكايتها من أولى الحلقات و هي تفكّ الألغاز شيئا فشيئا عن سرّ الجسد المقبور في الجلاّز و حكاية الابن المسجون و الآخر المقهور و الأخير المفقود . فتبرز شخصيّة "خضراء الجباليّة" و أصولها البدويّة و تتكشّف أسباب سجن الشابّ "غيث" بشيء من التّقسيط المُثير ثمّ ارتدادٌ إلى الماضي القريب للنّبش في سيرة الابن الثاني المقهور "منصف" و قد انتهى به المطاف "على ضفاف سبخة السيجومي مع السّكارى و البطّالة و المسطولين و المُشرّدين" ثمّ يطفو فجأة صوت السّاردة "دنيا" وهي تستعيد فتنة البدايات مع حكايات الأمّ "خضراء" عن بطولات الكاهنة و تغريبة بني هلال ثمّ طالبة حالمة بالجامعة فمعلّمة بقرية سرا الرّيح بأقصى الشمال الغربي فقصّة حبّ مع الكولونيل "الصادق" لتنتهي إلى نقل عذابات الانتظار على بوابة السجن المدني بصفاقس ثمّ ينهضُ قادحٌ أخير من خلال سؤال وارد على لسان الأمّ خضراء وهي تحتضر فتقول "فين الأولاد ؟ " فيظطلع هذا "الموتيف" السردي الأخير بملء انتظارات القارئ حول قصة طارق المفقود و الذي اختفى في مكان مجهول بعد "حرق" على قوارب الموت .
تنتهي الرواية و قد خرجت "دنيا " من أقبية وزارة الداخلية ، تجد نفسها وسط شارع بورقيبة ، يخامرها الرحيل و لكن ... ثمّ يتكثّف الرمز فجأة و يتسلّل إلى ثنايا الحكاية فترى الساردة غرابيب سود تسقط فتغمرها النشوة و ينطق تمثال ابن خلدون أخيرا .
بين عمليّة الاستباق و الارتداد في زمن السّرد و تقنية القطع و الإرجاء في الكشف عن أفق الأحداث تتحقق متعة التلقّي و يتّسع أفق انتظار القارئ وهو يُلاحق حكايات منقوصة لسدّ فراغاتها . كما عمل التّرميز الذي انفتحت به الرواية و انغلقت على الحدّ من الواقعيّة الفجّة للأحداث فما نلبث أن نجد أنفسنا في الأخير نتحرّك في مدار حكاية "خضراء الجباليّة" الأمّ و الأرض و الوطن ، تتّسع رمزيتها تدريجيا و قد نحتت الساردة هويّتها على نحو محكم عجيب ، فهي الخضراء خضرة النخيل و الزيتون و السنديان تجمع بلونها وسطا و جنوبا و شمالا ، و من غريب المعجم أن منحت العربية اسم "الخضَر" بفتح الضّاد لجريد النّخل إضافة إلى دلالته على اللون و النّضارة ، وهي الخضراء العاشقة "لإيديث بياف" و أم كلثوم و عُليّة التونسية، وهي التي رفضت زواجا تقليديا "كقطوس في شكارة" فكسرت التقاليد و فرضت شروطها بشيء من المغامرة و التّحدّي . فهل كانت الكاتبة بذلك تنحتُ شخصيّة عاديّة من لحم و دم أم تبني ملامح وطنٍ ينزف و شعبه بعضه في المعتقلات و بعضه في المنفى و ما تبقّى مغلوب على أمره مقهور.
هكذا شكّلت رشيدة الشارني روايتها فبثّت الرّمز في ثنايا الواقع و نقلت عذابات الوطن في فترة الحكم السابق دون أن تسقط في التقوقع الإيديولوجي منتصرة بذلك لخضراء الجبالية وحدها و لا سواها . من حسن الحظّ أنّ وكالات الأسفار الأجنبيّة في عالم الرواية لم تجدْ لها فرصة للرّحيل و إلاّ لسافرت السّاردة على ضفّة أخرى و تلك المصيبة . آثرت البقاء مهما كانت الأحوال و كأنّها تقول : "إنا باقون في أرضنا لا لن تهون " إنّا باقون ما بقي النّخل و السّنديان .
[1] Divergente
[2] Motif
[3] L’analepse
[4] L’enchâssement