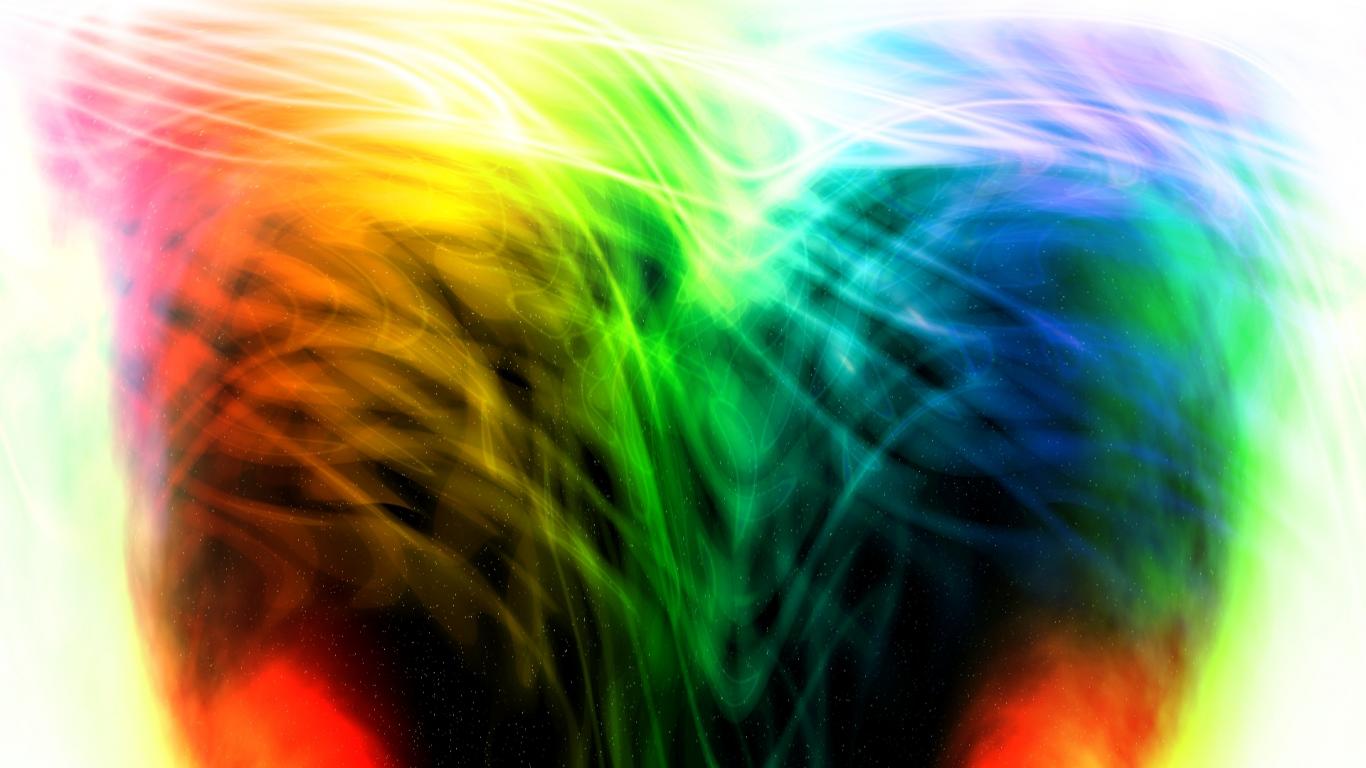كان السوق شبه فارغ يوم الجمعة، وقد ساد الصمت طيلة الفترة التي انشغلا فيها بنشر سلعتيهما وبسطها، جلس أحمد أولا غير بعيد عن السلعة، ثم التحق به إدريس، فأخذ كتابا في الوقت الذي كان أحمد يدخن سيجارته على مهل وينفث الدخان من فمه، فوق، كان كأنه يريد إيصاله إلى أبعد مكان، أو ربما يجرب قوة زفيره.
ما إن فتح الكتاب حتى انغمس فيه كليا، لا يخرج من عالمه إلا إن وقف على سلعته زبون ما.
في حدود الساعة الحادية عشر، كان قد باع حذاء واحدا فقط في ذلك الصباح كله، فالتفت إليه احمد وقال بصوت أجش:
ــ لا تعتمد علي فيما حدثتني فيه أمس.
نظر إليه إدريس من أعلى الكتاب، ثم عاد إلى ما كان فيه من قراءة، وهو يقول كأنه لم يسمعه:
ــ الدنيا كلها تجارب مؤلمة، والناس كلهم جروح. آه، لو نعري غطاء النفوس فنكشف عن حجم المعاناة! لما تحدثنا عن آلامنا إلا بقدر ما
يتحدث الأطفال عن ساعات لعبهم. لكن الألم يا أخي ضروري لصهر الإنسان وتهذيب النفوس وفرز جواهر الناس، والدليل عندي أنت، أنت يا أحمد، مهما كان ما تخفيه عني، مهما كان. وكذا مي طامو، ثم فاطمة، هي أيضا وإن كنت لا تعرفها ولا تعلم عنها شيئا فإنها غارقة في الألم.
وكذلك الأمر بالنسبة لكل الناس؛ لا نعرف عنهم إلا النزر الذي يكشفوه طوعا، أو دون وعي.
ثم قال بعد صمت:
ــ تأكد أني لن أسألك مجددا عن أي شيء، ولا في أي شيء، لا أنت ولا غيرك، فما عدت أحتمل إيذاء الناس. بإمكاني التخمين فيمن كان الجاسوس الذي أخبر مي طامو ولن ألومه، لا، ولن أحاسبه، بل لن أفكر حتى في ذلك؛ قد قرأت عن أحدهم أنه يرفض الانتقام لأنه لا يرغب أن يطارد كلبا إن عضه لينتقم منه، مع أني أتحفظ على أن أستعير لهذا الحاقد صفات الكلب، أولا، رأفة بالكلب، وثانيا، وهو الأهم، احتراما للإنسان فيه؛ تعلمت أنه علي أن أحترم الإنسان في البشر، لأني بذلك أحافظ على ماء الإنسانية في وجهي، ومن يدري؟ لعل الله أرسله من أجلي؛ فأنا بداية كنت أفكر في تغيير الإقامة، ولكني كنت أؤجل ذلك فقط، وثانيا وأخيرا، ربما لأكتشف خطيئتي، ولاسيما حجم وقعها على غيري، ولكن لا بأس، فمدبرها حكيم.
ولأن ذلك الجاسوس ـ يا أخي ـ قد أذاني في علاقتي مع مي طامو، التي كنت أوقرها حد التبجيل؛ تلك الأم التي احتضنتني، وآوتني، فكانت كالرحم الثاني الذي أحسست فيه بالأمان، لذلك كله فإني سأحتسب صبري على الأذى عند الله فقط، وكذلك لتتطهر به نفسي.
إن الصبر على الأذى أفضل مادة لتنظيف النفوس، وتطهير الأرواح، ها أنت، اقرأ، أو استمع لما يقوله هذا البطل في هذه الرواية.
أقفل دفتي الكتاب تاركا سبابته في الصفحة التي كان فيها، وذلك ليتعرف اسم صاحبه أو عنوان المؤَلَّف، لكن الغلاف كان ممسوخا، فعاد ليتلو من حيث كان موضع إصبعه:
ــ "إن أردنا إصلاحا، فأنفسنا أولى".
كان أحمد حينها قد قام ليلبي طلب زبون فصمت، وتابع قراءته سرا، ولما عاد أحمد إلى المقعد بجواره، اقترح عليه أن يجمعا سلعتهما، ويعودا إلى البيت، لأنه عازم على أن يبدأ الصلاة من يومه هذا، الصلاة التي كان منقطعا عنها منذ مدة، وعلل تعجله بالعودة إلى البيت بأن عليه أن يأخذ دشا ويقصد المسجد مبكرا حتى لا يُفَوِّت الخطبة، وأن يلحق المسجد قبل امتلائه بالمصلين.
كان إدريس منشغلا بتقطيع الخضر حين رن هاتفه، وكانت فاطمة على الخط، فرد عليها، واتفقا على الخروج معا قبيل العصر.
ألقى هاتفه بعيدا بعد انقطاع الخط، وعاد إلى طبقه؛ وضع الخضر التي قشرها وقطعها بعناية في الطاجين؛ فبدأ بدوائر البصل، وفوقها وضع فخذ الدجاج، ثم رتب قطع البطاطس والجزر وهكذا إلى أن ملأ الفراغات بحبات البازلاء الخضراء الطرية، وفوق الكل تربعت دوائر الطماطم، ثم أضاف قطعا من الثوم والقزبر، والبقدنوس، أما الملح والتوابل فخلطها مع الزيت في كأس وصبها من فوق.
وبينما كان يرفع الطاجين ليضعه على موقد الغاز المشتعل بنار مهيلة، إذ وقف عليه أحمد بجلبابه الأبيض واللوحة في يده، ولأن إدريس قد كان منشغلا بما يعد ويداه مبتلتان، فقد وضعها مسندة إلى الحائط، ثم اعتذر عن كونه لن يتغذى معه كما اتفقا، بل سيأكل الكسكس في باب المسجد.
لم يمتنع إدريس، ولكنه قال ممازحا:
ـ إذن، ستصلي الجُمَعَ فقط، وأنا أيضا، سألحق بزمر المؤمنين، الأسبوع المقبل طبعا، أما اليوم فلا زلت على جنابة، ثم أردف بنبرة الجد: إن لم تمانع يا أخي، فأعطني ذلك الكتاب الذي حدثتني فيه، ذلك الذي قلت إن فيه شعرا جميلا في الحب.
خرج أحمد في صمت وهيبة، ثم عاد وفي يده ديوان شعر، أوراقه من الحجم المتوسط، ويبدو من حجمه أنه لا يتجاوز المائة صفحة إلا قليلا.
لما عاد أحمد من المسجد وجد إدريس غارقا في الديوان، وقد اشرف على الانتهاء منه، وكان الباب مشرعا ورائحة الطاجين فواحة، فحيَّاه بيده وإطلالته وهو ماض إلى غرفته، ورد إدريس التحية، ثم قال بصوت عال:
ــ من لم يقرأ الشعر بتلذذ، فقد ضاعت حياته.
قال هذا، وهبَّ من مكانه قاصدا صديقه في غرفته، والديوان مفتوح في يده، ومن الباب بادر بالكلام:
ــ لا بد أن الدم في عروق الشعراء ليس كالدم الذي يجري في عروقنا نحن، أو إن الله قد خصهم بشيء من روحه، ثم أردف بنبرة المتيقن:
ــ والله إننا لا نحتاج إلا لأن نفرد حيزا من وقتنا، وقسطا من حياتنا للشعر، فتتحسن أحوالنا، وتتهدب أخلاقنا ونرتقي.
رد عليه أحمد وهو مستلق على ظهره،
ــ لم أر شخصا مثلك! لقد سكنتك الكتب، أما الناس هنا فلم يسكنهم إلا حب الحياة الرخيصة.
ــ الكتب يا أخي، وجدت فيها ما لم أجده في الناس وغير الناس، وأهم شيء، أنها تمنحك عمرا آخر، تخلقك من جديد، لقد سمعت أحد الطلبة يوما يقول بأن القراءة وسيلة لفهم العالم، وإذن فهم الحياة.
دار بينهما حديث مطول، وأهم من ذلك أنه عذب، لم يتطرقا فيه إلى شيء مما يخص أحمد، ولا التغيرات التي طرأت عليه مؤخرا، لم يستفسره عن السبب الذي دفعه للصلاة اليوم بالذات، والآخر لم يحدث له من أمره ذكرا.
رأى إدريس أن الخدر بدأ بالدبيب في جسد أحمد، وأن عينيه ضاقتا، ولسانه ثقل وكلامه قد نزر، فتركه مستسلما لنومه الهنيئ؛ وأقفل الباب وهو يفكر "ربما ارتاح بالصلاة، فقد قرأت في كتاب ديني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للمؤذن: " أرحنا بها يا بلال"، ثم ناجى نفسه مؤنبا:
ــ وأنت، متى سترتاح بها يا إدريس؟ إلى متى ستساير سيل الإغواء الجارف؟ إلى متى؟.
كانت ساعة اللقاء تدنو سريعا، فتناول لقيمات سد بها الجوع، وقام من مكانه تاركا كل شيء على حاله، اختار قميصا مناسبا وسروال جينز نقي، ثم رش قليلا من العطر، وخرج لملاقاة فاطمة.
في آخر المساء كانا عائدين من جولتهما، فأكلا رائبا وحلوة في أحد المحلات المتناثرة بمداخل مدينة الرباط القديمة. عادا كأنهما طائران قد صفا لهما الفضاء، وخفق القلب في جو السكينة، فكادت، لولا صخب حركية المدينة تُسمع نبضاته، كانت المرة الأولى التي تحدثا فيها عن السعادة، وقد عجبت هي لما كان يتحدث بلسان المثقفين، ولطالما كانت تقول بلسان المتعجب:
ــ أنت أفضل معرفة من بعض الطلبة الجامعيين الذين عرفتهم عن قرب، وحتى تدفع اللبس أضافت: "أولائك الذين يرتادون المقهى لمراجعة دروسهم ومطالعة الكتب".
أخبرته مرارا أنها لم تصدق أنه كان أميا!، وكان يرد عليها مكررا ما أجاب به غيرها من قبل، فيخبرها أن تعلم القراءة باللغة العربية أمر سهل لكل من امتلك الإرادة؛ إذ بمجرد معرفة الحروف الهجائية، فإن الطريق نحو فهم الكلمات التي هي أصلا قريبة من الدارجة يصبح أمرا ميسرا، طبعا إن توفر شرط العزيمة، وأكد لها أن النزوع نحو الكتاب، كان قد تملكه منذ الفترة التي عاشر فيها الطلبة الجامعيين، هناك، بفاس، خاصة أولائك المناضلين؛ ما كانوا يكفون عن القراءة، خاصة الكتب الحمراء، وكانت معارفهم، وطرق حديثهم تدهشه.
ثم عدد لها فوائد القراءة، خاصة عليه هو بالذات، لأن القراءة أكسبته مكانة بين أهل السوق، اللصوص أنفسهم لا يتجرؤون عليه، بل يوقرونه؛ رغم أنهم في البداية قد قابلوا علاقته الغريبة بالكتب بكل سخرية، لكن، ومع مرور الوقت، اكتسب هيبة وتوقيرا.
وأكثر من ذلك، إن مجرد قراءة كتاب في السوق أو بالأحرى فتحه، يجعل الزبون مطمئنا إلى البائع، خاصة وأن لرواد ذلك السوق تمثُّل سابق عن الباعة؛ حيث إن أغلبهم يتعاطون المخدرات علنا، كما تنتشر بينهم السرقة والنصب والتدليس بشكل ملفت، وما إلى ذلك مما يدفع بالزبناء إلى التعامل معهم بحذر.
وفوق هذا وذاك، قد تحصل له من القراءة فائدة عظمى، ولتأكيد قوله أقسم يمينا أنه كلما ختم كتابا إلا وأحس كما لو أنه قد وُلِد من جديد، ثم إنه قد وجد في الكتاب أبا نصوحا وخلا وفيا، وغير ذلك.
كانت تصغي إليه باهتمام بالغ أو مبالغ فيه، أما هو فقد وجد في إنصاتها حافزا على أن يحكي لها بعضا مما قرأه، اعترفت له أنها قد وجدت لذة في الاستماع إلى حكاياته، وأنه يتقن حبكها فَرَاقه ذلك، لكنه ضحك بحرقة لما طلبت منه الكتابة، الكتابة عن حياته.
لم يفكر في الأمر حتى، لأنه لم يجد في حياته ما يستحق الكتابة، ولكنه أبدى اهتماما بحياتها هي لما أخبرته أنها انقطعت عن الدراسة وهي على مشارف الباكلوريا، فلعن الظروف المزرية، وحنق على الدولة التي لا ترعى مواطنيها، وتأفف من الدنيا التي لا تنصف الناس.
كانا لا يزالان في جولتهما بشوارع الرباط حين دار بينهما الحديث حول هذا الموضوع، ما جعلها تتلفت يمنة وشمالا خشية أن يسمعه أحد وهو يسب النظام، وكان هو يطمئنها أن ذلك النظام الذي تخشاه ما عاد يهتم بمثل هذا.
تنوعت المواضيع التي ناقشاها وتعددت، فكانا يقفزان من موضوع إلى آخر كيفما اتفق؛ فيحدث أن يتكلما عن الكتب، ثم ينتقلان إلى السينما، فإلى الفقر والجوع والضياع المستشري في الأحياء الهامشية، والتي لا يظهر لها أي أثر في شوارع المدينة.
وعقب لحظة صمت وجيزة قالت وهي تشير إلى امرأة أنيقة تتمشى أماهما:
ــ كم ننافق أنفسنا! نحن الفقراء، والمرضى الحمقى الجُهَّلُ الواهنون الضعاف العاجزون والمنافقون، نختار أفضل ما لدينا من ثياب لنواجه الناس، ببطوننا الفارغة وعقولنا الواهية.
وافقها في غُصتها، رغم أنه أحس لوهلة كأنها تقصده بكلامها الحانق، ثم اطمأن إلى أنها ربما تقصد نفسها أيضا، وما كانت المرأة أمامهما إلا تمويها.
جلسا متكاتفين عند الصخور المطلة على البحر وأمواجه الصاخبة فسألها بلكنة المحتار عن طبيعة علاقتهما، فأجابته بقبلة في خده؛ ليس ببعيد عن الشفاه. وقد سكن روعه لما أيقن أن قبلتها تختزل الجواب اختزالا؛ فهو قريب جدا، وعزيز جدا، تحبه، ولكن ليس حب الحبيب للحبيب، إذ إن هناك حدودا باهتة بينهما، لم يتجرأ أحد منهما على تحطيمها، أو تقويمها.
فكر في ظل الصمت أن يسألها فيما إن كان في حياتها شخص آخر يستحق قبلة على الشفاه، ولكنه خشي أن تنقلب الآية؛ فيجد نفسه حائرا، ولن يستطيع جوابا.
تذكر نعيمة وليلته معها؛ لقد قضاها ممتعة، وفي ظل حكم الظلام وشِرعته كانت امرأة أخرى، فلم يتطلع في العتمة إلى أسنانها، أما رائحة السجائر فلم تضايقه أبدا، نسي فكرة الصلاة أو خوفه من الإغواء، بل ذهب فيه حد الذوبان، فقد كانت خبيرة في إثارته، ولما دق المنبه فجرا ودعها على مضض، فقبلها خلسة من شفتيها عند الباب وهو يدس في يدها الورقة النقدية الزرقاء، قبلها دون أن ينتبه لشعرها المبعثر، ولا لتفاصيل وجهها البادية على حقيقتها دون زينة.
جالت في جسمه لذة عابرة من الذكرى، وجد فيها حلاوة ومتعة، تلك النعيمة تمتعه حضورا وغيابا فحاول استحضارها بتفاصيلها لكنه لم يستطع، ربما منع حضورَها شخصُ فاطمة الماثل.
لم يندم في قرارة نفسه على ليلته مع نعيمة، بل ارتاح لها، وخامرته فكرة دعوتها الليلة مجددا على أن يحتاط هذه المرة، أقلها ريثما انتقل إلى مسكن آخر، فإن كان الإغواء سبب شقائه، فليغرق فيه حد الثمالة وليكن أمر الله فيه كما شاء، هكذا حدثته نفسه.
التفت إليها، وتفحصها وهي لا تزال صامتة، كانت كأنها سابحة في ملكوت بعيد جدا، أو كأنها تستطلع المستقبل خلف أمواج البحر، أو، ربما تراجع الماضي، فرأى في وجهها أثر الزينة. كل النساء ــ فكَّرَــ ولا واحدة منهن تخرج من بيتها دون زينة، لكن لم لا يضعنها في البيوت؟ انتبه إلى أن فاطمة لم تتطرق إلى وضع التبرج لما تحدثت طويلا عن نفاق الناس في مواجهة بعضهم البعض بلباس منتقى.
وليقض جدار الصمت الذي قيدهما، أبلغها أنه ينوي الانتقال إلى مسكن آخر، وبرر ذلك بكونه لا يفكر في قضاء فصل الشتاء تحت القصدير، أو الاستمرار في مثل تلك الأوضاع المهينة، ووافقت هي من جهتها مثمنة الفكرة، ثم أخبرها أن رغبة قد امتلكته في الارتقاء بوضعه المادي والمعنوي؛ فإن لم يكن بمقدوره تغيير أحوال الناس في الحي، لاسيما مي طامو وأحمد، فإنه يرغب في ترك ذلك الكاريان البئيس، في الحقيقة، قد خانته اللغة فلم يجد كلمة أصدق تعبيرا لوصف ظروف الحياة هناك، لكنه استعان بما للفظة البؤس من حمولة.
حاول، في مرات عدة، أن يقارن بين فاطمة ونعيمة، كل حين، وتحت أي ظرف، وفي لحظة ما، أحس أنه ربما يحب نعيمة أكثر؛ اختلطت عليه المشاعر فما استطاع تمييز الحب من غيره من الأحاسيس والعواطف.
كاد أن يفاتح فاطمة في الموضوع، أقلها كان ليسألها عن الحب، وعن رأيها في ارتباطه بالمتعة واللذة، لكنه، ورغم انفتاحه كليا عليها، خاصة ذلك المساء، إلا أنه لم يغامر بذلك، بل حافظ على سره لنفسه، وفي طريق العودة سمح لهم الوقت بدخول مسرح محمد الخامس، فشاهدا مسرحية قصيرة ومجانية تحت عنوان " قيس ولد الحومة"، وهي تمثيلية تدور أحداثها حول موضوع الحب، وأبطالها كلهم ذكور؛ تبدأ بانبعاث قيس الشاعر في أطراف مدينة حديثة فجرا، ليعلن انبهاره من العالم الجديد، وهنا يلتقي بالبطل الذي ستنتقل إليه حمى الحب أو لعنته، ولكنه لم يتمكن ــ لظروفه ــ من الزواج بمن سلبت قلبه، ثم، وفي غمرة تطور الأحداث يتحول من حب ليلاه إلى حب شامل لا يقتصر على شخص المرأة بل إلى حب الله ومخلوقاته جميعها، فيحتار الأصدقاء من ذلك التحول الذي لحقه، ويعجز هو عن تفسير ما به.
أخبرته فاطمة في طريق العودة أن في سطح العمارة حيث تسكن شقةً صغيرة للإيجار، وأنها قد بنيت وجهزت حديثا، وهي مطلية ومعدة للسكن، ثم أطلعته علما أن صاحب العمارة قد بنى تلك الشقة في السطح بعد أن رشا المقدم والقائد، وأكثر من ذلك، كان البناء سريا تماما؛ فلا يباشَر إلا ليلا، وكل جزء بني كان يطلى بمثل لون الجدار في ليلته، وهكذا، إلى أن تم البناء.
ولأنها تعرف صاحب العمارة عن قرب، وهو أيضا من رواد المقهى، ولن يخيب لها طلبا، فقد عرضت عليه التوسط إن رغب، وكذلك كان.
ظل، طيلة أسبوعه الأخير عند مي طامو، يقصد دار الدعارة، كل ليلة؛ فبعد أن يترك فاطمة عند باب العمارة، يودعها ويتوجه إلى بيته، فيأكل ما تيسر، ثم يضع الورقة النقدية الخضراء في جيبه، وما هي إلا دقائق، حتى يكون بين أحضان نعيمة، إلا أنه ما إنْ كان يخرج من عندها حتى يتحاماه الندم والحسرة فَيَعِد نفسه ألا يعود في غده، لكن دون جدوى.
ونعيمة هي الأخرى تعودت انتظاره في الوقت نفسه من كل ليلة كما تنتظر الزوجة زوجا طال غيابه، فتتزين وتتهيأ، وأكثر من ذلك، كانت تمنحه وقتا أطول من غيره، وربما ردت زبونا إن صادف قدومه إلى المبغى ساعة دخول إدريس، أو قبله قليلا.
وهكذا استمر الحال بينهما حتى بعد انتقاله إلى جوار فاطمة، ولمدة قاربت الشهر؛ فكان يتسلل ليلا، كل ليلة، وفي الوقت نفسه، ثم يعود نادما وحسيرا كسيفا.
في تلك الليلة السوداء، ربط المطر ليل المدينة بنهارها فطال مكوثه في غرفته، ثم خرج كعادته إلى المقهى قبيل المغرب، وعادا معا إلى الدار تحت المطر فدخل معها إلى بيتها، وتناول اللمجة مع اثنتين من صديقاتها، فلم تُبْدِ ولا واحدة منهما رفضا أو اعتراضا، ثم بعد حديث طريف تركهن وقصد غرفته.
كانت ساعة الموعد المعلوم تقترب بتؤدة، فبات يراقب الوقت بالدقيقة والثانية، عزم ألا يذهب لقضاء نزوته ففتح جريدة من بين التي جلب معه تحت كمه، لكنه لم يستطع قراءة سطر واحد؛ غطى شبح نعيمة كل الصور، وطمس اسمها كل الكلمات، ثم لفحته أنفاسها المتوهجة من كل صفحة، فضرب الجريدة عرض الحائط، ونزع ملابسه ثم دخل فراشه متدثرا. ولكن، ما إن هدأت أنفاسه حتى رن الهاتف، وكانت نعيمة من يتصل فجاء الصوت خافتا:
"أنا أنتظرك"
قام من مكانه مسرعا، وفي طرفة عين كان يقفز على الدرجات نازلا عبر درجات السلالم. التقى فاطمة عند الباب الخارجي فأدهشه الأمر؛ إذ كانت تلهث وهي مبللة، وواضح أنها عائدة لتوها من الخارج، إلا أنه لم يكن في يدها شيء، فتذكر أنها كانت عازمة على أن ترتاح من تعب نهارها، ولم يجد مبررا لخروجها.
وقفا صامتين، وربما مصدومين، دارت في ذهنه الأفكار السلبية جميعها، فحياها مكشرا عن ابتسامة مغتصبة، ومضى في صمت.
دعته بكل اسم هو له(إدريس، بو كتاب، الفاسي)، وهو يسير تحت وقع المطر فلم يعرها اهتماما، اخترق الحي الصفيحي ورأسه يغلي، ثم دخل الدار الوطئة وهو يتقاطر من كل ناحية من جسمه، رأى أن سقف فسحة الدار لم يقطر رغم أن الزقاق المكشوف كانت قد تشكلت فيه بعض البرك الصغيرة.
استقبلته نعيمة بمنشفة وقبلة حارة وعناق دافئ أنساه وقع المطر، لم يدخلا الغرفة الضيقة المظلمة التي اعتاداها، فقد كان سقفها يقطر، وربما انبعجت إحدى صفائح القصدير من وقع الزخات المطرية وتراكم الماء كما أخبرته، ولذلك ولجا غرفة أخرى بجوار المطبخ. وتحت سلطة الظلام سألها:
ــ أتحبينني أنا؟، أم مالي؟
ولما أقسمت أنها أحبته بصدق، انفلت السؤال الأخطر من فمه:
ــ تتزوجينني؟
لم تجبه، بل اقتربت من فمه تتشمم رائحته، ففِهم مرادها وما دار في ذهنها، وأكد لها أنه ليس تحت تأثير السكر، وأنه واع تماما بما يقول.
ــ لو أتيت قبل اليوم، ربما نعم.
ــ لا همَّ لي بماضيك.
ــ مستقبلي المظلم سيبقى هنا، أما أنت، فلك أن تبحث عن امرأة صالحة، قادرة على أن تهب الحياة، ليس من واجبك أن تتقاسم معي مأساتي، ولا أن تحمل معي ثقلي. لقد حكم الله أن تكون أنت الذكر، وما كان لي أنا أن أكون إلا الأنثى، التي يجب أن تعطي كل شيء، وتفنى في العطاء.
لست نادمة على شيء؛ ليس الأمر بيدي، وأنا لم أصنع رحمي بيدي هاتين، ولو كان الخيار لي لكنت تلك التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالودود الولود، ولو كان الأمر بيدي لجئت ذكرا. لكن، حتى لو كنت رجلا، فما كنت لأطلق امرأة لأن ليس برحمها...
توقفت عن الكلام حينا، ثم أجهشت بالبكاء، وغرست وجهها في صدر إدريس ثم قالت وهي تغمغم:
ــ ما كنت لألقي بها في مثل هذه الحفرة.
طال بهما المقام بين الدمع والشجون، فطرقت يمنى ذات الشارب باب الغرفة، مستعجلة إياهما، وكان صوت الطرقة كفيلا بأن تنفجر القنبلة، وتنقلب نعيمة وحشا كاسرا؛ فخرجت عارية، واتجهت نحوها فأمسكت بخناقها وهي تصيح بكل الكلمات النابية.
كادت لتقوم قيامة داخل المبغى، لولا تدخل من حضر. وفي الأخير، مد الورقة النقدية لصاحبة البيت في الوقت الذي تكفلت فتاتين بإدخال نعيمة إلى الغرفة التي خرجت منها، ثم وضح لها أنهما لم يفعلا شيئا، وأنه كان بإمكانها ألا تطرق عليهما الباب، فلا زبون عندها، ولا سببا آخر يدفعها لذلك.
خرجت نعيمة من الغرفة وقد ارتدت بعض ملابسها، وقصدت المطبخ، ثم خرجت وفي كفها سكين صغير الحجم، فشرعت تضرب ساعدها والدم يتطاير من كل جرح إلى أن تدخلت زميلاتها فأمسكنها ومنعنها من إيذاء نفسها، وبالمشقة نزعن السكين من يدها ومنعنها من الاستمرار فيما كانت فيه.
وقف مدة وهو عاجز عن أي فعل، يشاهد بعينيه الدم وهو ينز من الجروح، ثم استدار نحو الباب يائسا، أما هي، فقد انهارت بين أيدي صديقاتها.
كان المطر الغزير يقرع رأسه المكشوف بحدة وهو يذرع الطريق كالمجنون، فيركل بين الفينة والأخرى قنينة في طريقه، وأحيانا كان يرفع يديه عاليا نحو السماء المظلمة كأنه يفاوض الله ويجادله.
مر بالقرب من بيته القديم لعله يجد أحمد صاحيا فيشكو له مما هو فيه، أطل من شق بالباب فلم ير أثرا للضوء، وإشفاقا على صديقه ومي طامو لم يطرق الباب، ثم ترك الحي الصفيحي مغموما، وعوض أن يعود إلى بيته، قصد أمه الحديقة.
انهار فوق أول مقعد حديدي، وتحت وقع المطر كان يبكي؛ بكى إلى أن جفت مقلتاه: بكى نفسه وبكى والديه، بكى مي طامو وأحمد، وحتى الجاسوس، بكى حال نعيمة أكثر.
أخذته رعشة برد، ثم تلتها أخرى، فتوالت الرعشات، إلى أن اضطره إحساسه بالبرد أن يعود إلى بيته.
في باب العمارة وجد فاطمة، واقفة منتظرة، فلم يمد يده مصافحا، ولا حتى أعارها انتباها؛ مر بجانبها كأنه لم يرها، وفي السلالم كان يسمع وقع خطواتها خلفه.
ساد الصمت طيلة مسار الصعود، عدا إيقاع وقع الأقدام، والنحيب، وعند وصوله قرب باب دارها بادرها بكلام جاء في نبرة حادة وإيقاع واحد:
ــ أنت نادلة نذلة، ساقطة، وأنا لست خرقة بلهاء في يدك، لتمسحي بي خطاياك، ولست شاذا لتقضي بي وقت فراغك؛ وأنت، كما فضحك الله الليلة، تخرجين مع غيري في كل حين، كل النادلات، جميعكن عاهرات.
قال هذا وانصرف صعودا، لم يلتفت خلفه مع أنه سمع أنينها على طول مساره إلى غرفته، وما إن بلغ السطح؛ حيث يسكن، حتى جلدته سياط المطر والريح، اللذان اشتدا وصارا أكثر عنفا وصريرا.
والبيت الذي يسكنه إدريس لا يجمعه سقف واحد موحد؛ فيه غرفة واسعة نسبيا، على الأقل قياسا إلى الغرف التي سكنها طوال حياته، ومطبخ ومرحاض. وللخروج من الغرفة إلى المطبخ كان عليه مواجهة العراء، مهما كانت الظروف.
فتح غرفته بشق الأنفس؛ فقد كان يرتجف ويرتعد بكل عضو منه، أما سرواله، فقد كان ملتصقا بجلده من كثرة البلل، ولما كانت تأخذه الرعدة، فتصطك أسنانه ويرتجف جسمه كاملا، أضف هذا كله إلى تشتت تركيزه، فإنه قد وجد صعوبة في فتح الباب.
لكنه رغم ذلك، لم يعر الأمر اهتماما، وما إن دخل حتى أقفل الباب دونه، ثم نزع ثيابه، ونشف جسده بحركات عصبية، كأنه يصارع ثيابه وكل شيء أمامه، كان الماء يقطر منه كأنه أوراق شجرة تحت المطر، فقد تبلل كليا، في كل عضو من جسمه؛ من شعر رأسه حتى أخمص قديه.
لم يقرأ أي كتاب ليلته تلك، بل اكتفى بعناق فراشه والظلمة وصوت المطر.
دارت الأكوان بذهنه فلم يستطع نوما، تقلب كثيرا في فراشه، وبين الأفكار؛ وعاد به الحنين إلى أيام فاس، فتساءل:
ــ لو كانت جدتي على قيد الحياة، أمَا كانت لتبحث عني؟ أم إنها عاجزة؟ لا بد أن عظمها قد وهن، وأنها قد خضعت لإرادة أخوالي، أخشى أن أولائك الحمقى، لا قدر الله، قد أودعوها دار العجزة، فما أكثر ما يجر المجانين والديهم إلى تلك الدور البئيسة، أما كان علي أن أبحث عنها؟ لقد أخللت بواجبي اتجاهها.
ونعيمة، ما الذي حصل لها؟ آه، كله مني، الأذى كله، كانت هانئة بحياتها، أقلها كانت مستسلمة لقدرها، تجتر أيامها، وتنتظر قضاء الله.
يأبى لساني إلا أن يؤذي الناس من حولي، هل كنت لأتزوجها حقا؟ ربما نعم، ولكن أكيد لا، أبدا، لا يمكن. أين سأهرب بها؟ ومن ماضيها؟ ومن أعين الناس، وألسنتهم:
"تزوج عاهرة"، "يا زوج العاهرة"،"يا ديوث".
ثم قال في ثورة غضب وكأنه يبصق في صدره:
ــ تفووو، نحن أدنى مرتبة من الحيوان؛ نغتصب المرأة ونلقي بها في أحضان الرذيلة ثم نلعنها، وبينما نلعنها جهرا تحت أشعة الشمس، نسعى إلى أحضانها ليلا تحت جنح الظلام.
ولما طال سهاده تذكر فاطمة، فتساءل إن كان بمعاملته إياها على ذلك النحو، سيدفعها إلى المسار نفسه، ولو دون وعي أو قصد، أحس بالذنب، ولاسيما بالمسؤولية على مسارها إن ارتمت بين أحضان الرذيلة بسببه، لكنه اطمأن إلى براءته، فهي قبل أن يتعرف عليها كانت نادلة، ولا بد أنها...
لم يستطع مواصلة الفكرة، ولما آلمه ذلك، عاد إلى حادثته الأخيرة معها بالضبط، وتساءل إن كان في ذلك دليل على غيرته، وبالتالي حبه لها.
أعلن آذان الفجر عن ميلاد يوم جديد، ولا يزال المطر مستمرا في توقيع موسيقاه دون كلل، ففكر إدريس أنه قد اغتسل أو تعمد بماء المطر أمس، وأن بإمكانه قصد المسجد للصلاة بعد وضوء صغير، وأن عليه أن يتوب لله وينقطع عن الدنيا وما فيها، وأن يتبتل لله، وربما يهاجر إلى مدينة أخرى بحثا عن حياة أخرى، والهجرة من الإغواء لله وإليه وسيلة أخرى وأجدى لتطهير النفس...
لم يُصَلِّ الفجرَ، ولكن مجرد الفكرة قد ملأت روحه طمأنينة فسرت في أوصاله سِنة وراحة، وما هي إلا لحظات، حتى استسلم لنوم عميق لم يفق منه إلا على سماع طرقات ببابه، طرقات رافقها صوت أحمد المبحوح مناديا إياه.
تحدثا في أمور كثيرة، في كل ما لا علاقة له بليلة أمس، وعلى هذه الحال أمضوا أياما ثلاثة؛ يزوره أحمد كل صباح فيناقشا الشعر والحكايات وكل ما يدور في فلك الكتب، لا يشغلهم إلا إعداد طبق أو إبريق شاي، واستمر المطر طيلة تلك الأيام في ري الأرض بلا كلال، لا ينقطع فترة إلا ليعود، وفي اليوم الرابع كانا في السوق.
يكتظ السوق أيام الآحاد بالباعة والمشترين فتزدحم ممراته، وفي ذلك اليوم؛ الأحد الأخير من فبراير، كان إدريس جالسا في مكانه رفقة كتابه، كالعادة، لكنه كان وحده، وأمامه قد فرشت بعض الكتب وكثير من الأحذية، وخلف البساط كانت اللوحة معروضة للبيع، متكئة على كرسي أحمد الفارغ، بحيث تواجه المارة.
فتح كتاب شرح المعلقات السبع بين يديه، فتراه يقرأ منه بمثل نبرة من يتهجى الحروف أول مرة؛ يقرأ البيت الشعري فوق، بصعوبة، ويبحث عن معاني الكلمات في الهامش أسفل الصفحة، إلى أن وقف عند البيت حيث يقول امرؤ القيس:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
ولما فهم معنى كل كلمة منه، أبحر في رحلة البحث عن مقاصد الشاعر ومراميه، أحس كما لو كان هو نفسه قائله، فطالما أحس بالقهر الممتد كليل الشاعر، وود لو ينجلي عليه بصباح يسعد به، ولو أن الغد غير مضمون العواقب، لكنه الأمل، والأمل آخر الشرور كما قرأ يوما في كتاب قديم؛ كانت كتب الأساطير والمسرح اليونانية منتشرة في السوق، وقد وجد فيها متعة لا توصف ومنها تعرف أسطورة الخلق اليونانية، وصندوق الشرور الذي أرسلته الآلهة إلى المرأة...
كان غارقا في المعلقة الأولى لما وقف على رأسه شخص رأى ظله عند موقع قدميه، كانت الظهيرة في أوجها ما جعل الظل يظهر قصيرا، ولا يعكس حقيقة صاحبه، رفع عينيه فوقعتا على رشيد.
ذلك الشاب ربع القامة وحسن الأخلاق، مجرد وجوده في السوق خطأ طبيعي في تصنيف الناس حسب أقدارهم؛ شاب خلوق، أسمر الإهاب، ربما اكتسب لون بشرته من كثرة معانقته لشمس البحر التي تلفحه في كل الأسواق والشوارع، وهو رب لأسرة صغيرة، يكدح من أجلهم في السوق، وبين المتشردين؛ لم يرض العمل عند أصحاب المصانع، فهم ـ حسبه ــ مجرد مصاصي دماء لا يجب على الإنسان حتى ذكر أسمائهم كي لا تتسخ الأسامي.
انحنى رشيد إلى أن حاذى إدريس في جلسته، فمد يده مصافحا بأدب، وبعد أن تبادلا عبارات مجاملة خفيفة، بادر بالسؤال:
ــ أخي إدريس، أنت أخونا، كما هو أحمد، وككل هؤلاء التائهين في دروب الحياة، لا يصح أن تحمل الهم وحدك، أخي، يشهد الجميع بخلقك الحسن، والذي لم ولن يساورنا فيه شك، ولكننا حائرون بشأن أحمد، وأنا شخصيا، بالإضافة إلى بعض الحرفيين اقترحنا أن نساهم معك في الأجر.
لقد افتقدنا أحمد في السوق، ولما تفقدناه في غرفته، أخبرتنا العجوز المسكينة أنه مرض أياما، وأنك، جازاك الله خيرا، كنت قائما بخدمته على أحسن وجه، وأنك أيضا قد نقلته إلى غرفتك، وقد حمدنا له ذلك منك، وأثنينا على كرمك وإنسانيتك، فارتاحت النفوس، وعزت مكانتك بيننا، والله على ما أقول شهيد.
لكن أحدهم أخبرنا أنه شاهدكما أول أمس عائدين إلى البيت، وأنه رأى أحمد في حال سيئة.
ــ لو سألتموني عنه لكنت أخبرتكم. نعم، إنه مريض؛ فقبل أسابيع، كثرت شكاويه من ألم ألمَّ بجنبه، ثم تبعه سعال شديد، وصل به ــ في ليال عدة ــ حد الاختناق. لذلك، لازمته أياما وليال، إلى أن قصد المستشفى استجابة لإلحاحنا؛ أنا ومي طامو. وهناك، أشار بسبابته نحو الشرق، في ذلك المستوصف، لم يصفوا له إلا مشروبا مهدئا للسعال وحبات لعلاج الحمى وتخفيف حدة وقعها، كما منعوه من التدخين، ولكنه ،شافاه الله وعافاه، لا يزال مدمنا على ذلك السم، نطق كلمة مدمن بحرقة وهو يمد يده نحو فمه مفرجا بين سبابته ووسطاه.
صمت قليلا، ونظر في وجه رشيد ليتأكد من انتباهه ثم أضاف لما اطمأن لذلك:
ــ لم يُحَسِّن الدواء حاله أبدا، فما زاد مرضه إلا حدة، وعظمه إلا وَهَنا، وإنه كان أكثر ما يشتد عليه المرض ليلا، حتى إنه لم يعد قادرا على تحمل نوبات السعال التي كانت تأخذه لدقائق متواصلة، فلا تتركه حتى تقطع أنفاسه وتمزق رئته فيبصق الدم أحيانا، ولطالما وجدته مهدودا حينما كنت أزوره صباحا.
لذلك ارتأيت نقله عندي؛ حتى أستطيع مساعدته، وخدمته، لاسيما ليلا، وهكذا كان. ثم، في بداية هذا الأسبوع قصدنا مستشفى العاصمة الكبير، وأثناء عودتنا، ربما رآنا صديقك.
اعتذر رشيد عن قطع حديثهما، على أن يواصلاه بعد خدمة زبون كان عند بساطه، وما كان ليذهب إليه لو لم ير منه إلحاحا في معرفة الثمن.
تتبع إدريس بعينيه حركات أيد رشيد وهو يفاوض زبونه، فنسي الكتاب ولاذ بالصمت. بعد برهة، عاد رشيد معتذرا من جديد، أما عينا إدريس حين عودته، فكانتا مركزتين على اللوحة، وقال مسترسلا:
ــ طلب منا الطبيب صورة بالأشعة لصدره، ولأجل ذلك قصدنا المختبر العمومي، ولأنه عمومي، ثم فرك سبابته بإبهامه في وجه رشيد للدلالة على الرشوة، وهو يقول:
ــ لا بد أنك تعرف كيف تسير الأمور هناك؛ أعطونا موعدا بعد شهرين، وهل تحتمل صحة أحمد صبر شهرين كاملين؟
ــ يعني أنه يجب أخذه إلى مختبر خاص.
ــ وذلك ما أنا عازم عليه، هل تعلم؟ هذه اللوحة، التي كان يساومني فيها ذلك المجنون، أغلى عندي من أن أبيعها، إنها تمثلني؛ إذ أرى نفسي واحدا من هؤلاء اللاحقين بالمرأة العملاقة، ربما أنا هذا وأنت ذلك، وسيكون أحمد هو ذلك الجاثي على ركبتيه في الخلف، تقودنا هذه المرأة/الدنيا، عارية الصدر، نحو المجهول، لا أفق أمامها، لكنها مقبلة في شموخها...
مكانة هذه اللوحة غالية عندي، وما كنت لأبيعها لو لم تكن حياة صديقي أحمد أغلى. صمت حينا، ثم أردف: "صدقت حرقة عمر بن الخطاب لما قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته".
بهذا أنهى كلامه، وزم شفتيه، ثم انزوى كأن لا أحد معه.
ربت رشيد على كتفه، وقام من مجثمه فأزاح اللوحة من مكانها وهو يقول:
ــ اللوحة لن تباع، عينك على سلعتي!
قال هذا وهو يقوم من عنده، ثم توجه مباشرة إلى بائع الأواني في الجهة المقابلة، فأخذ سطلا أسود، وأخرج من جيبه بعض العملات المعدنية فوضعها فيه وهو يصيح في الجميع:
ــ يا حرفيين، يا باعة، يا إخوان... أخوكم أحمد مريض، ويحتاج مساعدتكم، أتتركونه للموت؟ أترضى أنفسكم هذا؟
وما هي إلا خطوات وصيحات، حتى بدأت الأيادي تمتد إلى السطل، والقطع النقدية تتناثر فتؤلف إيقاعا فريدا، فبدا رشيد وهو يدلف بين الجموع كأنه صوفي قد اتحد بالكون في رقصة الوجود، كان صوته متناغما مع حركته، وللحظة لم يكن الشاب الأسمر وحده من يستعطف الناس، بل انضم إليه ثلاثة آخرون، رأى إدريس بأم عينيه هذا التضامن الفريد بين الجميع، الباعة كلهم، والمتشردون، وحتى اللصوص والبغايا، كل ساهم قدر استطاعته، بل وإن منهم من وضع أوراقا نقدية من مختلف الفئات.
تابع إدريس المشهد من بعيد، فاختلطت عليه مشاعر الأسى والفرحة، بل والعجب أيضا، ولكم كانت دهشته كبيرة حين أبصر بمقلتيه الاثنتين، وبتقزز، تلك المخلوقات العفنة التي كانت ترتدي تحت ستراتها قمصانا جديدة، وتربط أعناقها بأشرطة موشاة، أصحاب الأحذية الملمعة، من ذوي البطون المتكرشة، والخدود الملمعة.
رأى من مكانه الكيفية التي كانوا ينحرفون بها، جميعهم، عن طريق رشيد وصحبه، كأن بهم جربا أو مرضا يخشون عدواه، رافضين المساهمة لإنقاذ حياة ضعيفة ولو بالقدر الذي يتركه أحدهم عند نادلة ليغريها بكرمه.
عاد رشيد متوسطا بثلاثة من شبان الحي القصديري، مصفد الجبين بالعرق، فاغرا عن ابتسامة وشفتين جافتين، فوضع السطل مملوءا إلى نصفه بالمال، وبقي إدريس جالسا في كرسيه، حائرا، مذهولا، معقود اللسان.
شكل رشيد ومن معه ما يشبه اللجنة، فقصدوا بالسطل تاجر متلاشيات، ثم عادوا ومعهم ما يناهز الثلاثة ألاف درهم، فوجد إدريس نفسه حائرا؛ فيما إن كان من واجبه شكرهم، أو الاعتذار لهم عن الأحكام المسبقة التي كان قد بناها في حقهم. هُمْ أنفسهم لم يتركوا له فرصة لفعل أي شيء مما ساورته نفسه فيه.
في المساء، كانت غرفة السطح مكتظة عن آخرها بالزوار؛ جاؤوا ومعهم ما لذ وطاب، فأمسى أحمد ليلته تلك جذلا، ونام إدريس مرتاح البال، اللوحة هي الأخرى عادت إلى مسمارها بالحائط.
وهُما في هدأة الليل، أخبره أحمد أن شابة من الجيران قد خدمته بحفاوة حين كان غائبا في السوق، فاكتفى بأن طلب منه أن يرتاح.
صباح الاثنين، كانوا في المختبر؛ أحمد وإدريس ورشيد والثلاثة الآخرون. وبعد مدة قصيرة على خروج أحمد من قاعة الأشعة، قدم لهم المسؤول على الاستقبال صور الأشعة في مغلف، وما هي إلا أن دار أطول عقارب الساعة دورة كاملة، حتى كان أحمد وإدريس معا عند الطبيب الذي يتابع حالته في مستشفى العاصمة، والآخرون في قاعة الاستقبال منتظرين.
عندما خرجا تلقفوهما بالأيد والأسئلة؛ بدا إدريس منكس الرأس وشاحب الوجه، وفي غفلة من أحمد غمزهم وهو يعض على شفته السفلى وواضعا سبابته على طول أنفه راجيا منهم ألا يضايقوه بالأسئلة، ولكن لسان أحمد كان ينساب كالجدول:
ــ توقعت ذلك، لست خائفا، والله وحده قادر على تصريف قضائه على عباده بالشكل الذي يرضيه.
في الوقت الذي كان أحمد بين أكتاف اثنين من أبناء الحي، انفرد إدريس برشيد والثالث معهما فأخبرهما هامسا:
ــ إنه السرطان، وفي مرحلة متقدمة، نسأل الله العافية، وقد أخبرني الطبيب على انفراد، وذلك سبب تأخري بالخروج قليلا، أن الحالة شبه ميؤوس منها، وأن وضع أحمد الصحي لا يُمَكِّنه من تحمل العلاج الكيماوي حاليا؛ ولذلك، فقد طلب منا أن نعطيه هذا الدواء، وأخرج ورقة تلقفها رشيد من يده وهو لا يزال قائلا:
ــ هذا الدواء ـ حسب الطبيب ــ بالإضافة إلى تغذية خاصة سيقوي بنيته، ويخفف من وقع الألم عليه، لاسيما ليلا.
لطالما أصر إدريس على أحمد أن يرافقه إلى البيت في السطح وهم في الطريق إلى الحي، لكن الأخير كان مصرا على العودة إلى بيته عند مي طامو، ونزولا عند رغبته، اتفق الجميع على خدمته، مناوبة، وبدت العجوز سعيدة جدا بعودته، فرفضت أخذ الإيجار وهي تقول:
ــ أحمد ولدي، والبيت بيته.
قدم لها رشيد كيسا محملا بالدواء تكلف بشرائه من ماله الخاص موضحا لها كيفية أخذه وساعة تناول كل دواء على حدة، ثم أخبروها كل شيء، عدا عن نوع مرضه.
طغت على الأجواء حميمية قل نظيرها، ولا قدرة للغة على وصفها بدقة، وكذلك استمرت الأيام الموالية، لكن، ومع مرور الأيام، فقد أحمد الشهية، فحتى الدواء الذي هو دواء، ما كان يستسيغ بلعه إلا ويتقيؤه قبل أن يستقر في معدته، فزادت حدة آلامه.
داوم إدريس على قضاء ساعات طويلة من الليل رفقته، طيلة الأيام الأخيرة، فلا يفارقه إلا بعد أن يحرص على أخذ أحمد دواءه، فتخف حدة سعاله، ويراود النوم عينيه. ربما حضر في بعض الليالي رشيد أو غيره، ولطالما آلمتهم تلك النوبات التي كان يدخلها صديقهم المريض؛ إذ يشتد سعاله حتى يتفتت كبده، ثم يخرج الدم مع بصاقه.
في تلك الليلة، الليلة المشؤومة، لم يستطع إدريس ترك صديقه، كانت حالته حرجة جدا، فقد انقطع منه الكلام، ورغم أن سعاله قد خف، إلا أن حشرجة رافقت تنفسه؛ ولما رآه يتنفس بصعوبة رفع رأسه متمهلا، وأسنده على ركبته. ثم، وفي حدود الواحدة صباحا، اشتد أنين أحمد، وبزغت عيناه، فكانت أنفاسه تتقطع بين الفينة والأخرى من الإجهاد، ولما بلغ به الألم المتفاقم مدى لم يتحمله، سارع إدريس إلى مي طامو فأيقظها، ثم خرج في طلب رشيد.
كانت ليلة مقمرة، من أشد الليالي ثقلا على الصدور، أخذوه في تاكسي صغير إلى طبيب خاص، ولما كانت عيادة الطبيب في فيلته، فإنه لم يتأخر في محاولة تقديم المساعدة، جاهد كثيرا من أجل إسعافه، لكن لا راد لأمر الله، دخل المسكين فترة راحة أبدية، آخذا سره معه؛ إذ أكد لهم الطبيب أن أكثر ما عجل بوفاة صديقهم لم يكن المرض، بل غصة في قلبه؛ ففي عينيه، كما في قبضة يديه المتشنجة رغبة في البوح والتعبير عما لا يعلمه إلا الله.
ارتأى إدريس أن يؤبن صديقه بالطريقة اللائقة، وأصرت أمي طامو أن تخرج الجثة من غرفته في بيتها؛ فنظفتها المسكينة وعيونها أغزر من الديمة الهتانة، ثم طيبتها بالعطر والرياحين، وهناك قضى ليلته الأخيرة مع شمعتين إلى الصباح، وفي خيمة نصبت أمام المنزل، أقيم العزاء لثلاث ليال تباعا.
بعد أيام، نُسي أحمد كأنه لم يكن، ودخل شقته وافد جديد، وعاد إدريس إلى سابق عهده في السوق عازما أن يغير حياته جذريا؛ فلم يقصر نشاطه التجاري على الصباح فقط، بل اشترى دراجة، وبها كان يقصد سويقات أخرى في أحياء سلا والرباط، كما أنه لم يقتصر في تجارته على الأحذية المستعملة فقط، بل صار يتاجر في كل ما وصلته يداه، وبالإضافة إلى هذا كله، انقطع لقراءة الكتب في أوقات فراغه كلها، وابتعد عن مزالق الهاوية فلم يقرب دور الدعارة يوما، ولا أخر صلاة عن ميقاتها وتحت أي ظرف.