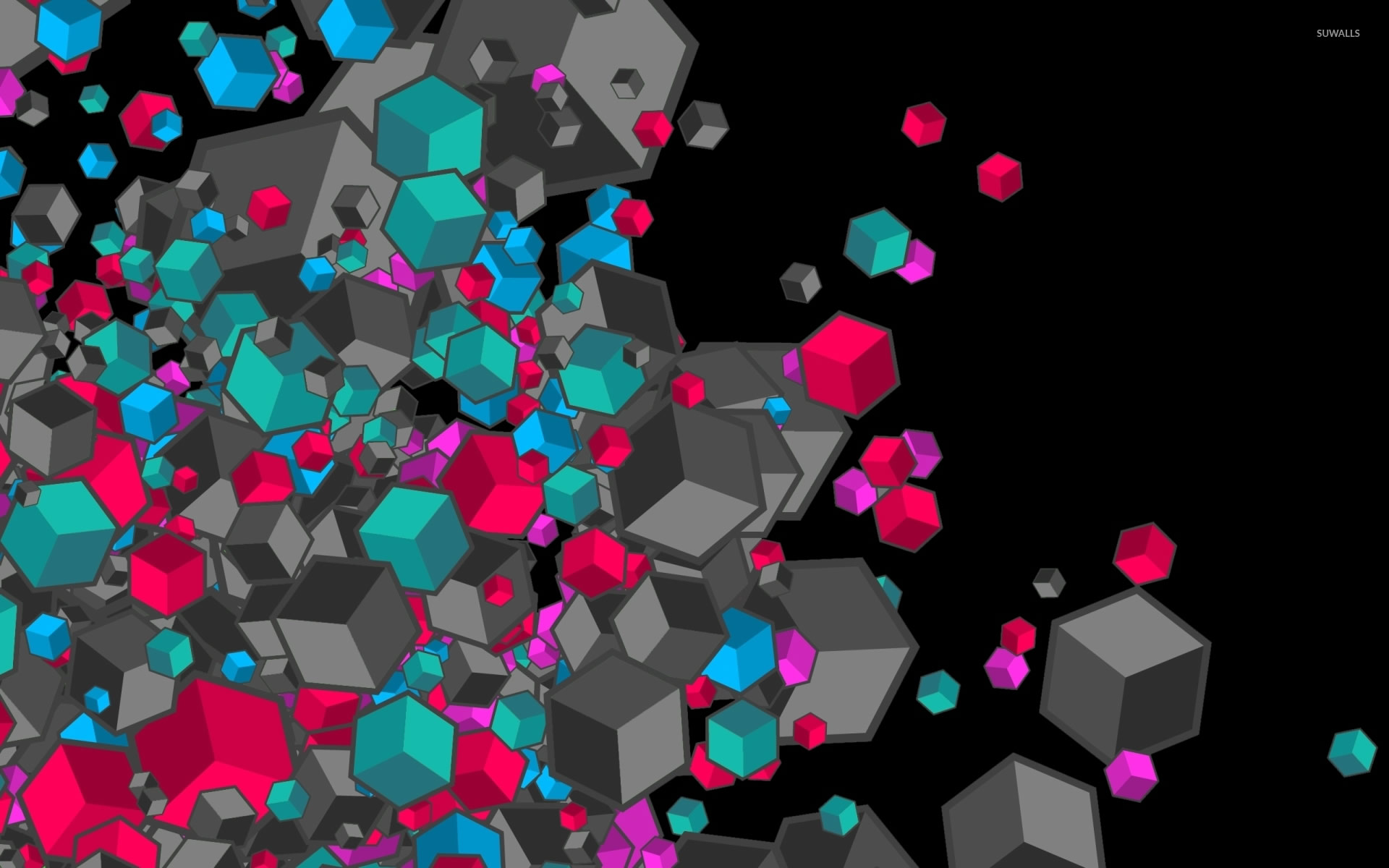مدخل تمهيدي وإشكالي :
تشكل التربية على قيم المواطنة مكونا أساسيا ضمن البنية المهيكلة للمناهج التعليمية، حيث تراهن عليه جل المنظومات التربوية العالمية في أفق العمل على بناء مواطن الغد المشبع بمنظومة القيم المواطناتية المحلية والكونية (المواطنة النشيطة/المواطنة الفاعلة). إنجاح هذا المكون التربوي يتطلب استحضار الفاعلية العملية لتقاطع وتكامل النشاط التربوي لعمل المؤسسات المجتمعية (المدرسة – الأسرة – الإعلام – مؤسسات المجتمع المدني...) بهدف المساهمة الإيجابية في ترسيخ ونشر المنظومة القيمية المواطناتية بين الناشئة المتعلمة من جهة ، كما يتطلب من جهة أخرى استشراف دور الهيئة التدريسية في إدراك وضبط المقومات الأساس المشكلة لمنهاج مادة التربية على قيم المواطنة/المرجعية الديداكتيكية للمادة، بهدف تمكين هذه الناشئة من اكتساب منظومة القيم المواطناتية، والتشبع بها، وممارستها، والمساهمة في التأثيث لترسيخ ثقافة قيم المواطنة بين أجيال المتعلمات والمتعلمين في أفق تكوين مواطنين واعون بأدوارهم المجتمعية، عبر إكسابهم منظومة الكفايات والقيم الإنسانية السامية التي ترقى بهم إلى مستوى المواطنين الفاعلين والأناس النبلاء...
ما المقومات العامة المؤطرة لمنهاج مادة التربية على قيم المواطنة؟ وإلى أي حد يمكن للتربية على قيم المواطنة من بناء مواطن الغد المشبع بقيم المواطنة والمنفتح على القيم الكونية في أفق المساهمة في بناء «المواطنة النشيطة/الفعالة» والمدرسة المواطنة وتنمية المجتمع الحداثي الديمقراطي؟
المحور الأول : في الحديث عن منظومة التربية على القيم من في بعديها البيداغوجي والديداكتيكي
واقع العملية التعليمية التعلمية بالمغرب نموذج تدريس مادة الفلسفة - مريم المفرج
تهدف عملية التدريس إلى إحداث تغييرات في سلوك المتعلم، وإكسابه المعلومات والمهارات والمعارف والاتجاهات والقيم المرغوبة فيها، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب على المعلم أن ينقل له هذه المعارف والمعلومات بطريقة مشوقة تثير اهتمامه ورغباته إلى التعلم. والمعلم الناجح هو الذي يعرف جيدا كيف يجعل حصته حصة مشوقة بعيدة عن الملل، من خلال اعتماد طرق تعليمية ملائمة لمادة الدرس، قد تكون متنوعة بحسب الظروف والمتطلبات الصفية، لأن إتباع المعلم طريقة واحدة معينة، أو التعصب لأسلوب معين، يحكم عليه في أحيان كثيرة بالجمود، يؤدي به إلى تجميد المادة الدراسية، لذلك وجب على المعلم الإلمام بطرائق التدريس المتنوعة، وامتلاك القدرة على استخدامها بالشكل الصحيح، لجعل الدرس مفيدا وممتعا في آن واحد، ومناسبا في الوقت نفسه لقدرات طلابه وميولهم.
وعليه فواقع التدريس، وتدريس مادة الفلسفة بمدارسنا خير دليل على ما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فمن الملاحظ مثلا على مستوى تدريس مادة الفلسفة بالباكالوريا، أنها باتت تشكل عائقا معرفيا لدى المتعلمين، وذلك راجع بالأساس إلى الكيفية التي يقدم بها المعلم درسه، فلا ريب إن كانت تتسم بالجمود والتكرار القائم على طريقة التدريس التقليدية أن تجعل المتعلم ينفر من هذه المادة، فهي بالنسبة له كإشكال بحث رجل أعمى عن قط أسود داخل بيت مظلم، والحال أن المتعلم المستقبل يبني مهاراته التعليمية التعلمية من المرسل الذي يمده بالمعرفة عن طريق القناة، فإن لم تكن هذه القناة جيدة أصبح الحديث عن النخبة حديثا فارغا من كل مضمون علمي، ومما لا شك فيه وحسب واقع تدريس الفلسفة، أن هناك هوة تزداد عمقا يوما بعد يوم ما بين المطلوب والمنتظر، أي بين المعلم والمتعلم، حيث أصبحت المسافة بين المرسل والمستقبل تقاس بالسنين الضوئية، على اعتبار أن الدرس يخلو تماما من أي تمييز بين المتعلمين من جهة إيصال المعلومة، في حين نجد المتعلمين فارغين تماما من أي كفاءة تجعلهم قادرين على مواكبة درس المعلم، والذي سبق وقلنا أنه يفتقر لطرق إيصال تتناغم والمتعلم، مما يجعل الدرس الفلسفي يتميز بالرتابة والدغمائية والبؤس، إذ يصبح المتعلم بين جحيم الحصول على معدل يخول له الانتقال للمرحلة الجامعية، وبين عائق فهم المادة التي هي الجحيم بعينه بالنسبة له.
أهمية تدريس الفلسفة للأطفال ـ اسماعيل بوزيد
من الأسئلة البديهية التي قد تتبادر إلى أذهاننا، والمتعلقة بتدريس الفلسفة للأطفال، هي من قبيل: لماذا يجب على الأطفال دراسة الفلسفة؟ وحينما نقول تدريس الفلسفة للأطفال، فهل يعني هذا تدريس الفلسفة بشتى مواضيعها كما هو الحال في المستويات التعليمية الأخرى، أم أنّ الأمر يتعلق بتدريس موضوع من موضوعات الفلسفة والتمثل بالخصوص في التفكير النقدي؟ وهل يمكن للطفل أن يتفلسف؟ وما هي الطرق والسبل الممكنة لتدريس الفلسفة للأطفال؟ وما هي النتائج المترتبة عن تدريس الفلسفة للأطفال؟
إذا تأملنا جيداً في الحياة المعيشية للأطفال، فإنّنا نجد أنّ الأطفال فلاسفة عفويون، لأنّهم في الثلاث سنوات الأولى من عمرهم يسألون باستمرار سؤال لماذا؟ إلا أنّنا غالباً لا نشجّع الأطفال على طرح أسئلة من هذا القبيل ومواصلة النقاش حول أشياء لا يعرفونها، بل الأكثر من ذلك نقوم بردع الأطفال، حتى لا يقوموا بطرح تلك الأسئلة التي تشغل أذهانهم.
إنّ عقل الطفل الذي يتساءل ويطلب تبريراً للمعايير المقبولة، يشير إلى البحث الغريزي عن المعنى، أي معنى الأشياء. ويمكن تشجيع هذا المسعى وتوجيهه في اتجاه بناء شخصية متكاملة وقوية للطفل، وهذا هو الجانب الذي يمكن أن تساعد دراسة الفلسفة على تحقيقه. وقد أظهرت الدراسات أنّ الأطفال الذين يدرسون الفلسفة هم الأكثر تحقيقاً لنتائج أكاديمية أفضل، كما يتمتعون بمزايا اجتماعية مثل تحسين احترام الذات وإظهار التعاطف مع الآخرين.
الأسس الأسطورية للنجاح المدرسي : "بِيجماليون" أنموذجا – د. علي أسعد وطفة
بِيجماليون نحات أسطوري إغريقي فاقت شهرته الآفاق، نحت تمثالا لامرأة فائقة الجمال تدعى غالاتيا، فوجد نفسه أمام آية فنية رائعة الجمال، فصعق بجمالها ووقع في حبها وهام بها عشقا، ولما أضناه الحب ونال منه جنون العشق، أشفقت عليه إفروديت Aphrodite إلهة الحب والجمال فوهبت محبوبته الحجرية نسغ الحياة، ليتزوجها وينهل من حبها إلى الأبد.
لقد شكلت هذه الأسطورة السحرية موضوعا أثار اهتمام المفكرين وعلماء الاجتماع، وقد تفتق هذا الاهتمام عن تساؤل جوهري حول القيمة الواقعية لما يعتقده الإنسان ولما يفترضه، وعن إمكانية تحويل الطموحات والأحلام والتوقعات الإنسانية إلى وقائع وحوادث وفعاليات ترتسم في نسق الحياة وتستقيم على دروبها.
وقد اثارت هذه الفكرة الأسطورية اهتمام المفكر وعالم الاجتماع المعروف روبيرت ميلتون Robert MERTON الذي أطلق على هذه الظاهرة النبؤة المتحققة ذاتيا (prophétie auto-réalisatrice) واستحضر حدثا واقعيا يتعلق بإفلاس أحد البنوك في عام 1932 على اثر إشاعة مغرضة ليس لها أساس من الصحة.
وتتمثل الدلالة التربوية لمعادلة بيغاميليون Pygmalion في تحقيق نتائج تربوية تستند إلى مجرد توقعات وتكهنات تتعلق بالمستقبل التربوي للتلاميذ حيث يتحول الافتراض إلى حقيقة تفرض نفسها في مجال الواقع التربوي. فالإنسان يحاول دائما أن يتجلى على منوال الصورة التي يرسمها الآخرون حوله، وتصورات الآخرين قد تفعل فعلها المكين في نفوسنا وعقولنا، فآراء الآخرين حولنا يمكن أن تدمي قلوبنا ويمكن أن تحيينا، وإذا كان الأمر على هذه الدرجة من الأهمية فكيف يمكن أن يكون الأمر بالنسبة لأطفال على مقاعد الدراسة في مواجهة أحكام المعلمين وتقديراتهم التي قد تكون مفرغة من حكمة الصواب. فأحكام المعلم ونواهيه حول المتعلم تمتلك قدرة سحرية تؤثر في شخصية التلميذ وقد تدفعه إلى تحقيق النجاح أو إلى كارثة العدم التربوي إذا كانت مجحفة وقاسية. وما تأثير بيغاميليون إلا صورة لهذه العلاقة التربوية المتشبعة بالأحكام التي يطلقها المعلم على تلامذته وطلابه في داخل الفصل وفي خارجه.
المُتنـمر.. تقريب للصورة ـ حميد بن خيبش
يرتبط التنمر أو (الاستقواء) بالبيئة المدرسية ارتباطا وثيقا، لكونها الحاضنة الأساسية لهذا السلوك العدواني، و الفضاء الأنسب للمُتنمر كي يوقع الأذى النفسي أو الجسدي، أو الإلكتروني في ظل فورة الاتصال، على طلاب ضعاف من حيث القدرة البدنية و العقلية.
ورغم أن الظاهرة تزداد خطورة بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي ألمت بالأسرة العربية، من حيث تراجع الرقابة الأسرية، وهيمنة وسائل الاتصال الحديثة على وجدان الطفل وخياله، وانفرادها بتشكيل مواقفه و تمثلاته، إلا أن المكتبة العربية تشكو من عجز واضح في الدراسات و البحوث الكفيلة برصدها وبحث سبل العلاج. بالمقابل، يكشف المجتمع الغربي عن تراث سيكولوجي مهم في رصد التنمر، وتجميع الإحصاءات وتنويع المقاربات وأدوات التشخيص، لا سيما بعد أن استفحلت المشكلة على نحو مرعب، إذا يؤكد الخبراء أن %20 من مجمل الأطفال الذين يتعرضون للتنمر في الولايات المتحدة، و البالغ عددهم 3،7 ملايين طفل، يعانون من تأثيرات نفسية ودوافع انتحارية متزايدة.
يختلف التنمر عن باقي أشكال العنف في كونه سلوكا هادفا ومتعلَّما، بمعنى أن المتنمر يستحضر نية الاعتداء مسبقا لإظهار سلوك محكوم بتوابع اجتماعية معينة. وبحسب نظرية التعلم الاجتماعي فإن أي طفل يمكنه أن يصبح متنمرا، عن طريق محاكاة نماذج يتسم سلوكها بالعنف، كالأب داخل الأسرة، أو أبطال الرسوم المتحركة والأفلام السينمائية. أما الاتجاه العقلاني فيرى أن مبعث هذا السلوك مرتبط بأفكار منحرفة، وقناعات خاطئة تستلزم مواجهتها عن طريق تغيير ما يسمى بحديث الذات السلبي(1).
الرغبة في التعلّم، فعل التدريس والهدف منه ـ محمد أبرقي
« Si vous ne savez où vous allez, vous arriverez probablement ailleurs »
R.Mager.
درسنا اليوم! بهذه العبارة المثيرة كنّا نحرص على التمهيد لدروسنا،ونرجو منها خلق الفضول العلمي لدى تلاميذنا وتلميذاتنا ،وإثارة الشغف السيكولوجي والمعرفي لديهم،وغالبا ما لا يمكننا أن نتصور مدرسا جيدا وهو مفتقد للاهتمام بمادته الدراسية مع اللاّمبالاة بها وبتلاميذه((L’art d’enseigner, J.Banner et Au.2013.
يستطيع الفرد التعلّم لوحده،ولا يمكننا التعلّم بدلا عنه. بداهة يتفق حولها الجميع، ولكن الممارسة تقول أمرا آخر: ليس من شيء مطلوب سوى إعداد،وتقديم،ثم عرض درسٍ حتى يتمكن التلميذ من التعلّم ومرافقته في ذلك((Apprendre, A.Giordan,1998 .
وبقدر ما تغرقنا أدبيات التربية وعلوم التربية بكثير من التصورات،والنظريات،والمقترحات التجريبية حول التدريس وفق مقاربة الكفايات،مع ما تتسم به من تعددية في التعريف،والدلالة،والتأويل، والتنزيل،وكذا حول التقويم المتلائم معها،فإن الممارسات السائدة تثبت أن السؤال حول مشروعية الحديث عن تجاوز التدريس الموجّه على ضوء الأهداف ما يزال مشروعا،فهل صار فعلا اختيار وتحديد ثم بناء وبلوغ الهدف البيداغوجي(التعلمي) ضمن دائرة المكتسبات النهائية ؟
عقلنة التدريس،والاهتمام بالتحفيز،وبالتعزيز،ثم توفير شروط انبثاق الرغبة في التعلم،هي موضوعات كان التفكير فيها ملازما لتاريخ الفكر التربوي،وانخرط فيه –أكثر من المربين أنفسهم- فلاسفة،وأطباء،ومحللون نفسانيون،وعلماء فيزيزيولوجيا،وبيولوجيا،ولِسنيون،لتعلو في العقد الراهن مساهمة المتخصصين في علوم الأعصاب حاملة وعودا وآمالا جديدة معها،ولأن الإلمام بالجديد يفترض استيعاب السابق (القديم !) والقدرة على الملاءَمة بينهما،نجد مشروعية الحاجة للعودة بين الفينة والأخرى إلى ينابيع التفكير التربوي والبيداغوجيات المؤسِّسة،فاكتساب،وترسيخ،وتقويم الكفايات،يمكن مقارنته بتلك الطريق المترامية والممتدة أمام الفرد،يَسلكُها،ويسير عبرها،وما يعيشه من تجارب تكون فرصا لتطوير كفاياته،كما يمكنه خلالها تعبئة ما يراكمه من موارد في خضم تلك التجارب لمواصلة السير نحو الهدف.
المسرح المدرسي و دوره في بناء الفعل التعليمي التعلمي بالمدرسة الابتدائية ـ عبد الوهاب لمقدمي
توطئة :
إن عبارة المسرح المدرسي تتركب من كلمتين هما : المسرح و المدرسة . فعندما نذكر المسرح تتبادر إلى الذهن الفرحة و المتعة و الفرجة و الترفيه و الترويح عن النفس .. إنه من الفنون الجميلة الممتعة التي بدأت مع حياة الإنسان المبكرة ، و هو مدرسة من مدارس الحياة و حركتها و ديمومتها ، بل هو صورة من صورها . أما المدرسة فهي هيئة اجتماعية رسمية ، تتولى وظيفة تنشئة الأبناء و البنات ، و تعمل على رفع قُدراتهم و مهاراتهم في شتى المجالات ، بما يتيح لهم فرص الاندماج في المجتمع ، فهي تقوم إلى جانب الأسرة و مؤسسات أخرى بوظيفة التنشئة الاجتماعية للفرد ، و زرع القيم لديه ، كما أنها المكان التربوي الذي يهتم بتربية الطفل تربيةً سليمةً من الناحية الحس ـ حركية و العقلية ، و المعرفية و العاطفية ، في إطارٍ من البرامج و المناهج المحددة سلفا ، بهدفِ تكوين شخصيته لتكون متزنة و متوازنة ، و بغايةِ أن تجعل منه المواطن الصالح .
و سنحاول في هذا العرض المقتضب تسليط الضوء على المسرح المدرسي كرافعة أساسية لدعم الفعل التعليمي التعلمي بالمدرسة الابتدائية ، و ذلك من خلال تناول المحاور الآتية :
ـ مقدمة .
ـ تعريف المسرح المدرسي .
ـ أهمية المسرح المدرسي .
ـ أنواع المسرح المدرسي .
ـ أهداف المسرح المدرسي بالمرحلة الابتدائية .
ـ إعداد نص مسرحي .
ـ العمليات المعتمدة لإعداد نص مسرحي .
ـ خاتمة .
خصوصية الجغرافيا وديداكتيكها ـ عبد الرحمان شهبون
إذا كان بناء المنهاج الحالي لمادة الجغرافيا بالمرحلة التأهيلية من التعليم الثانوي، قد ارتكز على خلفية المرجعية الديداكتيكية المؤطرة له وفق التصور الابستيمي الأكاديمي (مجالات الجغرافيا – المفاهيم المهيكلة للخطاب الجغرافي – النهج الجغرافي – الوسائل التعبيرية – الإنتاجات). إلا أن بعض المفاهيم المركزية التي تم تداولها ضمن ثنايا وثيقة التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس التاريخ والجغرافيا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي[1]، ومنها "منهج التفكير المجالي"، ظلت بدون تحديد سياقي وتأطير مفاهيمي، وتوضيح دلالي عميق...
يقدم المقال التالي توضيحا نسبيا لثلاثة مفاهيم مركزية/مفاتيح ضمن الحقل الابستمولوجي والديداكتيكي للجغرافية المدرسية وهي مفاهيم أساسية ومترابطة تنطلق من مفهوم إدراك المجال، إلى مفهوم الاستدلال الجغرافي، وأخيرا منهج التفكير المجالي. المقال هو أصلا ترجمة للفصل السادس من كتاب "أسس البحث في ديداكتيك الجغرافيا" لصاحبة "كريسيان دوديل"[2].
تشكل الجغرافيا المدرسية، موضوعا للمعالجة الديداكتيكية الخاصة، انطلاقا من دراسة إدراك المجال، الاستدلال الجغرافي، ومنهج التفكير المجالي. إن استثمار هذه المواضيع الثلاث هو ضروري لكونه يتضمن الخصائص الأساسية للإشكاليات الجغرافية.
التعليم التكويني والتدريس التربوي ـ د.زهير الخويلدي
"إذا كانت الأزمة في التربية هي أزمة في الحضارة بأسرها ، فإن التربية في حد ذاتها تتحمل مسؤولية هذه الأزمة بصورة كبيرة ،وإن الحل يمكن أن يكون متأتيا منها بقسط كبير"
يحتل التعليم مكانة أساسية في الحياة الإنسانية وتقوم المؤسسات التربوية بإعداد كائنات بشرية حرة بغية القيام بأعمال صالحة في المجتمع وحسن استثمار المحيط وتنظيم العلاقات بين الناس وفق ملكة العقل.
من الجلي أن التربية هي واحدة من الرهانات الكبرى في الحياة الإنسانية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وأن العلاقات بين التعليم والتحضر وبين التمدرس والتمدن وبين طلب العلم وتطوير المجتمع لا يمكن إنكارها.
والآية على ذلك أن التربية المنشودة تسمح للمرء الذي لا يزال يافعا بالنماء والاندماج في المجتمع والتأقلم مع الواقع وأن يصير كهلا مسئولا ضمن نسق ثقافي معين ووسط منظومة قانونية تحكمها دولة مؤسسات.
علاوة على ذلك تكمل المدرسة المجهود الذي تقوم به الأسرة في تربية الأطفال وترافقتهم بلا كلل أو ملل لتخطي مرحلة المراهقة وبلوغ الرشد والحصول من المجتمع على المعارف ومقدرات إنتاجية تقوم ببثها.
موت المدرس وحياة التلميذ ـ يوسف عدنان
قد يبدو للوهلة الأولى ومن خلال إخضاع القارئ العنوان لفعل التأويل، أن نية الكاتب تذهب إلى افتعال مفاضلة ما بين الطرفين: المدرس والمتعلم. لكن من زاوية نقدية، فالمعنى المراد إيصاله يُفهم على نحو معكوس تماما أو على الأقل يرنو إلى مسك العصى من الوسط كما يقول المثل المتداول، دون التحيّز إلى أي طرف. فالحياة المعاصرة -وهو ما ينبغي الانتباه له-تُعلن انقلابا جذريا فكاكا لمجموعة من الارتباطات المحنوطة بثوب القداسة، منها: موت الكاتب وحياة النص، موت الأب وحياة الابن، موت الناقد وحياة المعلّق الافتراضي {...} إلى غير ذلك. وعليه فدلالة العنوان تُبطن تحريضا للوعي لكي يتخلّص من ركام معارفه السابقة ويجيد التنقل بسلاسة بين مجموعة الثنائيات التي أذابها واقعنا الحالي، منها: الأخذ والعطاء، التلقي والفاعلية، السلطة والسلطة المضادة، النموذج والقالب، المؤثر والمتأثر، العارف والمريد، الممثل والمشاهد، العنف الرمزي والعنف المادي {...} الخ، كلها متقابلات تصدق مفاعيلها على العلاقة المحقونة اليوم بين المعلم والمتعلم والتي لا يمكن الاكتفاء بعدّ العنف المدرسي الإفراز الوحيد لها. مادامت الإشكالات التي تطرحها العلاقة التربوية في الحياة المدرسية جد معقدة ومستعصية.
أزمة العزوف عن التعلم ـ عبد اللطيف الركيك
يلاحظ المدرس أحيانا بين أفراد جماعة الفصل الدراسي وجود فئة مهملة ومعرضة عن بناء التعلمات والمشاركة، فيها فيصدر عليها أحكاما قيمية نهائية، وقد يتشكل لديه تمثل سلبي عن مثل هؤلاء الافراد طيلة حياته المهنية، وقد يعمد إلى إقصاء هؤلاء الأفراد او الدخول معهم في مشاحنات تزيد الأمر تعقيدا.
في الواقع مثل هذه الحالات تحتاج إلى تفهم ومعاملة خاصة مهما كان مستوى خروجها عن تعاقدات الجماعة وتأثيرها على اتجاهاتها. قد يحتاج الأمر إلى بحث نفسي واجتماعي يمكن أن يميط اللثام عن ما هو مخفي بما قد يغير نظرة المدرس تماما. العزوف والإعراض العمدي أحيانا والإمعان في ذلك والحرص على إظهاره للمدرس ولجماعة القسم قد تقف خلفه عوامل ذاتية نفسية أو اجتماعية مرتبطة بالمحيط العائلي أو نتيجة هيمنة تمثلات على ذهنية المتعلم، تمثلات سلبية قد تكون خاطئة وقد تكون مبررة ومعقولة. فقبل أن يلج المتعلم حجرة الدرس يجد نفسه محاصرا بجميع هذه العوامل المعرقلة: نظرة متشائمة للمستقبل، مواقف سياسية واجتماعية غير مؤطرة، تمثل سلبي عن المدرسة كفضاء مغلق رسمي وقانوني، عن الإدارة، عن المدرس، عن الجماعة الفصلية، عن المادة...الخ
فهذه اشتراطات قد تغيب عن المدرس، وقد يكون مدركا لها إلا أنه يعتبرها خارجة عن نطاق عمله. وهنا تتعقد مشكلة العزوف أكثر بحيث يمكن أن تعيق السير العادي للدراسة.