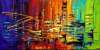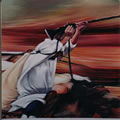 مدخل:
مدخل:الكتابة الشعرية هي فعل ممارسة للواقعية والّلغة. والواقعي هو ما يشغله الشاعر في خلق عمله الشعري ، في فهمه الصافي والمباشر للعالم. فالشاعر، في حال من الأحوال ،هو المتحكم في الدوال التي تنساق له. فضلا عن أنّ الكلام الشعري يفتح المجال واسعا أمام حقل إمكانات اللغة، ويتيح انفتاحا ما على المعنى، نحو مظاهر جديدة من الواقعية التي ينجح في اقتحامها. والواقعي ليس بالضرورة الواقعية ، بالرغم من أن أحد تجلياته الكبرى هو تمثّل الأثر القادم من فيض الواقعية . الواقعي هو دائما ما ننتظر ، على حد تعبير (ه. مالديني) وهو يساهم انطلاقا من المرعب أوالعقدي أوالهدم الذهاني psychotique ، أو اختفاء الموضوع/ الشخص المحبوب. والشعر هو الحاجة الملحاح إلى إثبات الكينونة التي تحفز فعل الإنسان. وهو يعكس في نفس الآن نزعة اللاّتحقق التي تقود الأسراب المدحّنة ، وعزيمة التحقق التي تطول الآخرين ممّن يستطيبون متعة النفوذ، فتقودهم رهانات الخطاطة الجوفاء على حساب الحقيقة الكاملة للكينونة الإنسانية.
وباب الشعر ليس لها مزلاج ولا مفتاح . بيد أنه يظل يقاوم من أجل اللاّنغلاق. ولايستطيع ولوجه إلا السّحرة الأبرياء الذين اعتادوا على نار التطهير. ولقد سئل الشاعر الأرجنتيني الكبير (روبيرتو خواروس ( 1925-1995) على غرار الكثيرين ، حول الكنه العميق للشعر ، فأجاب قائلا: (الشعر ميتالغة تعيد الارتباط بواقع ما... هو مخاتل لكلّ شكل تصنيفي ولكل تحقيق منتظم ، لأنه أكبر من الواقع)(2)
ففي الشّعر تمتد فيزيولوجيا الإدراك و فينمولوجيا التجربة الرؤيوية، في أبعادها النفسية وموضوعاتها ها المنفلتة، بين فيزيقا الواقعي وميتافيزيقا المرئي واللاّ ّمرئي ، لتفتح أما م الشاعر منفذا للعبور إلى سيرورات وظواهر ذهانية تعمل لأجل كشف شعرية الواقعي.
إنّ الحدث الواقعي يتم استيعابه في عالم الشعر "عبر" و"من خلال" مقدمات العمل الشعري. أمّا الواقعي/ الشعري فهو ما لايمكن تجليته. الواقعي هو المباغت الغامض الذي يجتاح الأنا ويأسره. وعليه ، فالمباغتة وفق هنا السّمت الباطني، هي عنصر مشارك للكينونة. ويمكن القول أنّ الواقعية تبدأ من حيث ينتهي الحديث عن الواقعي ، إذا ما اعتبرناه سمة تعبيرية ملازمة للشاعر. الواقعية هي المعنى النثري التي يضفيه قارئ الشعر للملمة الشتات المرجعي للتعبير الشعري . ذلك أنّّ الشعر يدعم الحاجة الجذرية للإنصات للآخر، من خلال إشراكه في عوالم الترميز والإيحاء، وإغوائه بمغازلة المتلاشي المجاور للاّمسمّى، وبالتّالي ، حفزه على كشف القناع وفك الحصار عن عزلته الخجولة.



 تعريف الرومانسية:
تعريف الرومانسية: موضوع الشهرة أو الانتشار الذي يحصده بعض المشتغلين في الحقل الرمزي دون سواهم من الظواهر الإنسانية الأكثر استشكالا ، يتجنب الكثيرون الخوض فيه ، ويربط البعض ممن يقدم على ذلك الشهرة بالعبقرية أو الذكاء الخارق أو النبوغ أو ما شابه هذه الصفات ، و التي و إن كانت تلامس التفسير ، فإنها لا تمسك به. بينما يرد البعض الانتشار بشكل ميكانيكي تبسيطي إلى عوامل من خارج الحقل الرمزي، من الحقل السياسي في الغالب، و من الحقلين الاقتصادي و الإعلامي في حالات عديدة، و من الحقول الثلاثة مجتمعة و متداخلة في أحسن الأحوال. و ضمن كل هذه الأنماط من قراءة ظاهرة الشهرة ، تبقى المنتوجات الرمزية التي من خلالها و بها تحقق الانتشار لصاحبه بعيدة عن كل نبش و حفر و تفكيك ، و الحال أن في ثناياها و بين تضاريسها يوجد التفسير ، أو على الأقل الجزء الأهم منه.
موضوع الشهرة أو الانتشار الذي يحصده بعض المشتغلين في الحقل الرمزي دون سواهم من الظواهر الإنسانية الأكثر استشكالا ، يتجنب الكثيرون الخوض فيه ، ويربط البعض ممن يقدم على ذلك الشهرة بالعبقرية أو الذكاء الخارق أو النبوغ أو ما شابه هذه الصفات ، و التي و إن كانت تلامس التفسير ، فإنها لا تمسك به. بينما يرد البعض الانتشار بشكل ميكانيكي تبسيطي إلى عوامل من خارج الحقل الرمزي، من الحقل السياسي في الغالب، و من الحقلين الاقتصادي و الإعلامي في حالات عديدة، و من الحقول الثلاثة مجتمعة و متداخلة في أحسن الأحوال. و ضمن كل هذه الأنماط من قراءة ظاهرة الشهرة ، تبقى المنتوجات الرمزية التي من خلالها و بها تحقق الانتشار لصاحبه بعيدة عن كل نبش و حفر و تفكيك ، و الحال أن في ثناياها و بين تضاريسها يوجد التفسير ، أو على الأقل الجزء الأهم منه.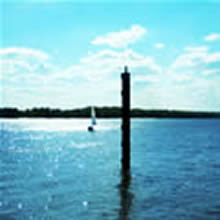 يتفق علماء السرد (Narratology) على أن اغلب قراء القصة القصيرة يشهدون بأن القص الجميل يمكن أن يصل إلى أعلى مراتب الفنون، وخاصة عندما يقبض موضوعها على هم إنساني كبير. فالقاص المجيد يطول بقلمه ما تطوله الفنون الأخرى، تقنية وإخراجا حيث يقود قصته شكلا ومضمونا لما تصل إليه تقنيات التكنولوجيا في السينما الحديثة، ويستطيع ان يحملها موسيقى هائلة، ويوقعها في نفس قارئه، وتظل تلازمه حتى وان انتهت القراءة فالنص الجميل سوف يبقى في الذهن يطارد قارئه، يمسك به لأجل أن يعود إليه مستدرجا اللذة إلى كمّها الأخير.. (فإذا كان الحب يعمي عن المساوئ، فالبغض أيضا يعمي عن المحاسن. وليس يعرف حقائق مقادير المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور، إلا عالم حكيم، ومعتدل الأغلاط عليم، والقوي المنة، الوثيق العقدة، والذي لا يميل مع ما يستمل الجمهور الأعظم، والسواد الأكبر- الجاحظ)، فإذ تتشكل كل مرة بمنظور جديد، وتعطي ذاتها كل مرة معاصرة لأحداث قد تنبأ النص بها، فالذهن يقارن اليوم وغداً، ويستشرف دائماً من خلال الإبداع، المهارة، والاستباق.. وقد اثبت المبدع (حسن كريم عاتي) في كتابه الصادر عن دار الشؤون الثقافية (2007م)، الموسوم بـ(عزف منفرد) بان فن القصة يستطيع ان ينافس الفنون الأخرى، شكلا ومضمونا إن توافر على مادة شيقة قد تكامل فيها كل ما يؤشر لصالح الكتابة المبدعة، حيث جاءت القصص (ألاثني عشر) بلغة متينة ارتقت إلى التعدد في المعنى، لتقرأ أكثر من مرة بتمحيص بحثا عن الاكتشاف الممتع لما فيها من جهد أنساني رفيع يبشر بتأشير جليل على خريطة الإبداع العراقي المتمكن، فتبلورت في جملة جماليات مقتدرة أجادها القاص المتمكن من سرد استنبط الأسس التي قامت بعقلانية من خلال نظم واضحة التعبير حكمت نتاجه وتلقيه.. في قص يأخذ القارئ ليركب بحرا عظيم اللجّة متلاطم الأمواج، ما بين موت محدق، وحياة حرّة كريمة..قصة مواجهه ذئب جسور وأنثاه الشرسة.. بتحدّ هائل الوقع أتقن القاص تصويره بموضوعية حاسمة دقيقة التفصيل… فـ(القصة الأولى- ليل الذئاب) بدأت فيها أنثى الذئب بالعواء التواصل لأجل ذكرها المقتول في غارة على قطيع تعودا النهش فيه كل ليلة حدّ الفناء.. ذئبان قويا الشكيمة، هما اللذان شكلا خطرا بليغا على الإنسان، وكلبه، وقطيعه.. بعد أن تعودا على إهانة ملكيته، وهدر كرامته، صار الصراع حتميا لن ينتهي إلا بالفصل القائم بالسلاح المواجه بكل مشروعيه، وعقلانية.. مصرا فيها الإنسان على احتراف قدره العظيم في الغلبة الدائمة على ظهر هذه البسيطة.. حيث يحفر حفرة دفاع أعدت بعد تفكير ملي.. لذلك الشأن وبقي بداخلها في ليل طويل ماطر، متشبثاً بالبندقية حبل خلاصه الذي لا يريم، إذ يصيب مقتلا في إلتماع العينين المتوقدة بالفتك.. بعد صبر، وخبرة الأربعين الرصينة.
يتفق علماء السرد (Narratology) على أن اغلب قراء القصة القصيرة يشهدون بأن القص الجميل يمكن أن يصل إلى أعلى مراتب الفنون، وخاصة عندما يقبض موضوعها على هم إنساني كبير. فالقاص المجيد يطول بقلمه ما تطوله الفنون الأخرى، تقنية وإخراجا حيث يقود قصته شكلا ومضمونا لما تصل إليه تقنيات التكنولوجيا في السينما الحديثة، ويستطيع ان يحملها موسيقى هائلة، ويوقعها في نفس قارئه، وتظل تلازمه حتى وان انتهت القراءة فالنص الجميل سوف يبقى في الذهن يطارد قارئه، يمسك به لأجل أن يعود إليه مستدرجا اللذة إلى كمّها الأخير.. (فإذا كان الحب يعمي عن المساوئ، فالبغض أيضا يعمي عن المحاسن. وليس يعرف حقائق مقادير المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور، إلا عالم حكيم، ومعتدل الأغلاط عليم، والقوي المنة، الوثيق العقدة، والذي لا يميل مع ما يستمل الجمهور الأعظم، والسواد الأكبر- الجاحظ)، فإذ تتشكل كل مرة بمنظور جديد، وتعطي ذاتها كل مرة معاصرة لأحداث قد تنبأ النص بها، فالذهن يقارن اليوم وغداً، ويستشرف دائماً من خلال الإبداع، المهارة، والاستباق.. وقد اثبت المبدع (حسن كريم عاتي) في كتابه الصادر عن دار الشؤون الثقافية (2007م)، الموسوم بـ(عزف منفرد) بان فن القصة يستطيع ان ينافس الفنون الأخرى، شكلا ومضمونا إن توافر على مادة شيقة قد تكامل فيها كل ما يؤشر لصالح الكتابة المبدعة، حيث جاءت القصص (ألاثني عشر) بلغة متينة ارتقت إلى التعدد في المعنى، لتقرأ أكثر من مرة بتمحيص بحثا عن الاكتشاف الممتع لما فيها من جهد أنساني رفيع يبشر بتأشير جليل على خريطة الإبداع العراقي المتمكن، فتبلورت في جملة جماليات مقتدرة أجادها القاص المتمكن من سرد استنبط الأسس التي قامت بعقلانية من خلال نظم واضحة التعبير حكمت نتاجه وتلقيه.. في قص يأخذ القارئ ليركب بحرا عظيم اللجّة متلاطم الأمواج، ما بين موت محدق، وحياة حرّة كريمة..قصة مواجهه ذئب جسور وأنثاه الشرسة.. بتحدّ هائل الوقع أتقن القاص تصويره بموضوعية حاسمة دقيقة التفصيل… فـ(القصة الأولى- ليل الذئاب) بدأت فيها أنثى الذئب بالعواء التواصل لأجل ذكرها المقتول في غارة على قطيع تعودا النهش فيه كل ليلة حدّ الفناء.. ذئبان قويا الشكيمة، هما اللذان شكلا خطرا بليغا على الإنسان، وكلبه، وقطيعه.. بعد أن تعودا على إهانة ملكيته، وهدر كرامته، صار الصراع حتميا لن ينتهي إلا بالفصل القائم بالسلاح المواجه بكل مشروعيه، وعقلانية.. مصرا فيها الإنسان على احتراف قدره العظيم في الغلبة الدائمة على ظهر هذه البسيطة.. حيث يحفر حفرة دفاع أعدت بعد تفكير ملي.. لذلك الشأن وبقي بداخلها في ليل طويل ماطر، متشبثاً بالبندقية حبل خلاصه الذي لا يريم، إذ يصيب مقتلا في إلتماع العينين المتوقدة بالفتك.. بعد صبر، وخبرة الأربعين الرصينة.
 يعتبر الوشم تقليدا طقوسيا عريقا وموغلا في الثقافة الأمازيغية، وغالبا ما يرتبط بالنظام القيمي أو الثقافي لدى المجتمع الأمازيغي الذي مارسه، أو بتقاليده ومعتقداته وديانته، فالإنسان الأمازيغي كان يعيش في عالم من الرموز والعلامات والقوانين التي يقصد بها التأكيد على انتمائه إلى هويته الأمازيغية، فهو إذن أسلوب ذو مضمون ثقافي أو ديني أو إجتماعي له علاقة وثيقة بالتفكير الأسطوري أو الفلكلوري كما يمكن أن يكون ذا مضمون جنسي ـ كما سنرى ـ خاصة عند المرأة الأمازيغية التي تتزين بالوشم في غياب المساحيق الملونة قصد التميز عن الرجل (1) ، ولقد ظل الوشم عبر العصور برموزه وأشكاله وخطوطه من بين أهم وسائل الزينة وتجلياتها القارة والدائمة على أجزاء معينة من جسد المرأة خاصة الوجه واليدين والرجلين(2). ويكتسي الوشم في ظاهره وباطنه دلالات عديدة وعميقة، فهو يأخذ من جسم الانسان فضاء للتدوين والكتابة ولوحة للرسم والخط (3). تقول الشاعرة الأمازيغية في هذا الصدد:
يعتبر الوشم تقليدا طقوسيا عريقا وموغلا في الثقافة الأمازيغية، وغالبا ما يرتبط بالنظام القيمي أو الثقافي لدى المجتمع الأمازيغي الذي مارسه، أو بتقاليده ومعتقداته وديانته، فالإنسان الأمازيغي كان يعيش في عالم من الرموز والعلامات والقوانين التي يقصد بها التأكيد على انتمائه إلى هويته الأمازيغية، فهو إذن أسلوب ذو مضمون ثقافي أو ديني أو إجتماعي له علاقة وثيقة بالتفكير الأسطوري أو الفلكلوري كما يمكن أن يكون ذا مضمون جنسي ـ كما سنرى ـ خاصة عند المرأة الأمازيغية التي تتزين بالوشم في غياب المساحيق الملونة قصد التميز عن الرجل (1) ، ولقد ظل الوشم عبر العصور برموزه وأشكاله وخطوطه من بين أهم وسائل الزينة وتجلياتها القارة والدائمة على أجزاء معينة من جسد المرأة خاصة الوجه واليدين والرجلين(2). ويكتسي الوشم في ظاهره وباطنه دلالات عديدة وعميقة، فهو يأخذ من جسم الانسان فضاء للتدوين والكتابة ولوحة للرسم والخط (3). تقول الشاعرة الأمازيغية في هذا الصدد: السكين لا القلم هو ما يكتب به محمد الماغوط أعماله، سواء كانت تلك قصائد أو مقالات أو مسرحيات، وهو يعمل القلم في ذلك الجزء الذي يبدو سليما من الجسد وينكأ الجراح المنتشرة فيه حتى لا تكون هناك راحة واسترخاء، وحتى لا تكون هناك طمأنينة إلى أن الجسد سليم معافى، فالجسد ليس سليما، بل مريض مثخن بالجراح من الرأس حتى أخمص القدم، والتغافل عن هذه الحقيقة يعني مزيدا من الجراح ومزيدا من الخراب.
السكين لا القلم هو ما يكتب به محمد الماغوط أعماله، سواء كانت تلك قصائد أو مقالات أو مسرحيات، وهو يعمل القلم في ذلك الجزء الذي يبدو سليما من الجسد وينكأ الجراح المنتشرة فيه حتى لا تكون هناك راحة واسترخاء، وحتى لا تكون هناك طمأنينة إلى أن الجسد سليم معافى، فالجسد ليس سليما، بل مريض مثخن بالجراح من الرأس حتى أخمص القدم، والتغافل عن هذه الحقيقة يعني مزيدا من الجراح ومزيدا من الخراب. "أبو سلمى".. هو عبد الكريم سعيد علي المنصور الكرمي. وإذا كانت كنية "الكرمي" تنسبه إلى بلدته الفلسطينية طولكرم التي أنجبته ذات يوم صيفي من عام 1909، فإن مدينة حيفا كانت حبه الأثير. فهو محاميها الشهير، وشاعرها الوفي. وتقتضي الأمانة الموضوعية أن نشير إلى أنه اختار لحيفا ضرّة عربية هي دمشق. فقد درس فيها المرحلة الثانوية. ثم لجأ من حيفا إليها بعد نكبة 1948، وعلى كثرة أسفاره في الدنيا شاعراً ومعرّفاً بالقضية الفلسطينية، فإنه لم يغير عنوانه الدمشقي، حتى بعد أن أغمض عينيه إلى الأبد في الحادي عشر من الشهر العاشر للعام 1980 في العاصمة الأمريكية، بين يديّ ولده الوحيد، الدكتور سعيد الكرمي، الذي حرص على نقله، بناءً على وصيته، إلى دمشق، حيث شهدت العاصمة السورية، في وداعه، واحداً من أكبر مواكب التشييع في تاريخها، وبدت مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك وكأنها ساحة يوم القيامة. وكان أبو سلمى من أسرة علم وأدب. فأبوه الشيخ سعيد من العلماء الأجلاء واللغويين الثقات وكان عضواً مؤسساً في المجمع العلمي العربي. أما أخوه أحمد شاكر الكرمي فكان من الصحفيين العرب الرواد ومن وجوه الوطنية والقومية حتى أن دمشق أطلقت إسمه على أحد شوارعها. وبرز أخوه حسن الكرمي "أبو زياد" كراوية علاّمة، وحقق شهرة مدوية من خلال برنامج "قول على قول" الذي كان يعدّه ويقدمه بصوته من إذاعة لندن. ارتبط أبو سلمى برفيقة عمره، المناضلة رقية حقي في عام 1935وقد تم الزواج في مدينتها عكا. ولم ينجبا "سلمى" ولكنه كان ينادى بأبي سلمى، لأسباب شعرية، منذ أن كان يدرس في معهد عنبر أيام المرحلة الثانوية في دمشق. وقد شكل أبو سلمى مع إبراهيم طوقان وجلال زريق ثلاثياً ظريفاً في الحياة والشعر. ولا يزال الرواة يتناقلون شفوياً قصائدهم الماجنة المازحة بألفاظها المكشوفة، وكثيراً ما لا يميز الرواة، في هذا المجال، بين ما كتبه إبراهيم وما كتبه أبو سلمى.
"أبو سلمى".. هو عبد الكريم سعيد علي المنصور الكرمي. وإذا كانت كنية "الكرمي" تنسبه إلى بلدته الفلسطينية طولكرم التي أنجبته ذات يوم صيفي من عام 1909، فإن مدينة حيفا كانت حبه الأثير. فهو محاميها الشهير، وشاعرها الوفي. وتقتضي الأمانة الموضوعية أن نشير إلى أنه اختار لحيفا ضرّة عربية هي دمشق. فقد درس فيها المرحلة الثانوية. ثم لجأ من حيفا إليها بعد نكبة 1948، وعلى كثرة أسفاره في الدنيا شاعراً ومعرّفاً بالقضية الفلسطينية، فإنه لم يغير عنوانه الدمشقي، حتى بعد أن أغمض عينيه إلى الأبد في الحادي عشر من الشهر العاشر للعام 1980 في العاصمة الأمريكية، بين يديّ ولده الوحيد، الدكتور سعيد الكرمي، الذي حرص على نقله، بناءً على وصيته، إلى دمشق، حيث شهدت العاصمة السورية، في وداعه، واحداً من أكبر مواكب التشييع في تاريخها، وبدت مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك وكأنها ساحة يوم القيامة. وكان أبو سلمى من أسرة علم وأدب. فأبوه الشيخ سعيد من العلماء الأجلاء واللغويين الثقات وكان عضواً مؤسساً في المجمع العلمي العربي. أما أخوه أحمد شاكر الكرمي فكان من الصحفيين العرب الرواد ومن وجوه الوطنية والقومية حتى أن دمشق أطلقت إسمه على أحد شوارعها. وبرز أخوه حسن الكرمي "أبو زياد" كراوية علاّمة، وحقق شهرة مدوية من خلال برنامج "قول على قول" الذي كان يعدّه ويقدمه بصوته من إذاعة لندن. ارتبط أبو سلمى برفيقة عمره، المناضلة رقية حقي في عام 1935وقد تم الزواج في مدينتها عكا. ولم ينجبا "سلمى" ولكنه كان ينادى بأبي سلمى، لأسباب شعرية، منذ أن كان يدرس في معهد عنبر أيام المرحلة الثانوية في دمشق. وقد شكل أبو سلمى مع إبراهيم طوقان وجلال زريق ثلاثياً ظريفاً في الحياة والشعر. ولا يزال الرواة يتناقلون شفوياً قصائدهم الماجنة المازحة بألفاظها المكشوفة، وكثيراً ما لا يميز الرواة، في هذا المجال، بين ما كتبه إبراهيم وما كتبه أبو سلمى. " قراءة في أضمومة ( اشتهاء)1 لمحمّد الهلالي "
" قراءة في أضمومة ( اشتهاء)1 لمحمّد الهلالي "