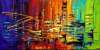تعـود قراءتي لرواية " السـّّد " للأستاذ محمود المسعدي إلى أواخر السبعيــنيات من خلال سلسلة دار " عيون المعاصرة " الصادرة فــى تونـس ، وأود قــبل الولـوج في قراءة جديدة لهذا العمل الإبداعي الجميل الذى قال عنه الأستاذ " توفيق بكار "المسؤول عن السلسلة ، لا يزال السّد إلى اليوم يتيم دهره ، نصًا وحيدًا غريـباً كأول عهده، أن أنوه الى نــقطة هــامة ذات علاقــة بـهذا العمل الفريد فــى الأدب العربـي المعاصر تقنية ولغة ، بأنه عنذ إقتنائي نسخة من طبعتها الجديدة ، الصادرة عن نفس الدار عام 1992 بعد ضــياع نسختى القديــمة في حلي وترحالي ، لفــت نــظري أن أستاذنا توفيق بكار قد حذف التقديم لهذه الرواية لعميد الأدب العربي "طه حسين " كان قد دبج بها الطــبعة الأولى ، ولا نـدري ســبباً لذلك الحذف ، خاصة وان الأسـتاذ بكـار يدرك أن مقدمة طه حســين لعــمل الأسـتاذ المسعدي لها بعُد آخر يتمــثل فــى الظاهرة التعبيرية " للمحاكاة " كإبداعات ملحقة لجوهر العمل الأصلي ، الذى أراه من وجــهة نظري الاندماج الاختياري للروح العربــية بطابع مشــترك لشخصيـتين تتعانقان في تاريخ الأدب العربي المعاصر ، لتكونا المعنى المقصود مـن النـثر الفـني بوجهــيه العام والخاص ، فاستاذنا توفيــق بكار الذى يتمــتع بحس مرهــف ، ولغة راقــية عنذ تــقديمه للعــديد من الأعمال ذات الطــابع الفلسفي ، يرمي إلى الاجتــهاد والإبانة وتأدية الجــهد فى صــيغة فنية ، وهوما أعــتبره بحذفه لهذه المــقدمة بمــثابة الفصل التعـسفي بيــن مضمون إبــداعي راق لعمل واحد يلــتقي في الشرق العربــي بمغربه، في بُعد مكــمل لبعضه ، وما أملنا إلا أن نـرى في طبعاته القادمة ، وقد وجد الأستاذ بكار هذين العنصرين المهمـين في إبداعهما، باعتــبار أن مقدمة طه حســين جزء مكمل لهذا العمل الإبداعي .
تعـود قراءتي لرواية " السـّّد " للأستاذ محمود المسعدي إلى أواخر السبعيــنيات من خلال سلسلة دار " عيون المعاصرة " الصادرة فــى تونـس ، وأود قــبل الولـوج في قراءة جديدة لهذا العمل الإبداعي الجميل الذى قال عنه الأستاذ " توفيق بكار "المسؤول عن السلسلة ، لا يزال السّد إلى اليوم يتيم دهره ، نصًا وحيدًا غريـباً كأول عهده، أن أنوه الى نــقطة هــامة ذات علاقــة بـهذا العمل الفريد فــى الأدب العربـي المعاصر تقنية ولغة ، بأنه عنذ إقتنائي نسخة من طبعتها الجديدة ، الصادرة عن نفس الدار عام 1992 بعد ضــياع نسختى القديــمة في حلي وترحالي ، لفــت نــظري أن أستاذنا توفيق بكار قد حذف التقديم لهذه الرواية لعميد الأدب العربي "طه حسين " كان قد دبج بها الطــبعة الأولى ، ولا نـدري ســبباً لذلك الحذف ، خاصة وان الأسـتاذ بكـار يدرك أن مقدمة طه حســين لعــمل الأسـتاذ المسعدي لها بعُد آخر يتمــثل فــى الظاهرة التعبيرية " للمحاكاة " كإبداعات ملحقة لجوهر العمل الأصلي ، الذى أراه من وجــهة نظري الاندماج الاختياري للروح العربــية بطابع مشــترك لشخصيـتين تتعانقان في تاريخ الأدب العربي المعاصر ، لتكونا المعنى المقصود مـن النـثر الفـني بوجهــيه العام والخاص ، فاستاذنا توفيــق بكار الذى يتمــتع بحس مرهــف ، ولغة راقــية عنذ تــقديمه للعــديد من الأعمال ذات الطــابع الفلسفي ، يرمي إلى الاجتــهاد والإبانة وتأدية الجــهد فى صــيغة فنية ، وهوما أعــتبره بحذفه لهذه المــقدمة بمــثابة الفصل التعـسفي بيــن مضمون إبــداعي راق لعمل واحد يلــتقي في الشرق العربــي بمغربه، في بُعد مكــمل لبعضه ، وما أملنا إلا أن نـرى في طبعاته القادمة ، وقد وجد الأستاذ بكار هذين العنصرين المهمـين في إبداعهما، باعتــبار أن مقدمة طه حســين جزء مكمل لهذا العمل الإبداعي .أقول بعد هذه المقدمة الضرورية إن من خلال قراءتي لنص الأستاذ المسعـدي السّد قد اضناني ذلك الصراع بين المأساة والزمن ، ليكونا صدمة حضارية مشبعة بـذلك الهم الإنساني المتجدر في شخوص الرواية الحاملة لأسماء جاهلية ميمونة ، غيلان
مياري ليخترق المفهوم المسيحي ، الذى يلتــئم ضمن التتابع للفاجعة العــبرية التــى نسجت من خلال التوراة ليحاصرها في بعدها المسيحي مــن خلال المسيح ، ليعانـق في النهاية ملامح المأساة اليونانية .



 لمّا مات جميل بن معمر وبلغَ بثينةَ نعيهُ , أنشدتْ هذين البيتين كعهدِ وفاء :
لمّا مات جميل بن معمر وبلغَ بثينةَ نعيهُ , أنشدتْ هذين البيتين كعهدِ وفاء : في المدة ما بين يونيو/حزيران 2005 وحتى يوليو/تموز 2007 كتبت سلمى صلاح القصص التالية: حتى الوسادة، حكيم وكنز وأشياء أخرى، السيارة التي بدأت الأمر والأخرى التي أنهته، بلل، 45 درجة في الظل، ثعلب، فتاة المنضاد، عندما تختارين جحيم عدن، حُليها، سد، عيد للعب، دوائر خفية، انتصار، خروج. ثم كونت هذه القصص المجموعة القصصية الأولى لها باسم "خروج" وصدرت عن دار ملامح في القاهرة ورسم غلافها عمر مصطفى، وفوتوغرافيا عادل واسيلى.
في المدة ما بين يونيو/حزيران 2005 وحتى يوليو/تموز 2007 كتبت سلمى صلاح القصص التالية: حتى الوسادة، حكيم وكنز وأشياء أخرى، السيارة التي بدأت الأمر والأخرى التي أنهته، بلل، 45 درجة في الظل، ثعلب، فتاة المنضاد، عندما تختارين جحيم عدن، حُليها، سد، عيد للعب، دوائر خفية، انتصار، خروج. ثم كونت هذه القصص المجموعة القصصية الأولى لها باسم "خروج" وصدرت عن دار ملامح في القاهرة ورسم غلافها عمر مصطفى، وفوتوغرافيا عادل واسيلى.  كثيرةٌ هي الروايات التي أمرُّ بها عرضاً, كما تمرُّ الريح الجنوبية في أغنيةِ الشاعر الإنجليزي شلي, وأكثرُ منها الدواوين الشعرية, المتأرجحةِ في مدىً من التلاشي والانسياحِ المتوَّهم, من دون أن أجنيَ منها قطرة رحيقْ.
كثيرةٌ هي الروايات التي أمرُّ بها عرضاً, كما تمرُّ الريح الجنوبية في أغنيةِ الشاعر الإنجليزي شلي, وأكثرُ منها الدواوين الشعرية, المتأرجحةِ في مدىً من التلاشي والانسياحِ المتوَّهم, من دون أن أجنيَ منها قطرة رحيقْ. وجوه ووجوه:
وجوه ووجوه: السرد الذي يحمل قيمة الشعر دون زخرفة لغوية أو إيقاعية واضحة هو التقنية الأهم ومفتاح الحالة الإنسانية التي يخلفها بداخلك الديوان الذي يجعل من القارئ/منا شركاء فى الديوان الذي يتحدث عن حالاتنا العادية وإنهزاماتنا البسيطة ظاهريا الكارثية داخليا ومعنويا التي تستطيع أن تقبض عليها في ديوان حارس الفنار العجوز الصادر عن الدار في القاهرة كديوان خامس للشاعر عزمي عبد الوهاب حيث صدر له من قبل.. النوافذ لا اثر لها عن صندوق التنمية الثقافية في مصر.. والأسماء لاتليق بالأماكن عن المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة..وبأكاذيب سوداء كثيرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة ...و بعد ذلك خروج الملاك مباشرة عن دار ميريت للنشر والمعلومات في القاهرة.
السرد الذي يحمل قيمة الشعر دون زخرفة لغوية أو إيقاعية واضحة هو التقنية الأهم ومفتاح الحالة الإنسانية التي يخلفها بداخلك الديوان الذي يجعل من القارئ/منا شركاء فى الديوان الذي يتحدث عن حالاتنا العادية وإنهزاماتنا البسيطة ظاهريا الكارثية داخليا ومعنويا التي تستطيع أن تقبض عليها في ديوان حارس الفنار العجوز الصادر عن الدار في القاهرة كديوان خامس للشاعر عزمي عبد الوهاب حيث صدر له من قبل.. النوافذ لا اثر لها عن صندوق التنمية الثقافية في مصر.. والأسماء لاتليق بالأماكن عن المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة..وبأكاذيب سوداء كثيرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة ...و بعد ذلك خروج الملاك مباشرة عن دار ميريت للنشر والمعلومات في القاهرة. يكاد يكون الاقتراب من عالم محمد السرغيني الشعري مغامرة غير محسوبة العواقب، ذلك أن الدخول إلى محراب تجربته الشعرية يحتاج إلى التسلح بمعرفة دقيقة وشاملة، وإدراك واع لغير قليل من المعارف والعلوم. ذلك أن صرح عالمه الشعري متماسك البناء، ومتنوع الأصول، وغني بحمولات معرفية، وثري بالرموز والدلالات. ولعل مرد ذلك إلى أن الشاعر متعدد الاهتمامات، ومختلف المشارب باعتباره: شاعرا إنسانا، وباحثا أكاديميا، وناقدا متمرسا، ومفكرا متأملا، ولغويا فذا، ومتصوفا سابحا في ملكوت الحلاج وابن عربي وجلال الرومي وابن سبعين… فكل هذا هو محمد السرغيني الذي يصدق عليه القول:
يكاد يكون الاقتراب من عالم محمد السرغيني الشعري مغامرة غير محسوبة العواقب، ذلك أن الدخول إلى محراب تجربته الشعرية يحتاج إلى التسلح بمعرفة دقيقة وشاملة، وإدراك واع لغير قليل من المعارف والعلوم. ذلك أن صرح عالمه الشعري متماسك البناء، ومتنوع الأصول، وغني بحمولات معرفية، وثري بالرموز والدلالات. ولعل مرد ذلك إلى أن الشاعر متعدد الاهتمامات، ومختلف المشارب باعتباره: شاعرا إنسانا، وباحثا أكاديميا، وناقدا متمرسا، ومفكرا متأملا، ولغويا فذا، ومتصوفا سابحا في ملكوت الحلاج وابن عربي وجلال الرومي وابن سبعين… فكل هذا هو محمد السرغيني الذي يصدق عليه القول: التراث الشعبي العربي عند ألفريد فرج هو المادة الخام الأساسية التي بنى عليها معظم نتاجه المسرحي، ومحطاته الكبرى كانت عند حكايات ألف ليلة وليلة، ومنها استمد عددا من أعماله المسرحية الهامة. والسؤال هل يمكن أن يكون المسرح تعليميا، وأن يكون هدفه الأوحد تغيير العالم؟ ليس السؤال مطروحا على فناني المسرح وحدهم بطبيعة الحال، لكن المسرح هو الفن الأكثر قدرة على صياغة الأسئلة وطرحها، وتقديم إجابات لها، كل حسب موقعه، وحسب ما يتوفر له من معطيات، وهو كذلك فن جماعي مركب، لا بد له من جماعة متآلفة من فنانين، وفنيين حتى يكتسب حياته فوق الخشبة، والحديث عن مسرح "ألفريد فرج" له جوانب متعددة، وقبل الشروع فيها لا بد من الحديث عن الواقع الذي نشأ له هذا المسرح.
التراث الشعبي العربي عند ألفريد فرج هو المادة الخام الأساسية التي بنى عليها معظم نتاجه المسرحي، ومحطاته الكبرى كانت عند حكايات ألف ليلة وليلة، ومنها استمد عددا من أعماله المسرحية الهامة. والسؤال هل يمكن أن يكون المسرح تعليميا، وأن يكون هدفه الأوحد تغيير العالم؟ ليس السؤال مطروحا على فناني المسرح وحدهم بطبيعة الحال، لكن المسرح هو الفن الأكثر قدرة على صياغة الأسئلة وطرحها، وتقديم إجابات لها، كل حسب موقعه، وحسب ما يتوفر له من معطيات، وهو كذلك فن جماعي مركب، لا بد له من جماعة متآلفة من فنانين، وفنيين حتى يكتسب حياته فوق الخشبة، والحديث عن مسرح "ألفريد فرج" له جوانب متعددة، وقبل الشروع فيها لا بد من الحديث عن الواقع الذي نشأ له هذا المسرح.