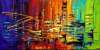1- تقديم:
1- تقديم:لقد أخذ الحديث عن المكان في الشعر العربي أبعادا مختلفة، بحسب زوايا الرؤية التي عالجته من جهة، وبحسب الفهم الذي أنيط به من جهة ثانية،وبحسب المعارف الرافدة التي تؤثث الدراسة. وكل مقاربة للمكان من هذه المنازع إنما قدمت نتائجها الدقيقة التي أعطت للمكان ثقله الفني في البناء الشعري شكلا ومضمونا، حتى غدت مقولة المكان من الخطورة ما يجعلها موضوعة تتشعب إلى رؤى ذات طبيعة ميتافيزيقية، بعدما كانت تدرك فقط في الحدود الجغرافية والاجتماعية والنفسية. ذلك أن المكان في صلته بالذات المبدعة والمتلقية، يتخذ من الصفات المتشابكة ما يجعله من المقولات الأكثر تعقيدا على مستوى المعنى والمبنى. وأن فك هذه العلاقات يقتضي من الدرس التحليلي أن يسترفد سائر المعارف التي أنتجتها العلوم الإنسانية لفك ألغازه، حتى تفضي إلى الحقيقة التي من أجلها سيق المكان في الشعر موضوعا، أو إشارة، أو رمزا.
2-الموضوع، النداء والتلقي:
فإذا كانت الدراسات الواقعية قد رأت في المكان " شيئا " يتحدد وجوده في إطار الواقع، بعين المواصفات الخارجية التي تمتلكها الأشياء، فإنه في الدرس النفساني يستحيل إلى " تمثيل" و " تصور " وكأن المسألة عند هؤلاء تفترق عن الشيء الغفل ذي المادة الصلبة، إلى لون من التصور الذي يحدث على مستوى النفس فقط، حين يجعلها تتمثل من خلال المكان جملة من الأحاسيس والمشاعر التي ربما أثارها المكان بمحمولاته التذكُّرية، التي لها صلة بالذات في لحظة من لحظاتها السالفة. والتمثيل يحيل المكان على عملية القلب التي ترتفع بالمكان من الوجود الفعلي إلى الوجود المتصور في أعماق الذات. فليس القصد من ورائه عرضه موضوعا جماليا، بل الغرض في اعتباره محولا يمكِّن الذات من التقاط المشاعر والأحاسيس، مما يفيض عن المكان، وهو يندرج ضمن البناء الفني عموما. فإذا آنسنا من الموقف الواقعي تطرفا في التعامل مع المكان، تطرفا يجعله شبيها بأي شيء آخر.فإن التطرف عينه نلحظه عند النفسانيين وهم يحاولون جعل المكان مجرد تمثيل، تُسلب منه خاصية الموضوع المستقل بذاته، ليكون أيقونا على إحساس ما يعتم في أعماق الذات.



 منذ ظهرَ الديوان الأول للشاعر محمد الماغوط: "حزن في ضوء القمر" عام 1959، ثم ديوانه الثاني: "غرفة بملايين الجدران" 1960، و"الفرح ليس مهنتي" عام 1970، كان الماغوط قد رسخ بقوة أسلوباً شعرياً جديداً من حيث الشكل والمضمون.. لقد كتب الماغوط المسرحية، والزاوية الصحفية، وكتب للسينما وللتلفزيون كما كتب رواية "الأرجوحة" إلا أنه في كل كتاباته ظلّ الشاعر الذي لا يمكن النظر إليه إلا من جهة الشعر!..
منذ ظهرَ الديوان الأول للشاعر محمد الماغوط: "حزن في ضوء القمر" عام 1959، ثم ديوانه الثاني: "غرفة بملايين الجدران" 1960، و"الفرح ليس مهنتي" عام 1970، كان الماغوط قد رسخ بقوة أسلوباً شعرياً جديداً من حيث الشكل والمضمون.. لقد كتب الماغوط المسرحية، والزاوية الصحفية، وكتب للسينما وللتلفزيون كما كتب رواية "الأرجوحة" إلا أنه في كل كتاباته ظلّ الشاعر الذي لا يمكن النظر إليه إلا من جهة الشعر!..  ما كادت سنوات العقد الثالث من القرن العشرين تستقر في تونس حتى أصبحت النصوص الشعرية المنشورة وقـتذاك تشتمل على أصناف عديدة من الشعر العمودي ، إلى الشعر المتحرر من النمطية العروضية ، إلى الشعر المنثور ذلك الذي اِقتبسه بعض الشعراء التونسيين من مدونة شعراء المهجر ومن الشعر الفرنسي خاصة و لكن ذلك لم يتجاوز المحاولات الفردية ومن حين إلى آخر فحسب ، ولقد كان أبو القاسم الشابي واعيا بتلك المسائل الشكلية في الشعر منذ البدايات الأولى له في النشر حيث أنه أرسل إلى صديقه محمد الحليوي في حاشية رسالته الثالثة قائلا خاصة :
ما كادت سنوات العقد الثالث من القرن العشرين تستقر في تونس حتى أصبحت النصوص الشعرية المنشورة وقـتذاك تشتمل على أصناف عديدة من الشعر العمودي ، إلى الشعر المتحرر من النمطية العروضية ، إلى الشعر المنثور ذلك الذي اِقتبسه بعض الشعراء التونسيين من مدونة شعراء المهجر ومن الشعر الفرنسي خاصة و لكن ذلك لم يتجاوز المحاولات الفردية ومن حين إلى آخر فحسب ، ولقد كان أبو القاسم الشابي واعيا بتلك المسائل الشكلية في الشعر منذ البدايات الأولى له في النشر حيث أنه أرسل إلى صديقه محمد الحليوي في حاشية رسالته الثالثة قائلا خاصة : شاءت عوادي الزمن الموبوء إلا أن تقتلع هامة من هامات شعرائنا الشرفاء، إنه محمد عمران الشاعر السوري الكبير الذي "حرنت خيله وسقط الشرق في ثيابه دنانيرا، وصلى لحضرة المطر ومضي بين الليل والفجر صخرا لا تحركه المدام ولا الأغاريد".
شاءت عوادي الزمن الموبوء إلا أن تقتلع هامة من هامات شعرائنا الشرفاء، إنه محمد عمران الشاعر السوري الكبير الذي "حرنت خيله وسقط الشرق في ثيابه دنانيرا، وصلى لحضرة المطر ومضي بين الليل والفجر صخرا لا تحركه المدام ولا الأغاريد".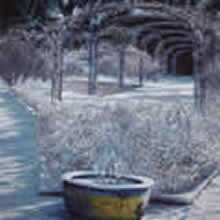 1
1 اتسم الأدب المغربي عموما والأنماط السردية المتجسدة في الرواية والقصة كنموذج بشكل خاص باحتوائها لمجموعة من القضايا ذات العمق والمتجذرة في قلب الواقع المغربي، عذا مع تسجيل بعض الاستثناءات البسيطة والتي لا تعدو أن تكون إنفلاتات لا غير، لكن هناك بعض القضايا ولقوة حضورها كانت غالبا ما تصفو على سماء الإنتاجات الأدبية السردية من رواية وقصة، ومن أبرز هذه القضايا وأكثرها حضورا القضية الوطنية، أي مجموع الشعور التي يكتنزه الفرد في ذاته واتجاه وطنه ويعبر عنه إما بالثورة أو المقاومة السرية ضد سالبيه حريته، ونقصد به المستعمر، وكان حضور هذه القضية مختلفا ما بين حقبة وأخرى، حيث كان حضور القضية الوطنية في الانتاجات ما قبل الاستقلال يحمل بعدا توعويا وتحميسيا يراد منه إثارة هيجان المواطن المغربي بغية تحفيزه ودفعه للإقدام نحو كل من عبد المجيد بن جلون وع بد الكريم غلاب، حيث نلمس هذا التحفيز وهذه الإثارة جليا في أعمالهما خصوصا السيرة الذاتية لعبد المجيد بن جلون " في الطفولة" و" دفنا الماضي" لعبد الكريم غلاب، إذ هناك بعض المقاطع في السيرتين المذكورتين تحاول إثارة شعور الثورة والهيجان في غياب المواطن المغربي لتدفعه للثأر والصراخ في وجه المستعمر وتحقيق أهداف الأمة النبيلة وفي مقدمتها الاستقلال.
اتسم الأدب المغربي عموما والأنماط السردية المتجسدة في الرواية والقصة كنموذج بشكل خاص باحتوائها لمجموعة من القضايا ذات العمق والمتجذرة في قلب الواقع المغربي، عذا مع تسجيل بعض الاستثناءات البسيطة والتي لا تعدو أن تكون إنفلاتات لا غير، لكن هناك بعض القضايا ولقوة حضورها كانت غالبا ما تصفو على سماء الإنتاجات الأدبية السردية من رواية وقصة، ومن أبرز هذه القضايا وأكثرها حضورا القضية الوطنية، أي مجموع الشعور التي يكتنزه الفرد في ذاته واتجاه وطنه ويعبر عنه إما بالثورة أو المقاومة السرية ضد سالبيه حريته، ونقصد به المستعمر، وكان حضور هذه القضية مختلفا ما بين حقبة وأخرى، حيث كان حضور القضية الوطنية في الانتاجات ما قبل الاستقلال يحمل بعدا توعويا وتحميسيا يراد منه إثارة هيجان المواطن المغربي بغية تحفيزه ودفعه للإقدام نحو كل من عبد المجيد بن جلون وع بد الكريم غلاب، حيث نلمس هذا التحفيز وهذه الإثارة جليا في أعمالهما خصوصا السيرة الذاتية لعبد المجيد بن جلون " في الطفولة" و" دفنا الماضي" لعبد الكريم غلاب، إذ هناك بعض المقاطع في السيرتين المذكورتين تحاول إثارة شعور الثورة والهيجان في غياب المواطن المغربي لتدفعه للثأر والصراخ في وجه المستعمر وتحقيق أهداف الأمة النبيلة وفي مقدمتها الاستقلال. يوضح علي كنعان علاقته بالشعر قائلا:
يوضح علي كنعان علاقته بالشعر قائلا: يقدم الجندي نفسه بقوله:
يقدم الجندي نفسه بقوله: