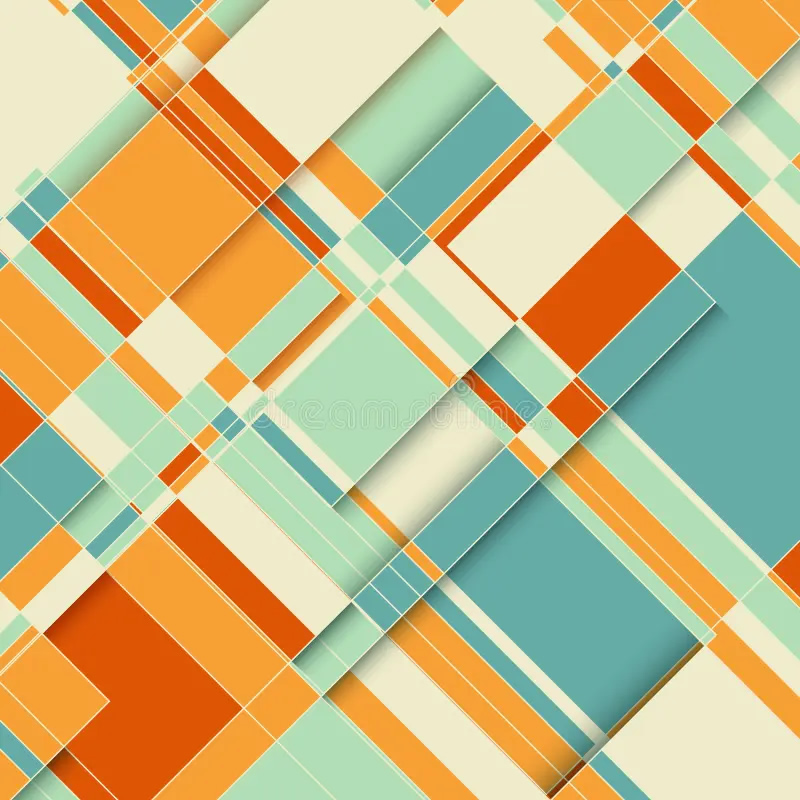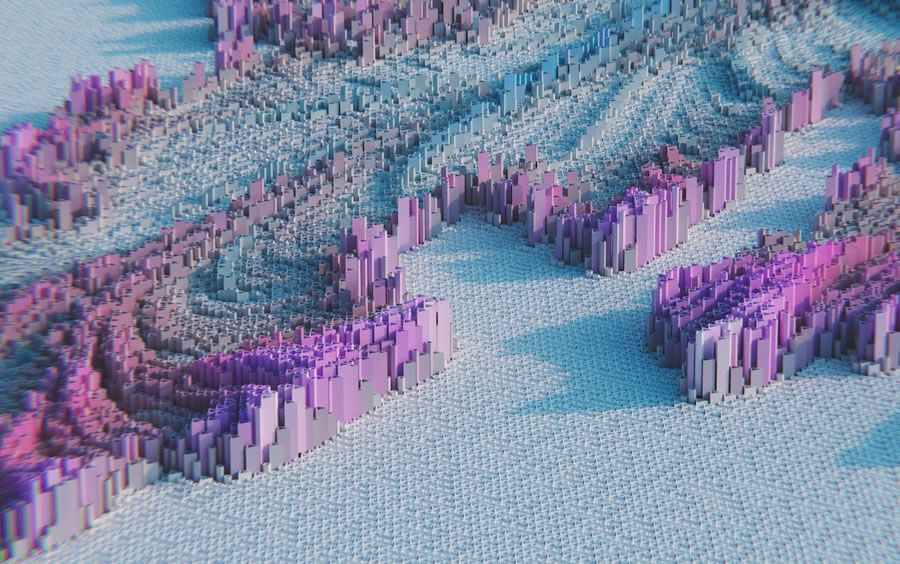باعتباري من أصدقاء الفلسفة، بشهادة أحد أساتذتها الباحثين الجامعيين بالمغرب على الأقل، خطر على بالي الإقدام على مغامرة ترجمة هذه الدراسة الأكاديمية التي جاد بها جاك بوفريس (Jacques Bouveresse)؛ الفيلسوف الفرنسي المولود في 20 غشت 1940 بإبينوي، والذي تتعلق فلسفته بلودفيغ فتغنشتاين والفلسفة التحليلية وفلسفة اللغة وفلسفة العلوم والمنطق. منذ عام 1995، شغل كرسي فلسفة اللغة والمعرفة بالكوليج دو فرانس.
"لا ينبغي أن تكون هناك فلسفة. إنها زلقة من جميع الجوانب. مهنة خطيرة مثل بناء الأسقف." ألان
1. الفلسفة وماضيها
في مقدمة الكتاب الذي نشره عام 1978، بالتعاون مع مايكل آيرز وآدم ويستوبي، "الفلسفة وماضيها"، يبدأ جوناثان ري، بشكل مفهوم ومتوقع، بالإصرار على حقيقة أن الفلسفة تحافظ على علاقة مع تاريخها، علاقة هي من نوع محدد تماما ومختلف تماما عن تلك الذي ترتبط بها العلوم مع تاريخها:
"تاريخ الفلسفة ليس ملحقا اختياريا للفلسفة. إنه يحدد النظريات والخلافات الرئيسية للفلسفة. إنه يقدس المفكرين العظماء والنصوص الأساسية لهذا التخصص؛ ويحدد الاتجاهات والفترات الرئيسية لتطوره. وهو بهذه الطريقة يقدم تعريفا ضمنيا للفلسفة، مشيرا إلى أن كونك فيلسوفا يعني أن تكون خليفة لأفلاطون وأرسطو والبقية، وأن تداوم على الممارسات التي – منذ بداية تاريخ الفلسفة – خلفها هؤلاء الرجال العظماء كإرث. وبطبيعة الحال، لا تزال هناك خلافات حول طبيعة الفلسفة. مثلا، طرح الفلاسفة الغربيون المعاصرون تعريفات مختلفة متنافسة: الفلسفة هي التحليل المفاهيمي، أو البحث عن الافتراضات النهائية للأنساق الفكرية، أو نظرية الممارسات النظرية، أو الصراع الطبقي على مستوى النظرية [إشارة إلى مفهوم الفلسفة الذي دافع عنه ألتوسير]، وهكذا.. لكن هذه التعريفات لن تكون متنافسة إذا لم تهدف إلى أن تكون تعريفات لنفس الشيء، وتحديد "نفس الشيء" هذا يتأثر بتاريخ الفلسفة. وبالتالي فإن مقولاتها لا يتم تطبيقها بأثر رجعي (وربما بشكل خاطئ) على الماضي فقط. تُترجم صورتها عن الماضي إلى واقع الحاضر: فطبيعة الفلسفة الحديثة تتحدد جزئيا من خلال الافتراضات المسبقة غير المدروسة لتاريخ الفلسفة."
أحد الأشياء التي قد تبدو مثيرة للدهشة في هذا المقطع هي فكرة أن تاريخ الفلسفة نفسه قد يكون بصدد القيام بطريقة أو بأخرى بالتحديد، الذي يحلم به الجميع، للموضوع الدقيق الذي يفترض في المفاهيم المتعددة والمتباينة للغاية تمثيله كل منها بطريقته الخاصة، أو ربما التي تمثل كل منها جانبا مختلفا منه. للوهلة الأولى، في الواقع، ما يمكن أن نتوقعه من تاريخ الفلسفة حول هذه النقطة يبدو قبل كل شيء أنه ينتج عددا أكبر من الإجابات المختلفة على السؤال المطروح، وليس بالتأكيد كونه يقربنا من إجابة محددة من شأنها أن تفرض نفسها بشكل نهائي كما لو أنها الإجابة الصحيحة. من المحتمل أن يكون الخيال الفلسفي قادرا على إظهار نفسه، عندما يتعلق الأمر بالإجابة على هذا السؤال، على أنه مبتكر وغير متوقع كما هو الحال عندما يواجه أي سؤال فلسفي آخر. والفلاسفة الذين اهتموا بشكل صريح بهذا النوع من المشاكل غالبا ما بدأوا بملاحظة أن الخلافات بين الفلاسفة حول مسألة ماهية الفلسفة بالضبط كانت كبيرة وبدت غير قابلة للحل مثل تلك التي تظهر في شأن جميع الأسئلة الفلسفية المعتادة. إذا كنا مستعدين، رغم كل شيء، لقبول فكرة أن تاريخ الفلسفة يمكن أن ينجح في النهاية في تزويد الفلسفة بإجابة مقبولة عالميا عن سؤال واحد على الأقل، وهو سؤال هويتها، فإن الاعتراض الواضح هو أن ذلك يتضمن مفهوما عن تاريخ للفلسفة ليس فقط ضربا من تفاؤلية لا شيء يبررها، لكنه أيضا نوع موضع شك إلى أعلى درجة ومتنازع عليه بشدة بشكل عام.