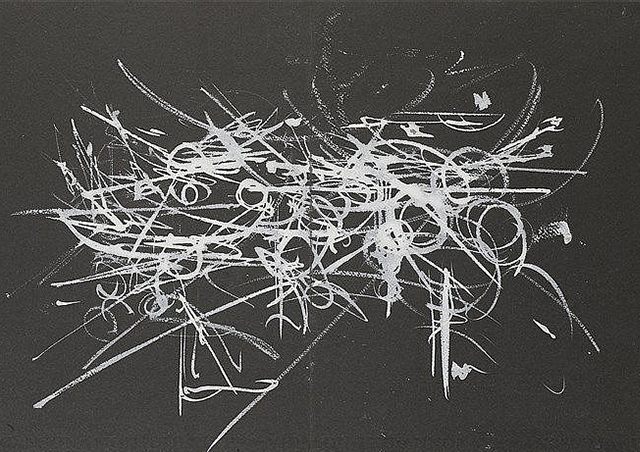القدرة على تفسير ظواهر التاريخ وأحداث الماضي ، تُعتبر من أهم خصائص العقل البشري . وهذه القدرة مُستمدة بالأساس مِن فهم الواقع واستيعاب أحداثه ، والعاجزُ عن فهم الحاضر ، هو _ بالضرورة _ عاجز عن فهم الماضي ، لأن الحاضر هو القاعدة الصُّلبة والركيزة الأساسية ونقطة الانطلاق نحو الماضي ، من أجل تفسيره ، والتنقيب عن إيجابياته وكنوزه ، وصَهر هذه الكُنوز في بَوتقة الوَعْي المنطقي ، والانطلاق نحو المُستقبل بخُطى ثابتة ومدروسة ، بعيدًا عن حرق المراحل والقفز في الفراغ، لأنَّ البِنية التركيبية للزمن عبارة عن مراحل تراتبية دقيقة، تُشبه دَرَجات السُّلَّم ، وصُعود السُّلَّم إنما يكون دَرَجة دَرَجة لتحقيق الأمان والفاعلية ، والوصول إلى الهدف المَنشود . والزمنُ مِثل مَوج البَحْر ، لا يُمكن امتلاكه والسَّيطرة عَلَيه ، ولكن يُمكن التعامل معه بذكاء ، والاستفادة مِن قُوَّته ، وتَوظيفه لصالح تحقيق المنافع والمكاسب . وبما أن السباحة ضِد التيار مُتعبة وشديدة الخُطورة ، وقد تُؤدِّي إلى الانهيار والغرق ، فإنَّ الحل الوحيد هو الاستفادة مِن حركة التيار ورُكوب المَوجة للوُصول إلى بَر الأمان . ويجب على الإنسان أن يَبحث عن مصلحته ونَجَاته ، ويُوظِّف جميعَ العناصر لتحقيق أحلامه وطُموحاته وصناعة حاضره ومُستقبله ، بشَرط أن يَكون ذلك بوسائل مشروعة وأدوات نظيفة ضِمن دائرة المشاعر الإنسانية النبيلة ، بعيدًا عن استغلال الآخرين ، والصُّعود على ظُهورهم .
ليوناردو فيبوناتشي.. ابن التاجر الإيطالي الذي علّم أوروبا الأرقام العربية - أحمد إبراهيم
في عصر الخليفة العباسي المأمون (ت 218هـ/833م) انفتحت الحضارة الإسلامية على باقي الحضارات المجاورة حين أنشأ هذا الخليفة مؤسسة "بيت الحكمة" الشهيرة التي كانت أحدث مؤسسة بحثية وعلمية آنذاك، أخذت فيها العلوم التجريبية والعقلية مثل الرياضيات والطب والكيمياء والصيدلة والعقاقير وحتى الفلسفة والتاريخ البيزنطي مكانتها من الترجمة والنقل.
لقد اتسع البحث في علم الرياضيات لا سيما في علم الجبر على يد العرب والمسلمين، وفي ذلك يقول غوستاف لوبون الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير:
"عُزي إلى العرب اكتشافُ علم الجبر، ولكن أصوله كانت معروفة منذ زمن طويل، ومع ذلك فقد حوّل العربُ علمَ الجبر تحويلا تاما، وإليهم يرجع الفضل في تطبيقه على علم الهندسة"[1].
وينقل غوستاف لوبون في كتابه الماتع "حضارة العرب" عن العالم الفرنسي مسيو شال في كتابه "خلاصة تاريخ أصول الهندسة" قوله إنه "لم تؤثر تلك الثورة العلمية (العربية الإسلامية) المباركة التي أدّت إلى طرح تلك الطرق المركبة الثقيلة في الجيب وتمام الجيب في علماء القرون الحديثة إلا بعد مرور خمسمئة سنة، وذلك بدعوة ريجيو مونتانوس، وإن جَهَل تلك الثورة كوبرنيكُ الذي ظهر بعد نحو قرن"[2]! والحقيقة أن الثورة العلمية التي أحدثها المسلمون في مشرق العالم الإسلامي ومغربه كان لها تأثيرها وصداها المدوّي في أوروبا لا سيما أثناء الحروب الصليبية وعقبها في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادي وما تلاه، بفضل اتساع التجارة بين شمال البحر المتوسط لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وجنوبه في مصر والشام والجزائر والمغرب.
حماية الإنسان من السقوط خارج التاريخ - إبراهيم أبو عواد
التفاعلُ الرمزي بين الإنسان والتاريخ يَعكس أهميةَ التواصل بين الذات والإطار الحاضن لها ، وبما أن الذات لا تَنشأ في الفراغ ، ولا تَنمو في العدم ، فمن الطبيعي أن تبحث الذات عن بيئة مُناسبة للإبداع ، تَكون كالتُّربة الخِصبة بالنِّسبة للوردة . ولكن الإشكالية أنَّ الإنسان يَنبهر بالوردة ، ويُركِّز في قَطْفها ، ويَنسى الأشواكَ التي تُحيط بها ، وهذه العملية الخطيرة تُشبِه الانبهارَ بالتاريخ ، والتَّركيز في الحَدَث ، ونِسيان الدوافع الخَفِيَّة التي تقف خلف صناعة الحَدَث ، وتعمل على تَوجيهه بشكل مُغرِض ، اعتمادًا على الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية . وكما أنَّه لا تُوجد فائدة مِن عطر الوردة وجَمَالها ، إذا كانت سَامَّةً وقاتلةً ، كذلك لا تُوجد فائدة مِن رُومانسية التاريخ ورَوعته ، إذا كان قائمًا على حضارة القتل ، واستغلال القويِّ للضعيف .
إله واحد وأرباب متفرّقون - عزالدين عناية
لا تزال مسألة التوحيد في الديانة الأخناتونية (أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد) مثار تساؤلات عدة في أوساط مؤرخي الأديان، وذلك لخروجها عمّا هو مألوف في التقاليد الدينية المصرية القديمة المحكومة بالتعدد والتجسيم في قضية الألوهية، ما جعل العديد من الدراسات الحديثة تسلّط الضوء مجددا في هذه الديانة بقصد تفسير ذلك الحدث. وبهذا المفهوم تُعدّ الإخناتونية الموحِّدة ديانة متفردة ضمن التقليد التعددي للتراث الديني المصري، دفعت البعض إلى ربطها بالتراث الإبراهيمي وإن لم يفصح التراث الكتابي عن ذلك. كتاب المؤرخ جان آسمان المتخصص في علم المصريات هو من الأعمال الجديدة الصادرة في المجال. والمؤلف من المهتمّين بالحضارة المصرية القديمة وقد درّس في العديد من الجامعات الغربية، في هايدلبرغ وباريس وشيكاغو وهوستن، وصدرت له مجموعة من الأعمال في الشأن منها: "الله والأرباب: مصر وإسرائيل ونشأة التوحيد" (2009)؛ "التميز الموسوي أو ثمن التوحيد" (2011) "الدين الكلّي: أصول العنف الديني وطبيعته" (2015).
ماذا فعلت الإنترنيت بالدين؟ - عزالدين عناية
بين أوّل دراسة علميّة جادّة حول المعبد الإلكتروني (1998)، أنجزتها اللاهوتية الأمريكية جينيفر كوب، وما نعيشه اليوم من تطوّرات في مجال العالم الافتراضيّ الدينيّ، جَرت مياهٌ كثيرةٌ في النهر. فعلى غرار الاقتصاد والسياسة والثقافة ومجالات حيويّة أخرى، بات الدين أيضًا عُرضة للتأثّر بوسائل التواصل الاجتماعيّ، والتفاعل مع الشبكة العنكبوتية، بما تمليه من أوضاع مستجدّة على البشر، وبالمثل ما تُتِيحهُ من إمكانيات. فلا شكَّ أنّ علاقةَ الحداثة بالأديان، قَبل ظهور الشبكة العنكبوتية، كانت إشكاليةً، لكن بُعيْد اكتساح وسائل التواصل الاجتماعيّ المجال الحياتيّ، حَدثت مراجَعات في علاقة الدين بأدوات الحداثة، جاءت في معظمها هادئة وصامتة. وقد زادت جائحةُ كورونا الأديانَ تمعّنًا في توظيف العنصر الافتراضي في التواصل الديني، وفي تيْسير أداء الفعل الطقسي، وهو ما يكشف عن قدرة للدين على التأقلم مع الطوارئ والمستجدّات، بخلاف ما يُرمى به أحيانا من نعوت الجمود والتكلّس.
الذات الجريحة للمسلمين والصراع على تِركة خريف العرب - أحمد أشقر
تُحدث هزائم الشعوب والأمم في المعارك والحروب المختلفة، حتى لو كانت "غير عادلة"، جروحاً في ذاتها لا تندمل إلا بانتفاء الهزيمة في حرب جديدة أو بنهضة اقتصادية علميّة تغطّي هزيمتها. ويُعلمنا التاريخ المُعاصر درسيّن مختلفين لهزيمة في حرب واحدة لكل من ألمانيا في الحرب العالميّة الأولى (1914- 1918) التي قبلت بها في "معاهدة فرساي" في الثامن والعشرين من شهر تموز لسنة 1919 وتم تعديلها في العاشر من كانون الثاني لسنة 1920، والإمبراطورية العثمانيّة النهبويّة التي قبلت بها تركيا "معاهدة سيفر" في العاشر من شهر آب سنة 1920 ووقع عليها "كمال أتاتورك" في 29 تشرين الأول سنة 1923. في الاتفاقية الأولى حمّلت الدول المُنتصرة ألمانيا مسؤولية شنّ الحرب وفرضت عليها دفع تعويضات للدول المُتضررة. وفي الثانية قامت الدول المنتصرة بتفكيك الامبراطورية العثمانية. إضافة للهزيمتين اعتبرت كلاً من الدولتين الاتفاقيتين مُذلّتيّن، وبأنهما مستّا بكرامة أُمتيهما، وخلفتا جرحاً عميقاً في ذات كل أمة منهما. ورغم مرور قرن على الهزيمتين، لا تزال كلاً من ألمانيا وتركيا تعانيان من هذا الجرح وتحاولان الشفاء منه، كلّاً منهما بطريقتهما الخاصة وبنتائج مختلفة. ويجب التأكيد هنا على أن هزيمة العثمانية اعتبرها المسلمون في العالم هزيمة لهم نتيجة لتآمر الغرب المسيحي على الإسلام وليس لصيرورة قوانين الصراع الطبقي والجيوسياسي.
حوار الحضارات وتأثير الجهالات - حسن رشيـدي
فجر الألفية... ونظرا لما تُمليه التحولات الجيوسياسية للسلطة المركزية، التي شهدت ضعفا أو شبه تلاشي -لظلها- في بعض المناطق الحدودية التي تعرف نزاعا دوليا أو عرقيا... أدى -التطور الحاصل- إلى بزوغ حركات فصائلية ذات نزعة قومية أو دينية، أمكن العمل من خلالها وبمساعدات خارجية إلى تبني إيديولوجيات معادية وذات بُعد استئصالي.
وفي مقابل ذلك، علا صوت الحكمة ليخفت ضجيج البنادق، وامتدت جسور المعرفة والحوار مع الآخر باعتباره الشريك في المسار الحضاري والإنساني على حد سواء، بل زادت وثيرة الحوار العالمي بمتتاليات متسارعة، في العُشرية الأخيرة: وشهدت زيارات رسمية لكلا الطرفين، وعلى رأسها: زيارة بابا الفاتيكان إلى المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين ومصر وتركيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وميانمار. وكان الحال نفسه لعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة ورؤساء الدول.
اليهوديّة بعيون مسيحيّة - عزالدين عناية
يدور مدار هذا الكتاب حول موضوع مهمٍّ على صلة بالأصول الدينية للمسيحية في علاقتها باليهودية وبإرث العهد القديم تحديدا، ومن ثَمّ حول البناء اللاهوتي للدين المسيحي، ألا وهو كيف اشترك دينان توحيديان (اليهودية والمسيحية) في مرجع كتابيّ واحد، وهو العهد القديم، وكيف اختلفتِ القراءة وتباينتِ الرؤية بينهما إلى حدّ الفراق والتغاير، وربّما شارفت في مراحل تاريخية مستوى من العداء المكشوف؟ فقد ساد على مدى عهود جفاء بين الدينين بلغ مستوى القطيعة؛ لكنّ مع التحولات المعاصرة وما شهدته العلاقة من تطبيع بين الدينين، سيما في أعقاب مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965)، استلزم الأمر نظرا مستجدّا في الرؤى اللاهوتية بقصد تنقيتها من الغلو والأخطاء، ومن كل ما يسيء للعلاقة بين الطرفين.