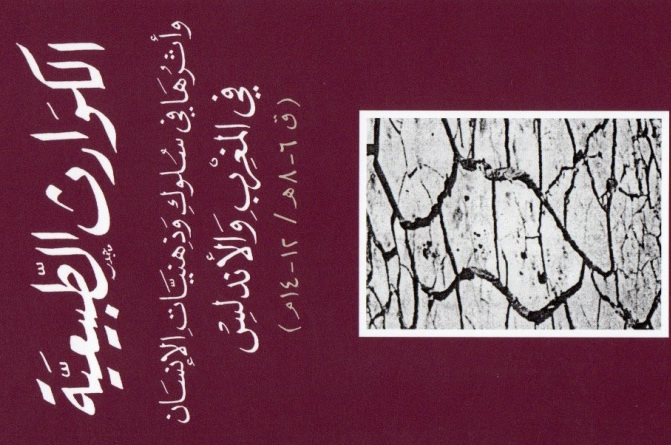” إن مخالطة الأغراب، لا سيما إذا كانوا من أولى الألباب، تجلب للأوطان المنافع العمومية “ ( مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية ص: 168)·. ” ... والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب التي لا ينكر إنسان أنها تجلب الأنس وتزين العمران.... أنهم يعرفون التوفير وتدبير المصاريف، حتى أنهم دونوه وجعلوه علماً “ (تخليص الإبريز في تلخيص باريز ص: 119-171) (الطهطاوي).
يعتبر رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873) أحد قادة النهضة العلمية في مصر والعالم العربي خلال القرن التاسع عشر، لقب برائد التنوير في العصر الحديث، لما أحدثه من أثر في تطور التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث. اختير إماماً مشرفاً ومرافقاً للبعثة العلمية الأولى التي أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا بعد أن رشحه الشيخ حسن العطار (1766-1835) لهذه المهمة وزكاه عند السلطان. بذلك يعتبر الطهطاوي هو أنبغ المصريين الذين بُعثوا إلى أوروبا، وقد كانت له بعد عودته جهود محمودة في حياة مصر الثقافية، مما يجعله بحق زعيماً لنهضتنا الفكرية في ذلك العصر.
وتعتبر هذه الزيارة التي قادت رفاعة رافع الطهطاوي إلى اكتشاف أسرار باريس، بعدما عين من طرف أستاذه حسن العطار كمشرف ليرافق البعثة التعليمية المتكونة من 40 طالباً مصرياً لفرنسا لتعلم العلوم والوقوف على المناهج التعليمية الفرنسية، زيارة تاريخية وقف من خلالها الطهطاوي على عوامل نجاح وتقدم فرنسا ثقافياً وحضارياً وعلمياً، ولم يكتف رفاعة الطهطاوي بمهمة الإشراف الديني على البعثة بل دفعه شغفه بالمعرفة وحب الاكتشاف إلى تعلم أبجديات اللغة الفرنسية وهو لا يزال على ظهر السفينة الحربية المتوجهة نحو فرنسا رفقة الطلاب المصريين.
كانت نصيحة العطار لرفاعة أن يُسجل مشاهداته في رحلته في كتاب خاص، وقد استجاب التلميذ لنصيحة أستاذه، فبدأ منذ ركوبه السفينة في الإسكندرية يَفتح عينيه وأذنيه ليرى كل شيء ويسمع كل شيء. وكان كلما رأى جديداً أو سمع جديداً، انطوى على نفسه يفكر فيما رأى وفيما سمع، ثم لا يلبث أن يستحضر في مُخيِّلته الصورة المقابلة - لِما رأى أو سمع - في وطنه، أو في ديار الإسلام عامة، ثم يترك نفسه على سجيتها يُلقي النظرة بعد النظرة على الصورتين: الصورة القديمة التي عرفها في وطنه أو في ديار الإسلام، والصورة الجديدة التي رآها في الغرب أو في ديار النصرانية، فإذا ملأ نظره من الصورتين انقلَب يُحلل ويُقارن؛ لأنه كان يرى دائماً أن الصورة القديمة باهتة كريهة وأن الصورة الجديدة زاهية حية محبوبة.
وُلد رفاعة رافع الطهطاوي عام 1801م، بمدينة طهطا بصعيد مصر. اعتنى به أبوه في صغره، رغم مروره بضائقة مالية فرضت عليه التنقل بعائلته من قرية إلى أخرى، إلى أن استقر المقام بهم في القاهرة. وكان رفاعة قد حفظ القرآن الكريم، ودرس النحو واللغة، كما حفظ كثيراً من المتون المتداولة في عصره. وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره أكمل رفاعة دراسته في الأزهر الشريف، ومن حُسن حظه أن درس على يد الشيخ حسن العطار، فقد كان واسع الأفق، كثير الأسفار، يقرأ كتب الجغرافيا والتاريخ والطب والرياضيات والأدب والفلك؛ فخرج رفاعة كأستاذه واسع الأفق، عميق المعرفة. وقد تخرج رفاعة في الأزهر في الحادية والعشرين من عمره.
- قراءة في كتاب رفاعة رافع الطهطاوي (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) عام 1834:
معنى الإبريز، حسب قواميس اللغة العربية، هو الذهب الخالص، ويقال: ذهب إبريز، والقطعة منه إِبريزة، ويعود الفضل إلى رفاعة رافع الطهطاوي الذي جعل هذه المفردة حاضرة، حين اختارها في عنوان كتابه الأشهر: " تخليص الإبريز في تلخيص باريز "، الذي يمكن أن نعده النافذة العربية الأولى على الفكر الأوروبي الحديث، وأحد الكتب المؤسسة لفكر النهضة العربية، بل لعله أهمها.