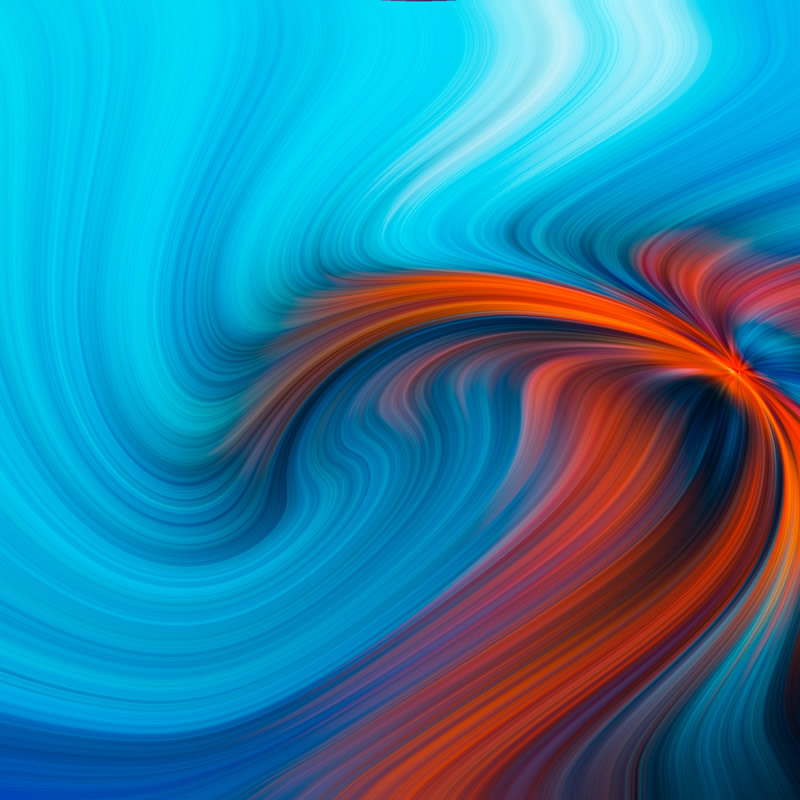بحكم قربه في كثير من النواحي من افكار الكتاب الذين مشوا في أثر توكفيل، يبدو أن رتشارد رورتي (1931-2007) ذهب إلى أبعد من ذلك. إنه لا يرى في العلمنة مجرد حركة تجري، بل إنه يرى فيها انحيازا يجب تأكيده على أنه ليبرالي بشكل مناسب. من هذا المنطلق، ربما يواجه فكر رورتي بعض الصعوبة في أخذه هنا، "لدى الفرنسيين" على حقيقته؛ وغالبا ما يتم تشويهه بسبب تقديمه بتفصيل. ونتيجة لذلك، فإننا نفتقد ما يشكل جذريته، ألا وهي الوحدة المنهجية للجهاز النظري المطبق. لأن توصيف فكر رورتي يرجع إلى الجهد المستمر الذي يبذله لبلورة الرابط بين فلسفة المعرفة والفلسفة السياسية.
من خلال شرح التعبيرات المختلفة للفكر "المرآوي"، يدعونا رورتي إلى لائحة اتهام دون انتداب فكر المحدثين. في هذا المقال، سنركز على بيان بعض السمات البارزة لهذا التساؤل حول الأساس الذي بُنيت عليه رؤية التعليم المدرسي في فرنسا. وبشكل أكثر تحديدا، سوف نحلل ما سيترتب عليه القضاء على أي عنصر خارجي ومتعال يمكن أن يبرر المعرفة ويشكل مجتمع المواطنين في نفس الوقت. لأنه، إذا أخذنا فكر رورتي على محمل الجد، فإن الأساس الذي نبني عليه عملنا التربوي هو الذي يهتز. ولكن في ظل هذه الظروف أيضا، فإن جذرية النقد تدعونا إلى التساؤل عن البراغماتية باعتبارها نتيجة حتمية للعلمنة الديمقراطية.
رتشارد رورتي، بخلاف جون ديوي، الذي يدعي أنه أحد خلفائه، لم يكتب شيئا عن التربية؛ ذلك أن السؤال التربوي لم يكن ضمن اهتماماته الصريحة. ومع ذلك، لا يمكن أن يترك فلاسفة التربية غير مبالين.
لا شك في ذلك أولاً وقبل كل شيء لأنه يواجه تحليلات تحاول تفسير، إن لم يكن أزمة في التربية، فعلى الأقل الصعوبات التي يعاني منها الإطار الذي تتم فيه الممارسة التربوية حتى الآن، وخاصة تنظيم التعليم المدرسي في فرنسا. في الأساس، كان هذا هو الحال مع ديكارت، الذي تناول فقط مسألة التعليم من خلال سرد سيرته الذاتية والذي دعا، بالفرنسية، الجميع، بمن فيهم "النساء أنفسهن" إلى تحرير ذواتهم من التقاليد من أجل التعاطي بشكل أفضل لاستقلالية العقل.
يمكن أن يبدو رورتي من نفس النوع (مسألة الأهمية والتوقير شيء آخر!): إنه يجبرنا على العودة إلى الأطر التأسيسية للحداثة، ومن خلال الدفاع عن المفهوم العلماني للثقافة بشكل فعال، يدعونا إلى تخيل ماذا يمكن أن تكون عليه التربية الليبرالية على وجه صحيح.
ضمن أفق فكر العلمنة، يمكن أن تبدو فلسفة رورتي قريبة من تنظيرات الكتاب الفرنسيين الذين مشوا في أعقاب توكفيل.
"من نواحٍ عديدة، يتلاقى الرهان المتمثل في تحليلات رورتي مع ما يمكن أن يكتبه مارسيل جوشيه: كلاهما قدم تقريرا عن حركة الدمقرطة التي ترفض كل تعال، بل كل متعال. بمعنى ما، سيجد رورتي نفسه في وصف غوشيه الذي أدرج الفردانية في إطارذ عملية أوسع للعلمنة. "من الفرد المجرد إلى الفرد الملموس": ترجع هذه الظاهرة إلى "اختفاء ما تبقى من الهيكلة الدينية للعلاقات الاجتماعية".
من ناحية أخرى، يعلن رورتي: "كما يبدو لي، انتقل العالم الغربي شيئًا فشيئا من عبادة الله إلى عبادة العقل والعلم. في الوقت الحالي، يتطور نحو مرحلة لم يعد فيها يعبد أي شيء". (رورتي، 1990، ص: 11).
أظهر رورتي أهمية إحلال الأمل وإعلان المستقبل محل المعرفة والقوة. لقد جعل من اعتبار المستقبل سمة من سمات فلسفته؛ يرد عليه غوشيه بأن "مجتمعات خرجت عن الدين (...) هذا يعني مجتمعات انتقلت من الإخلاص لماضيها وتقاليدها نحو المستقبل ونحو ابتكار ذاتها" (غوشيه، [2000] 2002، ص: 344). ويشهد كلاهما أيضا على نفس عدم الثقة في ما يتعلق بأي رغبة في جوهرانية حقوق الإنسان أو "تشكيلها في السياسة" (غوشيه، [2000] 2002، ص: 330). كلاهما يشترك بشكل أساسي في نفس الاهتمام بما يسميه غوشيه "الأنثروبولوجيا الديمقراطية" (غوشيه، 2002. ص: 19)، التي تأخذ في الاعتبار عملية "نزع اللاأمثلة".
في الحقيقة هدفت علمنة التنوير إلى إعلان تحرر الإنسان من كل خارجية. ولكن في نفس الوقت الذي استوعبت فيه مصدر النظام الاجتماعي، اقترحت على الأفراد الملموسين تخارجا ذاتيا، وموضعة لطبيعتهم الحقيقية التي قدمت نفسها بعد ذلك على أنها يجب أن تُعرف وتُتابع. ستدفع الآن حركة علمنة الثقافة الأفراد إلى تحرير أنفسهم من الإنسان بعد أن حرر الإنسان نفسه من الله. يمكننا المضي قدما في هذا الجرد، ولكن الشيء المهم هنا هو بطريقة ما أن نأخذ هذه الأماكن المشتركة كشاهد من أجل تحديد مكانة فلسفة رورتي. لأجل حمل هذا التوازي على محمل الجد، تبدو الطريقة التي يتم بها استقبال رورتي في فرنسا أكثر إثارة للدهشة.
لا يمكن أن يكون هذا التقارب مضللا. إن استقبال رورتي من قبل الفرنسيين سند الليبرالية بالتأكيد، لكنه، على وجه الخصوص، أدان نسبية ولاعقلانية مواقفه. ومع ذلك، مثل ديوي في عصره، استقبل رورتي في فرنسا، وربما، مثل ديوي، هو مصنّف أكثر من كونه مُحلَّلا، متموقعا اكثر من كونه مفهوما.
صحيح أن رورتي محير. وهكذا، بينما يُظهر بلا شك ليبرالية في جميع الأمور، يمكنه أن يعلن أنه يجب إعادة تأهيل الصراع الطبقي. ينتقد باسم رفض "الجوهرانية" و "التمثيلية" كل ادعاء للحقيقة والموضوعية لكنه يعلن انه لا يجد نفسه في النزعة الشكية.. إنه يطرح الاحتمالية او العرضية لجميع نقاط البداية لدينا ويرفض كل فلسفة عن الأساس، لكنه يعلن أنه لا ينطلق من النسبية. إنه يوضح أهمية الاندراج في الخاص والخصوصية ولكنه لا يحدد مواقفه في أعقاب الطائفية الصارمة؛ إنه يعرض فلسفة "قومية" لكنه يرفض أي تمركز إثني مغلق.
وفي ما يتعلق بتاريخ الفلسفة، إذا اقتفى أثر الفلاسفة الأمريكيين - جيمس وديوي على وجه الخصوص - فقد نوى الدخول في حوار ليس فقط مع كوين، كوهن، بوتنام، ديفيدسون أو سيلارز وغيرهم من الأمريكيين، ولكن أيضا مع هايدجر، الذي يعتبر مع فيتجنشتاين وديوي من بين "أالفلاسفة الثلاثة الأكثر أهمية في عصرنا" (رورتي، [1979] 1990، ص: 15).
جنح رورتي إلى التحاور حتى مع فوكو ودريدا. وبكلمة واحدة، يبدو أنه من أي نقطة يتم تناوله، يفلت فكر رورتي من توصيفاتنا المعتادة.
هناك بلا شك معارضة سياسية على وجه الخصوص في الانتقادات التي يمكن أن توجه في فرنسا إلى رورتي. ذلك أنه يعتبر ويعلن نفسه أمريكيا، ويصف فلسفته خصوصا والبراغماتية عموما بأنهما أمريكيتان. سيتعين علينا العودة إلى هذا الموضوع. لنكتف الآن بالقول إن فلسفته، المتأصلة على هذا النحو، لا يمكن أن تظهر إلا في تناقض أو تنافس مع نموذج يُزعم أنه فرنسي. وفي كثير من النواحي، على وجه التحديد، يمكن تصور الأفق الذي يتم فيه التفكير في فرنسا، وخاصة التفكير في التعليم المدرسي، باعتباره الهدف المميز لهجمات رورتي.. أولوية التضامن على الموضوعية؛ إعلان المعرفة بدون سلطة؛ رفض الكونية لصالح القومية المفتوحة والتقدم لصالح التقدمية؛ تأكيد السياسة بدلاً من الميتافيزيقيا وأهمية المستقبل بالنظر إلى التعلق بالماضي: تلك إشكاليات ميزت شخصية وصفت نفسها بأنها براغماتية وأمريكية وجعلت البراغماتية فكرة أمريكية بالتأكيد. في ظل هذه الظروف، وعندما نأخذ فكر رورتي على محمل الجد، فإن الأساس الذي نبني عليه عملنا التربوي هو الذي يهتز.
ولكن، فضلا عن ذلك، فإن الصعوبات التي يمكن أن نواجهها أمام فلسفة رورتي ترجع إلى راديكاليتها ونسقيتها. تسعى تحليلات عملية الدمقرطة في المجتمعات المعاصرة إلى تفسير اضطرابات الأطر التي شكلت حتى ذلك الحين حدود أوروبا العجوز. يبدو أن رورتي ذهب إلى أبعد من ذلك. إنه لم يكتف بالتحليل: هو انتقد واعتبر العلمنة ليس مجرد عملية تاريخية فعالة ولكن انحيازا يجب تأكيده والمطالبة به. هنا توقفت الليبرالية عن كونها مجرد مصير للمجتمعات، وكفت عن أن تكون هي نفسها مطبعة ومموضعة؛ اصبحت أو استحالت سياسية بشكل صحيح.
إذا كان فكر رورتي يواجه بعض الصعوبة في أخذه في فرنسا على حقيقته، فذلك لأنه غالبا ما يكون مشوها لكونه مقدما بتفصيل. نتيجة لذلك، يفقد ما يشكل قوته، ونقصد به الوحدة النسقية للجهاز النظري المطبق. ذلك أن وسم تفكير رورتي يرجع إلى الجهد المستمر الذي يبذله لإرساء علاقة بين فلسفة المعرفة والفلسفة السياسية. وهذا بلا شك ما سنفتقده إذا اقتصرنا على قراءة الفلسفة السياسية دون البدء بتحليل نظرية المعرفة.
بيد انه على وجه التحديد، ظل السياق الذي فكر فيه رورتي هو سياق الفلسفة التحليلية وما بعد التحليلية، التي واجهت بعض الصعوبة في كسب قبول المؤسسة الفلسفية في فرنسا. "في أوائل الخمسينيات (...) بدأت الفلسفة التحليلية في مد سيطرتها على أقسام الفلسفة الأمريكية (...). حوالي عام 1960 كان هناك نظام جديد للنماذج الفلسفية. تم الآن غرس نوع جديد من التعليم في الجامعات، تعليم حرم القراء من رواد الجيل السابق، ديوي ووايتهيد". (رورتي، [1982] 1993، ص: 380).
لكن، والحالة هاته، يلاحظ رورتي: "لا جسر يظهر أثناء عملية البناء فوق الفجوة التي تفصل بين ما يسمى بالفلسفة" التحليلية" وما يسمى بالفلسفة "القارية". يبدو لي هذا مؤسفا للغاية لأن العمل الأكثر إثارة للاهتمام الذي يتم إجراؤه في التقليدين يتقاطع في جزء كبير رغم كل شيء" (رورتي، 1995، ص: 57).
زيادة على ذلك، بينما قدمت نفسها منذ فترة طويلة في فرنسا على أنها "مغايرة" (طريقة أخرى لممارسة الفلسفة، لإلغاء التفلسف، مغايرة للفينومينولوجيا التي يدمجها بنفس القدر)، لا يرى رورتي في الفلسفة التحليلية "متغيرا من بين متغيرات أخرى للفلسفة الكانطية". لكن السياق يلزم، والنزعة الخصوصية تفرض، وهذان تحليليان بتصميم. وهكذا تمكن رورتي من تحديد موقع "الإنسان المرآوي": "تم تصميم هذا الكتاب على غرار كتابات الفلاسفة الذين أعجبت بهم كثيرا (فيتجنشتاين، هايدجر، ديوي): يهدف إلى أن يكون علاجيا عوض أن يكون بناء. ومع ذلك، فإن العلاج الذي يقترحه يغذي، مثل الطفيليات، الجهود البناءة التي يبذلها فلاسفة المدرسة التحليلية، التي أحاول التشكيك في إطارها المرجعي". (رورتي، [1979] 1990، ص: 17).
لذلك، في هذه النقطة أيضا، يُظهر رورتي تفرده. هل ربما لأن الفلسفة التحليليةا لا تزال تتميز بمواجهتها مع الفلسفة القارية؟ هل ربما لأنها ظلت من حيث تجذرها شديدة الارتباط بأصولها الأوروبية؟ صحيح أن رورتي ينتمي إلى جيل مفصلي في تاريخ الجامعات الأمريكية (ولد عام 1931)، يمتح مصادره من النموذج الفلسفي السابق، والأمريكي البحت، ونعني به براغماتية جيمس وديوي. وهذا بلا شك ينير سياق تناقضات الفرنسيين، وهذا يوضح لهم لماذا تمكن رورتي من أن يقول إن البراغماتية هي فلسفة أمريكية فريدة وأن جيمس وديوي أخذا أمريكا على محمل الجد .. ولدت الفلسفة التحليلية والوضعية المنطقية بقوة في أوروبا، او لم يكن راسل أول من انتقد البراغماتية كفلسفة أمريكية؟
لذلك، من وجهة نظر تحليل المعرفة، وبشكل أكثر تحديدا من وجهة نظر تحليل نظرية المعرفة، نظم رورتي فكره. تطرق لمعيار ترسيم الحدود؛ للتنازل عن شروط الحقيقة؛ لثنائيات الروح/المادة؛ الموضوعية/الذاتية؛ الوقائع/القيم؛ الفلسفة/العلم. فحص رورتي جميع الأسئلة التي حركت الفلسفة التحليلية. لكنه قام بذلك من وجهة نظر النموذج السابق إلى حد ما: نموذج البراغماتيين الأمريكيين، ولا سيما جون ديوي.
في الأساس، تضع فلسفة المعرفة بأكملها - وهذا هو بالضبط سبب انتقاد رورتي لها - استعارة في قلب نصوصها: "الصورة التي تطارد الفلسفة التقليدية هي تلك التي تساوي العقل بمرآة كبيرة، تحتوي على تمثيلات مختلفة، بعضها مناسب، والبعض الآخر ليس كذلك - مرآة يمكن دراستها باستخدام مناهج خالصة، غير تجريبية. (رورتي، [1979] 1990، ص: 22).
هكذا تستند الفلسفة التقليدية بأكملها إلى هذا الافتراض المسبق المزدوج لـ "جوهرنا المرآوي" المتعلق بالجواهر أو التمثيلات. ورورتي يتعامل مع ديوي الذي ندد بتصور يجعل من الذات العارفة متفرجة على "الأشياء" الثابتة، و "الجواهر". في هذا الصدد، يعطي للتصور الديكارتي، الذي يرى فيه رورتي أساس النظرية الحديثة للمعرفة، حياة ثانية للاستعارة الأفلاطونية: "إنها التمثيلات التي توجد في العقل . الأمر متروك لـعيننا الداخلية لفحص هذه التمثيلات بعناية على أمل العثور على علامة من شأنها أن تشهد على إخلاصها". (رورتي، [1980-1989] 1994، ص: 59). هكذا تنفتح الطريق أمام نظرية المعرفة: "البحث عن اليقين يحل بشكل نهائي محل البحث عن الحكمة" (رورتي، [1980-1989] 1994، ص: 75).
المرآوية: سيكون هذا هو التأكيد المركزي الذي يجب انتقاده واستكشاف تحديداته وصوره الرمزية. يحلل رورتي هذه الاستعارة من عدة زوايا. إنها تقع في قلب كتابه "الإنسان المرآوي". ومع ذلك، يمكن للمرء أن يجد في "التناسب" الافتراض المسبق الذي ينظم كل إخفاقات هذه الاستعارة: "الفكرة الأساسية لنظرية المعرفة هي أن تكون عقلانيا، وأن تكون إنسانيا بالكامل، وأن تقوم بما يجب، هو أن تكون قادرا على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين (...). كان هناك وقت تخيلنا فيه أننا سنجد هذه الأرضية المشتركة خارج أنفسنا - مثلا في نظام الوجود، من حيث أنه يعارض الصيرورة، في الأشكال التي توجه الفكر في نفس الوقت وتعمل كهدف له. ثم، كما في القرن السابع عشر، تخيلنا أننا سنجدها فينا، أنه يكفي أن نفهم عقلنا للوصول إلى الطريقة التي من شأنها أن تسمح لنا بالوصول إلى الحقيقة. من جانبهم، اعتقد فلاسفة المدرسة التحليلية أنه من الضروري الاعتماد على اللغة، من المفترض أن توفر التصَوُّر الشامل لجميع المحتويات الممكنة والواقع وَسَط بَيْن الْمَعْنَى الْمُجَرَّد وَالْإِدْرَاك". ويضيف رورتي: "المناهج المختلفة (الكلية، اللاتأسيسية، البراغماتية) للمعرفة والمعنى (...) هي بالنسبة للعديد من الفلاسفة غير مقبولة تقريبا، على وجه التحديد لأنها ترفض أي مشروع للتناسب وبالتالي تقدم نفسها ك"نسبوية". (رورتي، [1979] 1990، ص: 350-351).
يمكن لنا أن نفهم أن ما يرفضه رورتي ليس اتفاقا أو إجماعا، بل افتراضا مسبقا بأن إطارا ثابتا ومتعاليا بطريقة ما، سواء كان خارجيا أو داخليا، سواء كان من نظام الأشياء أو من نظام ما يقع بين المعنى المجرد والإدراك، هو شرط الإجماع. بعبارة أخرى، ما يرفضه رورتي، في ظل هذا الافتراض المسبق للتناسب، ليس سوى افتراضات الثبات والذرية في تنظيم المعرفة. ذلك أن هناك "فكرة نجدها بين الأفلاطونيين كما نجدها بين الكانطيين والوضعيين: سيكون للإنسان جوهر - أي كاشف الجواهر. أن تكون مهمتنا الأساسية هي أن نعكس بشكل مناسب، داخل "جوهرنا المرآوي"، الكون الذي يحيط بنا، يستجيب للفكرة المشتركة بين ديموقريطس وديكارت، وهي أن الكون مشكل من أشياء بسيطة للغاية، يمكن معرفتها بشكل واضح ومميز، وأن معرفة جوهرها يوفر المعجم الرئيس لتناسبية جميع الخطابات". (رورتي، [1979] 1990، ص: 393).
انتقد فلاسفة ما بعد الوضعية هذه النزعة الذرية الغنوصية بشكل جذري مما يعني أنه من الممكن عزل بيانات معينة، أو تمثيلات معينة أو عمليات معينة، لبناء مجموع المعارف انطلاقا من هذه المميزات الأساسية وتحديد معايير الترسيم العقلاني للحدود. وقد شجب كواين هذه النزعة الذرية باعتبارها واحدة من عقائد التجريبية. في نفس السياق، انتقد دوهيم فكرة التجربة الحاسمة من خلال إظهار أنه لا يمكن عزل العنصر المراد اعتباره في مجال المعرفة لتأكيد النظرية. كل قضية علمية تحمل في طياتها مجمل المعرفة العلمية. يضيف كواين إلى "الشمولية المعرفية" لـدوهيم "الشمولية الدلالية": فهو يجعل شمولية المعرفة والثقافة هي ما يسمح لنا بالتفكير في استخدام ومعنى مفهوم العلم. تصادف انتقادات كواين للنزعة الذرية رفض المرآوية.
بالمثل، ساهم النقد الذي بلوره كواين لثنائية التحليلي والتركيبي في نقد أي شكل عقلاني خالص. لأنه من خلال القيام بذلك، يدعو كواين إلى التشكيك في فكرة أنه يمكن أن يكون هناك منهج، بعد استجابته لماهية عقلنا، سيسمح لنا بالوصول إلى الحقائق أو الوسيط بين المعنى المجرد والإدراك المنظم لجميع المحتويات الممكنة. لكن رورتي يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث شجب لدى كواين شكلاً من أشكال الحنين إلى الماضي في ما يتعلق بنظرية المعرفة والتجريبية، التي تسعى إلى إعادة بناء مفهوم الملاحظة بحدود البيذاتية، والتي تحدد ملفوظ الملاحظة على أنه "ملفوظ يحكم عليه جميع المتحدثين بلسان ما بنفس الطريقة عند خضوعهم لنفس المحفزات المترابطة" (كواين، [1969] 1977، ص: 101-102؛ رورتي، [1979] 1990، ص: (254). وقال رورتي ملاحظا: "يبدو لي ان كواين كان على حق عندما تصرف بتلك الطريقة لأجل الاحتفاظ بأساس الحقيقة الخاص بالنزعة التجريبية؛ ذلك أنه، من خلال القيام بذلك، نجعل واضحا أنه إذا كان أي شيء يمكن أن "يحل محل" نظرية المعرفة، فهو تاريخ وسوسيولوجيا العلوم، إنه بالتأكيد ليس علم النفس. لكن ليس هذا هو السبب الذي قدمه كواين. (رورتي، [1979] 1990، ص: 255).
نحن هنا في قلب فكر رورتي لأنه لا يربط نفسه من الداخل بنقد نظرية المعرفة. لا يتعلق الأمر بإنقاذها. وليست المسألة بالنسبة له هي استبدالها. إنه ينوي تجاوز إطار نظرية المعرفة، ومن ثمة المشاركة في حركة علمنة الثقافة التي تسعى إلى تحرير نفسها مما تحمله الحداثة بعيدا عن التقليد الأنطولوجي اللاهوتي. يغير رورتي زاوية اعتباراته: فهو يأخذ القضايا السوسيولوجية في الاعتبار؛ يجعل المجتمعية بعدا رئيسيا للثقافة. وبهذه الطريقة يشعر أنه خليفة ديوي الذي "صاغ خطبه اللاذعة ضد التصوير التقليدي كراء لشكل جديد من المجتمع" (رورتي، [1979] 1990، ص 23) الذي يعرف كيف يضيف البعد الاجتماعي والسياسي إلى النقد الإبستيمولوجي (:فيتجنشتاين) والتاريخي (هايدغر).
ذلك بالضبط هو سبب كون مسألة التناسب في قلب نقد استعارة الفلسفة التقليدية. في الواقع، تتناول الحداثة العقلانية كمجموعة من القواعد وباعتبارها تحيل بشكل صحيح إلى الطبيعة. ثم يُنظر إلى العقل على أنه "قدرة عبر ثقافية على التطابق مع الواقع، ملكة يتم إثبات امتلاكها واستخدامها من خلال الخضوع لمعايير صريحة" (رورتي، [1990] 1994، ص: 47). وبما أن العقلانية تقوم على ربط التطابق بالواقع واحترام منهج ما، أي احترام قواعد ومعايير موضوعة قبليا بطريقة أو بأخرى يتعين "اكتشاف"ها، يصبح من الواضح من ناحية أنه يمكن اعتبار العلم الطبيعي نموذجا للعقلانية؛ من ناحية أخرى، تكون الكونية والحقيقة متحدتين بشكل لا ينفصم. لكن فجأة يبدو أن تناسب الخطابات أصبح مؤشرا على طبيعة بشرية ثابتة، أبدية وعبر ثقافية. تستجيب المرآوية الغنوصية بشكل طبيعي تماما "لمفهوم الطبيعة البشرية كبنية داخلية تقود جميع أعضاء النوع إلى التقارب نحو نفس النقطة، إلى التعرف على نفس الفضائل، ونفس الأعمال الفنية التي تستأهل "الشرف". (رورتي، [1990] 1994، ص: 47).
لكن بجعل التناسب حجر الزاوية في التصور المرآوي، وجد رورتي رابطا قويا للغاية بين نظرية المعرفة والفلسفة السياسية. كلاهما يبحث عن السند في تأكيد وجود امة، طبيعة بشرية مشتركة. "لذلك من المفهوم أنه بالحفاظ على عدم وجود مثل هذه الأرضية المشتركة، يكون لدينا جو من المخاطرة بالعقلانية؛ فمن خلال التشكيك في هذه الحاجة إلى "التناسب" يبدو أننا نبدأ العودة إلى حرب الكل ضد الكل" (رورتي، [1979] 1990، ص: 351).
فضلا عن ذلك، وهذا هو الرهان المتمثل في تأكيد الأمل بدلاً من المعرفة أو أولوية التضامن على الموضوعية، يُنظر إلى البعد الاجتماعي والسياسي على أنه مشكل لإدراك أهمية خطاب العلم. ويستفاد من دروس تحليلات كوهن أن الخضوع للحقيقة ليس هو الذي يفسر اتفاق العقول، بل الاتفاق بين العلماء هو الذي يعكس تأكيد الموضوعية.
لكن هنا مرة أخرى، يذهب رورتي إلى أبعد من ذلك لأنه، إذا كان من الضروري الاحتفاظ بشيء من قابلية التناسبية من خلال تحرير الذات من كل الميتافيزيقيا ومن أي إكراه خارجي، فهناك شيء من "الوضع الطبيعي" في قابلية التناسب المقبولة. يتعلق الأمر فقط بتأويل "الخط الفاصل بين الخطابات التي يمكن جعلها قابلة للتناسب وتلك التي لا يمكن أن تكون كذلك، مثل تلك التي تفصل الخطابات"العادية"عن الخطابات "غير العادية"، وهو تمييز يعمم التمييز الذي يقوم به كوهن بين العلم "العادي" والعلم "الثوري". لا لا تتعلق المسألة هنا بمعيار ترسيم الحدود، لا مجال لمنظور تأسيسي، بل يتعلق الأمر فقط بمسألة اختلاف في الألفة، بمسألة عملية بحتة. من خلال جعل المحادثة والحفاظ على المحادثة كمفتاح للمعقولية وما يمكننا تسميته بعد ذلك ب"العقلانية"، نؤكد أن التضامن هو الذي يصنع الموضوعية، وأن الاتفاق بين الخطابات لا يمكن أن ينشأ من بعض الإكراه الخارجي، ولا يمكن من جهة ان يكون الاتفاق مطلوبا على هذا النحو. وهذه بالفعل هي الطريقة التي يمكن بها اعتبار النشاط العلمي نموذجيا لأن "المؤسسات العلمية تجعل من الممكن إعطاء فكرة الاتفاق بدون قيد توضيحا دقيقا ومفصلاً ؛ إنها توسع نطاق فكرة "مناقشة حرة ومفتوحة" (...) حيث تكون أفضل طريقة لمعرفة ما يجب تصديقه هي الانتباه إلى أكبر عدد ممكن من القضايا والحجج". (رورتي، [1987] 1990، ص: 55).
تلك رؤية الانتشار بدلاً من التقارب: لا يمكن أن نقترح شيئا أكثر ليبرالية. باختصار، إذا كان العلم شيئا نموذجيا، فذلك لأسباب أخلاقية أكثر منها معرفية: "الشيء الوحيد الذي يجعل العلم نموذجيا هو أنه نموذج للتضامن البشري". (رورتي، [1987] 1990، ص: 55).
هذا هو الرهان الكامن في رفض أولوية الموضوعية على التضامن. "بمجرد أن تحل المحادثة محل المواجهة، يمكن التخلي عن فكرة العقل-المرآة في الطبيعة". (رورتي، [1979] 1990، ص: 195).
ولكن، في الوقت نفسه، فإن التضامن باعتباره عقلانية "ضعيفة" وموضوعية مقبولة هو شرط لرفض النسبية. لأنه من الممكن رفض أي فكرة عن المعايير والمعايير القبلية التي يتعين الاستجابة إليها أو التي سيكون من الضروري التقرب منها كما لو كانت مثالا، والاكتفاء في باب الموضوعية "باتفاق بدون إكراه"؛ بجعل العقلانية "لوحة (...) لإجراءات التبرير المألوفة" ؛ بجعل الحقيقة هي الالتزام البسيط الذي نطبقه على المعتقدات المشروعة (مفهومة، على سبيل التذكير، ليس كأساسية بل ك"عادية"). ويوضح رورتي: "يرى خصومنا في ذلك موقفا" نسبويا "لأنهم لا يستطيعون تخيل إمكانية إنكار واقعة أن الحقيقة لها طبيعة جوهرية (...) نحن، معشر البراغماتيين، لا نملك نظرية عن الحقيقة، ولا حتى نظرية نسبوية؛ لأننا مؤيدون للتضامن، يقوم تفسيرنا لقيمة البحث البشري على أساس أخلاقي حصري، وليس على نظرية المعرفة أو على ميتافيزيقا ما". (رورتي، [1987] 1990، ص: 51).
بعبارة أخرى، إذا كانت البراغماتية تؤكد منظورا شموليا، أي أنه لا يمكن الخروج من الجماعات لنصل إلى وجهة نظر "متعالية" محايدة، فهي لا ترفض بأي حال إمكانية تبرير هذه الجماعات نفسها. ولا حتى التفضيل التي يمكن لنا أن نخص به مثل هذه الجماعات بدلاً من غيرها، مثلا، الجماعات الليبرالية على المجتمعات الشمولية. الاختلاف من الأهمية بمكان، هو لا يبحث في التضامن، في الجماعات، في المؤسسات الديمقراطية، عن وسائل مرتبطة بهدف ما، ب"قوة غير بشرية"؛ بينما التضامن هو الفضيلة الوحيدة والإطار الوحيد الذي يمكن أن يخلق الإيمان ويسمح للنشاط البشري أن يكون دائما أفضل وأكثر ثراء. هكذا يخلق الاختلاف واقعيا، عمليا اختلافا. تلك طريقة أخرى للقول أن "التضامن لا يتم اكتشافه بالتأمل: بل إنه يصنع". (رورتي، [1989] 1993، ص: 17).
ها نحن مرة أخرى نلتقي بهذا الوصف للبراغماتية بأنها ديمقراطية وأمريكية. هنا تلتقي السياسة بنظرية المعرفة. ذلك لأن تعارضات الفلسفة التقليدية تستجيب لتصور إقطاعي عن الثقافة. ربما يتعلق الأمر بأن نرى في التصور التقليدي الذي يسعى إلى المواجهة والثنائيات المتعددة (الروح/الجسد؛ الوقائع/القيم؛ الضرورة/الصدفة؛ الواقع/المظهر، إلخ..) انعكاس أو إسقاط الظروف الاجتماعية والسياسات للتنظيم القديم، غير المتكافئ، لمجتمع النظم. ويتذكر رورتي في هذه النقطة ما قاله ديوي: "اقتنعت بأن كل ما هو خطأ في الفلسفة الأوروبية التقليدية كان نتيجة لموقف التمسك بصورة قديمة للعالم ناتجة عن مجتمع غير متكافئ وتستجيب لاحتياجاته. بدت له الثنائيات القاتلة في التقليد الفلسفي كبقايا وتعبيرات عن التقسيم الاجتماعي الذي يعارض ، صمن البشر، أولئك الذين يتأملون والذين يعملون، طبقة مرفهة وطبقة منتجة". (رورتي، 1995، ص: 27).
وهنا بالذات نرى كيف أن البراغماتية هي انحياز لعملية العلمنة. إنها ترفض أي فكرة عن عملية أو نظام طبيعي يجب فهمه من أجل التصرف. على العكس من ذلك، عندما يتعلق الأمر بوضع المثقفين "في خدمة الطبقة المنتجة بدلاً من خدمة الطبقة المرفهة"، سوف "تتعامل البراغماتية مع النظرية على أنها مساعدة للممارسة بدلاً من أن ترى في الممارسة نتاج تدهور النظرية". (رورتي، 1995، ص: 29).
ها هنا، تعتبر البراغماتية كحركة فكرية تستجيب للعلمنة أمرا أمريكيا على وجه الخصوص: "ما يعارض الأوروبيين والأمريكيين يمكن أن يُنظر إليه على أنه معارضة بين الميل الإقطاعي لاعتبار أفعالنا في خدمة القوى العليا لأنها لازمنية، والميل الأمريكي إلى اعتبار إلا على مضض واجب الولاء لكل شيء فوق زمني". (رورتي، 1995، ص: 48).
ذلك أن هناك ثلاث سمات تميز البراغماتية: رفض كل جوهرانية (تظهر البراغماتية نفسها على أنها معادية للجوهرانية ومناهضة للتمثيلية)؛ رفض ثنائيات الطبيعة؛ رفض أي إكراه خارجي ومتعال، وتأكيد الطبيعة العرضية لجميع منطلقاتنا. ويوضح رورتي أن هذا هو التوصيف الذي يفضله: "البراغماتية هي المذهب الذي بالنسبة له لا يخضع البحث لأي إكراه، باستثناء إكراهات المحادثة - لأي إكراه كلي، ناتج عن طبيعة الأشياء، عن العقل أو عن اللغة، ولكن فقط تلك الإكراهات التفصيلية التي تنبثق من ملاحظات محاورينا في البحث".
بهذا المفهوم، يمكن القول بأن البراغماتية تستجيب بشكل فعال لروح أمريكا. لأن أمريكا في الأساس قوية بعرضية أصولها. دولة جديدة، تم اختراعها، انطلاقا من مبادرة الإرادة، تخلق باستمرار دون الاضطرار إلى الولاء ودون أن تكون مسؤولة عن ثقل زمن الأنظمة ووزن الماضي الذي يبرر نظاما يلزم، أمريكا بمثابة تجربة.
"هذا البلد وأبرز فلاسفته يقترحون علينا أنه يمكننا، في السياسة، إحلال الأمل محل هذه المعرفة المحددة للغاية التي اعتاد الفلاسفة أن يحاولوا الحصول عليها. لطالما كانت أمريكا دولة موجهة نحو المستقبل، وهي دولة لا تزال تفرح بخلق ذاتها في الماضي القريب نسبيا". (رورتي، 1995، ص: 18).
وهكذا تكمن مفارقة أمريكا في أن قوتها ترجع تحديدا إلى حقيقة أنها تجرب ذاها باستمرار وأن تطورها ذاته يتم في مطاردة الأفضل دائما لمستقبل يشكل المعيار الوحيد لعملها. الأمل بدلاً من المعرفة: هذا الإعلان جذري. "استبدلت بالأمل والمستقبل ما استثمرته أوروبا في الميتافيزيقا والإبستيمولوجيا. فعوض المحاولة الأفلاطونية للخضوع للزمن، تعلق الأمر بالأمل في إنتاج مستقبل أفضل" (رورتي، 1995، ص: 50).
لا يتعلق الأمر هنا باستبدال نظرية بأخرى، ضمن متتاببة تأخذ فيها الممارسة بطريقة ما مكانا جديدا في السلسلة الميتافيزيقية المعرفية..؛ الله، العلم ... لأننا بالتعريف لا نعرف شيئا عن المستقبل. لذلك من المستحيل معرفة أي من معتقداتنا ستكون مبررة غدا. هذا بالفعل ما يدل عليه تأكيد الاحتمالية لجميع نقاط البداية لدينا. "ليس أكثر من التطور البيولوجي أو تطور متطلبات الفضاء الحيوي، لا يتحدد التطور الثقافي وتطورات متطلبات التبرير وفقا لقانون. يتم تحديد أحدها مثل الآخر بشكل عشوائي من خلال سلسلة من الحوادث، أحيانا تكون سعيدة، وأحيانا غير سعيدة:". (رورتي، 1995، ص: 51).
الامل الذي يتعلق به الأمر ، الذي يتخلص إذن من أمل المعرفة، هو أمل بحت باحد الأشكال؛ "الأمل في أن ننجح في خلق عالم جديد، يمكن أن يعيش فيه أحفادنا، عالم لا يمكننا تصور سماته أكثر مما لم يمكن لنا نحن أنفسنا أن تتصورنا الأنواع التي سبقتنا خلال التطور". (رورتي، 1995، ص 52). باختصار، يسير الأمل هنا في اتجاه وسائل "للسيطرة على العابر بدلاً من السجود للأبدية" (رورتي، 1995، ص: 54).
البراغماتية إذن هي في الواقع من نظام الفعل والقرار، الذي يسعى إلى الجمع المناسب وليس التطابق أو التماثل مع حقيقة ما أو قيمة ما تقف خارج نظام الفعل، والتي من شأنها بالتالي إضفاء الشرعية على القرار أو الاختيار. ومن هنا نرى أن البراغماتية لا يمكن اختزالها في الأداتية. هذه الأخيرة التي تفصل نظام الغايات عن نظام الوسائل، والتي لا زالت تسعى إلى مطابقة ما، وملاءمة ما، وبالتالي إلى نقاط مرجعية خارجية.
على العكس من ذلك، فإن البراغماتية التي يتم تصورها على هذا النحو هي تأكيد على الممارسة الصارمة من خلال افتراض الصدفة، من خلال تأكيد العرضية. لكن ذلك، للتذكير، لا يرقى إلى اختزال البراغماتية في النسبوية لأن "المستقبل الأفضل" الذي يتم إنتاجه بعد ذلك يحدث فرقا. من غير المجدي، بالطبع، البحث عن نقطة ما للمقارنة يمكن من خلالها تحديد الطريقة الأفضل. الشمولية تقتضي ذلك: كلمة الأفضل هي كسائر العبارات التي لا تشير إلى العالم ولا إلى تمثيلات العالم، بل إلى عبارات أخرى. أفضل نتيجة لقرار متخذ هو ببساطة ما يجعل إمكانا يحققه ضمن مجموعة من الإمكانات. التعددية، المنافسة، المستقبل: البراغماتية تستجيب بفاعلية لتصور ليبرالي مناسب عن الثقافة ما جعل رورتي يقول إن "الأمريكيين قدموا لنا أفضل الأفكار حول كيفية التوفيق بين أمل التنوير وبيولوجيا داروين. (رورتي، 1995، ص: 54).
عند قراءة فكر رورتي بهذه الطريقة، رغم أنه راديكالي، قد يشعر المرء بالارتياح لأنه لم يكتب شيئًا عن التربية. هذا ما ينم عن سوء نية لأن الانتقادات التي عبر عنها شوشت على مفاهيم الفرنسيين سواء في باب نظرية المعرفة أو في ما يتعلق بالسياسة. ذلك أنه بقدر أكبر بالنسبة لأوروبا العجوز، يكون التصور الفرنسي المتجسد في التعليم المدرسي هو الذي قد يشعر بأنه مستهدف من انتقادات رورتي. إذا أردنا أن نصدق حايك، في الواقع، فإن الفكر الفرنسي هو الوجه النموذجي لهذه "العقلانية البنائية" التي تسعى إلى السيطرة على الطبيعة من خلال معرفة منابع الفكر، والتي تعتقد أنه من الممكن إعادة تشكيل العالم والمجتمع مثل المهندس الذي يبني جسرا أو صاروخا.
رأى حايك في التعارض بين "العقلانية التطورية" و"العقلانية البنائية" مفتاح الاختلافات الأكثر أهمية في عصرنا (حايك، [1973] 1995، الجزء الأول، الفصل الأول).
يتمثل مشروع رورتي، مثل مشروع ديوي، في "الاحتفاظ بليبرالية الأنوار مع التخلي عن عقلانيتها" (رورتي، [1989] 1993، ص 92). بهذا المعنى يبدو أن مبادئ إنشاء المدرسة في فرنسا هي التي تتعرض للهجوم. الطابع التحرري للمعرفة؛ الإعلان عن الكونية الإنسانية العقلانية، إشراك كل فرد في الجماعة القومية التي يشكلها ويحددها في آن واحد: إنها الفكرة ذاتها لمدرسة جمهورية تبدو مرفوضة هنا. لأن المدرسة في فرنسا، أو على الأقل فكرتها، يبدو أنها تشير إلى تلك "المحاولات الميتافيزيقية أو اللاهوتية لربط البحث عن الكمال بشعور الجماعة (التي) تلزمنا بالتعرف على طبيعة بشرية مشتركة. إنهم يطلبون منا أن نصدق أن الأهم بالنسبة لكل منا هو ما نشترك فيه مع الآخرين: أن نوابض الإنجاز الخاص والتضامن البشري هي نفسها". (رورتي، [1989] 1993، ص: 13).
سوف نكتفي هنا ببضع نقاط.، وقبل كل شيء بهذه النقطة، الأساسية، المتعلقة برفض كل مرآوية. ذلك أن هناك دائما بعض الأفلاطونية في تنظيم حتى البداغوجيا، التي تفترض أن المعرفة نظر وأن التدريس إتاحة النظر. من هنا هذه السبورة وهذه الطاولات التي وضعت أمامه، وهذا المعلم الذي يكتب ما يظهر، مموضعا لأنه يُنظر إليه، باعتباره شيئا-حقيقة ثابتة ومتطابقة للجميع في المقياس الدقيق الذي يتم تقديمه على أنه خارجي ومتعال على التلاميذ والمعلم سواء بسوا. احذفوا السبورة واستعيضوا عنها بـ"الدرس" الذي يتميز، بخلاف الدرس النموذجي، بإتاحة النظر إلى فكر المعلم من حيث الفعل والحركة؛ عندها سيحل ببساطة منهج الوصول إلى الحقيقي محل الحقيقي! وبشكل أساسي، نفس الشيء ينطبق على العلاقة الديداكتيكية التي تجعل من موضوع المعرفة ما يسمح بإقامة العلاقة بين الذات التي تتعلم والذات التي تعلم. كل واحد منهما يمنح ذاته على وجه التحديد في علاقة المساواة إلى الحد الدقيق الذي ترد فيه قابليتهما للتناسب إلى الخضوع لشيء يتعلق به كلاهما.
وماذا عن الافتراض المسبق عن الذرية؟ إنه يحكم تصورنا عن الأةدولي في المعرفة. ليت هذا الأخير يدرك كأساس او كعنصر ناتج عن تفكيك، نفترض انه من الممكن عزل بعض الأفكار، بعض المعطيات، بعض القضايا، بعض الكفايات الأثيرة وأن نعيد فهم المجموع انطلاقا منها. لا يبدو أن فكرة القاعدة المشتركة للمعرفة تفلت من هذا الافتراض المسبق، الذي يعتبر هذه المعرفة وهذه المهارات شروطا لإمكانية كل ما تبقى. اجتمعت الديكارتيكية والتجريبية ها هنا وتعانيان أيضا من انتقادات رورتي. تحويل، نقل ديداكتيكي، تمفصل المعرفة العالمة/المعرفة الملقنة لا يمكن له ان يفلت من افتراض قابلية الترجمة المندد به من قبل رورتي كشكل من أشكال الفرض الزائف لقابيلة التناسب.
هذا ينطبق حتى على الانتقال نحو الممارسة وتحليلها كما تطبق في تكوين المعلمين. من المسلم به أن تحليل الممارسات هو تحليل متناقض من حيث أنه لا يعتقد أن الكل قابل للاختزال إلى مجموع أجزائه: إنه يفترض أن شيئا لا يمكن اختزاله عمليا يفلت من التحليل. تبقى الحقيقة أن تحليل الممارسات المهنية، مهما كان التيار الذي نتبعه، هو دائما تفكيك وهذا بلا شك يسمح لنا بفهم الأهمية التي يعطيها للخاص والتفصيل. بيد انه، عند النظر إليه عن كثبب، يبدو، في مجال العمل والممارسة كليهما، أنه صورة رمزية للمرآوبة. إنه يضع افتراضا مسبقا يتمثل في الاعتقاد بأنه يكفي الشرح والتعبير والتوضيح، لرفع الحجاب عن تغيير الممارسات أو تحويلها. هنا مرة أخرى يجعل من النظر مبدأ للمعرفة ومن المعرفة مبدأ للقوة. باعتباره تجريبية على نحو منهجي، يتصرف كما لو كانت الوقائع موجودة قبل التحليل، والعدة التحليلية تقتضي تحديدا الكشف عن جزء من اللغز. وباعتباره ذرية، يفكر في الاشتغال على "وضعية" (مهمة، لحظة، مشكلة؛ الفروق هنا غير ذات بال) كما على عنصر، يتم تمييزه بطريقة أو بأخرى عن السياق الذي يتم فيه إدخال التحليل، متسلسلا ومنفصلا عن مسار العمل؛ قابلا لأن يعزل عن العلاقات مع وضعيات أخرى؛ منفصلا كحالة خاصة عن بنيات التفاعلات.
إذا كان علينا إذن أن نجد بعض التصورات التي يمكن أن تقاوم اعتراضات رورتي، فربما يمكننا الأخذ بعيادة النشاط (إشارة إلى العمل الذي تم إجراؤه حول إيف كلو بواسطة مختبر CNAM). يسلط هذا المفهوم "الشامل" الضوء على العلاقات ليس بين الأفراد في حد ذاتهه ولكن بين مستويات النشاط (الشخصية، البيشخصية، غير الشخصية، عبر الشخصية)، وبين أساليب العمل (الموصوف، والمنفذ، لحقيقي، الممنوع) ولا تتوخى المهمة، ولا الفعل، بل النشاط كتعبير ليس عن فرد بقدر ما هو تعبير جماعي في الفرد وعن دور الفرد في تنمية الجماعة. ما يجعل من الممكن تسليط الضوء على عيادة النشاط من خلال توفير أداة قوية لفهم علاقتنا بمهنتنا وتحولات مهنتنا، إنه بالضبط تعبير عن نموذج للتضامن. نتيجة لذل ، لم يعد تحليل العمل سيكولوجيًا بحتًا ليصبح سياسيا محضت.
يساعد هذا الالتفاف من خلال عدة عملية لتكوين المعلمين على فهم كيفية استجابة تنظيرات رورتي لعمليات دمقرطة المجتمع وعلمنة الثقافة. من المؤكد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا التخلي عن فكرة الموضوعية العقلانية والمثل الأعلى للكونية. نحن نقاوم هذا الأمر بالتخلي عن العالم من أجل ربط أنفسنا بالحكاية؛ بوضع السخرية مكان اليقين. بالبناء والاختراع، العمل بدون سلطة وبدون التحكم في مستقبل ممارساتنا ، مع برنامج وحيد يتلخص في الأمل في الأفضل بدون غاية مثالية. لكن نقد رورتي، الذي يكمل مساهمات الوضعيين وما بعد الوضعيين، يساعدنا على تحرير أنفسنا من التصنيفات والانقسامات التي، وهي تقسم التخصصات والثقافات، تضع حدودا أمام البحث وتدعو إلى الإنغلاق. هناك مصلحة معرفية وسياسية في انتقادات رورتي. لأنه إذا كان صحيحا أن التضامن البشري لا ينبع من وقائع وموضوعات مثبتة مسبقا، إذا لم يتبع التقاليد بشكل طبيعي؛ إذا كان نتاج علاقات بين الأفراد، فعندئذ وحدهما النقاش، ومقاومة الإكراهات الخارجية هما خميرة الديمقراطية.
ومن ثم فإن التربية أمر أساسي لا يتم اختزاله في "التعلم الخالص والبسيط لنتائج البحث العادي" الذي يجعل "فن صياغة الأشياء ذا أسبقية على امتلاك الحقائق"، يرتبط بهذا "المبنى"، بهذا "الصرح"، كلمتان ا تشيران إلى "هذا البحث عن صيغ أفضل وأكثر إثارة للاهتمام وأكثر إثمارا" (رورتي، [1979] 1990، ص: 395-396). انطلاقا من هنا، فإن النقد المشترك للعقلانية والموضوعية والكونية باسم رفض المرآوية ليس رفضا للثقافة. يأخذ المنظور العملي والأخلاقي الأسبقية على الجذور الإبستيمولوجية، لكن الثقافة العلمانية لا يمكن أن تختفي بسبب كل ذلك. تظهر على العكس من ذلك، بقدر ما يتم تصورها في تعددية تعابيرها ومفرداتها، كما يتعين تعليمها. ولهذا السبب يمكن أن نتفاجأ بتحليلات رورتي، التي تظهر، كما قلنا، النزعة الأمريكية في فلسفته، والتي يمكن أن ترفض أي هدف كوني، ومع ذلك نرفض ما نسمعه اليوم في فرنسا تحت اسم الطائفية، أي أهمية الفرد. إذا اتبعنا رورتي، بشرط أن يكون ليبراليا، فإن التربية تحديدا تضمن لنا - سواء كنا فنانين او شعراء أو علماء- أن نتمكن جميعا من الوصول إلى تعدد هذه النصوص الروائية والتاريخية والصحافية والفلسفية التي تمنحنا معنى عرضية مراجعنا وبالتالي وعي مجتمعنا، وتقترح أو تؤدي إلى ممارسات جديدة. وهكذا تساهم التربية في علمنة الثقافة: مشروع أخلاقي وسياسي، سيشارك في هذه الحركة التي تساهم في توسيع الإحساس بتضامننا في عمل لا يمكن فيه التغاضي عن وجهة نظر الآخر. هذا تضامن بلا سيطرة. هذه هي الديمقراطية.